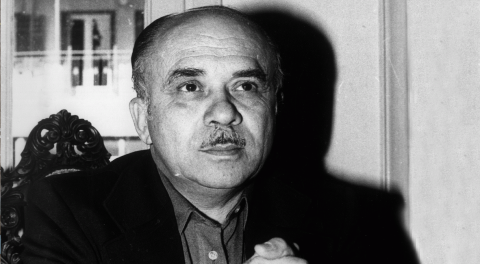يصدر مطلعَ الشهر القادم عن دار الآداب كتاب جديد لأستاذ علم اجتماع المعرفة في الجامعة اللبنانيّة، د. فؤاد خليل، وهو بعنوان: العروبة رِكازُ الأمّة ـــ في ثنائيّة العروبة والإسلام. وقد اخترنا هنا جزءًا كبيرًا من مقدّمته.
في النعي والقصّة الصغرى
الكتابة في العروبة اليوم قد تكون، في نظر بعض من أهل الفكر والثقافة، ضربًا من التفكير النوستالجيّ البائس، وانزياحًا عن الفكر المعاصر إلى قضايا فائتة لم تعد تملك مشروعيَّتَها التاريخيّة والنظريّة. وربما تكون عند بعضٍ آخر انزلاقًا إلى وعي إيديولوجيّ زائف يحاول أن يحجبَ حقائقَ الواقع، وأن يطمس مكوّنات الحاضر المجتمعيّ بواسطة مفاهيم كبرى، كالعروبة والقوميّة والأمّة والوحدة أو الاتحاد ــــ وهي مفاهيمُ باتت، بالنسبة إليه، أقربَ إلى حديث الخرافة منها إلى حقيقة المعيش.
لذا، لم يكن مستغربًا أن يذهب رهطٌ من هذا البعض أو ذاك إلى نعي العروبة، والطعنِ في القوميّة العربيّة، والشكِّ في وجود أمّة عربيّة، وتصوُّرِ أيّ حديث عن أيّ شكل وحدويّ بأنّه حديثٌ في التهويم. كأنّما المفاهيم أو الظواهر، حسب منطقه، تنشأ وتزول بناءً على انطباع شخصيّ أو حُكم قيميّ أو نزق فكريّ.
هذا الرهط، وهو على أسماءٍ(1) ووجوهٍ متعدّدة، استند في مواقفه أعلاه إلى الطفرة الفكريّة العالميّة التي دعت إلى "فكر النهايات،" بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفييتيّ، نحو: نهاية(2) التاريخ، ونهاية الإيديولوجيا، ونهاية اليوتوبيا. والمعلوم أنّ هذا الفكر وَجد في الليبراليّة خيارَ البشريّة النهائيّ؛ وهو الخيار الذي "انتصر له التاريخُ" وانتهى به في الغرب، بعد أن ثبت "فشلُ (أو عقم)" الإيديولوجيّات الشموليّة التي أخذ بها العالمُ غيرُ الغربيّ في بناء تاريخه وأشكالِ تنظيمه المجتمعيّ والسياسيّ: كالماركسيّة والقوميّة والاشتراكيّة والوطنيّة وإيديولوجيّات التحرّر الوطنيّ. وتبعًا لهذه الرؤية يغدو مطلوبًا من العالم الشموليّ أن يندرجَ في الليبراليّة، وفي حركة السوق "العقلانيّة،" من أجل التخلّص من "شقاء التاريخ" الذي يعيش فيه، ولكي يفوز بـ"التاريخ الحقيقيّ" ويدخلَ إلى "الفردوس الأرضيّ"!
على هذا، يظهر أنّ رهطَنا المثقّف وجد سندَه أو إطارَه المرجعيّ في تلك الطفرة. فجرى "فكرُ النهايات" على لسانه رَذْلًا للإيديولوجيّات الشموليّة، ونعيًا (ثمّ تشييعًا) للعروبة، وطعنًا في القوميّة، وشكًّا في الأمّة. ومن ثمّ أجرى تعظيمًا لخيار الليبراليّة، و"أسطرةً" للديمقراطيّة،(3) وتزيينًا لفوائد السوق واعتبارها السبيلَ الوحيدَ لخلاص الإنسان من "البؤس والتخلف."
لكنّ التاريخ لم ينتهِ، على ما اعتقدَ "أهلُ النهايات." فما سُمِّي "النظامَ العالميّ الجديد" أَطلق منذ التسعينيّات مسارًا معقّدًا من الصراعات التي تأثّرتْ بأطروحة "صِدام(4) الحضارات،" واتّخذتْ أشكالًا تتعاكس مع "الخيار النهائيّ" للبشريّة وهي: الإثنيّة والعِرقيّة والدينيّة. وحينما وقعتْ أحداثُ الحادي عشر من أيلول تفاقمت الصراعاتُ على المسرح الدوليّ كلّه، إذ أقدم الغربُ السياسيّ الليبراليّ، بقيادة الولايات المتحدة، على السيطرة المباشرة والمعولمة أمنيًّا وعسكريًّا على بلدان الجنوب، وبخاصّةٍ على بلدانٍ عربيّةٍ وإسلاميّة. فتبيّن، بالملموس، أنّ هذا الغرب ما زال يتموضع في مجرى التاريخ من خلال السيطرة على الآخر غير الغربيّ بذريعةٍ "حضاريّةٍ" معاصرة، هي "مكافحة الإرهاب." كما تبيّن أنّ الرأسماليّة، وهي الاسمُ الحقيقيّ لليبراليّة القديمة أو الجديدة، تحتاج دائمًا إلى اصطناع عدوٍّ خارجيٍّ من أجل شنّ الحرب عليه، أو إلى خارجٍ تابعٍ لكي تستغلّه وفاق شروطٍ تريدها "مثاليّةً" دائمًا.
إذن، التاريخ ما زال يجري، وما زالت الليبراليّةُ في حمأته تبني عالمًا معاصرًا يشهد باستمرارٍ تهميشَ أو إقصاءَ كتلٍ بشريّةٍ واسعةٍ في أرجاء المعمورة كلّها. وجرّاء ذلك، انهار "فكرُ النهايات" وتلاشى في تضاعيف التهميش المجتمعيّ المعولم، فتراجع عنه صاحبُه ومقلِّدوه. ثم أخذت الساحةُ الثقافيّةُ في الغرب تَطرح، من جديدٍ، مفاهيمَ الوطنيّة والهويّات المفردة والجماعيّة، أو الجزئيّة والكلّيّة، التي تمثّلتْ لدى عدد من المفكّرين والباحثين في سؤال: "من نحن؟" أوْ: "من نكون؟"
إنّ سؤال الهويّة المتجدّد جعل أفكارَ مثقّفينا حول النعي، والتشكيكِ في العروبة والأمّة، في وضع "الفوات التاريخيّ." فما نعاه الواقعُ، في النهاية، هو النعيُ الذي ركن إليه هؤلاء؛ ذلك أنّ أفكارهم لم تتحصّل من الحقائق الموضوعيّة في مجتمعاتنا، بل من الانفعال بطفرةٍ فكريّةٍ أصابت زهوًا إيديولوجيًّا للحظةٍ من الزمن.
وثمّة اليومَ أيضًا ميلٌ من بعض مثقّفينا إلى فكرِ ما بعد الحداثة،(5) وهو يظنّ أنّه يمارس معاصرةً فائقة. وتماشيًا مع ما لجأ إليه، تراه يعترض على أيّ أصلٍ أو مبدأ في النظر، ولا يُقرّ إلّا مبدأً واحدًا هو "الصيرورة." وهكذا، فالأصل الميتافيزيقيّ الذي يتحدّد به الإيمانُ، ويجعل الإنسانَ يتجاوز ذاتَه من أجل معنًى أو غاية، هو ـ في نظره ـ لغوٌ لا طائلَ منه. والحال أنّ الإنسان، من وجهة النظر هذه، كيانٌ طبيعيٌّ أو مادّيّ، يحرّك الاقتصادُ والرغبةُ صيرورةَ حياته، فيعيدان إنتاجَ ماديّته وطبيعته، من دون أدنى حاجة إلى التجاوز والتعالي.
والعقل، الذي يشكّل مبدأَ النظر في الطبيعة والمجتمع، ويملك أن يُنتج معرفةً عامّةً بهما، لا يُنتج، عند مثقّفنا ما بعد الحداثيّ، إلّا معرفةً محدودةً في إطار الظاهرة المدروسة؛ أيْ إنّه لا يملك أن يتجاوزَ المعرفة بالجزئيّ إلى ما هو كلّيّ، أو بالخاصّ إلى ما هو عامّ، أو بالمفرد إلى ما هو جمعيّ. وهذه النظرة تحيل على عالمٍ يعيش واقعَ التشظّي والتجاور والانقطاع: فلا يعود هناك كلٌّ أو شمول، أو قضيّةٌ عامّة، أو مفاهيمُ كبرى، أو ديمومة؛ بل يغدو الجزءُ يجاور الجزءَ الآخر، ينقطع عنه ويعيش في صيرورة مستقلّة، فيصبح في تغيّر دائم، وتصبح نسبيّتُه مطلقةً، ويتفلّتُ من كلّ حقيقة أو يقين يصدران عن مبدأ عقليّ أو أصلٍ ميتافيزيقيّ. إذّاك، لن تبقى للإنسان إلّا صيرورةُ الجزئيّ، يبني من خلالها قصّتَه أو سرديّتَه الصغرى، ثم يأخذ يرويها إلى إنسانٍ آخر. وعليه، يغدو المجتمعُ عبارةً عن "قصصٍ" صغيرةٍ متبادلة، أو "محادثةٍ" بين سرديّاتٍ شخصيّةٍ متغيّرةٍ باستمرار، وبالتالي تتلاشى منه السرديّاتُ الكبرى: أي القضايا المجتمعيّة والوطنيّة العامّة.
التجاوز الغائيّ، الكلّ المجتمعيّ، القضيّة العامّة، الظواهر الشاملة، القوميّة، العروبة... الخ: كلّها مفاهيمُ أو سرديّاتٌ كبرى يَطرحها جانبًا ما بعد الحداثيّ، ويهتمّ بالجزئيّ أو بقصّته الصغرى؛ وهي قصّةٌ تنطوي في أحد عناوينها على هويّته الفرديّة التي لا تنشغل بالقيم الإنسانيّة أو بالغايات الكبرى، بل بغايةٍ قد تكون شبه وحيدة: الجري الدائم وراء متعة الاستهلاك.
أيًّا يكن الأمر، فإنّ مَن يتفحّص واقعَنا العربيّ يجد أنّ قضايانا كبيرة جدًّا ومصيريّة؛ وأنّ مستقبلنا يتوقّف ـ إلى هذا الحدّ أو ذاك ـ على مبدأ النظر إليها . وليس من المبالغة القول إنّ العروبة تأتي في طليعة تلك القضايا، وإنّ أيّ رفض لدورها في حفظ الكيانات العربيّة يعرّض كلَّ مجتمعٍ عربيّ لخطر التشظّي والتبعثر في منطويات الإثنيّ والعشائريّ والطائفيّ والمذهبيّ. وحينذاك، لا يبقى أمام المثقف العربيّ المسحور بفكرِ ما بعد الحداثيّ متّسعٌ من الوقت لكي يصنع سرديّتَه الصغرى؛ ذلك لأنّ السرد الحقيقيّ يكون للهويّات الفرديّة والجمعيّة (طائفيّة ـــ مذهبيّة) المتذابحة إلى يوم الدين.
سرديّة معاكسة
يُفصح السردُ الحقيقيّ الراهن في المشهد العربيّ عن نفسه في ثلاث ديناميّات قاتلة:
1) ديناميّة التدخّل الكولونياليّ الجديد، التي قد تذهب إلى إعادة بناء الدول في المشرق العربيّ وفاق خارطةٍ جديدةٍ، بما يَخدم المصالحَ الكولونياليّة في نهب النفط والغاز من بلادنا، ويَضمن أمنَ العدوّ الإسرائيليّ.
2) ديناميّة الاستبداد العربيّ، في شكليْه الجمهوريّ والملكيّ، التي تتغذّى من دعم حركات الإسلام السياسيّ المتطرّف ومحاربتها في آن، من أجل تأمين شروط تجدّد الاستبداد واستمراره.
3) ديناميّة الاستبداد الدينيّ (السلفيّة الجهاديّة بشتّى أسمائها)، وهي ديناميّةٌ تضرب في وجود الدولة والمجتمع، وتجري على إيقاع عصفٍ جوْفيّ في النسيج المجتمعيّ القائم.
ثمّ جاء التداخلُ بين هذه الديناميّات لينتجَ أشكالًا من الصراعات الهويّاتيّة المفردة، أيْ أشكالًا من الصراعات القبليّة والطائفيّة والمذهبيّة التي تهدّد وحدةَ المجال الوطنيّ للدولة، أو وحدةَ مجالها المجتمعيّ.
لكنْ، على الرغم من كارثيّة هذا السرد، فإنّه لا يعكس البتّةَ انسدادًا تاريخيًّا كما يرى كثيرون. فالتاريخ لا يُقاس بعمر فردٍ، أو بلحظة، أو بمرحلة؛ ذلك أنّ المجتمع لن يفقد خزينَه التاريخيّ والبنيويّ تحت وطأة مرحلةٍ ما. بتعبير آخر: لن يفقد المجتمعُ العناصرَ البنيويّة لمشترَكِه (اللغة والثقافة والتاريخ وأشكال التنظيم المجتمعيّ...الخ). وهذا المشترك، الذي يحفظه المجتمعُ بالرغم من صراعات مكوّناته، ليس إلّا سرديّتَه الكبرى التي تتجسّد في العروبة المجتمعيّة، وهي الرابطة الجامعة التي تشكّل ضرورةً وجوديّةً لبناء الدولة الوطنيّة وبقاءِ تلك المكوّنات على قيد الحياة.
هنا يظهر أنّنا نأخذ بسرديّةٍ معاكسةٍ للسرديّة المرحليّة السائدة، التي تتنامى في ضوئها الأحاديثُ والقصصُ عن صراعات الهويّات ما قبل الدولتيّة المدمِّرة. فاذا كانت السرديّة الراهنة تدميريّةً، فستغدو الحاجةُ أكثرَ من ضروريّة لمواجهتها، ليس فقط في السياسة والاقتصاد والعسكر، بل أيضًا في الحقل الفكريّ لدى كلّ عاملٍ في هذا الحقل ما زال يلتزم برسالته في الدفاع عن القيم والقضايا المجتمعيّة والإنسانيّة الكبرى، ويرى في "القصّة الصغرى" أو في انتفاء المعنى والغايةِ من الوجود أقصرَ الطرق إلى خسارة معنى وجوده بالذات.
من هذا المنطلق أخذنا بالعروبة، سرديّتِنا الكبرى في هذا البحث. وهي سرديّةٌ تحتاج، بكلّ تأكيد، إلى مقاربةٍ جديدةٍ تتعارض مع السائد أو الشائع عنها كما يتمثّل في الكتابات العربيّة في المشرق والمغرب العربيْين على السواء. ذلك أنّنا لن نجد في استغلاق الجماعات على ذاتها إلّا اندفاعًا نحو الفتنة، أيْ حربِ الواحدِ على الجماعة؛ كما لم نجد في الحرب الأهليّة إلّا حربَ الآحاد (الجماعات) على مشتركها.
وعليه، فحين نقوم بمقاربة العروبة بالتأسيس على المشترك البنيويّ في كلّ مجتمع عربيّ، وبتظهير جدليّة العلاقة بينه وبين مكوّناته، نكون قد قدّمنا ـ على ما نزعم ـ جديدًا معرفيًّا يَنقض فكرَ الفتنة والحرب الأهليّة: وهو ما يتمثّل في أنّ المجتمعيّ يبقى حيًّا بالعروبة، وأنّ العروبة تبقى حيّةً بالمجتمعيّ.
إطار الفهم
ينطلق إطارُ الفهم في بحثنا الراهن من أنّ مقاربات الفكر العربيّ للعروبة على قاعدة التلازم بينها وبين الإسلام أدخلت التناقضَ إلى هويّة الأمّة العربيّة حين وجدتْ أنّ مشترَكَها المجتمعيّ، أو أساسَها الهويّاتيّ، يتمثّل في الإسلام لا في العروبة؛ أيْ حين أحلّت الجزءَ مكانَ الكلّ، أو المكوّنَ الواحدَ مكانَ مشترك المكوِّنات كلّها؛ فعاشت التمزّقَ في هويّتها: بين ماضٍ تراثيّ لن يعود، وحاضرٍ مجتمعيّ لا ينبني بواسطة نسْخِ (أو نقل) حاضرٍ مجتمعيٍّ من الخارج.
كما أنّه ينطلق من أنّ العروبة الرسميّة، أو عروبة الأنظمة، في صيغتيْها: عروبة "المواجهة" (الأنظمة الجمهوريّة) وعروبة "الموادعة" (الأنظمة الملكيّة والأميريّة)، وَجدت انتظامَها التاريخيّ في مشروعٍ سياسيّ حوّلها إلى إيديولوجيا سلطويّة تعبِّر عن مصالح أهل الحكم في السياسة والاقتصاد والاجتماع. وهو ما جعلها تحجِّب القمعَ والاستبدادَ تحت شعاراتٍ وطنيّة وقوميّة وهي تمالئ ثنائيّة العروبة والإسلام. كما أنّ عروبة الأنظمة تُخفي الفئويّة، نظيرَ المِلّة أو النِحْلة (العصبيّة)، باسم "الوحدة الوطنيّة"، وتسوِّغ إلغاءَ السياسة في المجتمع تحت يافطة "الاستقرار والتقدّم." فكان من الطبيعيّ أن تعجز العروبةُ الرسميّة عن تحقيق المهامّ المتعلّقة بالوطنيّ والقوميّ، كما المرتبطة بالاقتصاديّ والمجتمعيّ.
ومع هذا العجز المتنامي طوال عقودٍ متتالية، كانت العروبة الرسميّة تَحْكم على نفسها بالموت البطيء والمحتوم، وتخطُّ بقلمها الرسميّ أوراقَ نعيها، قبل أن يَكتب رهطٌ من أهل الفكر والثقافة أوراقَ نعيه الخاصّةَ بها.
وفي تينك الحاليْن شكّلت الثنائيّةُ بين العروبة والإسلام عقبةً معرفيّةً أمام تظهير الأساس المادّيّ والرمزيّ لهويّة الأمّة العربيّة؛ وأعني الأساسَ الذي يخلّصها من التمزّق والتناقض في وعيها لذاتها وللآخرين في آن. وهذا لن يكون إلّا بتجاوز تلك الثنائيّة، بما يتيح تظهيرَ المشترك المجتمعيّ، أساسِ الهويّة الجامعة بين مكوِّناته.
إنّ المجتمع، في أيّ كيان عربيّ، لا يحفظ وجودَه موحَّدًا إلّا برابطةٍ أو هويّةٍ تتأسّس على المشترك البنيويّ بين مكوِّناته المفردة. وتلك الرابطة لن تكون سوى العروبة لأنّها تمثّل التجسيدَ الواقعيّ لهذا المشترك من جهة، ولأنّها تتبدّى بأشكال متفاوتة في عناصر المجتمع المتنوّعة من جهةٍ أخرى. إذّاك تغدو العروبة رابطةً وطنيّةً تؤطّر التنوّعَ في داخل الوطنيّ، ورابطةً قوميّةً تأتلف المتعدّدَ بين الوطنيّ والآخر. بمعنًى آخر: العروبة تشكّل حاملَ الوحدة في التنوّع، والتنوّع في الوحدة. وبذلك تغدو متساوقةً مع الديمقراطيّة بوصفها نمطَ حياةٍ يؤطِّر جدلَ العلاقة بين الوحدة والتنوّع في نطاق منظومةٍ فكريّةٍ حداثيّة تنهض ابتداءً على الفرد المواطن، وتنتهي بالدولة الوطنيّة بوصفها التعبيرَ السياسيّ عن سيادة المجال العامّ وأداةَ تنظيمه وعقلنته.
وحين تتأسّس العروبة على المشترك، يكون لكلّ عنصرٍ منه، في ماضيه وفي حاضره، نصابُه المخصوصُ في عمليّة البناء. وبالطبع تكون أحجامُ الأنصبة متفاوتةً من حيث الكمّ والكيف. لكنّ التفاوت هنا لا يمكِّن أيَّ عنصر من أن يختزِلَ المشتركَ بثقافته أو بدينه أو بفلسفته أو بإيديولوجيته الخاصّة، لكون المشترك نتاجَ عمليّةٍ متكاملةٍ لكلّ العناصر مجتمعةً، لا نتاجَ جهودٍ فرديّةٍ أو متفرّقةٍ لكلّ عنصرٍ منها على حدة.
وتبعًا لذلك، لا يعود بوسع دينِ أيِّ عنصر (الإسلام أو أيّ دين آخر) أن يسم العروبةَ بثقافته دون سواه، بل تغدو أديانُ جميع العناصر (الجماعات) مكوِّناتٍ ثقافيّةً وتراثيّةً لهذه العروبة، وإن اختلفتْ درجةُ تأثير مكوّنٍ عن آخر. وهذا يعني أنّ العروبة المجتمعيّة، كرابطة جامعة، تغدو متلائمةً مع العلمانيّة؛ ذلك أنّها تتحرّر من دينٍ بعينه، لكونها تأتلف أديانَ المشترك كلّها وتجمع بينها. وحينما تتحرّر العروبةُ من دينٍ ما، فإنّها تعيد إليها (أيْ إلى هذه العروبة) الدينَ في وصفه مكوِّنًا ثقافيًّا وتراثيًّا، لا في وصفه الـ ثقافةَ أو الـ تراثَ.
وفي المساق نفسه، يأخذ العنصرُ العربيّ (الجماعةُ العربيّة) موقعَه أو مكانتَه إزاء العناصر الأخرى من خلال فعله البنائيّ في عمليّة تشييد المشترك، لا من خلال ميزاتٍ أو خصائصَ ثابتةٍ تعود إلى جنسه أو عِرقه أو لونِه. كما تأخذ العناصرُ (الجماعاتُ) موقعَها أو مكانتَها إزاءه، وإزاء بعضها البعض، في ضوء أفعالها البنائيّة في مجرى العمليّة ذاتها، لا في ضوء ميزاتٍ أو خصائصَ ثابتةٍ ترجع إلى قوميّة كلّ عنصرٍ منها أو إثنيّته أو عِرقه. وبذلك تتخالف طبيعةُ العروبة، كما نفهمها، مع كلّ فلسفة تسِمُها بالعرقيّة أو بالهيمنة العربيّة؛ ذلك لأنّ المشترك الذي تتأسّس عليه قد صنعه الجميعُ، ولا يستمرّ إلا بصناعة الجميع.
وهكذا يظهر أنّ العروبة سرديّةٌ كبرى تتوافق طبيعتُها، التي تجمع بين الوحدة والتنوّع، مع الديمقراطيّة. وهي تتلاءم مع العلمانيّة، لأنها تملك أن تتحرّر من أيّ دينٍ بعينه. وهي تنطبع بالإنسانيّة، لأنها لا تقوم على أيّ عِرقٍ أو جنسٍ أو لونٍ دون سواه. إنّها، والحال هذه، عروبةٌ مجتمعيّة ــ ثقافيّة تتوافر على شروط بنائها المتواصل، وتتفاعل مع حقائق العصر ومتغيراته.
بيروت
1ـ من تلك الأسماء على سبيل المثال: حازم صاغية، وداع العروبة (بيروت: دار الساقي، 1999).
2ـ نشير هنا إلى كتاب فرنسيس فوكاياما، نهاية التاريخ والإنسان الأخير (بيروت: مركز الإنماء القوميّ، 1993).
3ـ انظر نقد الديمقراطيّة في: نعوم شومسكي، إعاقة الديمقراطيّة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة، 1992).
4ـ نشير هنا إلى كتاب صمويل هنتنغتون، صِدام الحضارات (ليبيا: الدار الجماهيريّة للنشر والتوزيع، 1999).
5ـ انظر حول هذا الفكر على سبيل المثال: د. أحمد عبد الحليم عطية، ليوتار والوضع ما بعد الحداثيّ (دار الفارابي، 2011)؛ د. أحمد عبد الحليم عطية، جاك دريدا والتفكيك (دار الفارابي، 2010). وانظر نقد الفكر ما بعد الحداثيّ في: د. عبد الوهاب المسيري ود. فتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة (دار الفكر، دمشق، 2003).