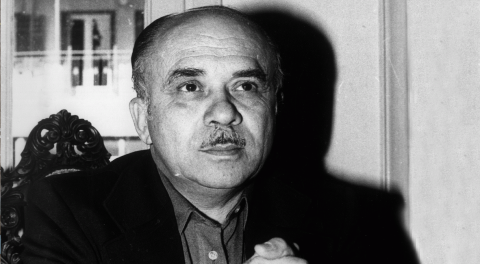باحث ومترجم فلسطينيّ. طالب في برنامج
الدكتوراه في العلوم الاجتماعيّة في جامعة
بيرزيت. يشارك في تأليف كتاب حول سيرة
رئيس بلديّة نابلس الأسبق بسّام الشكعة
وتجربته.

غسّان كنفاني وباسل الأعرج كاتبان وشهيدان فلسطينيان قضيا على يد آلة العنف الاستعماريّ الصهيونيّة، اغتيالًا واشتباكًا. هذا التوكيد مهمّ لأنّ استخدامَ مصطلحات من قبيل "الأديب، المثقّف، الصحفيّ،" من جهة، أو "المناضل، المتحدّث، المقاتل، المعتقَل، المطارَد،" من جهةٍ أخرى، قد يَمنع الجمعَ بين كنفاني والأعرج في سياقٍ واحد كما تفترض هذه الورقة.
تحاول هذه الورقة تناولَ المشترك في تجربة الكتابة لدى كنفاني والأعرج، صاحبَي الحياة القصيرة والتجربة الكثيفة، وفكرة الاستمراريّة فيها، على الرغم من عشرات السنوات التي فصلتْ بين مولدهما وفعلِ كتابتهما واستشهادهما - - وهي استمراريّةٌ قد تعكس جانبًا من استمرار فعل مقاومة الاستعمار فلسطينيًّا نتيجةً لاستمرار فعل الاستعمار نفسه. وتدّعي هذه الورقة أنّ كنفاني والأعرج، على الرغم من اختلاف ظروف حياتهما (زمانيًّا ومكانيًّا ومهنيًّا)، واختلافِ خلفيّتهما الثقافيّة والطبقيّة، واختلافِ شكل الاستعمار الإسرائيليّ الذي عايشاه، قد استطاعا الإمساكَ بالخيط الناظم لهذه التجربة الاستعماريّة، ولمقاومتها التي كانا جزءًا منها.
تفترض الورقة أنّ كنفاني والأعرج يتقاطعان في فعل الكتابة عن التحرّر من الاستعمار، وأنّ كتابتَهما هذه تشكّل جزءًا من محاولة الفلسطينيّين ممارسةَ هذا التحرّر؛ فكتابتُهما تصف وتحلّل الفعل، ولكنّها جزءٌ منه في آن. لذلك ستتناول الورقة فعلَ مواجهة الاستعمار في التجربة الفلسطينيّة من خلال:
- نصّين لكنفاني: نصّ فكريّ (ثورة 1936 - 1939 في فلسطين) ونصّ أدبيّ (عن الرجال والبنادق). يتناول أوّلُهما ثورةَ العام 1936 والنكبة، ويتناول الثاني العملَ الفدائيّ الفلسطينيّ في الستينيّات من القرن الماضي.
- نصوص للأعرج، مأخوذة من كتابٍ صدر بعد استشهاده. ضمّ هذا الكتابُ مقالاتٍ منشورةً له، ونصوصًا أخرى كان قد نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، وهو بعنوان: وجدتُ أجوبتي. هذه النصوص تتناول مسألةَ التحرّر من الاستعمار، ولكنْ يمكن أيضًا أن تُحلَّل بوصفها فعلَ كتابةٍ تحرّريًّا.
تفحص الورقة مدى توقّف كنفاني والأعرج عند إبراز طريقة تشكيل الاستعمار لنا. كما تفحص مدى تمكّنهما من التقدّم في اتجاه البحث عن نموذج معرفيّ يرفض فكرةَ "المثقّف كصناعة حداثيّة." وتفحص الورقة أيضًا موقعَ هذين الكاتبين في الإنتاج المعرفيّ، ودورَ هذا الإنتاج في التثوير والتغيير؛ علمًا أنّ فكرة "الموقع" هنا لا تتعلّق بأمرٍ خارج فعل الكتابة، بل هي أمر يبرز من داخل نصوصهما. على أنّ الورقة لا تكتفي بنصوص كنفاني والأعرج طبعًا، بل تقيم حوارًا مع عدد من النصوص لكتّابٍ تناولوا مسائلَ من قبيل علاقة الكاتب والمثقّف بالنصّ، وتعريف دور المثقّف والثقافة، والكتابة التحرّريّة من الاستعمار، وهم: أنطونيو غرامشي، وفرانتز فانون، وإدوارد سعيد، وفالتر بنيامين، ونغوجي وا ثيونغو.
المثقّف، الكاتب، الإنتاج
يفرّق إدوارد سعيد بين مصطلحَي "المثقّف" و"الكاتب":
- فللأول سياقاتٌ مختلفة. إذ يشير في السياق العربيّ - الإسلاميّ إلى المرشد أو القائد، وكلاهما مضادٌّ للدولة العربيّة الراهنة المتكلّسة. أما في السياق الفرنسيّ فكلمة "المثقّف" مرتبطة بحقل مناقشته من طرف مفكريّن كزولا وسارتر وفوكو وأرون. الأمر نفسُه في السياق البريطانيّ، بعد أن حدثتْ "عدوى" من السياق الفرنسيّ مع استمرار هيمنة الثقافة الثاتشريّة - النيوليبراليّة. وأمّا في الولايات المتّحدة، فاستخدامُ المصطلح أقلُّ تواترًا ربّما بسبب النزعة التخصصيّة الأكبر فيها، وسطوة المشهد السياسيّ على الثقافيّ.[1]
- أما مصطلح "الكاتب" فقد ارتبط عادةً بالإنتاج الأدبيّ، والاستقلاليّة، والقدرة على الخلق والإبداع. لكنْ، مع مرور الوقت، وخلال القرن العشرين، أصبح الكتّابُ يأخذون سماتٍ أساسيّةً من سمات المثقّفين، ولا سيّما قضيّة المعارضة السياسيّة.[2]
أ - أمّا بالنسبة إلى سعيد تحديدًا، فإنّ "المثقّف" متربطٌ بالحريّة، أو بتعدّد الخيارات السياسيّة والاجتماعيّة، وبكسر الهيمنة المفروضة من قوًى غير مرئيّة،[3] أيْ غير ماديّة أو مباشرة غالبًا. والمطلوب من المثقّف المكافح/الناقد، المثقّف الجمعيّ، المثقّف الحارس، ومن غيرهم من أنواع المثقّفين (الذين يعدِّدهم سعيد): السعيُ إلى وقف محاولات تغييبِ الماضي ونسفِ تعدديّة التاريخ وتعقيده، ومحاولةُ إيجاد فرصِ تعايشٍ مجتمعيّ بدلًا من فُرص نزاعٍ تعيد إنتاجَها الدولةُ ما بعد الكولونياليّة، وتشكيلُ ذاكرةٍ مضادّة وضميرٍ يقظٍ بعيدًا عن سطوة المصالح السياسيّة والاقتصاديّة للدول والمنظومات.[4]

اهتمّ والتر بنيامين بموقع الكاتب من عمليّة الإنتاج بالمعنى المادّيّ الواسع، لا بموقف الكاتب منها فحسب.
ب - وأمّا بالنسبة إلى فالتر بنيامين، فإنّ أعمالَه، خلافًا لأعمال سعيد، لم تحفلْ كثيرًا بتعريفات المثقّفين وتقسيماتهم. فقد اهتمّ بنيامين بموقع الكاتب من عمليّة الإنتاج بالمعنى المادّيّ الواسع، لا بموقف الكاتب منها فحسب.[5] الكتابة عنده، عادةً، منحازة طبقيًّا، إلى البرجوازيّة أو البروليتاريا، ولا يمكن أن تكون مستقلّةً أو محايدة.[6] وقد أظهر بنيامين أنْ لا تناقضَ بين الانحياز السياسيّ والجوْدة الأدبيّة.[7] وهو ما يخلص إليه أيضًا نغوجي وا ثيونغو، حين يؤكّد أنّ ما يُنتِج كتابةً جيّدةً هو الفهم الأشمل لما يمكن تطبيقُه على الصعيد المحسوس.[8]
وسؤال موقع الكاتب من عمليّة الإنتاج يقود إلى التقنيّة الأدبيّة، التي يمكن أن تقودَ بدورها إلى كسر رتابة العلاقة بين الصحافة والأدب، وبين الكاتب والقارئ، بحيث يتحوّل القارئُ إلى كاتب من خلال فهمه لما يُنتجه الكاتبُ وحواره معه. وبنيامين هنا يورد مثالَ الصحافة السوفييتيّة والمنبر الذي كانت تتيحه لهؤلاء القراء - الكتّاب؛ وهذا ما يسمّيه بعمليّة إعادة التشكيل الضخمة التي تطول الاختلافاتِ المعروفةَ بين الأنواع الأدبيّة، وبين الأدب والصحافة، وبين الكاتب ومَن يمارس الدعاية الجماهيريّة.[9] فهنا تتراجع أهميّةُ الشكل الأدبيّ أو النصّي أو حتى الموقف لصالح الموقع من عمليّة الإنتاج، بمعنى أنّ الكتابة تغدو فعلًا يصنَّف ضمن نمط الإنتاج ووسائله وعلاقاته، بالمعنى الاقتصاديّ - الاجتماعيّ الأوسع.
ويتحدث بنيامين في هذا الصدد عن سيرجي تريتياكوف مثالًا على "الكاتب الفاعل." فهذا الكاتب السوفييتيّ لا يكتفي بالكتابة والنشر والدعاية لمشروع سياسيّ اقتصاديّ يؤمن به، بل هو "يناضل" أيضًا ضمن هذا المشروع عبر القيام بأنشطة تعبويّة وإداريّة تهدف إلى إنجاحه.[10] ونمط "الكاتب الفاعل" هذا، بالمناسبة، ينطبق على كنفاني والأعرج بشكل كبير، لكونهما لم يكتفيا بنضالٍ ثقافيّ أو فكريّ يدعم مشروعَهما، بل كان الأمر نضالًا سياسيًّا حزبيًّا لدى كنفاني، وجماهيريًّا ثم فدائيًّا لدى الأعرج. والفرق الوحيد أنّ تريتياكوف عاد من تجربة العمل في المزارع الجماعيّة بكتابٍ تناول تجربتَه، أمّا كنفاني والأعرج فقد خُتمتْ تجربتُهما بالشهادة، وإنْ كان نصُّ "لماذا نذهب إلى الحرب؟" (الذي يبدو أنّ الأعرج كتبه خلال اختفائه الذي سبق استشهادَه) يسجِّل جوانبَ من تجربته النضاليّة.[11]
كما يتناول بنياميين المثقفَ الموظّف الذي لا يسعى إلى تغيير جهاز الإنتاج جذريًّا، بل يمدُّه فقط بمواضيعَ جديدة. ثمّ إنّ الوظيفة الاجتماعيّة التي يؤدّيها إنتاجُه ليست وظيفةً اجتماعيّةً جديدة، بل هي إعادةُ إنتاج لوظيفة اجتماعيّة قديمة (وغير ثوريّة) للكتابة، ألا وهي التسلية والمتعة،[12] وإنْ شملت الكتابةَ مواضيعَ مثل الفقر ومحاربته.[13] (وهذا التوصيف يذكّرنا، بالمناسبة أيضًا، بشخصيّةٍ تتصل بالراوي في مجموعة عن الرجال والبنادق لكنفاني من أجل تغطية حملة جمع ألعابٍ تُهدى إلى أطفال المخيّمات في العيد؛ الأمرُ الذي اعتبره الراوي رغبةً في إشباع نزعة عمل خيريّ لدى نخبةٍ مخمليّةٍ من المجتمع). فبحسب بنيامين، على الكاتب "أن يفكّر، وأن يتأمّل موقعَه من عمليّة الإنتاج،" وهذا ما سيقوده إلى "خيانة" طبقته إنْ أراد التضامنَ مع البروليتاريا تضامنًا حقيقيًّا. إنّ تحويلَ الكاتب إلى بروليتاريّ أمرٌ غيرُ ممكن بسبب ارتباطه بنمط إنتاجٍ غير بروليتاريّ؛ لذا يبقى الممكنُ هو الاستعانة بكتّابٍ يخونون طبقاتِهم، أي أنّهم يعملون على تحويل نمط الإنتاج الكتابيّ لا مدخلاته (بمعنى المادّة أو الثيمات الأساسيّة للكتابة) فحسب.[14]
ج - وأمّا بالنسبة إلى غرامشي، فإنّه يركّز في كرّاسات السجن[15] على فئة المثقّفين العضويّين الذين يرتبطون بالطبقات المختلفة، لا على فئة المثقّفين التقليديّين الذين يحترفون العملَ الثقافيّ مهنةً. المثقّفون، بالنسبة إلى غرامشي، فئةٌ خاصّةٌ بكلّ طبقة على حدة، ولا يشكّلون طبقةً في حدّ ذاتها. وفي بعض الأحيان تميل فئةُ المثقّفين العضويّين إلى الاستقلال عن طبقتها لتشكيل كيانها الخاص ورؤيتها المثاليّة.

إنّ جزءًا من عنف الاستعمار هو في محاولة استخدام الثقافة لثني ضحاياه عن حَراكهم الثوريّ (فرانتز فانون)
د - في عُرف فرانتز فانون، يمكن أن تصبح الثقافةُ أداةً في يد السلطة الاستعماريّة. في معذّبو الأرض،[16] يؤكّد فانون أنّ جزءًا من عنف الاستعمار هو في محاولة استخدام الثقافة وأدواتِها في سبيل ثنْي ضحاياه عن حَراكهم الثوريّ. ولهذا يستعين بالمثقّفين المحلّيين الذين تشرّبوا قيمَه ونشأوا في ظلّه للقيام بهذه المهمّة، حتى باتوا على قناعة بـ "الحلول الوسط" أكثرَ من الاستعمار نفسه! وبعد الاستقلال، يكون لهذه الفئة من المثقّفين دورٌ أساسٌ في الالتفاف على هذا الاستقلال واستدامة الاتصال بالاستعمار. وهذا مردُّه إلى أنّ تفكير هؤلاء نابعٌ أصلًا من ثقافة البرجوازيّة الاستعماريّة ونزعتِها الفرديّة. ولا يعيدهم إلى حضن الشعب ومساره إلّا انخراطُهم في ثورته وخوضُهم غمارَ مسارها الطويل؛ وإلّا فسيقومون بإعادة إنتاج الاستعمار محلّيًّا بعد الاستقلال.
لكنّ هؤلاء المثقّفين، بحسب فانون، حين ينخرطون في الثورة، لا تغادرهم روحُ الشكّ واليأس والإغراق في التفاصيل، عكس الجمهور. وتظهر تناقضاتُهم في عمل الأحزاب السياسيّة، ذاتِ الحاضنة المدينيّة، وفي مطالبها، لكون هذه الحاضنة أكثرَ تأثّرًا بالاستعمار من الريف.

"مع الاستعمار، هل بمقدورنا أن نظلّ محايدين؟" نغوجي وا ثيونغو
هـ - نغوجي وا ثيونغو والمثقف. لا يرى فانون سبيلًا إلى تبلور وجود الأمّة إلّا في انهيار نظام الاستعمار والعالم الذي بناه ورتّبه. لكنّ ذلك لا يعني انقلابًا جذريًّا بعد خروج الاستعمار مباشرةً؛ فخطابُ العنف يظلّ حاضرًا، وكذلك انتهازيّةُ النخب السياسيّة والثقافيّة. وإذا كان فانون قد تناول العنفَ في سياق الاستعمار ومساعي التحرّر منه، فإنّ لدى الكاتب والروائيّ الكينيّ نغوجي وا ثيونغو مقاربةً ثقافيّةً مختلفة لمقاومة الاستعمار. يعبّر وا ثيونغو، في كتابه تصفية استعمار العقل، عن مشروعٍ يسعى إلى إعادة تعريف الآداب الإفريقيّة، وإعادة الاعتبار إلى اللغات الإفريقيّة، ونزعِ الإطار اللغويّ الاستعماريّ المقيِّدِ لانطلاقها وإبداعها؛ وهذا جزءٌ من مشروع تحرّريّ كينيّ - إفريقيّ - إنسانيّ. وهو ينطلق من اللغة المستعمَرة والمسلوبة والمعاقَبة ليكتب بها وعنها ولها، في نصوص أدبيّة تحديدًا، وذلك في إطار من التعدديّة اللغويّة - الهوياتيّة في إفريقيا.
وا ثيونغو لا يكتب ترفًا، بل ضمن عمليّة صراع وتحرّر من الشرط الكولونياليّ وما بعد الكولونياليّ، الذي يُجرِّم اللغةَ المحلّيّةَ بصفتها هويّةً، وهذا يجعل من التركيز على لغة الاستعمار في الكتابة، لا سيما الأدبيّة، وفي التعليم ومختلف مجالات الحياة لاحقًا، وصفةً للاغتراب الثقافيّ الكولونياليّ وما بعد الكولونياليّ.
يبرّر وا ثيونغو الدعوةَ التي يطلقها إلى إعادة اكتشاف اللغات الإفريقيّة واستخدامها بكونها دعوةً إلى "إعادة علاقة حيويّة مع ملايين الألسنة الثوريّة المطالبة بالتحرّر في إفريقيا والعالم أجمع. إنّها دعوةٌ إلى إعادة اكتشاف اللغة الحقيقيّة للجنس البشريّ: لغة النضال. إنّها اللغة الشاملة المتضمَّنة في كلّ كلام وكلمات تاريخنا ونضالنا..."[17] هكذا تغدو إعادةُ الاعتبار إلى اللغة والأدب الإفريقيّين مسألةَ حياةٍ ومقاومةٍ وتواصلٍ للماضي والحاضر والمستقبل، لا تغني عنها لغاتُ المستعمِر وأنماطُ إنتاجه الثقافيّ والأدبيّ المستورَدَةُ وغيرُ المناسبة لحاجات الأفارقة بالضرورة. اللغة والأدب يأخذان هنا معنى الإنتاج، ويعيدان إنتاجَ قيم وثقافة محليّة بمهمّاتٍ واستخداماتٍ جديدة معاصرة.
وضع وا ثيونغو يده على مسألة خطيرة: لمنْ نكتب؟ فالكتابة بالإنجليزيّة بالنسبة إليه عنَت عدمَ قدرته على إيصال ما يكتبه إلى الفلّاحين الكينيّين، وإلى الأفارقة بشكلٍ عامّ، وهم الذين كتب عنهم ولهم. لذا انتقل في كتابة الأدب وغيره إلى اللغة الإفريقيّة، وحقّقتْ روايتُه شيطان على الصليب، التي كتبها باللغة المحلّيّة، نجاحًا واسعًا. ولم يتوقّف انتشارُها على الأوساط القارئة بين الفلّاحين الكينيين، بل تحوّلتْ إلى نصٍّ محكيٍّ يُقرأ في التجمّعات والأمسيات بين الفلّاحين غير القارئين أو الذين لا يقتنون الكتب. وربّما هذا يشبه تأثيرَ مواقع التواصل الاجتماعيّ الآن مقابل منابر النشر التقليديّة. وبالمناسبة أيضًا، فإنّ نصوصَ باسل الأعرج والتسجيلات المصوّرة التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ أكثرُ وصولًا وتأثيرًا وسلاسة وجذبًا من تلك المنشورة عبر منابر أكثر صرامةً كالمجلات والمؤتمرات والمواقع الإلكترونيّة "المرموقة."
يرفض وا ثيونغو حيادَ المثقّفين في ظروف الاستعمار وعدم المساواة: "في فترة الاستعمار، أين نقف حقًّا؟ في مجتمعٍ مشيَّدٍ على اللامساواة، أين نقف؟ هل بمقدورنا أن نظلّ محايدين، متقوقعين في مكتباتنا وانضباطنا الأكاديميّ متمتمين لأنفسنا: أنا جرّاح، أنا ناقد، أنا اقتصاديّ، أنا عالم، أنا معلم؟!"[18]
بعد هذا التمهيد النظريّ المطوّل بعضَ الشيء، ننتقل إلى نصوص كنفاني والأعرج لنتناول بعض القضايا المشتركة أو المنفصلة التي تناولاها ممّا يقع ضمن سياق اهتمام هذا البحث.
حقائق من الواقع أمْ من رومانسيّة وخيال؟
بدأ كنفاني كتابَه ثورة 1936 - 1939 في فلسطين باستعراض الواقع الطبقيّ والاقتصاديّ للفلسطينيّين قبل ثورة العام 1936، وكذلك التطوّرات الاقتصاديّة التي لحقتْ بحياة المهاجرين اليهود إلى فلسطين في هذه الفترة. وهو هنا يأخذ موقفًا نقديًّا من الأنظمة العربيّة المحيطة بفلسطين؛ ومن القيادات الرجعيّة المحليّة شبه الإقطاعيّة - الدينيّة بشكل عامّ؛ وكذلك من الحزب الشيوعيّ الفلسطينيّ في طريقة تعاطيه مع المسألة القوميّة العربيّة - اليهوديّة في فلسطين وخلطِه بينها وبين الصراع الطبقيّ الحقيقيّ؛ فضلًا طبعًا عن موقف كنفاني الجذريّ من المشروع الإمبرياليّ الصهيونيّ.[19] وهذا الاستعراض المفصّل الذي يقدّم به كنفاني كتابَه مهمّ لكونه يعكس الأرضيّة الطبقيّة الثقافيّة التي ينطلق منها أو يتبنّاها:

كنفاني منحاز إلى العربيّ والفلسطينيّ غير النخبويّ، في وجه محاولات تمييع الصراع
فهو منحاز إلى العربيّ والفلسطينيّ غير النخبويّ، وغير المنتمي إلى القيادة (السياسيّة - الدينيّة - الاقتصاديّة) للبلاد. كما أنّه منحاز، بشكلٍ خاصّ، إلى الفلّاح والعامل العربيّ، في وجه محاولات تمييع الصراع القوميّ، بالخلط بينه وبين الصراع الطبقيّ في فلسطين؛ ولذلك يوضح أنّ العمّال العرب واليهود لم يكونوا في جبهة واحدة أساسًا بسبب تفاوت فرص العمل وظروفه وأجوره، وموقعِ كلّ فئةٍ منهما من البنية الاقتصاديّة الاجتماعيّة، ناهيك بالتفاوت في موقع كلّ منهما بالنسبة إلى القوّة الاستعماريّة الإمبرياليّة والصهيونيّة. باختصار، انحياز كنفاني هنا يقوم على أساسيْن، قوميّ ثمّ طبقيّ، لا ينفصلان.
في هذا السياق رأى كنفاني أنّ من أسباب هزيمة ثورة 1936 - 1939 في فلسطين الانتقالَ العنيفَ من مجتمع زراعيّ عربيّ إلى مجتمع صناعيّ يهوديّ، ما حدّ من دور البرجوازيّة العربيّة وركّز القيادةَ في يد الإقطاع التقليديّ وفئة رجال الدين المرتبطة به.[20]
في نصوص باسل الأعرج أيضًا كانت الظروف الماديّة والموضوعيّة حاضرة، لكنه ركّز على الرومانسيّة مضادًّا لـ "عقلانيّة" الحداثة. ورأى أنّ الرومانسيّة هي التي تدفع إلى استمرار القتال، على الرغم من عدم مواتاة الظرف الذاتيّ والموضوعيّ، وهي التي ينزعها الأكاديميّون عن كتابة التاريخ فيجعلونه جافًّا جامدًا. إنّ الرومانسيّة والخيال ضروريّان لمواصلة النضال، وإنّ الرومانسيّة ضحيّة الحداثة.[21] وهذا مرتبط بكون فلسطين ما زالت تعيش زمنَ الاستعمار، بالمعنى التامّ والمباشر، وهي لذلك تقبع خارج زمن الحداثة وما بعدها.[22]
"لا تبحث عن حبيبة إنْ لم تتخلّص من قهرك لتخلّصها وتخلص نفسك... لا تبحثي عن حبيب إنْ لم تتخلّصي من قهرك وتخلّصيه."[23 هكذا تكتمل فكرةُ الذهاب إلى الحرب كعمليّة رومانسيّة، بمعنى أنّ مواجهة القهر - بمعناه القوميّ هنا بشكلٍ أساس - خطوةٌ أولى نحو الحبّ والعودة إلى حياة إنسانيّة طبيعيّة خالية من الاستعمار.
الثقافة والمعرفة، المثقّفون والثورة
في سياق التحرّر من الاستعمار، لم يكن "الجوّ الثقافيّ العام في فلسطين خلال الثلاثينيّات، على أهميّته،" هو ما يهمّ كنفاني، بل كان يعنيه على وجه التحديد "الانعكاساتُ التحريضيّةُ التي أدّى إليها من خلال علاقته بتفاقم المأزق الاقتصاديّ والقوميّ."[24]
يتناول كنفاني المثقّفين، الشعراءَ الشعبيّين والقوّالين وأئمّةَ المساجد، بصفتهم يعكسون متطلّبات الجماهير أو يعبّرون عنها بأحسن الأحوال. وكلّما زادت حدّةُ تطوّر الأمور نحو المواجهة أو الثورة، اقتربتْ هذه الفئةُ من التعبير عن المسعى التحرّريّ؛ والعكس بالعكس. وهذه المهمّة العاكسة أو التعبيريّة لا تقلّل من دور هذه الفئة التي لعبت دورًا في معركة التحرّر الوطنيّ يفوق أمثالَه في أماكن أخرى ذات ظروف مشابهة أسماها كنفاني "الشروط الكلاسيكيّة لمعركة التحرّر الوطنيّ."[25]
وعلى الرغم من عدم مبادرة المثقّفين إلى إنتاج ثقافة ثوريّة في ظرفٍ يسبق الثورةَ الفعليّة، فإنّ علاقتَهم بالثورة والنضال تطوّرتْ؛ فلم تقتصرْ على التسجيل والوصف، بل تعدّتهما إلى الدعوة والتحريض. وهذا لا يقتصر على الأدب المكتوب بالفصحى، بل يشمل أيضًا الثقافةَ الشعبيّة، وبالأخصّ شعراء الأرياف الشعبيّين الذين حاولوا بشكل مستمرّ الانفكاكَ من أسْر الثقافة التقليديّة الموروثة الناتجة من تراكم القهر والقمع الطبقيّ ذي السِّمة القدَريّة المفرطة.[26] ويفسّر كنفاني قدرةَ بعض الشعراء على اجتراح نبوءات شعريّة (تشْبه الرجمَ بالغيب كما يقول) بعمق التحامهم بالجماهير، وقدرتِهم على التعبير عمّا يدور في نفوسهم، وتمكِّنهم من فهم حركة المجتمع بشكل عامّ أيضًا.[27]
في هذا الصدد يأتي كنفاني على ذكر استشهاد الشاعر عبد الرحيم محمود في معركة الشجرة عام 1948. لكنّه يركّز على دوره مع الشاعريْن عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) وإبراهيم طوقان في "إرساء دعائم الشعر الفلسطينيّ المقاوم،" الأمرُ الذي كان له دور بارز لاحقًا في تعزيز صمود الفلسطينيّين.[28] وهنا لا يركّز كنفاني على انتقال محمود من فعل الكتابة الشعريّة، تسجيلًا ووصفًا وتحريضًا على الثورة، إلى فعل المواجهة المسلّحة والمباشرة مع العدو؛ فربّما لم يعتبر كنفاني أنّ هذا الانتقال يشكّل تغيّرًا في موقف محمود أو منطلقاته، بقدر كونه تغيّرًا في أداة التعبير عن الموقف والمنطلقات. أمْ أنّ تركيز كنفاني هنا انصبّ على الفعل الثقافيّ كشيء قائم بذاته، لا كشيءٍ يتكامل مع مراحلَ أخرى من نضال الإنسان المستعمَر؟
هذا التساؤل مهمّ مثلًا في التفريق، أو عدم التفريق، بين كنفاني الكاتب والصحفيّ والأديب من جهة، وكنفاني السياسيّ من جهةٍ أخرى. وربّما يرتبط هذا التساؤل، بشكل أكبر، بالأعرج أكثر من كنفاني: فهل تُمْكن قراءةُ الأعرج ككاتب نصوصٍ تتناول مقاومةَ الاستعمار بعدسةٍ لاحقة كوّنتْها تجربتُه النضاليّةُ المباشرة، ومواجهتُه الأخيرةُ مع أداة العنف الاستعماريّ؟ أمْ أنّ كلًّا من الأمرين يمكن أن يدرَس بشكل منفصل؟ هذا الطرح يحيل على طرح بنيامين حول كسر الجدران بين الكاتب والأديب والصحفيّ وغيرها من المسمّيات في إطار التحوّلات الكبرى التي تناولها.
تحت عنوان "الفن في فلسطين" تحدّث الأعرج عن التعبيرات الفنّيّة المختلفة بين العامين 1927 و1938، مركّزًا على العام 1936. وقد اعتبر الفنّ، وتحديدًا الشعر بشقّيْه الشعبيّ والفصيح، أداةً للتعبير عن الثورة، والتأريخِ لها، ونقلِ أفكارها وتعليماتها ورسائلها إلى الجماهير؛ بمعنى أنّ هذه الفنون كانت مرآةً عاكسةً وأداةً ناقلةً وماكينةَ إنتاجٍ لفكرة الثورة ومقاومة الاستعمار، بطرقٍ متباينةٍ ومتكاملة. ركّز الأعرج على الشعراء والفنّانين الذين مزجوا بين دورهم الفنيّ ودورهم القتاليّ حتى الشهادة، على حدّ تعبيره، كسبيتان عوض ونوح إبراهيم وعبد الرحيم محمود، بالإضافة إلى الفنّانيْن التشكيليين فيصل الطاهر وخليل بدويّة.[29] ومع أنّ الأعرج قدّم مسحًا للنشاط الثقافيّ والفنّيّ المحلّيّ والوافد خلال الفترة المدروسة، فإنّه بذكره وتركيزه على هذه النماذج من الشعراء - الفنّانين المقاتلين قد كان يشير إلى خياراتٍ مادّيّةٍ لا بدّ من أن يتخذها المثقّفُ الملتزمُ بقضيّة شعبه ومجتمعه عند احتدام الاشتباك مع المشروع الاستعماريّ احتدامًا مباشرًا، كما فعل الأستاذ معروف في نصّ كنفاني، عن الرجال والبنادق.
يرى كنفاني أنّ الإقطاع وثقافةَ الاستكانة حلفاءُ الماضي، وأنّ ثقافةَ التمرّد وثقافةَ الطبقات الأخرى (من فلّاحين وعمّال وبرجوازيّة متوسّطة وصغيرة) حليفةُ الحاضر والمستقبل. هنا تظهر أهمّيّةُ الزمن: مَن يريد الاتّكاءَ على الماضي باستمرار، مقابل مَن يريد الاستثمار في الحاضر والمستقبل. كما تظهر أهميّةُ تغيّر أنماط الإنتاج عبر تراجع أهميّة طبقة الإقطاع، وتنامي أهميّة طبقة العمّال والطبقة البرجوازيّة المرتبطتيْن بالتوجّه نحو التصنيع، وهو التوجّه الذي كان سمةَ التحوّل في الاقتصاد. لكنْ ما كان يصعِّب الأمور على البرجوازيّة المحلّيّة تحديدًا هو أنّ السِّمة العامّة للتصنيع كانت بريطانيّة - صهيونيّة أيْ وافدة مستوردة لم تتطوّر من رحم تطوّر المجتمع واقتصاده.[30]
هناك فكرة تتكرّر لدى كنفاني في كتاب ثورة 1936 - 1939 في فلسطين، مفادُها أنّ قادةَ الهيئة العربيّة العليا الذين تزعّموا الثورةَ الفلسطينيّة بين العامين 1936 و1939 كانوا ضعيفي الإدارة، وأنّ معظمَهم افتقر إلى القدرات التنظيميّة اللازمة لإدارة الثورة. ربّما يعكس تحليلُ كنفاني، هذا، طريقةَ فهمه للثقافة في تقاطعها مع الفعل الثوريّ: الاستفادة منها في إدارة أمور الثورة وتنظيمها. وهو الأمر الذي قاد، بحسب كنفاني، إلى اعتقال سلطات الانتداب البريطانيّ، خلال أحداث الثورة، اثنين فقط من أعضاء "الهيئة العربيّة العليا" دون غيرهما، وذلك لتمتّعهما بقدراتٍ إداريّة وتنظيميّة نسبيّة في هذا السياق. وهذا يشير إلى اقتناع كنفاني بأنّ الموقف الطبقيّ والسياسيّ والثقافيّ ليس كافيًا لتشكيل خطر على المنظومة الاستعماريّة ما لم يُستغلّ في محاولة زعزعتها بشكل جادّ ومباشر.
وهذه الفكرة تتقاطع مع فهم المعرفة كشيءٍ يُستخدم عمليًّا، لا كشيء يشكّل هدفًا في حدّ ذاته. فمعرفة هؤلاء القادة لم تكن مطلوبةً كأمرٍ قائمٍ في ذاته، بل كشيء يُستخدم في تنظيم الثورة وإدارتها. وهنا يتقاطع طرحُ كنفاني مع ما تناوله خضر سلامة في مقاله عن الأعرج ضمن كتاب وجدتُ أجوبتي، عندما وصف الأعرج بجملةٍ كثيفةٍ مفادُها أنّ الأخير تعلّم إطلاقَ النار من مسافة صفر في سنّ الثامنة عشرة، ليَستخدم هذه المعرفةَ في سنّ الثانية والثلاثين تقريبًا في اشتباكه الأخير.[31] وطرحُ سلامة هذا يحيلنا على أشكال المعرفة المتوخّاة عند الأعرج؛ فالأمر لا يتعلّق بمعارفَ أكاديميّةٍ أو بثقافةٍ شاملة أو بنتاجٍ ثقافيٍّ ضخم، بقدرِ تعلّقه باكتساب معرفةٍ وعلمٍ ومهارةٍ وقدرةٍ، عمليّةٍ أو فكريّةٍ، تُستخدم لاحقًا في مواجهة المشروع الاستعماريّ.
تحوّلات الوعي: نماذج المثقّف
تُظهر شخصيّاتُ مجموعة كنفاني القصصيّة، عن الرجال والبنادق، تحوّلاتِ الوعي والإدراك الوطنيّ والسياسيّ، في لحظة مواجهةٍ وشيكةٍ وحاسمةٍ مع المشروع الاستعماريّ في فلسطين. فبين والدتيْن، من أمّ قاسم في بداية لوحات هذه المجموعة القصصيّة، إلى أمّ سعد (التي أضاف قصّتَها محرِّرُ الآثار الكاملة في نهاية المجموعة)، تبدو مسيرةُ عقودٍ من تحوّل وعي الفلسطينيّين. فبعد الأم السلبيّة المستكينة في الحالة الأولى، التي لا تعرف ما يدور حولها وماذا يفعل زوجُها وأبناؤها، بتوجّهاتهم المختلفة، في لحظة مواجهةٍ كبيرةٍ وحاسمة مع مشروع الاستعمار الصهيونيّ في فلسطين، تأتي الأمُّ المؤمنةُ بمشروع ابنها القاضي بالتحاقه بمعسكرات الفدائيين، بل رغبتها في الالتحاق به وخدمته وخدمةِ زملائه. وإذا كان كنفاني في كتابه ثورة 1936 - 1939 في فلسطين قد ذكر أبياتَ الشعر الشعبيّة ("يا عربيّ يا ابن المجرودة، بيعْ أمّك وجيب البارودة، والبارودة خير من أمّك، يوم الحرب تشيل همّك")، فإنّ هذه الأم التي تعوق ابنَها عن الانخراط في مشروع التحرّر من الاستعمار، يجري الاستغناءُ عن سذاجتها ووعيها البسيط؛ تمامًا كالأمّ الأخرى التي تبارك لابنها براءتَه بعد تبرئة جنود الاحتلال له من "شبهة" العمل الفدائيّ، في لوحةٍ أخرى من لوحات المجموعة القصصيّة. أمّا في نموذج وعي أم سعد، فتصبح هي وبندقيّةُ الفدائيين شيئًا واحدًا تقريبًا بإقرارها أنّ خيمةَ اللجوء تختلف جذريًّا عن خيمة الفدائيين الذين تريد أن تشاركهم جهدَهم التحرّريّ وتقدِّم لهم الخدمةَ الممكنة.
أبو قاسم، هو الآخر، نموذجُ الوعي المختلط بين الحرص التقليديّ على الأبناء، والاستعداد للتضحية من أجلهم. فهو يذهب إلى القتال ليحصل لابنه على بندقيّةٍ يهديه إيّاها في زفافه، فيُستشهد في هذا المسعى المختلط: بين السعي إلى التحرّر من الاستعمار، والاستمرار في النظر إلى الأمور من زاويةٍ شخصيّةٍ بحتة. واختلاطُ الوعي هذا موجود لدى التاجر الحاج عبّاس، المستعدِّ لتأجير بندقيّته لمقاتلٍ في ذروة المواجهة مع المشروع الاستعماريّ، عوضَ أن يستخدمَها بنفسه (أو يعيرَها هذا المقاتلَ على الأقلّ!) في النضال ضدّ هذا المشروع.
ويعبّر الدكتور قاسم عن نموذج الوعي المضادّ، غيرِ الملتصق بالأرض ولا بالمجتمع المحلّيّ، المتأثّر بالدراسة في الخارج، والاحتكاكِ بالثقافة الغربيّة. كما أنّ فردانيّته المفرطة لا تمنعُه من مصادقة فتياتٍ يهوديّاتٍ جلبَهُنّ، وعائلاتِهنَّ، المشروعُ الاستعماريُّ إلى فلسطين، بينما كان والدُه وشقيقُه الصغير يصوّبان بندقيتيْهما نحو المشروع ذاته. نموذج المثقّف - المتعلّم المتعالي، المتغرّب، الهارب من الواقع، الفرديّ، الأنانيّ، ليس نموذجًا فريدًا. لكنّ المفارقة ليست فقط في تناقضه مع محيطه (والده وشقيقه هنا)، بل في التناقض الاجتماعيّ الأوسع أيضًا. فبينما لا يُرضي ما يقوم به والدَه، ولا يُعجب شقيقَه الأصغر، فإنّه يُفترض بالصغير المقاتل، وبرعاية الوالد، أن يستمرّ في تأدية فروض الاحترام والتبجيل لشقيقه الأكبر، المهادنِ للمشروع الاستعماريّ والمتقبّل له!
لكنّ الدكتور قاسم ليس نموذج المثقّف - المتعلّم الوحيد في هذه المجموعة القصصيّة. فالأستاذ معروف يمثّل نموذجًا مختلفًا: قائد ميدانيّ يحمل السلاحَ، ويتعرّض للخطر الداهم والمباشر أثناء الاشتباك الدامي مع المستعمِرين. وكأنّ كنفاني يريد القول إنّ المثقّف - المتعلّم لن يجد مناصًا من هذا الاشتباك إنْ أراد أن يكون ذا دور حقيقي في مواجهة الاستعمار والسعي إلى التحرّر منه.

باسل الأعرج: أولويّة المواجهة على المواجهة الثقافيّة المواربة.
وهذا الطرح يتقاطع مع طرح الأعرج في نصّ "لماذا نذهب إلى الحرب،"[32 وذلك عندما يرى في هذا النصّ (الذي يبدو أنه كتبه خلال اختفائه الذي سبق استشهاده) أنّ الثقافة والكتابة أصبحتا أمريْن عبثييْن، وهو الذي طالما مارسهما، في إشارة ضمنيّة إلى أولويّة لحظة المواجهة الحقيقيّة والمباشرة على المواجهة الثقافيّة والمعرفيّة المواربة.
كما أنّ طرح الأعرج في النصّ نفسه حول رومانسيّة الحرب، وسببِ الذهاب إليها، يتقاطع مع طرح منصور، أحدِ أبطال عن الرجال والبنادق لكنفاني، في رفضه الإجابةَ عن سؤال الأستاذ معروف "لماذا يقاتل المقاتل؟" وهو يعتبر أنّ الأمر من قبيل البديهيات: "فأنت لا تستطيع أن تسأل مقاتلًا لماذا تقاتل؟ كأنك تسأل رجلًا لماذا أنت ذكر؟"[33]
من المهمّ الإشارة هنا إلى أنّ الأعرج، حسب مقدمة وجدتُ أجوبتي، كان يرفض أن تُطلق عليه صفةُ "مثقّف،" ويسعى إلى تعريف الثقافة من خلال وظيفتها الوطنيّة وصياغةِ الذات الثوريّة والتخلّق بقيم الوطنيّة المستمَدّة من سِير المقاومين والشهداء.[34] كما كان يرفض استخدامَ السياسة كحرفة،[35] بشكلٍ متمِّمٍ لرفضه استخدامَ الثقافة كحرفة؛ وهو الأمر الذي يتقاطع فيه مع كنفاني.
وهذا مرتبط أيضًا بتناول الأعرج لتحرير العقل من السلطة الاستعماريّة ورفضها، ولو لم يستطع الإنسانُ إلى ذلك سبيلًا إلّا بالرفض الفرديّ والرمزيّ. كما يشدّد على أهميّة المبادرات الفرديّة في التغيير، والتي يمكن أن تقود إلى ثورة كاملة لاحقًا. ويستشهد بأمثلة فرديّة محدودة لحالات رفض رمزيّ، لكنْ جذريّ، مارسها فلسطينيّون ضدّ الهيمنة الاستعماريّة الصهيونيّة.[36]
الإعجاب بنموذج المقاوم
بالعودة إلى منصور، في عن الرجال والبنادق، فهذا الفتى يشكّل نموذجًا مضادًّا لنموذج المتعلّم - المثقّف، خصوصًا الذي يمثّله شقيقُه الدكتور قاسم. فمنصور ملتصق بالأرض والحقّ والقرية، لا حسابات معقّدةً لديه، يشتري ذخيرةً من حرّ ماله، ويستعير بندقيّةً تارة، وتارةً يذهب إلى المعركة بيدين فارغتين على أمل اغتنام بندقيّةٍ هناك! وهو يكتفي من معركةٍ خاضها في مدينةٍ غريبةٍ عنه مع أشخاص يلتقيهم للمرّة الأولى، وغالبًا الأخيرة، بإطلاق رصاصةٍ واحدة: تقتل أو تعطّل قنّاصًا معاديًا، وتنقذ مقاتلًا ربطتْه به علاقةٌ لم تتعدَّ بضعَ ساعات! هذا النموذج الذي يقدّمه كنفاني هو تجسيدٌ لنموذجٍ واعدٍ لفدائيّي المستقبل، لرجالٍ "يزحفون تحت صدر العتمة ليبنوا لنا شرفًا نظيفًا غير ملطَّخ بالوحل."[37]
يبدي الأعرج إعجابَه بنموذج "المثقّف المختلف،" والتعبير لفيصل درّاج، الذي مثّله الشهيد عبد القادر الحسيني[38]: بدءًا بالانتفاض على النظام التعليميّ الغربيّ حيث كان يدْرس في مصر، وصولًا إلى المشاركة في العمل العسكريّ المباشر ضدّ القوّات الصهيونيّة والبريطانيّة، والذي اختُتم باستشهاده في معركة القسطل في نيسان 1948. وسببُ ذكر الحسينيّ هنا أنّه جمع بين صفتي الثقافة والمقاومة. والأعرج بدا في كتابه معجبًا، إلى حدّ الهوس، بتجارب المقاومين الفلسطينيّين تحديدًا وقصصهم، في الماضي والحاضر. وهو من أنصار مدرسة التركيز على بطولات الثورة والمقاومة الفلسطينيّة، بدل استجلاب نماذج مقاومة خارجيّة قد لا تناسب حيثياتُها ظروفَ الواقع.
لم يكتفِ الأعرج بأسطرة المناضلين وتحليل عمليّة أسطرتهم. بل إنّه، بتجربته القتاليّة التي قضى فيها شهيدًا، ربّما يكون قد سعى إلى خلق أسطورة جديدة يتّكئ عليها نضالُ الشعب الفلسطينيّ مستقبلًا ضمن عمليّة استمرار النضال. يتناول الأعرج نموذجَ الشهيد يحيى عيّاش وكونَه لم يكن خارقَ القدرات والمواهب، لكنّ تميّزَه كان في رفض الأمر الواقع. وهو يرى أنّ استنساخ هذه التجربة ممكنٌ في الضفّة الغربيّة.[39] وربّما هذا ما حاول الأعرج القيامَ به لاحقًا في عمله المقاوم، الذي كانت حدودُ المواجهة وسقوفُها فيه عالية جدًّا: "حربُنا لن تنتهيَ حتّى يتمّ إنهاءُ إسرائيل وانهيار الرأسماليّة العالميّة."[40]
وفي هذا الإطار تَحْضر فكرةُ الذاكرة، الجماعيّة والفرديّة. وهذه من الأفكار الأساسيّة التي تتكرّر في كتاب باسل الأعرج، وجدتُ أجوبتي، وتحديدًا قصص أبطال المقاومة، وبالأخصّ الشهداء، ومآثرهم. وكأنّ الأعرج كان ينطلق من ذاكرةٍ تحتشد فيها البطولاتُ والتضحياتُ لتوصله إلى مشروعه المقاوم؛ بالإضافة إلى إيمانه بالإنجاز الفرديّ للمقاوم، البطل - الشهيد، الفرد.[41]
الطريق إلى التمرّد
تناول الأعرج الانتقالَ من الخروج على القانون والنظام إلى الثورة بمعناها السياسيّ والإنسانيّ الواسع. وهو يرى أنّ الاستعدادات والخبرات المكتسبة من قِبل الخارجين عن قانون الدولة الحديثة يمكن أن تنتقل بسهولةٍ إلى المواجهة مع قوى الاستعمار بشكل مباشر. وهو يعرّج على العديد من نماذج هؤلاء الخارجين عن القوانين والأنظمة، فلسطينيًّا وعربيًّا وعالميًّا، ويبدي إعجابَه بتجربتهم.[42] صحيح أنّ الأعرج لم يكن ضمن هؤلاء، لكنْ يمكن القول إنّه اشترك معهم في الخروج عن قيم المنظومة السياسيّة الاقتصاديّة الاجتماعيّة السائدة: فاستبدل بمهنة الصيدلة التي عمل بها وقتًا قصيرًا تجربةً اختلط فيها العملُ التطوعيّ والبحثُ التاريخيّ والنشاطُ السياسيّ، لا سيمّا معارضة التطبيع والدعوة إلى إنهاء الانقسام ومقاطعة منتجات الاحتلال، وصولًا إلى العمل المقاوم، اعتقالًا ومطاردةً واشتباكًا حتى الشهادة. وهنا تأتي إشادتُه بعمليّات التخريب، وسرقة بيوت المستوطنين، والحرائق، ... وإمكانيّة أن تكون تكتيكًا ناجحًا وقت الحرب.[43]
ومع أنّ الأعرج لم يكن من هؤلاء الخارجين عن القانون والنظام، فقد كان معجبًا بهم: "في زيارتي إلى الأردن قمتُ بمقابلة أحد أعتى مجرمي الأردن... ولا أخفيكم أنّ اللقاء كان رائعًا، وأنّ الرجل يتمتّع بذكاءٍ مرعبٍ وثقافةٍ لا بأس بها. عندما كنت أقول لأصدقائي بأنّي قابلتُ فلان كان الاستغراب واضحًا على وجوههم والسؤال المتكرّر: ’شو بدك فيه؟‘ كنت أجيب أنّ الثوّار فعليًّا هم قطّاعُ طرق يحملون مشروعًا سياسيًّا ويملكون حاضنةً شعبيّة، فلا فرق بين حرب العصابات الثوريّة وبين عصابات قطّاع الطرق إلّا بالمشروع السياسيّ والحاضنة الشعبيّة."[44]
ويرى الأعرج أولويّة الفعل على التنظير، فكتب في أحد منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعيّ: "في الأول كان يجي الفعل، بعديه تيجي الكتابة والعقل الذي يكتب عن الفعل وينظّم الجهد العام للفعل الموجود."[45]
والأمر لا يتعلق بمقارنات عامّة أو تنظير. فالأعرج مثلًا يتعلّم درسًا من فتًى من مخيّم شعفاط في تكتيكات ضرب الحجارة وممارسة السيادة المضادّة لمشروع الاستعمار على أرض المخيّم. هنا لا ينظّر الأعرج ولا يحلّل كعادة المثقّفين، بل يقف متعلّمًا من هذا الفتى، الشابّ لاحقًا، ومعجبًا بل ربّما منبهرًا بتجربته.[46]
وعندما تعرّضتْ أجزاءٌ من قريته، الولجة، ومنها أرضٌ تملكها عائلتُه، لتهديد صهيونيّ بالمصادرة، كتب في إطار الحديث عن نيّته العودةَ إلى قريته للمساهمة في زراعة هذه الأرض وتعميرها: "كلّ التنظير والعمل الثقافيّ والعمل التعبويّ ينهار أمام رصاصةٍ واحدة، وأمام ضربة معول. لا أستطيع ان أضرب رصاصةً، لكن أجيد الضرب بالمعول."[47] وما اتّضح لاحقًا أنّه كان يجيد الأمرين معًا، لكنْ في التوقيت الذي يختاره لا الذي يُفرض عليه.
خاتمة
يبدو أنّ الانتماء إلى قضيّة ما أمر يصنعه التزامُ الكاتب بقضيّته من خلال الكتابة والإنتاج المعرفيّ، أكثر من كونه أمرًا مفروضًا أو موروثًا، أو باعتباره شيئًا مفهومًا ومقبولًا بحكم الضرورة والأمر الواقع. فكما ظهر من خلال الكتابات النظريّة حول الموضوع، فإنّ الانتماء إلى طبقة معينة لا يضمن التعبيرَ عنها، أو أن يكون المثقّفُ هو المعبِّرَ عنها وعن تطلّعاتها. وهذا ينقلنا إلى تصنيفات الكاتب/المثقّف التي يمكن أن نضع ضمنها كنفاني والأعرج، أو أحدَهما. ومع أنّ نموذجَ الكاتب الفاعل الذي طرحه فالتر بنيامين وضرب له مثالًا بالكاتب السوفييتيّ سيرجي تريتياكوف، هو الأكثر شبهًا بنموذج كنفاني والأعرج، فإنّ قضيّة التصنيف هذه فيها قدر كبير من الاختصار المخلّ والمضلّل، وهي تحدّ من حريّة نموذجهما وانفتاحه على فضاءات واحتمالات لا حصر لها.
لقد حاولنا أن نُظهر من خلال معالجة نصوص مختارة لكنفاني والأعرج تبلورَ مفهوم المثقّف لدى الأعرج وكنفاني على مرحلتين: موضع المثقّف في نصوصهما، وموضعهما شخصيًّا كـ "مثقّفيْن" من عمليّة الإنتاج الثقافيّ ومشروع التحرّر من الاستعمار. في المسألة الأولى تَقاطَع الكاتبان في إدانة جبن قطاع من المثقّفين - المتعلّمين وانتهازيّته وفردانيّته، مقابل الإشادة بنبل قطاع آخر من الفئة ذاتها وشجاعته وتضحيته. فالمعيار لم يكن مدى الثقافة أو شكلها أو نوعَها، ولا نوعَ المثقّف - المتعلم أو الكاتب، بمقدار ما كان المعيارُ هو اقترابَ هذا المثقّف أو ابتعادَه عن مقاومة مشروع الاستعمار بتجلّياته المختلفة.
أما في ما يتعلّق بالمسألة الثانية، فالأمر يختلف بعض الشيء. فكنفاني يكتفي بأن يؤرِّخ وينظّر للكفاح المسلّح ويشيد به ويدعو إليه، إضافة إلى عمله السياسيّ والإعلاميّ طبعًا. أما الأعرج، فلم يكتفِ بالتعلّم والتتلمذ على يد مقاومين، راحلين ومعاصرين، كبارًا وأطفالًا، بل قرّر في مرحلة ما الانتقالَ إلى الفعل المقاوم بالمعنى الماديّ والمباشر، مطبّقًا ما تعلمه وتمثّله لسنوات، وكأنّه ينقل نفسَه من موقع المثقّف الفاعل إلى موقع "المثقّف المشتبك" كما أسماه أصدقاؤه ووسائلُ الإعلام بعد استشهاده.
في نهاية الأمر لم يطرح الكاتبان بديلًا مؤسّسيًّا جماعيًّا ومتكاملًا في رفض البنية الاستعماريّة وتمثّلاتها. وظلت المبادرة والقصة والتضحية الفرديّة هي النموذج الحاضر لديهما. وهذا لا يعني قصورًا في مشروعهما طبعًا، بل ربما هي الطريقة التي اختارا فيها النهاية المفتوحة لقصّتهما، وتركا البابَ مفتوحًا لكل الاحتمالات والنضالات، أو على طريقة النهاية المفتوحة التي ختم بها الأعرج قصّته:
"وجدتُ أجوبتي. يا ويلي ما أحمقني! وهل هناك أبلغُ وأفصحُ مِن فعلِ الشهيد؟! كان من المفروض أن أكتبَ هذا قبل شهورٍ طويلة، إلّا أنّ ما أقعدني عنه هو أنّ هذا سؤالُكم، أنتم الأحياء، فلماذا أجيبُ أنا عنكم؟ فلتبحثوا أنتم!"[49]
بيرزيت
[1] إدوارد سعيد، "الدور العام للكتاب والمثقّفين،" الكرمل، 68، 2001، ص 8 - 10.
[2] نفسه، ص 12 - 13.
[3] نفسه، ص 19.
[4] نفسه، ص 24 - 27.
[5] فالتر بنيامين، "المؤلِّف بوصفه منتجًا،" في: مقالات مختارة، ترجمة أحمد حسان (عمّان: أزمنة، 2007، تاريخ النشر الأصليّ: 1934)، ص 113.
[6] نفسه، ص 111.
[7] نفسه، ص 112.
[8] نغوجي وا ثيونغو، تصفية استعمار العقل، ترجمة سعدي يوسف (دمشق: دار التكوين، 2011، تاريخ النشر الأصليّ 1984 - 1985)، ص 145.
[9] بنيامين، مصدر مذكور، ص 113 - 115.
[10] نفسه، ص 113 - 114.
[11] باسل الأعرج، وجدتُ أجوبتي (القدس: دار رئبال، 2018)، ص 323 - 332.
[12] بنيامين، مصدر مذكور، ص 117 - 118.
[13] نفسه، ص 120.
[14] نفسه، ص 123 - 124.
[15] أنطونيو غرامشي، كرّاسات السجن، ترجمة عادل غنيم (القاهرة: دار المستقبل العربيّ، 1994، تاريخ النشر الأصليّ: 1978)، ص 223 - 292، و339 - 396.
[16] فرانتز فانون، معذّبو الأرض، ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي (بيروت: دار القلم، 1972، تاريخ النشر الأصليّ: 1961)، ص 19 - 59.
[17] وا ثيونغو، مصدر مذكور، ص 198.
[18] نفسه، ص 193.
[19] غسّان كنفاني، ثورة 1936 - 1939 في فلسطين، في: الدراسات السياسيّة - المجلّد الخامس (قبرص: منشورات الرمال - مؤسّسة غسّان كنفاني الثقافيّة، 2015)، ص 378 - 402.
[20] غسّان كنفاني، عن الرجال والبنادق، في: الآثار الكاملة - المجلد الثاني (مؤسّسة غسّان كنفاني الثقافيّة - دار الطليعة للطباعة والنشر، ط 2، 1980)، ص 442.
[21] الأعرج، مصدر مذكور، ص 327 - 330.
[22] نفسه، ص 331.
[23] نفسه، ص 170.
[24] كنفاني، ثورة 1936، مصدر مذكور، ص 403.
[25] نفسه، 404 -406.
[26] نفسه، ص 407.
[27] نفسه، ص 410.
[28] نفسه، الصفحة نفسها.
[29] الأعرج، مصدر مذكور، ص 83 - 99.
[30] كنفاني، ثورة 1936، مصدر مذكور، ص 415.
[31] الأعرج، مصدر مذكور، ص 367.
[32] نفسه، ص 323 - 332.
[33] كنفاني، عن الرجال والبنادق، مصدر مذكور، ص 663.
[34] الأعرج، مصدر مذكور، ص 9.
[35] نفسه، ص 214.
[36] نفسه، ص 205 - 207.
[37] كنفاني، عن الرجال والبنادق، مصدر مذكور، ص 615.
[38] الأعرج، مصدر مذكور، ص 100.
[39] نفسه، ص 283.
[40] نفسه، ص 307.
[41] سعيد، مصدر مذكور، ص 24 - 27.
[42] الأعرج، مصدر مذكور، ص 135 - 141.
[43] نفسه، ص 263.
[44] نفسه، ص 296.
[45] نفسه، ص 243.
[46] نفسه، ص 242.
[47] نفسه، ص 311.
[48] نفسه، ص 373.
باحث ومترجم فلسطينيّ. طالب في برنامج
الدكتوراه في العلوم الاجتماعيّة في جامعة
بيرزيت. يشارك في تأليف كتاب حول سيرة
رئيس بلديّة نابلس الأسبق بسّام الشكعة
وتجربته.