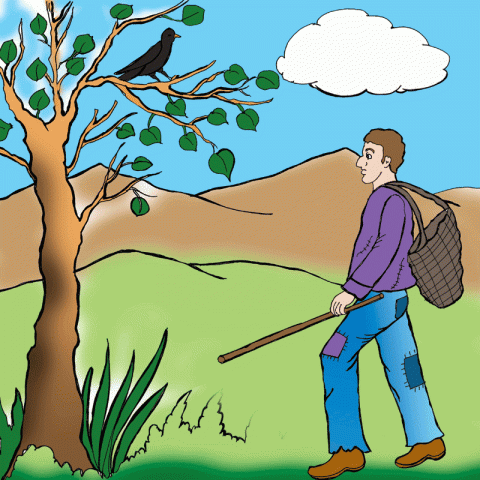جزائريّ مقيم في فرنسا. متحصّل على شهادة التبريز. يعمل أستاذًا في أكاديميّة فرساي. نشر دراسةً تاريخيّةً مع تحقيق لنصّ ابن خلدون عن تاريخ المغول.

عندما وصلتُ إلى باريس التحقتُ بالجامعة. في الأسابيع الأولى بحثتُ عن سكن. لم أكن أعرف أحدًا. ولأنّ الشدّة تُقرّب الفقراءَ والمساكين، فإنّي لم أتركْ بابًا إلّا طرقتُه. لكنْ، عندما يلتصق بك النحسُ فلا مفرّ منه إلّا بالاقتراب من المنحوسين مثلك.
ذاتَ يومٍ بارد، جلستُ في كافيتريا الجامعة. وإذ بي ألمح وجهَ طالب رأيتُه صبيحةَ ذلك اليوم في مُدرّج محاضرة "الأنظمة الاجتماعيّة المعاصرة." اقتربتُ منه وسلّمتُ عليه. كان لابسًا خزانةً من الثياب: قميصيْن وكنزتيْن وسرواليْن وجوربيْن. عرَفني هو أيضًا. ابتسم وقال إنّ اسمَه سيباستيان، ومدّ لي يدَه وقبض على يدي جيّدًا ثمّ أرخاها. قبضتُ على يده برخاوة، ثمّ وضعتُها على صدري، وهي عادةُ المسلمين أو العرب في التحيّة. دعاني إلى شرب فنجان قهوة، فقبلتُ لأنّي لم أتغدَّ يومها. سألتُه إنْ كان يعرف مسكنًا فارغًا لأنّي في حاجةٍ إلى بيتٍ يأويني. ضحك قليلًا وقال إنّ "المشاكل لا تأتي إلّا بعد أن توجد الحلول، لكنّ الانسان يُعقّد السبلَ لقبولها." تذكّرتُ أنّ خالي كان يقول لي حين تستعصي عليّ الأمور: "لا تتأزّم إلّا على إبليس، لعنةُ الله عليه." يبدو أنّ الشيطان كان يلاحقني حينها. ابتسمتُ لاقتراح سيباستيان. وسألتُه: "ما الحلّ؟" أجاب: "لي مكانٌ لكَ الليلة إنْ أردتَ." سألتُه عن الثمن. فقال لي: "بلا مقابل." فرحتُ حينها فرحتيْن.
خرجنا من الجامعة وكان الوقتُ مغربًا. كان سيباستيان كلّما مرّ بسيّارةٍ مرصوفةٍ يحاول فتحَ صندوقِها الخلفيّ. لا يترك سيّارةً إلّا ويضع أصبعَه الوسطى في مؤخّرتها. ومن حين إلى حين يقول: "لا ندري. ربّما!" بدأتُ أتأكّد أنّه غريبٌ بعضَ الشيء. دخلنا إلى مرأب سيّارات. اتجه من دون تردّد إلى سيّارة حمراء في زاوية مركونة. فتح بابَها الخلفيّ، وقال لي: "هذه هي غرفتُكَ الليلة. تعال معي إلى غرفتي. سأعطيك بطّانيّةً ومطرحًا ومخدّة." تجاوزنا ثلاثَ سيّارات، ثمّ فتح مؤخّرةَ السيّارة وأخرج منها عدّة بطّانيّات ومطرحًا ومخدّة. وضعها على صدري وقال لي: "ضعْها في الصندوق وارجعْ." سألتُه: "هل سننام هنا؟" ردّ: "ولا أحلى من مؤخّرات السيّارات."
أخرجَ من السيّارة مُسخِّنَ ماء، وذهبنا إلى زاوية المرأب حيث يوجد مخرجُ كهرباء. عبّأ المُسخّنَ بالماء ووضع فيه الشاي. شربنا أربعَ كؤوس شاي تباعًا. سألتُه عن البرد في الليل. قال "الفِراش يقي جيّدًا، لكنْ لا تدعْ بابَ الصندوق مشقوقًا لأنّ الهواء الصباحيّ خطير." كنتُ أعتقد أنّ السيّارات له، لكنّي فهمتُ أنّه يسطو على تلك التي ينسى أصحابُها إغلاقَها أو التي لا يشتغل قفلُها. وكان يُغيِّرها من حين إلى آخر، كما روى لي.
بقيتُ مع سيباستيان أربعة أسابيع. تنقّلنا حينها ثلاثَ مرّات. كان يقول لي إنّ سيّارات سيتروان هي الأحسن لأنّها تمنع دخولَ الهواء. أمّا أسوأ السيّارات فهي رونو الفرنسيّة؛ حديدُها بارد وهو قطعة من الجحيم.
كانت ثمّة جمعيّةٌ للكاثوليك أمام الجامعة. نمرّ عليها في الصباح فتعطينا كأسَ شوكولاطا ساخنة وقطعةَ حلوى. نأخذ حمّامًا ساخنًا هناك، نسخِّن به عظامَنا ونحْلق ذقنيْنا، ثمّ نلتحق بالمدرَّجات كبقيّة الطلبة.
تعلّمتُ الكثيرَ عن الفلاسفة الإبيقوريّين مع سيباستيان. تعرّفتُ إلى ديوجان الإغريقيّ، الذي كان يعيش في برميل خارج المدينة. كان إمامًا في الفلسفة. وقد أراد الإسكندرُ المقدونيّ أنْ يأخذ عنه الفلسفةَ، فوجده جالسًا أمام برميله يتسخّن على أشعّة الشمس، فقال له: "اصحبْني في يومي هذا، واطلبْ ما شئتَ يا ديوجان." ردّ عليه ديوجان: "أريدكَ فقط أن تتنحّى قليلًا لأنّك تحْجب عنّي الشمس."
غريبٌ أمرُ المهمَّشين: لا يتناقلون إلّا الأخبارَ التي تُسلّيهم في بؤسهم وتبرِّر لهم البقاءَ في غرقهم.
الضيفُ السارق
تجتاحني هذه الأيّام فترةُ كآبةٍ غريبة، أعيش فيها فراغًا وجوديًّا متواصلًا، مثل السقوط في هاوية من دون أن أصل إلى القعر.
هجرتُ سريرَ النوم، ورحتُ أقرفصُ على الكنبة مثلَ متشرّدٍ ينام في الشارع في ليلةٍ باردة: يضع يديه بين فخذيْه، ويدكّ رأسَه أمامه منحنيًا على صدره، ويلفّ ساقيْه فتشدّ قدماه على مؤخّرته. المؤخّرة تدفّئ القدمين، والفخذان تُنعشان اليدين بحرارتهما، والكتفان تضُمّان الرقبةَ والرأس.
هزُل وزني خمسة كيلوغرامات في وقتٍ قياسيّ. ولم أعد أتناول إلّا القهوةَ والخسّ. توقّف الخبزُ عن جذب شهيّتي، وصار اللحمُ ثقيلًا على معدتي. أشاهد التلفزيون ساعات، لكنْ لا أفهمُ شيئًا. صوتُ الراديو بات مثل الذبذبات المشفَّرة. حتّى الموسيقى لا تقْبلها أذني. أفتح كتابًا وأنهي فصلًا، ثم لا أفهم علاقة الخاتمة بما سبق.
منذ مدّة، بعد منتصف الليل، صرتُ أسمع قفلَ الباب الخارجيّ يُفتح. يدخل شخص ثمّ يُغلق البابَ وراءه. أكون حينها مقرفصًا وواعيًا بما يجري، لكنْ لا رغبةَ لي في القيام والاستفسار. يضع الشخصُ شيئًا مثل الكيس على الأرض. ينزع حذاءه. يخلع معطفَه ويعلّقه. يذهب نحو النافذة جنب الكنبة التي أنا عليها. لا أعرف إنْ كان يقترب منّي ليعاينني، أمْ لينظر من النافذة الى أضواء باريس. تبدأ الأفكارُ تغزو مخّي، وتكثر الأسئلةُ والتحاليل: فأنا الوحيد الذي يملك مفتاحَ البيت، وهذا الشخص ليس لصًّا بالتأكيد؛ فقد أغلق البابَ ونزع حذاءه وأخذ راحتَه في استكشاف المكان.
أسمعُ الخطوات تتّجه نحو المطبخ. يضع شيئا في المسخِّن. يفتح الثلّاجةَ ويُخرج شيئًا منها ليضعه على صحن ثمّ يغلقها. يشغِّل الراديو، فأسمع معه موسيقى الجاز الخفيفة. يُخرج الطعامَ من المسخّن ويبدأ في تناوله. تطول فترةُ الأكل، فأغفو قليلًا. أستيقظُ على وقع نزول المياه في المرحاض. يتّجه نحو المغسل ليصبّ الماءَ على يديه. ثمّ أسمعُ الثيابَ تُنزع وتوضَع على المشدّ، ويشرع في أخذ دوشٍ خفيف، وبعدها ينشّف نفسَه بمنشفتي. يأخذ في لبس ثيابه وتعطير نفسه بعطري، ويحلق بمحلقتي أيضًا. يطفئ أضواءَ الغرف ويتّجه نحو الباب. يلبس حذاءه ومعطفَه ويخرج مغلقًا البابَ خلفه بالمفتاح.
هذه هي المرة الرابعة التي ينزل فيها هذا السارقُ الضيفُ عندي ليلًا. وأظنّه سيرجع ليلة غد.
ينسون
حياتي لم تكن سهلةً معها في البداية، لكنّي اعتدتُها مع الوقت. أشياءُ غريبةٌ كانت تحدث معي. كنتُ قبل أنْ أنام أحسّ أنّ جسمًا كثيفًا واقفًا أمامي، ظُلْمتُه أشدُّ من ظلمة الغرفة. أفتح عينيّ جيّدًا لأراها، فلا أبصر شيئًا. ثمّ أسمع حركةَ قدميْن تضرب بخفّةٍ على أرض الغرفة. أتوقّف عن التنفّس. ألمّ البطانيّة على رأسي. أحاول أن أفهم وجهتَها. أبقى على هذه الحال ساعةً أو أكثر، إلى أنْ أنام.
مرّات، في أحلامي، كنتُ أرى بنتًا جميلةً. سمراء الوجه، عيناها واسعتان، ويتغيّر لونُهما في كلّ مرة. شعرُها طويل جدًّا، ربّما يصل إلى ركبتيها، تُطْلقه ناعمًا مثلَ الحرير. تقترب منّي وتضع إصبعَها على فمي، فأستيقظ وأحسّ بحرارةٍ غريبةٍ على فمي. مرّات، أفيق من نومي مذعورًا، وأحسُّ أن جسمًا ثقيلًا فوقي، وأجد نفسي عاجزًا عن الحركة.
عندما تكرّرتْ هذه الظواهر أخبرتُ أمّي، فقالت إنّ عليّ أن أضعَ مصحفًا تحت الوسادة وأنْ أقرأ القرآن قبل النوم. لكنْ عبثًا، إذ واصلت البنت زياراتِها لي.
كنتُ أعلم أنّها جنّيّة. لكنْ، أهي مسلمة أمْ لا؟ وقلتُ في نفسي إنّ القرآن لا ينفع معها، فلا بدّ إذًا من أن تكون من قبيلة الجنّ المسلمين.
بعد شهور من هذه الظواهر بدأتْ نفسي تَطْرب إليها. وصارت تحدّثني في المنام. مرّةً سألتُها عن اسمها، فقالت: "ينسون." وكانت تخبرني في أحلامي عن أسماءِ أصدقائي أو عائلتي، وفي الغد ألتقيهم، فيزيد انشراحي لها لأنّها تخبرني عن الغيب.
وكانت أطولَ من قامتي كثيرًا. ربّما كانت أطولَ من قامة البشر قليلًا. وبدت أنّها تكبرني قليلًا.
بعدما زرتُ فقيهًا يحفظ القرآنَ، وأخبرتُه عن حالها، قال لي: "إيّاك أن تتزوّجَها إنْ طلبتْ ذلك. سوف تختطفك ويَذهب عقلُك." لكنّها لم تتكلّمْ معي في الزواج. ما أتذكّره أنّ اضطرابَها يتضاعف عندما أحدّثها عن البنت التي أحبُّها في الجامعة. كانت علاقتي بصديقتي الجامعيّة تتحسّن يومًا ثمّ تفسد أسابيع، ومع الوقت فهمتُ أنّ سوءَ العلاقة كان بسبب غيرة ينسون.
ما استغربتُه من ينسون أنّها تقترب منّي عندما أكون على جنابة، أو عندما أكون متوضّئًا، أو مُصلّيًا. أظنّ أنّ الجنّ لا يهتمّون بهذه الجزئيّات الدينيّة؛ إذ عندما يتعلّقون بإنْسيّ، فإنّهم لا يُعِيرون دينَه أو عِرقَه أو لغتَه اهتمامًا.
مرّةً، رافقتني إلى غابةٍ سوداء. خفتُ كثيرًا. بلغنا بيتًا غريبًا أخضر. أدخلتْني فيه، فوجدنا أُمًّا وأبًا وأبناءً صغارًا. أكلنا معًا، ثمّ أخرجتني من الغابة، ورجعتْ إلى البيت الأخضر. مازلت أقول إنّها، آنذاك، عرّفتْني إلى عائلتها.
كنتُ أحيانًا أتمنّى أن أمارس معها الجنس. لكنْ لم يحدث شيء من هذا القبيل في الأحلام.
مرّاتٍ، قبل النوم، كنت أحسُّ بأنهّا قربي، فأحاول أنْ أتكلّم معها، لكنّها لا تردّ عليّ. ولم أكن أسمعُها وأنا مستيقظ.
في رمضان كنتُ أضع كوبَ ماءٍ قرب رأسي كي أشربَ منه قبل السحور، فأجده فارغًا. وكنتُ أحيانًا أترك كوبَ الماء في غرفتي أيّام الصوم، لأجدَه بعد قيلولتي فارغًا. عرفتُ حينها أنّها لا تصوم رمضان، أو ربّما رمضانها يأتي في زمنٍ غير زمننا.
وكانت تقودني في الليل إلى بعض الأضرحة. وفي الغد أزورُها وحدي. وكنت أجدُ في الأضرحة خبزًا أو فاكهة، فآكل، وأحسب أنّ ينسون هي التي وضعتْهما.
عندما ذهبتُ إلى فرنسا توقّفتْ ينسون عن زيارتي. ومن حينها وأنا أنتظرُ رجوعَها. وكنت عندما أرجع إلى بلدي أذهب إلى الأضرحة التي كانت تقودني إليها، علّي أجدُها. لكنّها اختفت.
الحادث
أن تختارَني الطريقُ شاهدًا على حادث مرور، فهذا أمرٌ غيرُ متوقّع. كنت أسوق سيّارتي في وقتٍ متأخّرٍ على الطريق الملتوي بين مدينتيْ معسكر ووهران. الطريق جدُّ ضيّق، ولا يفصل بين الاتجاهين إلّا خيطٌ أبيض ممحوٌّ بعجلات السيّارات.
ألُفُّ المقوَد وأسمع للشابّ خالد أغنيتَه "طريق الليسي عقبة وكي عياتني" (ما أشدّ ما أتعبتني طريقُ الثانويّة التي تُشبه المرتفع). فجأةً، أبصرتُ على الحافّة الأخرى سيّارةً شبهَ مقلوبة. زجاجُها الأماميّ مثقوب، وفيه فتحةٌ تسمح بخروج حصان. ابتعدتُ قليلًا عن الحادث. وبدأتُ في التفكير: هل أتوقّف وأرى الحادث، أمْ أذهب لشأني وأترك المسألةَ للسيّارات الآتية من بعدي؟
بعد عشرة أمتار أو أكثر وجدتُ نفسي أعود إلى مكان الحادث. رصفتُ سيّارتي وراء السيّارة المنتحِرة. المحرِّك يخرج منه الدخان، ولا أحد في السيارة، والعجلة المعلّقة في الهواء تدور بقوةٍ كالمجنونة. أطللتُ على الهاوية: عينٌ على رجلي وأين أضعُها، وعينٌ على الهاوية. رأيتُ على بعد أمتار تحت الطريق لباسَ امرأة، ورجْلُها مكشوفة. بحثتُ عن سيّاراتٍ قادمة يمكن أن تساعدني على إخراج هذه المرأة أو النزول إليها. ثمّ فكّرتُ في الإقلاع بسيّارتي وتركِ هذه المرأة هنا؛ فهي وحدها المسؤولة عن هذا الحادث، ولا أظنّ الأمرَ ارتطامَ سيّارتين. أصلًا، لماذا تسوق المرأةُ السيّارة؟ لماذا تخاطر بحصول خلل في الغدّة الخاصّة بإفراز البويْضات؟! لماذا تسوق بلا مَحْرم؟! ولماذا تسوق في الليل، واللهُ جعله للسكون والمبيت، خصوصًا للنساء؟!
بدأتُ أنادي الجثّة: "يا بنت! يا امرأة! ردّي عليّ!" فلا تردّ عليّ إلّا العجلةُ المجنونة. جاءتني فكرةُ أنْ أدليَ إليها بحبلٍ وأجذبَها نحوي، لكنّها لا تتكلّم ولا تتحرّك، فكيف تتعلّق بالحبل؟ قلتُ في نفسي ربّما أربط حبلًا في سيّارتي وأنزل به لأرى حالتَها، لكنْ لو تقطّع الحبلُ فمن سيبحث عنّي؟ فكّرتُ في الاتصال بالشرطة أو الإسعاف، لكنّي تذكرت أنّني نسيتُ هاتفي في وهران.
انتظرتُ قليلًا ريثما تمُرّ سيّارة ونتشاور في إخراج الضحيّة أو نتّصل بالشرطة. لكنْ لماذا أقدّم مساعدةً إلى صاحبة الحادثة ولستُ أنا المسؤول عن الحادث ولا أملك حبلًا طويلًا وآمنًا يضمن لي أنْ أصل إليها؟ أصلًا أنا لستُ منقذَ أرواح، وقد أنقذتُ نفسي من هذه الحياة بشقّ النفس!
فتحتُ بحذرٍ سيّارةَ المرأة من جهة الطريق وبدأتُ أبحث عن هاتف، فلم أجد شيئًا. لكنّي وجدتُ قنّينة بيرة مفتوحةً مرميّةً على الأرضيّة، وزبدُها مازال يُخرج الفقعات. استغفرتُ الله، وعدّلتُها حتى لا يتواصل سيلانُها.
خرجتُ من السيّارة وأعدت الصراخَ على المرأة بصوتٍ عالٍ، متمنّيًا أن تردَّ عليّ أو تتحرّك قليلًا. ثمّ تبيّن لي ضوءُ سيّارةٍ آتيةٍ من بعيد.
الجزائر
جزائريّ مقيم في فرنسا. متحصّل على شهادة التبريز. يعمل أستاذًا في أكاديميّة فرساي. نشر دراسةً تاريخيّةً مع تحقيق لنصّ ابن خلدون عن تاريخ المغول.