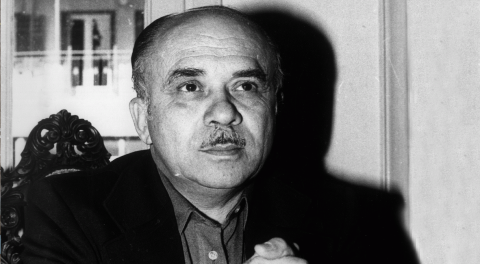كاتب ومترجم، وأكاديميّ سوريّ. عضو اتحاد الصحفيين السوريين، ومدرّب دوليّ في مجالات التحكيم التجاريّ الدوليّ وإدارة النزاعات.

نُشرتْ قصّة "عربي" ضمن مجموعة أهالي دبلن في العام 1914. وقد اعتُبرتْ من أروع القصص القصيرة؛ كما حصلتْ على المرتبة الأولى في مجموعة قصص لطلّاب المدرسة العليا. وفيها تظهر براعةُ الكاتب الإيرلنديّ الكبير جيمس جويس في وصف مشاعر فتًى يقترب من مرحلة البلوغ: حماسًا، وافتتانًا، وارتباكًا، فإحباطًا. إنّ أخت "مانغان" لهي أيقونةٌ للشغف المراهق الأول، الذي يشْغل الفتى عن درسه ولعبه وكلّ الأمور الأخرى، وهي علامةٌ على التفارق المذهل بين المثال الإكزوتيكيّ (أخت مانغان والبازار "العربيّ" المؤمثَل في صورة استشراقيّة) والواقع الرتيب (الشارع المعتم، العمّ المتأخر، البائعة غير المبالية، الأنوار المطفأة،...)
الآداب
***
نظرًا إلى أنّ شارع رشموند الشماليّ غيرُ نافذ، فقد كان هادئًا، خلا الساعة التي تُطلِق فيها مدرسةُ الإخوان المسيحيين سراحَ التلاميذَ. عند نهاية الشارع المغلقة، انتصب منزلٌ غيرُ مأهولٍ بالسكّان، مؤلّفٌ من طابقيْن، تفصله عن جيرانه ساحةٌ مربّعة. وكانت بقيّةُ المنازل في الشارع، إذ تعي وجودَ الحيواتِ الكريمةِ القاطنةِ فيها، تتأمّل بعضها بعضًا بوجوهٍ بنّيّةٍ هادئة.
كان المستأجِرُ السابقُ لمنزلنا، وهو قسّ، قد توفّي في غرفة الاستقبال الخلفيّة. وكانت رائحةُ العفن منتشرةً في كلّ الغرف لكونها قد أغلقتْ فترةً طويلة، وغرفةُ النفايات خلف المطبخ مليئةً بالأوراق القديمة العديمة الفائدة. وبين هذه، وجدتُ بعضَ الكتب ذات الأغلفة الورقيّة، وكانت صفحاتُها مجعّدةً ورطبةً مثل: الدير للكاتب وولتر سكوت، والخطيب المتديّن ومذكّرات فيدوك. أحببتُ الكتابَ الأخير أكثرَ من الكتب الأخرى لأنّ أوراقه كانت صفراء. وقد احتوت الحديقةُ البرّيّة خلف المنزل على شجرة تفّاح في المنتصف، بالإضافة إلى العديد من الأغصان العشوائيّة، التي وجدتُ تحت أحدها مضخّةَ هواءٍ صدئةً تعود إلى درّاجة القسّ المتوفّى. لقد كان القسّ يحبّ أعمالَ الخير كثيرًا؛ وقد كتب في وصيّته أنّه يترك كلَّ أمواله للمؤسّسات [الخيريّة]، بينما ترك أثاثَ منزله لأخته.
عندما تحلّ أيّامُ الشتاء القصيرة، ينتشر الغسقُ قبل وقتٍ طويلٍ من تناولنا طعامَ العشاء. وعندما نلتقي في الشارع، يكون لونُ المنازل قد غدا قاتمًا، وتصير مساحةُ السماء من فوقنا بلون بنفسجيّ متغيّر على الدوام، وفي اتجاهها ترفع أضواءُ الشارع مصابيحَها الخافتة. كان الهواءُ البارد يلسعنا، وكنّا نلعب حتى تتوهّج أجسادُنا. وكان صدى صراخنا يملأ الشارعَ الصامت. وكان مسارُ لعبِنا يقودُنا، عبر الطرق الموحلة الواقعة خلف المنازل ــ وهناك نتعرّضُ إلى نقد القبائل الجلِفة القاسية وهي في أكواخها ــ إلى الأبواب الخلفيّة للحدائق المتقطّرة الداكنة، حيث تتصاعد الروائحُ من حُفر الرماد، وصولًا إلى الاسطبلات الداكنة الكريهة الرائحة، حيث سائسُ خيلٍ ينعِّم شعرَ الحصان ويمشِّطه أو يُحْدث رنينًا من اللجام المشدود. وعندما نعود إلى الشارع ، يكون الضوء المنبعث من نوافذ المطبخ قد ملأ المنطقة . وإنْ شوهد عمّي ينعطف عند زاوية الشارع، اختبأْنا تحت الظلّ، إلى أن نراه يدخل منزلَه بأمان. وإنْ خرجتْ أختُ مانجان عند عتبة الباب تنادي أخاها لتناول شايه، راقبناها من ظلّنا. وكنّا ننتظر لنرى إنْ كانت ستبقى خارجًا أمْ ستدخل المنزل؛ وفي حال بقائها خارجًا كنّا نغادر ظلّنا ونصعد إلى درج مانجان مذعنين. وهناك تكون في انتظارنا، فنتعرّف إلى مظهرها من الضوء المنبعث من الباب نصفِ المفتوح. وكان أخوها يغيظها قبل أن يطيعَ أوامرَها. وكنتُ أقف بجانب السياج أنظر إليها، وفستانُها يتمايل إذ تحرِّك جسدَها، فيتمايل حبلُ شعرها الناعمُ ذاتَ اليمين وذاتَ اليسار.
كنتُ أتمدّد كلَّ صباح على الأرض في البهو الأماميّ أراقب بابَها. وكانت الستارةُ تُنزل بوصةً واحدةً عن إطار الباب بحيث لا يراني أحد. حين تتخطّى عتبةَ البيت، يقفز قلبي من مكانه. أهرع إلى القاعة، وألتقطُ كتبي، وأتبعُها. كنتُ أبقي عينيَّ بشكل دائم على طلّتها البنّيّة. وعندما نقترب من النقطة التي تتفارق فيها طريقانا، أحثّ الخطوَ وأتجاوزُها. كان ذلك يَحدث صباحًا تلوَ صباح. لم أكن أكلّمها مطلقًا، باستثناء كلماتٍ عرضيّةٍ عابرة. لكنّ اسمَها كان بمثابة استدعاءٍ لكلّ دمي الأحمق.

جيمس جويس
كان طيفُها يرافقني حتى في أكثر الأماكن عداءً للرومانسيّة. في أمسيات السبت، عندما تذهب عمّتي للتسوق، كان عليّ أن أرافقَها لأحملَ بعض الأغراض. كنّا نسير في الشوارع الصاخبة، يدفعنا رجالٌ سكارى ونساءٌ مساوِماتٌ، وسط لعناتِ العمّال، ووسط نداءاتٍ عاليةٍ يطْلقُها أولادٌ يعملون لدى مَتاجر ويقفون متيقّظين أمام براميل لحم الخنزير، ووسط غناءِ مغنّي الشوارع وهم يخنّون من أنوفهم أنشودةً عن [القائد الإيرلنديّ] أودونفان روسّا أو أغنيةً شعبيّةً عن مشكلات وطننا الأمّ. وكانت هذه الأصواتُ تتجمّع، بالنسبة إليّ، عند إحساسٍ واحد: وهو أن أتخيّل أنني أحمل خمرةَ قرباني بأمانٍ وسط ثلّةٍ من الأعداء. كان اسمُها يقفز إلى شفتيّ أحيانًا في صلواتٍ ومدائحَ غريبةٍ لم أكن أنا نفسي أفهمُها. وكانت عيناي غالبًا ما تمتلئان بالدموع (ولم أكن أعرف لماذا)، وأحيانًا كان يبدو وكأنّ سيلًا من الدموع ينسكب على صدري. كنتُ قلّما أفكّر في المستقبل. لم أكن أعرف إن كنتُ سأتحدّث معها يومًا أمْ لا. وإنْ تحدّثتُ معها، فكيف لي أن أخبرَها بإعجابي المضطرب؟ لكنّ جسدي كان مثلَ القيثارة (الهارب)، وكانت كلماتُها وإيماءاتُها مثلَ الأصابع التي تحرّك أوتارَ تلك الآلة.
ذاتَ مساء، ذهبتُ إلى غرفة الاستقبال الخلفيّة التي توفّي فيها القسّ. كانت ليلةً ظلماءَ ماطرةً، ولم يكن هناك أدنى صوتٍ في المنزل. سمعتُ من خلال أحد ألواح الزجاج المكسور صوتَ المطر يسقط على الأرض، وإبَرَ الماء الناعمة المتواصلة تعزف فوق الأرض المشبَعة بالماء. ثم ظهر ضوءٌ بعيد، أو أومضتْ تحتي نافذةٌ مضيئةٌ ما. كنت ممتنًّا لأنّني لم أستطع أن أرى إلّا القليلَ جدًّا. كانت كلُّ مشاعري تبدو وكأنّها تتوق إلى أن تحجبَ نفسَها. وإذ شعرتُ وكأنّني أنسلّ منها، فقد ضغطتُ راحتيْ يديّ الواحدة فوق الأخرى حتى ارتجفتا، وتمتمتُ عدّة مرات: "آهٍ من الحبّ! آهٍ من الحبّ!"
أخيرًا تحدّثتْ إليّ. عندما خاطبتْني بكلماتها الأولى شعرتُ بالارتباك إلى حدِّ أنّني لم أعرفْ بمَ أجيب. سألتْني إنْ كنتُ ذاهبًا إلى "عربي." نسيتُ إنْ أجبتُها بنعم أو بكلّا. قالت إنّه سيكون بازارًا رائعًا، وإنّها تحبّ أن تذهب إليه.
سألتُها: "ولمَ لا تستطيعين الذهاب؟"
بينما كانت تتحدّث، راحت تدير سوارًا فضّيًّا مرّاتٍ ومرّاتٍ حول معصمها. قالت إنّها لا تستطيع أن تذهبَ لأنّها لا تستطيع أن تنسحب من عظة هذا الأسبوع في الدير. كان أخوها يتعارك مع صبيّيْن آخريْن من أجل قبّعاتهم، وكنتُ بمفردي عند السياج. أمسكتْ بأحد المقابض، وأحنت رأسَها في اتجاهي، فأظهر الضوءُ المنبعثُ من المصباح المقابل لبابنا ثنْيةَ عنقها البيضاءَ، وأنار شعرَها المتدلّي، وأضاء يدَها على السياج. سقط الضوء على جانبٍ من فستانها، وأبرز الحدَّ الأبيضَ من تنّورة داخليّة بانت للعيان ما إنْ وقفتْ باسترخاء.
قالت: "لا مشكلة بالنسبة إليك."
أجبتُها: "إنْ ذهبتُ فسأحْضرُ لكِ شيئًا."
ما أكثر الحماقات التي حوّلتْ أفكارَ يقظتي ومنامي هباءً منثورًا بعد ذلك المساء! تمنّيتُ لو أمحو الأيّامَ المملّةَ قبل رؤيتها من جديد. صارت الواجباتُ المدرسية تغيظُني، وحالت صورتُها بيني وبين صفحة الكتاب التي أجهدُ في قراءتها ليلًا في غرفة نومي، ونهارًا في الصفّ. وحضرتْ إلى مخيّلتي المقاطعُ الصوتيّةُ لكلمة "عربي" في ساعات الصمت التي أستمتعُ بها ، وألقت عليّ سحرَ الشرق. طلبتُ إجازةً للذهاب إلى البازار ليلةَ السبت. دُهشتْ عمّتي، وأملتْ ألّا يكون معرضًا ماسونيًّا. أجبتُ عن أسئلةٍ قليلةٍ في الصف، وراقبتُ وجه معلِّمي يتبدّل من الودّ إلى القسوة؛ كان يأمل ألّا أكونَ قد بدأتُ بالتكاسل. لم أستطع أن استحضرَ أفكاري المتجوّلة وأجمعَها. وفقدتُ كلَّ صبر ممكن على العمل الجادّ في الحياة، وهو عمل بات يقف حائلًا بيني وبين رغبتي، فبدا لي أنّه لعبٌ طفوليّ؛ لعبٌ طفوليّ قبيحٌ ورتيب.
صباحَ السبت، ذكّرتُ عمّي بأنّني أرغب في الذهاب إلى البازار في المساء. كان يستند إلى سياج السلّم يبحث عن فرشاةٍ لطاقيّته. أجابني باقتضاب:
"نعم، يا صبي. أعلمُ."
كان في القاعة، فلم أستطع العبورَ إلى غرفة الاستقبال الأماميّة والاستلقاءَ بجانب النافذة. غادرتُ المنزل بمزاجٍ سيّئ، ومشيتُ ببطء نحو المدرسة. كان الهواءُ فجًّا بلا رحمة، وكانت الهواجس والظنون تتنازع قلبي.
عندما عدتُ إلى المنزل لتناول العشاء، لم يكن عمّي قد عاد بعد؛ فقد كان الوقتُ مبكّرًا. جلستُ أحدّق في الساعة بعض الوقت. وحين صارت دقّاتُها تزعجني، غادرتُ الغرفة. صعدتُ الدرجَ، وبلغتُ الجزءَ العلْويَّ من المنزل. حرّرتني الغرفُ العلْويّةُ الباردة الخاوية الكئيبة، فشرعتُ أغنّي وأنا أتنقّل من غرفة إلى أخرى. من النافذة الأماميّة شاهدتُ رفاقي يلعبون في الشارع تحتي. وصلتني صرخاتُهم ضعيفةً لا يمكن تمييزُها. أسندتُ جبهتي على الزجاج البارد، ونظرتُ إلى المنزل المظلم حيث كانت تعيش. لعلّي وقفت هناك ساعةً من دون أن أرى سوى شكلِها البنّيّ الذي يخيّم على خيالي، يلمسه بشكلٍ خافتٍ ضوءُ المصباح على ثنية عنقها البيضاء، وعلى يدها القابضة على السياج، وعلى طرف التنّورة الداخليّة.
عندما هبطتُ الدرجَ ثانيةً، وجدتُ السيّدة ميرسير تجلس قرب الموقد. كانت عجوزًا ثرثارةً، أرملةً تُقْرِض الأموالَ، وتجمع الطوابعَ المستعملة من أجل غايةٍ دينيّةٍ ما. كان عليّ أن أحتمل ثرثرتَها على طاولة الشاي. تأخّرت الوجبةُ أكثر من ساعة، وعمّي لم يأتِ بعد. وقفت السيّدة ميرسير تهمّ بالذهاب، وأبدت أسفَها لأنّها لا تستطيع أن تنتظر أكثر؛ فالساعة تجاوزت الثامنة، وهي لا تحبّ الخروجَ في وقت متأخّر لأنّ هواء الليل يُضرّها. عندما غادرتْ، بدأتُ أذرعُ الغرفة جيئةً وذهابًا، شابكًا قبضتيّ. قالت عمّتي:
"ما أخشاه هو أن تؤجِّل زيارةَ البازار هذه الليلة لسبب لا يعلمه إلا الله."
عند التاسعة، سمعتُ مفتاحَ عمّي يتحرّك في قفل باب القاعة. سمعتُه يكلّم نفسَه، وسمعتُ صوتَ المشجب يئنّ تحت وطأة معطفه. أستطيع أن أفسِّر هذه الإشارات. عندما كان في منتصف عشائه، طلبتُ منه أن يعطيَني المالَ للذهاب إلى البازار، لأنّه كان قد نسي ذلك.
أجابني: "الناسُ في أسرّتهم، وهم تجاوزوا الآن بداية نومهم."
لم أبتسمْ. أجابته عمّتي بحماس:
"ألا تستطيع أن تعطيَه المالَ وتتركَه يذهب؟ لقد أخّرتَه بما يكفي."
قال عمّي إنّه آسف جدًّا لأنّه نسي. وقال إنّه يؤمن بالمثل القديم الذي يقول: "عملٌ كثيرٌ بلا لهوٍ، يجعل المرءَ ضجرًا مضجرًا." سألني إلى أين سأذهب. عندما أجبتُه للمرة الثانية، سألني إنْ كنت أعرف قصيدة "وداع العربيّ لجواده" [لكارولين نورتون]. حين غادرتُ المطبخ كان على وشك أن يُسمع عمّتي الأبياتَ الأولى من هذه القصيدة.
قبضتُ على قطعة الفلوران النقديّة، وأنا أمشي بسرعة هابطًا شارعَ بكنغهام نحو المحطّة. لقد ذكّرني مشهدُ الشوارع، المزدحمةِ بالبائعين، والمتوهّجةِ بالبنزين، بالغرض من رحلتي. جلستُ في مقعدي، في عربة الدرجة الثالثة، في قطار مهجور. وبعد تأخير لا يُحتمل، تحرّك القطار خارجًا من المحطّة ببطء. زحف نحو الأمام وسط منازلَ مدمَّرةٍ وفوق النهر المتلألئ. عند محطّة ويست لاند رو، اندفع حشدٌ من الناس نحو أبواب العربات، لكنّ الحمّالين أعادوهم إلى الخلف قائلين إنّ هذا القطار خاصّ بالبازار. بقيتُ وحيدًا في العربة الخاوية. خلال دقائق، اقترب القطارُ من رصيف خشبيّ مرتجَل. خرجتُ إلى الطريق، وشاهدتُ من خلال قرص ساعةٍ مضاءٍ أنّ الساعة صارت العاشرةَ إلّا عشر دقائق. أمامي، انتصب بناءٌ ضخمٌ يظهر عليه الاسمُ السحريّ.
لم أستطع أن أجد أيَّ مدخلٍ يُدخلني البازرَ بستّة بنسات. وخشيةَ أن يغلقَ المعرضُ أبوابَه، دخلتُ بسرعةٍ من أحد المعابر، بعد أن قدّمتُ شلنًا إلى رجلٍ يبدو عليه التعب. وجدتُ نفسي في صالة كبيرة، في منتصفها معرض. كانت معظمُ الأجنحة مغلقةً، والقسمُ الأعظم من القاعة غارقًا في الظلام. لاحظتُ صمتًا يشبه الصمت الذي يجتاح الكنيسةَ بعد عظة. مشيتُ إلى وسط البازار بتردّد. كان بعض الناس يتجمّعون حول الأجنحة التي ما تزال مفتوحةً. ثمّة رجلان اجتمعا، وراحا يَعدّان النقودَ على صينيّة أمام ستارةٍ خُطّ عليها بمصابيحَ ملوّنة "المقهى المغنّي." هناك، استمعتُ إلى أصوات سقوط النقود المعدنيّة.
وإذ تذكّرتُ بصعوبةٍ سببً مجيئي، توجّهتُ إلى أحد الأجنحة، وتفحّصتُ المزهريّات الخزفيّة وأطقمَ الشاي المزيّنةَ بالورود. عند باب الجناح شابّةٌ تتحدّث وتضحك مع شابّيْن. لاحظتُ لكنتَهم الإنكليزيّة، واستمعتُ على نحو غير واضح إلى محادثتهم.
" أوه! لم أقل شيئًا كهذا على الإطلاق."
"أوه! بل قلت ذلك."
"أوه! لم أقلْ ذلك."
"ألم تقلْ هي ذلك؟"
"بلى. سمعتُها."
"أوه....هناك ... كذب."
وعندما لاحظت الشابّةُ وجودي، اقتربتْ منّي، وسألتني إنْ كنتُ أرغب في أن أشتري شيئًا. كانت نبرةُ صوتها غيرَ مشجِّعة، إذ بدت وكأنّها تتحدّث معي انطلاقًا من شعورٍ بالواجب. نظرتُ بتواضع إلى الجِرارِ الكبيرة التي كانت تنتصب مثل حرّاس شرقيين على جانبيْ مدخل الجناح المظلم، وتمتمتُ:
"كلّا. شكرًا لك."
غيّرت الشابّةُ مكان إحدى المزهريّات، وعادت إلى الشابّيْن، وأكملوا الحديث في الموضوع ذاته. رمقتني الشابّة نظرةً أو نظرتين من خلف كتفها.
تسكّعتُ أمام جناحها، مع أنّني كنتُ أعلم أنّ وجودي بلا فائدة. كنت أريد أن أجعل اهتمامي بأوانيها يبدو طبيعيًّا. ثم استدرتُ بعيدًا ببطء، ومشيتُ إلى منتصف البازار. سمحتُ لقطعة نقودٍ من فئة البنسيْن بالسقوط على البنسات الباقية في جيبي. سمعتُ صوتًا ينادي من أحد أطراف البازار أنّ الأنوار انطفأتْ. وتحوّل الجزء العلوي من البازار إلى ظلام دامس.
حدّقتُ في الظلام، ورأيتُ نفسي مخلوقًا يقوده الغرورُ ويَسْخر منه؛ فاشتعلتْ عيناي ألمًا وغضبًا.
كاتب ومترجم، وأكاديميّ سوريّ. عضو اتحاد الصحفيين السوريين، ومدرّب دوليّ في مجالات التحكيم التجاريّ الدوليّ وإدارة النزاعات.