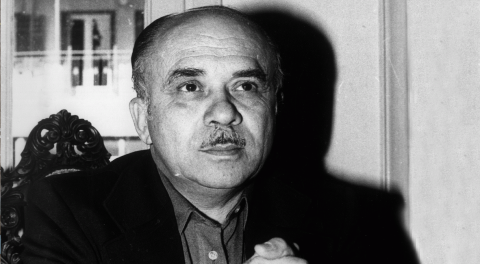في 22/11/2020 نظّمتْ مجلة الآداب ندوةً رقميّةً مستوحاةً من ملفّها لشهريْ 10-11، 2020، بعنوان "التعليم في زمن الكورونا." قدّم الندوة د. شوقي عطيّه، وتحدّث فيها (الفبائيًّا) كلّ من الدكاترة: ثناء الحلوة، وعلي خليفة، وهلا عواضة. هنا المداخلات بالتدريج.
***
تقديم ندوة "التعليم من بعد" – شوقي عطيه

في تشرين الثاني 2019 سُجّلتْ أوّلُ حالة، رسميًّا، لكوفيد-19 في الصين والعالم. وفي 21 شباط 2020، سُجّلتْ أوّلُ حالةٍ في لبنان. وفي آخر أيّام شباط 2020 أُعلنتْ في لبنان "التعبئةُ العامّة،" وأُقفلت المدراسُ والجامعاتُ والمعاهد، ولم يعد بعدها الطلّابُ إلى مقاعد الدراسة، ودخل العامُ الدراسيّ 2019-2020 في المجهول، ولم تُجْرِِ وزارةُ التربية امتحاناتٍ رسميّةً في قطاع التعليم المدرسيّ للمرّة الأولى منذ إعادة تفعيلها بعد الحرب. هكذا دخل اللبنانيّون، وقد سبقهم إلى ذلك مواطنو دولٍ عديدةٍ في العالم، في مجهولِ العمليّة التعليميّة. وبدأت المؤسّساتُ التعليميّةُ في التخبّط بعد تمديد الفترة الأولى للتعبئة، وبعدما تبيّن أنّ المرحلةَ الراهنة طويلةٌ ولن تنتهي في المدى المنظور.
الكلّ، إذًا، يدرك ضرورةَ العمليّة التعليميّة في جميع المراحل. إلّا أنّ كلمة "الكلّ" تتوقّف هنا. فهذا "الكلّ" تفرّع إلى جماعاتٍ متضاربةِ الرؤى والاتجاهات. فالانقسام أتى بين مكوّنات العمليّة التربويّة: الطلّاب، والأساتذة، والإداريّين (ومن ضمنهم أصحابُ المدراس)، والأهل. وكلُّ مكوِّن من هذه المكوِّنات الأربعة انقسم - بدوره - لأسبابٍ مختلفة، منها الذاتيُّ ومنها الموضوعيّ. وأنا هنا، إذ أصوغ عباراتي من وحي ما ورد في ملف "التعليم في زمن كورونا" في مجلّة الآداب، أشير إلى هذه الآراء المتضاربة:
- بين طلّابٍ لا يُمْكنهم إلّا اعتبارُ المؤسّسات التعليميّة، وخصوصًا المدرسة، سجنًا لا بدّ منه، ولا تُعِينُهم عليه في "مصيبتهم" إلّا فرصةُ لقاء أصدقائهم فيه؛[1] فكيف سيَنْظرون إليها الآن بعد أن سلختْهم من التفاعل الاجتماعيّ-الفيزيائيّ الفعليّ مع أترابهم، ووضعتْهم في قفصٍ من أطرافٍ أربعة: ظهرِ مَقْعدٍ، ويديْ هذا المقعد، وشاشةٍ زرقاءَ؟!
- وطلّابٍ آخرين، أكبرَ سنًّا من الأوّلين، لم يروْا من امتحانات الجامعة اللبنانيّة إلّا الموتَ، وكأنّها الجلّادُ الذي لا همَّ له إلّا تعذيبهم على أوتادٍ مسنونة.
- وأهلٍ لم يروْا في العمليّة التعليميّة الكحلاء (والكحلُ هنا أحسن من العمى) إلّا حجزًا لحريّاتهم من أجل خدمة أبنائهم من المتعلّمين.
إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ العمليّة التربويّة-التعليميّة يجب أن تقف. بالعكس تمامًا! فسُلَّمُ التربية، الذي حملناه في لبنان "بالعرض" طوال عقودٍ من عمليّات تطويرٍ بطيئةٍ، لا يمكن أن يتحوّل إلى "سلّمٍ بدرجاتٍ مفقودةٍ" (والتعبير للدكتور علي خليفة)؛ والدرجات هنا هي السنوات التعليميّة. فالطالب يُفترَض أن يتسلّقَ أكثرَ من خمسَ عشرةَ درجةً ليتخرّجَ من الجامعة في لبنان، فكيف سيتسلّق هذا السلّمَ إذا كانت درجاتُه مفقودةً بسبب تعطيلٍ أو إلغاءٍ لأعوامٍ دراسيّة؟ وأقول "أعوام" لأنّنا لا نعرف مصيرَ هذا العام تمامًا، كما لم نكن نعرف مصيرَ الذي سبقه.
ولم يكن التعليمُ الجامعيّ أقلَّ تضرّرًا، لا بل عانى الواقعَ نفسَه: ضياعًا وتخبّطًا، وسطَ مفاجأةٍ، لا بل زلزالٍ، في بلدٍ لا يستطيع السيطرةَ على حريق بضعةِ أشجار! فبدأتْ كلُّ مؤسّسة تعليمٍ عالٍ تضع خططَها وتكتيكاتِها لأنّها لم تكن تتوقّع أن تحتاجَ إلى استراتيجيّة. وبالطبع، برز التفاوتُ الطبقيّ، المتمثّلُ في الإمكانات المتاحة بين جامعةٍ وأخرى.[2] ومن البديهيّ أن أبسطَ هذه الإمكانات كانت تلك المتاحةَ للجامعة اللبنانيّة، وخصوصًا لطلّابها الذي يتوزّعون على مختلف الطبقات الاجتماعيّة، مع غلبةٍ واضحةٍ للطبقات الاجتماعيّة دون الوسطى.
وللمقارنة، اسمحوا لي هنا أن اقتبسَ ما تقدّمتْ به زميلةٌ لنا، وكتبتْه في الآداب، عن تجربتها في إحدى أكبر الجامعات الخاصّة في لبنان: "وسرعانَ ما تنبّه الطلّابُ إلى أنّها ستكون مرحلةً أشدَّ صعوبةً بكثيرٍ من زمن القاعات. والأسبابُ عدّة: لم نكن بعدُ مهيَّئين تقنيًّا - أو نفسيًّا - لخوض تجربة التعليم عن بُعد، وأغلبُ المحاضرات كانت قد صيغت بشكلٍ يعتمد بكثافةٍ على الحضور الشخصيّ. فاعتمدنا، في البداية، على نشر الرسائل الصوتيّة المطوَّلة أو الفيديو المسجّل مسبَّقًا لشرح الدروس تفصيليًّا للتلاميذ."[3]
هذا ما حصل في بداية الأزمة، وإنْ تغيّر بشكلٍ متفاوتٍ بين جامعةٍ وأخرى. وبهذا تعيد الطبقيّةُ الاقتصاديّةُ إنتاجَ الطبقيّة الأكاديميّة والمعرفيّة والتعليميّة. فالمعلومات التي قدّمتها الجامعةُ اللبنانيّةُ عن التجهيزات بين أيدي الطلّاب أشارت إلى أنّ حوالي 20% "فقط" لا يملكون جهازاً ذكيًّا.[4] إشارة هنا إلى أنّ أجهزةَ الهاتف، بما فيها الأجهزةُ ذاتُ الشاشات الصغيرة، تصنَّف من ضمن "الأجهزة الذكيّة." ومعظمُ هذه الأجهزة لم يكن قادرًا، أصلًا، على حمل كمّ المعلومات التي أُرسلتْ إلى الطلّاب من خلال وسائل غير مخصّصةٍ للتعليم من بُعد.
مع بداية العام، ونتيجةً لجهودٍ متواصلةٍ جبّارة قام بها المعنيّون بملفّ التعليم من بُعد في الجامعة اللبنانيّة، جرى التوافقُ على اعتماد منصّةٍ موحَّدةٍ للجميع، هي MS Teams، مع تنظيمها، وتسجيلِ المحاضرات، وتقديمِ التسهيلات وغيرها. إلّا أنّ السؤال، الذي نتمنّى أن نسمعَ إجاباتٍ عنه في هذه الندوة، هو: كيف يمكن أن نتسلّقَ هذا السلمّ الذي باتت أدراجُه مكسّرةً ومهترئةً في ظلّ أزمةٍ اقتصاديّةٍ متفاقمة، إلى حدّ أنّ أبسطَ جهازٍ ذكيّ يكلِّف ضعفَي الحدّ الأدنى للأجور؟ كيف يمكن أن نتسلّقَ هذا الدرجَ مع انترنت سيّئٍ لناحية التحميل، هذا إنْ وُجد أصلًا؟ كيف يمكن أن نتسلّقَه في بلدٍ تموت فيه الكهرباءُ (إنْ وُجدتْ) عند كلّ ومضةِ برق؟ وكيف يمكن أن نتسلّقََه في بلدٍ تحوّل فيه الأهلُ إلى مراكزَ لتلقّي الشكاوى، وتحوّلتْ فيه المدارسُ إلى شركاتِ تحصيل أقساطٍ بالشروط الميسَّرة؟ كيف يمكن أن نتسلّقه، وطلّابُنا يروْن أنّهم - بالتعليم من بعد – قد انتقلوا من "القاووش" إلى "الانفراديّ" من دون ذنْبٍ اقترفوه؟
سؤالٌ بألف استفسار. لكنْ، قبل أن أطرحَه، اسمحوا لي أن أوضح أنّني من أشدّ مؤيّدي التعليم من بُعد، ولكنْ عندما تقتضي الضرورةُ ذلك، وضمن تأمين كافّة الشروط التقنيّة والفنّيّة والأكاديميّة له. لا بل إنّني اقترحتُ، من خلال موقعي الأكاديميّ، أن نذهبَ إلى تأسيس شُعَبٍ يجري فيها التعليمُ من بُعدٍ حصرًا، وتكون مخصَّصةً للطلّاب غيرِِ القادرين على الحضور.
إذاً، أصدقائي، وأصدقاء الآداب، اسمحوا لي أن أطرحَ هذا السؤال وغيرَه على ضيوفنا، وهم أهلُ البيت أصلًا. فلنبدأ.
***
إطلالاتٌ على تجارب مشاركين في الملفّ – مداخلة ثناء الحلوة

لأنّ ذاكرة البشر غالبًا ما تكون قصيرةَ المدى لا ترتبط إلّا بالأحداث القريبة، فإنّ العالم لم يُعِرِ اهتمامًا كبيرًا ما يمكن أن يَنتجَ من ظاهرة الكورونا، واعتبرها أنموذجًا جديدًا للأمراض: يَظْهر ثمّ يختفي خلال مدّةٍ قصيرة، يَحْصد مئاتِ الأشخاص في بقعةٍ جغرافيّةٍ محدّدةٍ ثمّ يرحل من دون أن يَترك أثرًا كبيرًا.
في الفترة الواقعة بين العاميْن 2010 و2020، انتشر العديدُ من الأوبئة، مثل كورونا الشرق الأوسط ، وإنفلونزا الخنازير، وفيروس إيبولا (الذي انتشر في عددٍ من الدول الأفريقيّة)، وفيروس زيكا (الذي انتشر في أميركا الجنوبيّة). وقبل العام 2009، ظهر إنفلونزا الطيور(2003) وتسبّب بوفاة حوالي 400 شخص، وسبقه فيروس سارس (2002) الذي أدّى إلى وفاة 800 شخص في العالم.[5] أمّا على مرّ التاريخ، فقد حصدتْ بعضُ الأوبئة أرواحَ مئات الملايين، وتسبّبتْ في تغيّراتٍ ديموغرافيّةٍ واجتماعيّةٍ واقتصاديّةٍ في العالم بأسره، ومنها جوائحُ غيّرتْ مجرى التاريخ، وكان أشهرها وأشدّها فتكًا في العصور القديمة والوسطى: الطاعون الأسود، وطاعون جستنيان، وطاعون عمواس بمنطقة الشام،[6] والكوليرا خلال القرن التاسع عشر،[7] والإنفلونزا الإسبانيّة مع بداية القرن العشرين.
دخلت الكورونا بقوّة إلى كلّ العالم مع أواخر العام 2019 وبدايةِ العام 2020، وأحدثتْ صدمةً مدوّيةً لا زال أثرُها حتى اليوم. توقّف العالم - إذا جاز التعبير - عن الدوران، وتوقفّت المسيرةُ التربويّةُ في أوائل آذار 2020. وقد قدّرت اليونسكو عددَ الطلّاب المنقطعين عن الدراسة في العالم بسبب تداعيات كورونا بنحو 420 مليون طالب، وأعلن 61 بلدًا إغلاقَ المدارس والجامعات جزئيًّا أو كلّيًّا.[8]
لم تستمرّ حالةُ الصدمة طويلًا، والرغبةُ في الحياة كانت أقوى. فبدأتْ معظمُ القطاعات تبحث عن الطرق المناسبة لإعادة العجلة الى الدوران؛ ومنها القطاعُ التربويّ. ولأنّ الكورونا فرضتْ مجموعةً من الإجراءات، أبرزُها التباعدُ الاجتماعيّ، فقد عاد التعليمُ أوائلَ العام الدراسيّ 2020-2021 بطريقةٍ مختلفة: عن بُعد. لم يعد المعلِّمُ "ملكَ الصفّ." ولم ينتظم التلاميذُ في الصفوف والمدارس. وملفّ الآداب "المتدحرج" عن "التعليم في زمن الكورونا" أظهرَ مجموعةً من الأزمات التعليميّة المتقاربة في عددٍ من الدول العربيّة والأجنبيّة (لبنان، فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، كندا، فرنسا،...)، أبرزُها: 1) معاناةٌ كبيرةٌ تطاول معظمَ المشاركين في العمليّة التعلّميّة، من متعلّمٍ ومعلّمٍ وإدارةٍ مدرسيّةٍ وأهل. 2) غرقُ المعلِّم والمتعلّم في محاولة التأقلم مع التقنيّات التكنولوجيّة بصرف النظر عن المحتوى التعليميّ.[9] 3) ضعفُ توفّر التقنيّات التكنولوجيّة لدى الكثير من المعنيّين: كهرباء، انترنت، عدم امتلاك الفقراء ومحدودي الدخل بشكل خاصّ جهازَ كمبيوتر. 4) التلقينُ وحشوِ ذهنِ المتعلّم بالمحتوى المعرفيّ. 5) التفاوتُ في فرص التعلّم بحسب الحالة المادّيّة. 6) التفاوت بين الأساتذة في المهارات التكنولوجيّة؛ وهذا ينطبق على الأهل أيضًا. 7) التفاوت الاجتماعيّ المناطقيّ الثقافيّ. 8) نفور المتعلّمين من التعليم.
هذا وقد لفتتني بعضُ المقاطع في ملفّ الآداب، وأودّ أن أقتطفها هنا، لكونها معبّرةً عن واقع تعليميّ صعب في زمن الكورونا. يقول د. وسام الرفيدي من فلسطين، وهو باحثٌ ومحاضرٌ متفرّغ في دائرة العلوم الاجتماعيّة في جامعة بيت لحم: "أمّا معالجةُ التعليم عن بعد انطلاقًا من وسائل التدريس التي تتناسب وهذا التعليمَ، فهي استمرارٌ لذلك النفق الذي يعتكف فيه علمُ التربية منذ عشرات السنين، غارقًا في تقنيّات العمليّة التعليميّة على حساب محتواها، ومن دون اعتبارٍ لضرورة العلاقة المتبادلة بين الشقّيْن، مع الأهمّيّة الكبرى لمحتوى العمليّة التعليميّة بناءً تحتيًّا تنهض عليه وسائلُ التدريس." أمّا د. شبل بدران، أستاذُ علم اجتماع التربية، والعميدُ الأسبق لكلّيّة التربية في جامعة الإسكندريّة، فيعلّق على هذا الموضوع قائلًا: "كان لجائحة كورونا أثرٌ كبيرٌ في العودة إلى التفكير في ’التعليم المستمرّ‘ والانتقالِ من وظيفة نقل المعرفة وتلقينِها وحشوِ ذهنِ المتعلّم بها ومن ثمّ استرجاعِها إلى تكوين الشخصيّة القادرة على التفكير النقديّ المستقلّ وإعمالِ العقل في ما تتعلّمه من مصادر التعلّم العديدة في ظلّ ثورة المعرفة والمعلومات." وتحكي د. سلام دياب دورنتون، الأستاذة في المعهد الفرنسيّ للشرق الأدنى- بيروت، عن التجربة الفرنسيّة، فتقول إنّ المؤسّسات التعليميّةَ الفرنسيّة "لم تكن مهيَّأةً بشكلٍ جيّد لهذا التحوّل القسريّ، على الأقلّ بالنسبة إلى الحَجْر الأوّل، على حساب الطلّاب الأكثر حرمانًا. فالتدابير التي اتُّخذتْ لمكافحة الجائحة أذْكتِ الشرخَ الرقميَّ، ومن ثمّ التفاوتَ الاجتماعيَّ وعدمَ المساواة: فثمّة تغطيةٌ ضعيفةٌ في الأحياء الفقيرة والمحرومة، وسرعةٌ غيرُ كافية (بسبب غياب الألياف البصريّة التي تؤمّن أنترنتًا عاليَ السرعة)، بالإضافة إلى غلاء هذا النوع من الاشتراك، وعدمِ وجود جهاز كمبيوتر أو جهازٍ لوحيٍّ في منزل العائلة الواحدة، ناهيك بصعوبة الدارسة أو استحالتها في وجود باقي أفراد الأسْرة في المنزل." وعن التجربة اللبنانيّة، تقول د. هلا عواضه، وهي أستاذة مساعدة في معهد العلوم الاجتماعيّة، وباحثة في قسم الدراسات والمعلومات في البرلمان اللبنانيّ: "اللافت أنّ غيابَ نسبةٍ عاليةٍ من الطلّاب لا يتعلّق حصرًا بالمحاضرات عن بُعد، وإنما هو كذلك أمرٌ ملحوظٌ بشكلٍ واسعٍ في المحاضرات المباشرة." أمّا مايا مجذوب، وهي أستاذةٌ في الجامعة اللبنانيّة-الأميركيّة، فتتطرّق إلى زاوية مختلفة من هذا الموضوع قائلةً: "معظمُ الطلّاب الآن يعاني الفقدَ والمرضَ والقلقَ والاكتئاب. وأنا بتُّ أشعرُ بأمومةٍ ما نحوهم، أمومةٍ من خلف الشاشة. يجب أن أزوّدَهم بالأمل. أليس هذا أيضًا جزءًا من مهمّتي ومن واجبي الأخلاقيّ كمُدرِّسة؟ كأمٍّ افتراضيّة؟"
تشكّل الأزماتُ التربويّةُ الحاليّة امتدادًا لواقع التعليم ما قبل الجائحة، وهي تؤشِّر إلى مجموعةٍ من النتائج المتقاربة، لا فرقَ بين دولٍ متقدّمةٍ ودولٍ نامية:
1) الحاجة إلى إعادة نظر شاملة في العمليّة التعليميّة (مناهج، طرق تدريس، تقويم، تجهيزات،...).
2) الحاجة إلى تكوين الشخصيّة القادرة على التفكير النقديّ المستقلّ، وعلى إعمالِ العقل في ما تتعلّمه من مصادر التعلّم العديدة في ظلّ ثورة المعرفة والمعلومات.
3) الحاجة إلى عقْد "مصالحة" بين العلم والمتعلّم، عبر مجموعة من النشاطات، مثل: القيام ببرنامج تعريفيّ يوثّق العلاقةَ بين الطلّاب ومعلّميهم خلال الأسبوع الأوّل من المدرسة، ويتمّ تعريفُهم على المناهج الدراسيّة الجديدة وعلى أنظمة المدرسة ومرافقها المختلفة؛ والقيام بأنشطة تربويّة يمارسها المتعلِّمون خارج نطاق الصفّ.
4) الحاجة إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة والقضاء على التفاوت في فُرص التعلّم والترقّي الاجتماعيّ للمتعلّمين.
5) الحاجة إلى تحسيس المتعلِّمين بالأمن والأمان والأمل (وبخاصّةٍ في مواجهة المرض والفقر).
ولأنّ التربية تستند إلى معيار التقويم الذي يحتاج إلى متابعةٍ وامتحانات، وهو ما لا يتوفّر حاليًّا في أغلب المدارس، فقد تساءل بعضُ التربويّين عن قدرتنا على تحويل هذه الأزمة إلى فرصةٍ تُمكِّننا من التحوّل من ثقافة الاختبار إلى ثقافة التقويم، ومن ثمّ تأمين ظروف اعتماد التقويم في خدمة التعلّم، بحيث يصبح التلامذةُ قادرين على تحمّل مسؤوليّاتهم وضبطِ التعلّم والتحكّم به.[10] واذا كان هدفُ التعليم أيضًا تحقيقَ العدالة الاجتماعيّة، وبناء المتعلّم-المواطن، وتطويرَ قدرات المتعلّمين، وإنتاجَ مواطنٍ فاعلٍ في مجتمعه ووطنه، فإنّ واقعَ الحال يشير إلى أنّنا استَهدفنا خلال مسارنا التعليميّ العلامةَ لا المعلومةَ، ولهثْنا وراء الشهادة بدلًا من تحفيز المعرفة لدى المتعلّمين.
ولأنّ التعليم يُعدّ من أبرز عوامل الحراك الاجتماعيّ الصاعد، فإنّه يبدو وكأنّه تحوّل اليوم إلى مؤشِّر صارخ على الحرمان، وإلى معطِّلٍ لمصعد الترقّي الاجتماعيّ وفرصِ الحياة.
صدمةُ الكورونا وضعتْنا أمام خياريْن: إمّا أن تكون الصدمةُ إيجابيّةً وتدفعنا إلى تقويم مسار العمليّة التعلّميّة ككلّ والعمل على استنباط طرقٍ جديدةٍ في التعليم والتعلّم؛ وإمّا أن تكون سلبيّةً وتخلِّف آثارًا مدمِّرةً في التعليم والمتعلّمين وعلى المجتمع والوطن.
أخيرًا، مع استمرار الوضعيْن الكورونيّ والاقتصاديّ، ومع الانقطاع الطويل عن المدارس خصوصًا للمتعلّمين الفقراء،[11] ومع نزول أغلب هؤلاء إلى سوق العمل لمساعدة الأهل، يبدو أنّنا في طريقنا إلى مواجهة أزمةٍ كبيرةٍ من التسرّب المدرسيّ [12] ليس في لبنان فحسب بل في كلّ المجتمعات أيضًا. نحن بحاجة إلى دقّ ناقوس الخطر، وملاحقةِ هؤلاء الأطفال قبل فوات الأوان. فما بالنا اليوم، وهذه الشريحة وقعتْ بين فكّي الجهل والفقر؟
***
قراءة في ملفّ الآداب - هلا عواضة

لم يسبقْ للبشريّة في تاريخها الحديث أن اختبرتْ تجربةً كالتي تختبرُها الآن في ظلّ جائحة كورونا، التي وضعت الناسَ حول المعمورة في حَجْرٍ قسريٍّ تفاديًا من انتقال العدوى. وهذا الوضع ألجأهم إلى اعتماد أساليبَ عديدةٍ لوصلِ ما انقطعَ من حياتهم الاجتماعيّة والعمليّة، فكانت التكنولوجيا نافذتَهم شبهَ الوحيدة التي يَعْبرون منها إلى العمل والتواصل. وهذا الواقع غيرُ المسبوق فَرض على المؤسّسات الأكاديميّة والتعليميّة، بشكلٍ خاصّ، تحدّياتٍ لم تكن في حسبانها، فلجأتْ إلى "التعليم عن بُعد."
مجلة الآداب بادرتْ إلى تناول هذا الموضوع الراهن في "ملفٍّ متدحرجٍ" شارك فيه العديدُ من الكتّاب والتربويّين في لبنان والعالم. كتب هؤلاء خلاصاتِ خبراتهم النفسيّة والاجتماعيّة إزاء مسألة التعليم من بُعد، والصعوباتِ التي عايشوها خلال السنة الدراسيّة الفائتة في المدارس والجامعات. وقد بيّنتْ تلك التجاربُ تعدّدَ المداخل التي يجري من خلالها تناولُ هذه المسألة، منذ أن تسلّلت العمليّةُ التعليميّةُ، مرغَمةً، إلى عقرِ دارنا. وتُظهر القراءةُ المتأنّية تمحورَها حول المقاربات الثلاث الآتية:
1 - القلق وتجسّداته الانفعاليّة. لم يكن سهلًا على العديد منّا أن يتفلّتَ من حال القلق والترقّب التي فرضها جلوسُنا أمام شاشات الكمبيوتر للقيام بأدوارنا العليميّة. فالتفاعل المباشر لم يعد كذلك، إذ شيّأت الرقميّاتُ مشاعرَنا، وتسيّدتْ جلساتِ التحضير للتعليم من بُعدٍ حالاتٌ من التوتّر وانعدامِ اليقين. وقد عبّرت الأستاذة في جامعة ماكغيل في كندا، رلى الجردي، عن حالها هذه، وكيف شعرتْ بـ"جوٌ من القلق والتردُّد، خصوصًا حين استُعرِضَت العقباتُ المنهجيّةُ والتقنيّةُ التي ستواجهُنا في تعليم صفوفِنا الإلكترونيّة، وكيف حاولْنا إيجادَ الطُّرق المُثلى لتطويرِ التفاعلِ بيننا وبين التلاميذ، وتنميةِ حماسهم العلميّ، إلى جانب تحقيقِ أهداف الدراسة."[13]
أمّا قلقُ الشاعر محمد خضير فقد تمثّل في الخوف من حلول الأجهزة التكنولوجيّة مكانَ الأستاذ، علمًا أنّ كرَمَها ليست في حجمِ كرَمِه: فالأستاذ لا يَبْخل بمعلوماته على صفٍّ بكامله، في حين أنّ الجهازَ التكنولوجيّ لا يمنح معرفتَه إلّا حاملَ كلمةِ سرّه. ويسترسل خضير في وصف ما يجري، لنكتشفَ معه أنّ المبادرة لم تعد في يد المعلّم الذي بات "يَسْكن هواتفَنا الذكيّة، لكنّه سرعان ما يغادرُها عند فقدان البطاريّة قدرتَها إنْ غابت الكهرباءُ بفعل الحربِ أو الفساد." كما يَكْشف لنا، بطريقةٍ حذقة، كيف انقلبت الأدوارُ حين حلّ الكمبيوتر مكانَ الصفّ، فلم يعد الأستاذُ يتسيّد صفَّه، بل صار "بإمكان الطالب إسكاتُ المعلّم متى شاء، وخفضُ صوته أو رفعُه، وربّما تغييرُ نغمةِ هذا الصوت إذا لم يرُقْ له!"[14]
واتّخذ القلقُ لبوسَ الرهبة من أن نفقدَ تفاعلَنا البشريّ، فيغزو الافتراضيُّ وجدانَنا؛ فنحن نخاف، بحسب تعبير مايا مجذوب، من العجز عن اختراق الشاشة، ومن المسِّ بقلوب الطلّابِ وعقولِهم. وما تلبث أن ترفعَ صدى هواجسها لتسألَ: "أنا خائفة... إذ كيف أحفظُ أسماءهم كلّها وأميّزُ الأصواتَ والشخصيّاتِ افتراضيًّا؟ كيف لي أن أوجِدَ لغةً مشتركةً بيننا، وأنا لا أرى انعكاسي في عيونهم؟"[15]
2 - قصور السياسات والفلسفات التربويّة. لم تقتصر المشارَكاتُ على التعبير عن المكنونات والمشاعر الإنسانيّة، بل عبّر عددٌ من المشاركين عن هواجسَ من نوعٍ آخر، تمثّلتْ في قصور الفلسفة التعليميّة عن مواكبة التقدّم الرقميّ، وتخلُّفِ المقاربات التربويّة عن مواكبة التحدّيات التي فرضها واقعُ التعليم من بُعد. هكذا ناقشت الزميلة ثناء الحلوة عجزَ المقاربة التعليميّة، حتى ما قبل جائحةِ الكورونا، عن إنتاج متعلّمٍ فاعل. وفي قراءتها المتأنّية للسياسات التربويّة أوضحتْ لنا العبءَ الذي يرتّبه التعليمُ من بعد على طرفٍ واحدٍ من أطراف العملية: فبعد أن كان التعليمُ "مسؤوليّةً مشتركةً بين الأسرة والمجتمع والدولة،"[16] إذ به يتحوّل حتى يكادَ يصبحُ مسؤوليّةَ الأهل وحدَهم، الذين يمارسونها في ظلّ أجواء ضاغطة، اقتصاديّةٍ ونفسيّة.
في السياق عينه، قدّم الباحث علي خليفة رؤيتَه للتعليم من بُعد، فوَجد أنّ الخطوات القسريّة - كالقفز إلى "ترفيع" الطلّاب من دون تقويم المهارات التي اكتسبوها - خسارةٌ يصعبُ تعويضُها لاحقًا. كما طرح إشكاليّةً ألقت بثقلها مع الانتقال من التعليم الحضوريّ (في الصفّ) إلى التعليم من بُعد: فقد تخلخل "مبدأُ المساواة التي تُقدّمها المدرسة، نظرًا إلى تفاوت المستوى الاقتصاديّ والاجتماعيّ لبيئات المتعلّمين وظروفِ توافرِ الخدمات."[17]
وأكمل الأستاذ شبل بدران مقاربةَ خليفة. فهو - إلى جانب تحفّظاتِه عن التعليم من بُعد في شكله الحاليّ - يؤكّد ضرورة إدخال تغييراتٍ على النظام التعليميّ التقليديّ، مع وجوب أن تكونَ في اتجاه "تقوية دور المدرسة، لا إضعافِها وتفكيكها."[18] فالمدرسة، بحسب بدران، لا يقتصر دورُها على نقل المعرفة، بل "هي المكانُ الذي يجب أن نجدَ فيه متخصِّصين في التعامل مع الأطفال والطلّابِ وتوجيهِهم وتحفيزِهم على التعلّم. هي البناءُ الآمنُ الذي يجب أن يتفاعلَ فيه أبناؤنا معًا لساعاتٍ عدّةٍ من كلّ يوم. وهي المكان الذي يجب أن يجد فيه الأطفالُ والطلّابُ الأمانَ والمساحةَ للحركة، والإبداع، والتنشئةِ الاجتماعيّةِ القائمة على قيم المواطَنة وحقوقِ الإنسان."
من ناحيةٍ أخرى، أضاءت النقاشاتُ على إيجابيّة اللجوء إلى التعليم من بُعد باعتباره "معالجةً آنيّةً لمشكلةٍ جوهريّةٍ مطروحةٍ وغيرِ محلولةٍ منذ عشرات السنوات،" بحسب الباحث في التربية والفنون نعمة نعمة، الذي يعتقد أنّ المشكلة تتركّز في كون نظامنا التعليميّ موضوعَ مساءلةٍ وتقويمٍ دائميْن، وبات من الواجب تغييرُ "الأدوات والتكنولوجيا والعوالمِ الافتراضيّة والمنظوماتِ القيميّة والعلاقاتِ الاجتماعيّة واللعبِ والتواصلِ والترفيه،" والتفكيرُ في "إعادة صياغة عالمنا الواقعيّ، ولاسيّما تغيير نظامنا التعليميّ."[19] لكنّ الصعوبة تكمن في ضآلة المخزون المعرفيّ لأصحاب القرار، وفي مقاومتهم للتغيير.
في سياقٍ آخر، يشاركنا الأستاذ الجامعيّ وسام الرفيدي من فلسطين تجربتَه في التعليم من بُعد، معتبرًا أنّ مِن الخطأ مقاربتَه بالتفتيش فقط عن وسائلَ تناسبه؛ فهذه المقاربة تجعلنا غارقين في تقنيات العمليّة التعليميّة على حساب محتواها. أمّا هو فيرى أنّ العمليّة التعليميّة لا تقتصر على تطوير المهارات، بل يجب أن تتضمّن بناءَ مقوِّمات "الشخصيّة الطالبيّة." وهذا البناء لا يتمّ إلّا بمعالجة الثلاثيّ: "محتوى التعليم، والعلاقة الإنسانيّة بين طرفَي العمليّة، والحياة الطلابيّة الجامعيّة."[20]
3 - تحدّيات اقتصاديّة لوجستيّة رقميّة. إلى جانب الطروحات السابقة قامت ثلّةٌ من المشاركين بعرض التحدّيات المتنوّعة التي واجهتْ تجربتَهم في التعليم من بُعد. فأبدوْا قلقَهم من القصور الرقميّ والتكنولوجيّ، والصعوباتِ الاقتصاديّة، وضعفِ البنيات اللوجستيّة الحاملة لهذه العمليّة لدى كافّة أطراف العمليّة التربويّة.
هكذا اشتكى الباحث رائد محسن من عجز "مناهج التعليم وقِدمها - تعود إلى العام 1997 [في لبنان] - عن تحقيق أهدافِها المرجوّة،"[21] وتحديدًا في ظلّ القصور الرقميّ لدى المدارس والعائلات على السواء، وعدم قدرتها الاقتصاديّة على تأمين الأجهزة الإلكترونيّة والهواتف الذكيّة لأولادها وطلّابها كي يتمكّنوا من متابعة الدروس من بُعدٍ في هذه الظروف.
وبالعودة إلى نعمة، فإنّه يرى أنّ التحدّيات التي تواجه التعليمَ من بُعد هي محضُ أعراضٍ للمشكلة الحقيقيّة. فالأزمة التي تعيشها المؤسّساتُ التربويّةُ ليست جديدةً، بل مردُّها إلى الفلسفة والسياسات التربويّة وطُرق التعليم غير المحدثة التي لا تستوعب الرقمنةَ أساسًا. أمّا رميُ المسؤوليّة على المعلّم أو المناهج أو توفّرِ (أو عدمِ توفّر) الإنترنت وغيرِها من الأدوات، فهو هروبٌ من المشكلة الحقيقيّة.
هكذا قدّمتْ كلُّ مشارَكة من المشارَكات في هذا الملفّ صورةً عن واقع الحال المعنيّة به، وأسهمت النصوصُ في مجملها في وضع اليد على أوجه القصور والخلل في التعليم من بُعد. وأبرزتْ بعضُ المشارَكات مكامنَ الخلل على مستوى الماكرويّ (سياسات تربويّة وفلسفات المناهج والتعليم...)، بينما دلّت مشارَكاتٌ أخرى ميكرويًّا على ضعف البنْيات اللوجستيّة والرقميّة. ولم تغفلْ هذه الكتاباتُ ذكرَ الطُرق التي "رقّع" فيها القيّمون على العمليّة التعليميّة الفجواتِ التي واجهوها في التعاطي مع أزمات التعليم في لبنان والعالم العربيّ، وهي فجواتٌ فضحتْها بشكلٍ سافرٍ جائحةُ كورونا.
***
كرة الثلج/كرة الوباء: اختراع أزمة مستجدّة في المدرسة – علي خليفة

يسير التعليمُ النظاميّ برجليْه ورأسه نحو حتفه، مثخَنًا بالمآزق والمشاكل والتعثّر والفشل. يكفي لذلك استعراضُ بعض عناوين الكتب الصادرة عالميًّا ومحلّيًّا: نريد مجتمعًا بلا مدرسة، يهتف إيفان إيليتش في أكبر محاكمةٍ عالميّةٍ وعلنيّةٍ لفعّاليّة المدرسة ودورِها الاجتماعي والتعليميّ؛[22] بل نريد مدرسةً حرّةً، يستدرك ألكسندر نايل مُحاكِمًا النظامَ التعليميّ، ومن ورائه النظامَ الاجتماعيّ بأسره؛[23] وصولًا إلى باسكال بوشار، الذي وضع المدرسةَ في موضع التيه، على صورة المجتمع الذي أصبح بلا مشروعٍ ولا هدف.[24]
ومحلّيًّا، أقام الرئيسُ الأسبقُ للمركز التربويّ للبحوث والإنماء، نمر فريحة، مرثاةً للتعليم والتربية، وذلك في كتابه بعنوان تعليم فاشل تربية فاشلة.[25]وقبله كتب الباحثُ التربويّ والمؤرِّخ نخله وهبه بالتفصيل عن مأزق المدرسة مع التربية الحديثة، واصفًا ما تؤدّيه بـتعليم الجهل، في كتابٍ لامعٍ يحمل هذا الطباقَ في العنوان، وفي متنه صفحاتٌ عديدةٌ خصّصها المؤلِّف تحديدًا لعمليّة تدريس التاريخ، مشبّهًا إيّاها بالتجهيل المقصود.[26] وفي كتابي بعنوان هكذا قتلتُ معلّم الرياضيّات، قلتُ إنّ قتلَ المعلّم يعني، في ما يعنيه، ولادةً جديدةً للمتعلّم، وإعادةَ مقاربةِ أبعادِ نموّه بشمولية، والنظرَ إليها بعيونٍ جديدة: "جريمة نظيفة، بلا شعور بالذنْب، ولا استحضار العقد... القتل من أجل الدفع قُدمًا بالممارسات التعليميّة التي شبعتْ موتًا وتخثّرًا."[27]
كانت جميعُ تلك المآزق والمشاكل في التربية والتعليم قبل أن تكون كورونا، ويكونَ الحجْرُ والعزلُ وإقفالُ المؤسّسات التربويّة. وإذ ببعض التربويّين يتّخذون الوباءَ جَمَلًا في اللّيل ليعلنوا قلبَ الطاولة، رافعين شعاراتِ حقّ - كنقص فعّاليّة المدرسة، وتراجُع موقع نظام التعليم وانحسار دوره، وبعض الممارسات التعليميّة الخاطئة – من أجل إحداث تحوّلٍ في برادايمات التعليم والتعلّم والهجرة من المدارس والصفوف بجدرانها الأربعة. فأقفرتْ مؤسّساتُ التربية والتعليم، وبدأ التسويقُ والتنظيرُ والتهليلُ لـ"التعليم من بعد" عبر وسائل التكنولوجيا ووسائطها.
والحقّ أنّ التكنولوجيا كانت، ولا زالت، حلقةً وسيطةً في التربية الحديثة. وهي، في المقابل، أشبهُ بشعرة معاوية بين التعليم والتجهيل. فعندما تقترن الرقمنة (Numérisation) بالنشر، تتحسّن جودةُ البحث العلميّ ومؤشِّراتُه من معامل تأثير وغير ذلك. وفي المقابل، عندما تزيد ساعاتُ التعرّض للشاشة الإلكترونيّة، فإنّ علماءَ النفس يتحدّثون عن "الإدمان الإلكترونيّ،" ويحذّرون من أثره السلبيّ في اكتساب الاستعدادات النفسيّة والملَكات والمعارف والمهارات. في زمن كورونا، فقدنا مناعةَ التفكير بعقلٍ علميّ وتربويّ، وصرنا نفكّر بالعاطفة العمياء التي تُغفل تقديرَ الخطر الصحّيّ بحجمه، أو نفكّر في المصالح وراء صفقات المنصّات وأدوات التكنولوجيا، أو لا نفكر البتّة. إنّه زمنٌ يجنّ فيه الجميع!
على مدى سنواتٍ طوال، كانت التكنولوجيا جزءًا من التعليم وفي خدمته. أمضيتُ عشر سنوات في تعليم الرياضيّات والفيزياء في الثانويّ وأنا أستخدم المحاكاة (simulation) والبرامجَ والتطبيقاتِ المتنوّعة. وفي التعليم الجامعيّ في كلّيّة التربية، لا يمرّ مقرَّر علميّ أو أدبيّ أعلّمه بلا تطبيقاتٍ تكنولوجيّة أو برامج، لا سيّما في المعالجة الإحصائيّة.
أمّا أن تقفَل المؤسّساتُ التربويّة في البلد، ويقول لك "المسؤولون" التربويّون: "علّمْ عن بعد بواسطة التكنولوجيا،" فهذا بظاهره غباءٌ تنبّأ به آينشتاين، الذي كان مرتابًا من تفشّي التكنولوجيا يومًا ما كالوباء. بيْد أنّ التفكير من منظور نقديّ يُفضي إلى أنّ ما يجري من تضحيةٍ بالتعليم في زمن كورونا إنّما يحصل من أجل التغطية على فشل إدارة الشأن الصحّيّ، أي فشل السياسات العامّة. وعندما يصبح التعليمُ مقتصرًا على التكنولوجيا ووسائلها، فإنّه يصبح رديفًا للتجهيل المقصود. وهنا، الأزمةُ عميقةٌ في مواطنيّتنا أيضًا لأنها تصادر وعيَ المواطنين كأفراد.
التكنولوجيا جزء من التعليم، وفي خدمته، وليست مستقبله، بل هي واقع بؤسه. انظروا إلى المدارس المقفرة والبيوتِ المزدحمةِ بالضوضاء حيث المعلّمُ صوتٌ هلاميٌّ لا ينجب معرفةً محسوسةً ولا تعلّمًا ملموسًا، وحيث المتعلِّمون أرقامٌ تسلسليّةٌ كوجوهٍ متعاقبةٍ من جريمةٍ منظّمة، وحيث الصفُّ بجدارنه الأربعة استحال شاشةً سوداءَ بأربع أضلع، وأُلقيتْ مسؤوليّةُ التعليم على أولياء الأمور بمعزل عن أميّتهم المعرفيّة أو الرقميّة لتشديد قبضة الاصطفاء الاقتصاديّ واللاتكافؤ، وأصبحتْ ساعاتُ الليل والنهار إدمانًا إلكترونيًّا طويلًا مثل الفجر الذي لا يأتي بيوم جديد.
إنّها ليست، إذًا، مسألةَ تحوّل رقميّ أو تطوير تربويّ، على الرغم من كلّ ما في الفضاء من غيومِ ادّعاءات. إنّها مسألة رمي مشكلة الصحّة والسياسة في ملعب التربية والتعليم. وهنا، ليس ترفًا أن يكون التعليمُ أولويّةً ولا مجالَ للمفاضلة، كقول بعض المعلّمين إنّ التعليم عن بعد هو "أهون الشرور،" وإنّه لا يجوز أن نضيفَ إلى الأخطار الصحّيّة أخطارًا تربويّةً محتّمة.[28 أمّا قولُ أولياء أمور المتعلّمين "إنّ صحّة أولادنا أولويّةٌ، لذا فإنّنا نؤيّد التعليم عن بعد على الرغم من الصعوبات،" فليس إلّا من قبيل تغليب العاطفة العمياء على التبصّر والتفكّر.
إنّ ما يشهده قطاعُ التربية والتعليم من أزمةٍ راهنة، مضافةٍ إلى أزماته السالفة، إنّما هو جزءٌ من الأزمة التي تجتاح مواطنيّتَنا وتصادر مشاعرَ الرضا عند المواطنين، فتدخل المسؤوليّات في دائرة الضبابيّة، وتختلط المعاني وتشتبه الأمور. الإقفال العامّ في البلاد هو عقابٌ جماعيّ. وإقفال المؤسّسات التربويّة للسنة الثانية على التوالي، في جزءٍ منه، إمعانٌ في الجريمة. ما كان البديلُ المنطقيّ والواقعيّ؟ رفعُ استعدادات القطاع الصحّيّ من دون التغطية على التقصير، والتشدّدُ في ضبط مخالفات الوقاية، والعودةُ الآمنةُ إلى المدارس. ولا يمكن تخطّي أزمة المواطنيّة إلّا بالدعوة الى عصيان القرارات الغبيّة، كالإقفال العامّ. فما أسوأَ خيارات السلطات السياسيّة والصحيّة لإدارة أزمة كورونا: من إقفال تامّ في البداية وضرب مصالح المواطنين وأبواب رزقهم، إلى إعادة فتح البلد من دون زيادة استعدادات المستشفيات، فإلى العودة إلى التخبّط وحجْر مناطق والإقفال التام وتضييع التعليم! وبالأرقام، لم تساهم القراراتُ الأخيرة في الحدّ من عدّاد الإصابات، بل ارتفع فقط عدّادُ مَحاضر ضبط السيّارات المخالفة!
هذا الوباء لن يزول على المدى المنظور. لذا فهذه القرارات غبيّة، وبدلًا من أن تحلّ المشكلة، فإنها تفاقم مشاكلَ أخرى، لا سيّما في التربية والتعليم.
لا يمكن مواجهةُ الوباء بغباء... المسؤولين.
بيروت
[1] أنظر في هذا الخصوص مقال د. علي خليفة في ملفّ الآداب، "التعليم في زمن كورونا،" وعنوانُه: "سلّم بدرجاتٍ مفقودة،"
[2] أنظر مقالة د. ثناء الحلوة، المنشورة في الآداب بعنوان: "التعليم في زمن كورونا":
[3] أنظر مقالة مايا مجذوب في الآداب، "عن زووم والأمل الافتراضيّ":
[4] من محاضرة حول التعليم من بعد، الجامعة اللبنانية، الحدث، 19-10-2020.
[6]-https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-24882
[8]-https://elauresnews.com/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%
D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-420-%D9%85%D9%84
%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B
[9] المهارة التكنولوجيّة تُعتبر مهارةً ثانويّةً (غير أساسيّة) للمعلِّمين في زمن ما قبل الكورونا (وهناك موظّف مسؤول عن الأمور التكنولوجيّة في مختلف المدارس اللبنانيّة).
[10] ماجد جابر، "ليس بالامتحان وحده يحيا التقويم،" جريدة الأخبار، الخميس 26/11/2020.
[11] الذين تضعف لديهم القدرةُ على التعلّم عن بعد، أو لا يملكون الوسائلَ الضروريّةَ للتعلّم (مثل أجهزة التواصل والإنترنت والكهرباء).
[12]- تعاني أغلبُ المدارس اللبنانيّة حالاتِ رسوبٍ وتسرّبٍ مدرسيّ لدى الأولاد عند الانتقال من الحلقة الأولى (نهاية الصفّ الأساسيّ الثالث) إلى الحلقة الثانية (الأساسيّ الرابع) لأنّ المرحلة الأولى تتضمّن "الترفيعَ الآليّ،" ما يجعل من الأساسيّ الرابع بدايةً لرحلة الرسوب، ولاحقًا التسرّب المدرسيّ.
[13] رولى الجردي، "الشاشة التي تُحْييكَ وتُميتُك،" ضمن ملفّ "التعليم في زمن الكورونا،" الآداب، 10-11، 2020.
[14] محمّد خضير، "عن بعد،" المصدر السابق.
[15] مايا مجذوب، "عن زووم والأمل الافتراضيّ،" المصدر السابق.
[16] ثناء الحلوة، "التعليم في زمن الكورونا،" المصدر السابق.
[17] علي خليفة، "سلّم بدرجات مفقودة،" المصدر السابق.
[18] شبل بدران، "هل سيتغيّر التعليمُ بعد جائحة كورونا؟،" المصدر السابق.
[19] نعمة نعمة، "التعليم الإلكترونيّ: الحلّ السحريّ المفقود،" المصدر السابق.
[20] وسام الرفيدي، "التعليم عن بُعد: ملاحظات على ضوء تجربة شخصيّة،" المصدر السابق.
[21] رائد محسن، "كورونا تستعجل رقمنةَ المناهج اللبنانيّة،" المصدر السابق.
[22] Ivan Illich, Une société sans école. Essai, 2003
[23] Alexander Neill, Libres enfants de Summerhill. Poche, 2004
[24] Pascal Bouchard, Une école sans boussole dans une société sans projet. Chronique sociale, 2010
[25] نمر فريحة، تعليم فاشل تربية فاشلة (بيروت: دار الجديد، 2019).
[26] نخلة وهبه، تعليم الجهل، 2016.
[27] علي خليفة، هكذا قتلتُ معلم الرياضيّات (بيروت: ألف ياء للنشر والتوزيع، 2018).
[28] مراجعة مقال المؤلّف في الآداب، بعنوان: "سلّم بدرجات مفقودة."