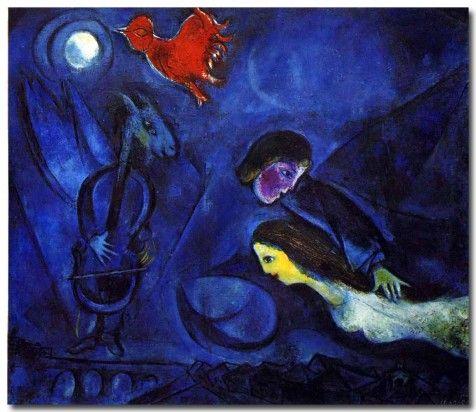محاضر جامعيّ، وكاتب وباحث سياسيّ متخصّص في العلاقات الدوليّة. صدر له مؤخرًا كتاب بعنوان: ما بعد القتال: حرب القوة الناعمة بين أميركا وحزب الله، وكتاب: الهيمنة الساحرة: اختبارات القوة الناعمة الأميركية في الشرق الأوسط.

مقدّمة
من اللحظات الأكثر حراجةً في تاريخ الإمبراطوريّات هي حين يصبح النظامُ العالميّ، الذي أقامته هذه الإمبراطوريّاتُ بهدف الهيمنة، متاحًا لقوًى أخرى تستغلّه للصعود وتغييرِ الوضع القائم. في تلك اللحظة تبدأ قطاعاتٌ داخل الإمبراطوريّة بخسارة أسواقٍ خارجيّةٍ لصالح منافسين جددٍ سيصِلون - هم أيضًا - إلى الأسواق الداخليّة للإمبراطوريّة نفسها. لا ينال سكّانُ الدولة المهيمِنة حصّةً متساويةً من عوائد التدخّل حول العالم؛ ولكنْ ما دام التفاوتُ ضمن حدودٍ "مقبولةٍ" لهم، فإنّهم يتساكنون مع المشروع الخارجيّ لدولتهم ونخبتِها.
المعضلة هي حين تؤدّي قواعدُ النظام الدوليّ وتوازناتُه وتركيبتُه إلى إحداث تفاوتٍ فاضحٍ في الثروة والدخْل والفُرص داخل الدولة المهيمِنة، بحيث تنقسم نخبتُها ومجتمعُها وقطاعاتُها بين تيّارَي "الحِمائيّة" و"تحرير الاقتصاد والتجارة." عندها تتعقّد التداخلاتُ بين السياسة الداخليّة والخارجيّة، وتتفاعل انقساماتُ الهويّة الداخليّة مع الانزياحات الخارجيّة في موازين القوى. وحينها تكون قوّةُ الهيمنة أمام اختبارٍ جدّيّ: هل تلتزم بقواعد النظام الدوليّ الذي أسّستْه وبشّرتْ به، أمْ تَهْجره؟
عند هذه النقطة تقف الولاياتُ المتحدة اليوم. وهو ما كان قد توقّعه المؤرَّخُ الإسكتلنديّ نيال فيرغسون منذ حوالي خمسة عشر عامًا.
أتى دونالد ترامب على صهوة شعار "أميركا أوّلًا،" فاختارته الأغلبيّةُ البيضاءُ عقابًا لنخبة المدن الأميركيّة المعولمة في قطاعات المال والتكنولوجيا ونُخَبِ المؤسّسة الأميركيّة في واشنطن. امتطى ترامب موجةَ اليمين البديل، وحوّله إلى نوعٍ من القبَليّة الدينيّة، مقدِّمًا إليها روافعَ اقتصاديّةً من خلال: شنِّ حربٍ تجاريّةٍ على الصين، والانسحابِ من الالتزامات الدوليّة المُقيِّدةِ للصناعات الأميركيّة، وابتزازِ حلفاء واشنطن في الخليج بصفقاتٍ ضخمة.
وفي المقابل نهضت النخبةُ الليبراليّةُ المعولمة بدورها، فخاضت أشرسَ انتخاباتٍ رئاسيّةٍ لإخراج ترامب وإحباطِ الترامبيّة بشعار "أميركا عائدة" انطلاقًا من أنّ أمنَ الأميركيّين ورفاهَهم مرتبطان بالنظام الدوليّ الليبراليّ. لكنّ الليبراليّين أدركوا أنّهم أصبحوا في حاجةٍ ماسّةٍ إلى أن يتلمّسَ الشعبُ الأميركيّ الفوائدَ الاقتصاديّة المباشرة لرعاية بلادهم للنظام الدوليّ حتى يتمكّنوا من احتواء النزعة القوميّة المتصاعدة في الداخل.
أوّلًا: الواقعيّة الكلاسيكيّة الجديدة والدولة
في العام 1998 ظهر مصطلح "الواقعيّة الكلاسيكيّة الجديدة" من خلال مقال غيديون روزْ، وذلك لتصنيف أعمال توماس كريستنسِنْ (1996) وراندال سيل (1998) وويليام ويلفورث (1993) وفريد زاكارايس (1998). يَعتبر الواقعيّون الكلاسيكيّون الجدد أنّ الضغوطَ المتأتّيةَ من المستوى الدوليّ (أي توزّع مقدِّرات القوّة بين الدول) هي السببُ الأهمّ وراء سلوك الدولة في السياسة الخارجيّة، ولكنْ فقط من خلال توسّط أثر المتغيّرات من داخل المستوى المحلّيّ، مثل تصوّرات النُّخب والظروف السياسيّة المحلّيّة. وبحسب الواقعيّة الكلاسيكيّة الجديدة، فإنّ على نظريّة السياسة الخارجيّة أن تأخذَ في الاعتبار تنوّعَ مصالح صانعي القرار ودوافعِهم؛ فتفضيلاتُ القادة هي حصيلةُ التفاعل بين هذه المصالح والدوافع من جهة، والشروط الدوليّة الحاكمة من جهةٍ أخرى.
تقدِّم هذه النظريّة مفهومًا للدولة "من أعلى إلى أسفل،" ما يعني أنّ العواملَ المتأتّية من النظام الدوليّ هي التي تحدِّد سلوكَ الدولة الخارجيّ. والدولة هنا محكومةٌ بجهازٍ تنفيذيٍّ للأمن القوميّ، يقيم عند التقاطع بين الدولة والنظامِ الدوليّ، مع قدرة نفاذٍ إلى معلوماتٍ تصلُه من الأجهزة العسكريّة والسياسيّة للدولة وتمنحه نوعًا من الامتياز؛ ومن ثمّ فإنّ هذا الجهاز هو المؤهَّلُ لإدراك القيود النظاميّة واستخلاص المصالح القوميّة. لكنْ، على الرغم من الاستقلاليّة الظاهرة للجهاز التنفيذيّ عن المجتمع، فغالبًا ما يكون مجبَرًا على المساومة مع الفواعل المحلّيّة (كالمشرِّعين، والأحزاب، والقطاعات الاقتصاديّة، والطبقات الاجتماعيّة، وعامّة الجمهور) بهدف سنّ سياساتٍ واستخراج مواردَ من المجتمع لتطبيق هذه السياسات. لذلك، فإنّ استجابة الدولة لتحوّلات ميزان القوى هي نتاجُ تعاونٍ، وأحيانًا تصارُعٍ، بين المجتمع والنظام. فالدولة والنظام ليسا بالضرورة لاعبًا موحَّدًا.[1]
إذًا يربط الواقعيّون الكلاسيكيّون الجدد بين تشكّل الدولة والضغوط المتأتّية من المستوى الدوليّ. ولهذه الضغوط التنافسيّة، وما تفرضُه من تنشئةٍ اجتماعيّة،[2] آثارٌ في تشكيل تركيب الدول الداخليّ. ففي وجه تلك الضغوط تقوم الدولةُ بسلوكٍ تكيُّفيّ، رغبةً منها في زيادة الأفضليّة التنافسيّة واحتماليّةِ البقاء. وهذا السلوك، في النهاية، يحدِّد شكلَ الدولة. لذا، فالدولة، بحسب جنيفير ستيرلينغ-فوكر، ليست الشكلَ النهائيَّ لتنظيم المجموعات، لكنّها الآن كذلك نتيجةً لـ"ديناميّات الفوضى التقليديّة."[3] فالدولة أثبتتْ أنّها الأكثرُ فعّاليّةً في المراحل الأولى من أوروبا الحديثة في تعبئة الموارد الداخليّة والاستجابة للتهديدات الخارجيّة؛ ما أدّى إلى انتشار هذا الشكل المؤسّسيّ في أوروبا، ولاحقًا حول العالم.[4]
ثانيًا: البُعد الداخليّ في تعريف التهديدات الخارجيّة
يترتّب على مقاربة النظريّة الواقعيّة الكلاسيكيّة الجديدة جملةُ تبعاتٍ على طبيعة السياسة الخارجيّة للدولة، بما في ذلك تعريفُها للتهديدات. ومن أبرز هذه التبعات:
1 - يرتفع تأثيرُ الفاعلين المحلّيّين ومجموعاتِ المصالح في سياسة الأمن الخارجيّ أثناء فترات الاستقرار، أو حين تواجِه الدولةُ بيئةً دوليّةً ذاتَ تهديدٍ منخفض، بحيث تكون كلفةُ السماح لهذه المجموعات بالمساهمة في صنع القرار قليلةً.[5] لذلك يمكن توقّعُ أن تَمْضي إدارةُ بايدن في سياستها الخارجيّة بشكلٍ حازمٍ من دون انتظار حصول توافقاتٍ داخليّةٍ واسعة، أو من دون استرضاء مجموعات المصالح، وذلك انطلاقًا من تشخيصها المتشائم للوضع الدوليّ. وهذا ما يوجب عليها القيامَ بخياراتٍ سريعةٍ وحازمةٍ في أكثر من ملفٍّ حيويّ.

الجهات الأكثر تأثيرًا في صنع القرار بالنسبة إلى إدارة بايدن: مجتمعاتُ المهاجرين، وجماعاتُ الحقوق الليبراليّة، وأنصارُ البيئة، والقطاعاتُ الماليّة والتكنولوجيّة
2 - الجهات المجتمعيّة الأكثر تأثيرًا في صنع القرار داخل النُّظُم "الديموقراطيّة" هي تلك القادرة على التحشيد الانتخابيّ، واللاعبون المحلّيّون القادرون على تأمين موارد للنظام، وهم عادةً موزّعون على عدّة جماعات مصالح.[6] هذه الجهات، بالنسبة إلى إدارة بايدن، هي مجتمعاتُ المهاجرين، وجماعاتُ الحقوق الليبراليّة، وأنصارُ البيئة، والقطاعاتُ الماليّة والتكنولوجيّة. ولذلك سيرتبط قسمٌ من السياسات الخارجيّة لهذه الإدارة بقضايا تعزِّز من نفوذ هذه الجهات.
3 - يركّز الجهازُ التنفيذيّ للسياسة الخارجيّة (الدبلوماسيّون، ضبّاطُ الاستخبارات، صنّاعُ القرار) في الخارج على توازن القوى النظاميّ (الدوليّ) وشبهِ النظاميّ (الإقليميّ)، وفي الداخل على توازن القوى المحلّيّ (حيت تتنافس الكتلُ الاجتماعيّة). والخطوط بين المستويات الثلاثة هذه ضبابيّةٌ ومتداخلة: فيمكن أن يتصرّفَ القادةُ داخل مستوًى واحد، لكنّ الهدف هو التأثيرُ في مستوًى آخر. ولذا إنْ حاولنا التركيزَ على تهديدٍ واحدٍ لفهم سلوك الدولة، فقد نجهل الدوافعَ الفعليّةَ لسلوكها، وكذلك نواياها.[7] بالمجمل، يكون القادةُ المجتمعيّون معنيّين بالتوزيع أو إعادةِ التوزيع غير المتكافئة لتأثيرات السياسة الخارجيّة في توازن القوى الداخليّ السياسيّ والاقتصاديّ. هذا ما يسمّيه ستيفن لوبيل نموذجَ "التعرّف المعقّد للتهديدات،" حيث يقوِّم الجهازُ التنفيذيُّ للسياسة الخارجيّة التهديداتِ على ثلاثة مستويات (دوليّ، إقليميّ، محلّيّ)، ومن ثمّ يمكن أن يتصرّفَ في مستوًى واحد بهدف التأثير في المُخرَجات في مستوًى آخر.[8] وهنا المحاججة الأساسيّة في هذه المقالة، وهي أنّ السياسة الخارجيّة لإدارة بايدن لا تهدف إلى التأثير في المستوى الخارجيّ فحسب، بل في التهديدات الناتجة من المستوى المحلّيّ أيضًا. وهذا ما سنستعرضه تاليًا.
4 - يرى لوبيل أنّ المهمّ ليس القياسَ الكلّيّ لقوّة دولةٍ ثانية، بل لمكوِّنٍ محدَّدٍ من مكوّنات قوّة تلك الدولة. أيْ إنّ التهديد يكون من زيادةٍ في مكوِّنِ بعينه (كالسكّان، أو الأرض، أو الصناعة، أو الإيديولوجيا، أو القوة الجوّيّة أو البحريّة أو البرّيّة، أو التكنولوجيا، أو تحالفٍ ما،...)، لا في مجرّد الزيادة الكلّيّة. وحينها سيكون من الممكن فهمُ السعي إلى التوازن بشكلٍ أفضل. وبناءً عليه، قد لا يتشارك تنفيذيّو السياسة الخارجيّة والقوى المجتمعيّة التقديرَ ذاتَه في خصوص أيّ مكوِّنٍ هو الأخطر ضمن مكوِّنات قوّة الدولة المعنيّة،[9] وحينها سيختلفون على ضرورة السعي إلى التوازن من عدمه.[10] مثلًا، يجد التيّارُ الترامبيّ في المكوِّن التجاريّ والصناعيّ التهديدَ الأبرزَ لدى الصين، بينما يخشى العاملون في مجال الدفاع من تطوّر القدرات البحريّة الصينيّة، في حين يتوجّس التيّارُ الليبراليّ من قدرات الصين التكنولوجيّة وصورةِ نموذجها.
ثالثًا: المصالح الداخليّة لسياسة بايدن الخارجيّة
أدّت العولمةُ النيوليبراليّة إلى إضعاف الطبقة الوسطى في الغرب، وإلى زيادة مستويات اللامساواة. وقد حفّز ذلك موجةً من الشعبويّة والقوميّة المشكِّكة في التجارة الحرّة والمعادية للمهاجرين وللتعدّديّة الثقافيّة والديمقراطيّة والليبراليّة، التي هي القيمُ الأساسيّةُ المفترَضة للنظام الدوليّ ما بعد الحرب العالميّة الثانية.
تدرك إدارةُ بايدن، والتيّارُ الليبراليُّ المعولم في أميركا والغرب عمومًا، أنّه لا بدَّ من إعادة ترميم مشروعيّة النظام الدوليّ داخل المجتمعات الغربيّة من خلال تأكيد دوره في رفاهِها وأمنِها. ولذا ستصبح هذه القوى أكثرَ حذرًا في خصوص الانعكاسات الداخليّة لسياستها الخارجيّة، وأكثرَ حرصًا على تثمير حركتها في الخارج لتعزيز ميزان القوى الداخليّ لصالحها.
وعليه ستعمل إدارةُ بايدن وفق الآتي:
1 - محاولة امتصاص الموجة الشعبويّة الصاعدة في الغرب، وتعريفها باعتبارها عدوًّا مشتركًا داهمًا. يتّهم الليبراليّون روسيا بوتين، على وجه التحديد، بأنّها مسؤولةٌ عن تغذية هذه الموجة من خلال حروب المعلومات (خصوصًا أثناء مواسم الانتخابات والاضطرابات الداخليّة) والتدخّل في الشؤون الداخليّة للدول، ويتّهمون الصينَ بأنّها مسؤولةٌ عنها من ناحية ترويجها لنموذج الرأسماليّة الاستبداديّة. تجد إدارةُ بايدن في تقويض هذه الموجة خارج الولايات المتحدة عاملًا مساهمًا في وأد الترامبيّة، التي ما تزال جذورُها متينةً داخل المجتمع الأميركيّ.
وفي هذا السياق يعيد بايدن التشديدَ على قيم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والحرّيّات ومكافحة الفساد، لا بهدف تحسين صورة أميركا في الخارج فقط، أو لاستهداف خصومِها فحسب، بل أيضًا لأنّها جزءٌ من المعركة الداخليّة. وقد تعهّد بايدن بإصدار مرسومٍ يعلن الحربَ على الفساد باعتبارها مصلحةً جوهريّةً لـ"الأمن القوميّ." وهنا ستَستخدم الولاياتُ المتحدة عنوانَ "محاربة الفساد" لمواجهة كلّ المنافسين غيرِ الليبراليّين، على ما أشارت إلى ذلك الرئيسةُ الجديدةُ للوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة USAID، سامانثا باور، مؤخّرًا. وأكّدتْ باور صراحةً أنّ هذه الحرب ستكون ملائمةً في وجه القادة الشعبويّين والديكاتوريّين؛ فقد لا يهتمّ الشعبُ بانتهاكاتِ قادته لحقوق الإنسان، أو لإعلان إعجابهم بالنموذج الصينيّ للرأسماليّة المستبدّة؛ ولكنّ الأمر مختلف بخصوص الثراء على حساب هذا الشعب.[11]
2 - توحيد الديمقراطيّات الليبراليّة في النظام الدوليّ في مواجهة الصين وروسيا. يحتاج الأميركيّون مجدّدًا إلى قضيّةٍ جامعة في الخارج تعمل بمثابة "غِراءٍ" لاصقٍ لهويّتهم المتشظِّية. وقد سبق أن أشار توماس فريدمان، غيرَ مرّةٍ، إلى أنّ انحلالَ الاتحاد السوفياتيّ كعدوٍّ خارجيّ ساهم في تصدّع البنية الاجتماعيّة الأميركيّة، التي وصلتْ إلى درجةٍ جعلتْه يعلن تكرارًا خوفَه من عودة الحرب الأهليّة الأميركيّة.[12]
تلاحظ المؤرِّخة الأميركيّة جيل ليبور أنّ تكوّنَ الدولة في حالة الولايات المتحدة سبقَ ولادةَ الأمّة. إحدى طرق تحويل الدولة إلى أمّة هي من خلال كتابة تاريخها. ولذا سعى الكثيرُ من المؤرِّخين الأميركيّين إلى كتابة التاريخ الأميركيّ بشكلٍ يبدو معه قيامُ هذه الأمّة حتميًّا، ونموُّها محتومًا، وتاريخُها قديمًا. كانت الحربُ الأهليّةُ الأميركيّة صراعًا بين فكرتيْن حول الدولة–الأمّة: أميركا البيضاء، حيث لا مساواة في الأعراق، أيْ حيث تسود قوميّةٌ غيرُ ليبراليّة أو قوميّةٌ إثنيّة (الجنوب)؛ وبين أميركا القوميّة الليبراليّة (الشمال). وعلى الرغم من فوز الشمال في الحرب، فإنّ القوميّة الليبراليّة منذ نهاية القرن التاسع عشر بدأتْ تنحرف نتيجةً لصعود السياسات الجماهيريّة، التي دفعتْ سؤالَ الأمّة والقوميّة وكلَّ أشكال الإحساس بالولاء إلى قمّة الأجندة السياسيّة. وجرى التعبيرُ عن صعود هذه الموجة بسلسلة تشريعاتٍ معاديةٍ للهجرة، ومؤيِّدةٍ للانعزاليّة والحِمائيّة الاقتصاديّة. وتَرافق ذلك مع موجة إعجابٍ بهتلر والنازيّة. لكنْ، مع نهاية الحرب العالميّة الثانية، عاد المؤرِّخون الأميركيّون ليقدِّموا تاريخَ أميركا على أنّه نتاجُ إجماعٍ ليبراليّ، وأغفلوا القوى المحافظةَ والأصوليّة. وبناء عليه ترى ليبور أنّ القوميّة الأميركيّة هي اختراعٌ وخدعةٌ وخيال.[13]
هذه الهشاشة في الهويّة الأميركيّة توجب، من وجهة نظر إدارة بايدن، مواجهةَ المدّ الشعبويّ والقوميّ حول العالم. ويبدو أنّ إدارةَ بايدن ستعمل على تكريس أولويّة التنافس مع القوّتيْن الكُبرييْن، الصين وروسيا، وذلك انطلاقًا من معطياتٍ جيوسياسيّة، وكذلك ثقافيّة، على اعتبار هاتيْن الدولتيْن تهديدًا للديمقراطيّة الليبراليّة حول العالم. وهذا ما سيُفيد في محاولة خلق قضيّة جديدة للأمّة الأميركيّة، ويفيد كذلك في شيطنة التيار الترامبيّ ومحاصرتِه.
3 - التشدّد مع الصين لإكراهها على التقيّد بمعايير النظام الدوليّ واستيعابِها داخله، مع الحرص على تجنّب مواجهةٍ عسكريّةٍ معها. ركّز ترامب أثناء الحملة الانتخابيّة على بثّ أخبارٍ تفيد بوجود صلاتِ بين الصين ومقرَّبين من بايدن. وكان هدفُ ترامب من ذلك تعزيزَ السرديّة القائلة بأنّ "الأوليغارشية" الليبراليّة الأميركيّة (الشركات، الجامعات، مراكز الأبحاث) أصبحتْ مستتبَعةً للصين من خلال روابطها الماليّة والتجاريّة، وذلك على حساب الولايات المتحدة وشعبها. كما زعم أنّ هؤلاء "المقرَّبين" يعزِّزون العلاقاتِ مع الصين، ويتسامحون مع ارتكاباتها، من أجل تقوية نفوذهم داخل النظام الأميركيّ، على حساب تيّار ترامب والإيديولوجيّين المتبقّين في الحزب الجمهوريّ، بعد هجرة أصحاب الشركات المتعدّدة الجنسيّات وكبارِ العاملين في القطاعيْن الماليّ والتكنولوجيّ في الحزب الجمهوريّ نحو الحزب الديمقراطيّ.[14]

ستعمل سياسة بايدن الخارجيّة على تكريس أولويّة التنافس مع الصين وروسيا
يريد بايدن أن تتوحّد "الديمقراطيّاتُ" لمواجهة الممارسات الاقتصاديّة التعسّفيّة للصين. وسوف تعمل هذه السياسة الخارجيّة على التأكّد من أنّ قواعدَ الاقتصاد الدوليّ لا يجري التلاعبُ بها ضدّ الولايات المتحدة؛ وهذه تهمةٌ كان ترامب نفسُه قد أوردها في استراتيجيّته للأمن القوميّ سنة 2018. ولذا سيعيد بايدن بناءَ الشراكات الآسيويّة، وتمتينَ المؤسّسات الدوليّة، للانخراط في جهدٍ جماعيٍّ هجينٍ ضدّ الصين، يَجْمع ما بين الانفصال الجزئيّ اقتصاديًّا وتكنولوجيًّا عنها والتعاونِ المشروطِ في القضايا الدوليّة ذاتِ المصالح المشتركة.
4 - التركيز على الأبعاد الاقتصاديّة للسياسة الخارجيّة بغْيةَ إقناع الأميركيّين بأنّ رفاهَهم وأمنَهم لا يُمْكن توفيرُهما بالعزلة، بل بدورٍ نشطٍ في الترتيبات الدوليّة. وقد اعتبر بايدن في مقاله في فورين أفيرز (آذار-أيّار 2020) أنّ "الأمنَ الاقتصاديّ يوازي الأمنَ القوميّ." ولذلك تعهّد باتّباعِ ما أسماه "سياسةً خارجيّةً للطبقة الوسطى" تتمحور حول الصين. وهذا يعني الحاجةَ إلى سياسةٍ خارجيّةٍ تقيِّد قدرةَ المنافسين الاقتصاديّة والتكنولوجيّة في الأسواق الدوليّة، وتَضْبط السياساتِ ذاتَ النزعة الحمائيّة (ذلك لأنّ 95% من سكّان العالم يقيمون خارج الولايات المتحدة، وعلى الأميركيّين الاستفادةُ من تلك الأسواق بحسب بايدن)، وتُمسك بقوّة بالمؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الدوليّة وتحدّد أجندتها.
لذلك أوصى أندرياس ويمر، أستاذُ علم الاجتماع والفلسفة السياسيّة في جامعة كولومبيا، بأنّ مواجهة صعود الشعبويّة والقوميّة في العالم الأوّل تستلزم حلولًا ثقافيّةً واقتصاديّةً من خلال مشاريع عامّة. وهذه المشاريع تهدف إلى تأمين مصالح الجميع، وإلى مواجهة التصوّر بأنّ هناك مجموعةً محدّدةً تحظى بالامتيازات، وإلى دعم الطبقة العاملة والجماعاتِ المهمَّشة كي لا تنجذبَ إلى الخطابات الشعبويّة. كلُّ ذلك يجب أن يسير إلى جانب نزعةٍ قوميّةٍ غير إقصائيّة.[15]
وفي السياق عينه، يحاجج يائيل تامير بأنّه ليس هناك صراعٌ بين الليبراليّة والقوميّة، بل توتّرٌ بين القوميّة والليبراليّة الجديدة بشأن مقارباتٍ مختلفةٍ للتوازن بين المصالح القوميّة والاقتصاد المعولم. ولذلك يخطئ الليبراليّون، في نظره، حين يواجهون كلَّ أشكال القوميّة؛ ذلك لأنّ الليبراليّة تحتاج أن تُطوِّرَ شكلًا من القوميّة يَضْمن للمواطنين أن تضعَ قيادتُهم مصالحَهم أوّلًا وأن تعملَ لأجلهم.[16]
5 - الحذر الشديد من التورّط في حروبٍ عسكريّةٍ واسعةٍ حول العالم، مع التركيز على تطوير أدوات "المنطقة الرماديّة" (حرب المعلومات، الحرب السايبرانيّة، الأنشطة الأمنيّة، الحصار، العقوبات الماليّة والاقتصاديّة، الحرب بالوكالة). تمتاز هذه الأدواتُ بأنّها لا تتضمّن كلفةً بشريّةً، ويمكن التحكّمُ نسبيًّا بمستوى التصعيد الناتج منها، وبأنّها قادرةٌ على إرغام الخصوم على تعديل سلوكهم أو رفعِ كلفتِه. هذا المسار، مع ما يتضمّنه من استهدافاتٍ أمنيّةٍ لجماعاتٍ ورموزٍ ودولٍ تُصنَّف "إرهابيّةً" أو "معاديةً" أو "ذاتَ نوايا" لمهاجمة الأراضي الأميركيّة أو مصالحها حول العالم، سيعزِّز من فرضيّة أنّ أمنَ المواطن الأميركيّ لا يمكن الدفاعُ عنه عند الحدود الأميركيّة وحدها بل من خلال دورٍ نشطٍ في النظام العالميّ أيضًا.
خاتمة
الأزمات هي مختبرُ الأفكار والقيم؛ فالقويّ يمتلك القدرةَ على أن يبدو متسامحًا ومنفتِحًا ومراعيًا للحقوق ما دامت قدرتُه على الهيمنة مستقرّةً. منذ 500 عام بدأ الغربُ مسارَ الصعود: فأخضع الإمبراطوريّاتِ الآسيويّة، واستعمر أفريقيا وأميركا اللاتينيّةَ عبر مجموعةٍ من البنى المادّيّة والمعرفيّة. في ظلّ هذه السطوة توفّرتْ له المواردُ الكافيةُ لضمان استقرار أنظمته السياسيّة واسترضاءِ مجتمعاته (مثل دولة الرفاه) وإتاحةِ هوامشَ للحرّيّات العامّة والفرديّة. كما بات يَنْفعه الترويجُ لتحرير التجارة، والانفتاح، وحقوقِ الإنسان، والقيمِ الليبراليّة، والسعي إلى نشر هذه الأفكار جميعِها؛ فهذه من مستلزَمات الهيمنة. كان الأميركيّون بالتحديد قادرين على الإمساك بهذه القيم والمفاهيم ومنحِها تعريفاتٍ تتناسب مع انقسام العالم بين شمالٍ وجنوب، حيث الأوّلُ هو مركزُ الاقتصاد والثقافة والسلطة والمعرفة.
الأزمة اليوم أنّه داخل ذلك "الشمال" ظهر "جنوب،" وهو ما يقوِّض قدرةَ النخبة الحاكمة على تأمين الاستقرار الداخليّ لمشاريع الهيمنة الخارجيّة. تستشعر كتلةٌ وازنةٌ من مواطني الولايات المتحدة وأوروبا بأنّ النظام الدوليّ تَحوّل إلى أداةٍ لتهميشهم داخل بلدانهم من قِبل أقلّيّةٍ حاكمة؛ وهو ما ينعكس على نمط حياة الطبقة الوسطى وظهور مستوياتٍ مرتفعةٍ من اللامساواة. وهذا ما يؤدّي إلى اضطراب العمليّة السياسيّة في تلك الدول، وإلى اتّساع التفسّخات في هويّاتها الوطنيّة. وبناءً عليه تذهب النخبةُ الليبراليّة المعولمة في الاتجاه المعاكس لقيمها المعلنة على المستوى الداخليّ: فتحاصِر منتَجاتِ التكنولوجيا الصينيّة في أسواقها بحججٍ أمنيّة، وتتبنّى نظريّات "المؤامرة" حول أدوارٍ روسيّةٍ وصينيّةٍ وإيرانيّةٍ في التوتّرات الداخليّة والعمليّات الانتخابيّة، وتُقلِّص هامشَ حرّيّة التعبير على وسائل التواصل بذريعة "حماية الحقيقة،" وتخترق الخصوصيّات بحجّة "محاربة الإرهاب."
إنّ هذه الانقسامات الداخليّة، المرشَّحةَ للتصاعد في الولايات المتحدة، بين الكتل المجتمعيّة وبين الفاعلين في المؤسّسات التنفيذيّة، ستضغط بشكلٍ متزايدٍ على مقاربة السياسة الخارجيّة لأيّ إدارةٍ أميركيّة. فهذه السياسة لم تعد نتاجَ ضغوطٍ من المستوى الدوليّ فقط ، بل هي أيضًا نتاجُ التنافسات بين المجتمع والدولة -- وهذا ما سيوثّر في توتير السياسة الخارجيّة الأميركيّة ويزيد من تقلّباتها. سيكون أداءُ إدارة بايدن محوريًّا في مسعى إعادة تكريس المشروعيّة الداخليّة للنظام الدوليّ الليبراليّ، وسيكون الفشلُ في تحقيق ذلك أخطرَ من أغلب التهديدات القادمة من الخارج. وحينها، هل ستقرِّر نخبةُ واشنطن احتواءَ تلك الانقسامات بسياسةٍ خارجيّةٍ هجوميّةٍ مغامِرة لتحطيم الأعداء والمنافسين، وتحديدًا الصين؟
ختامًا، من المناسب أن نستذكرَ مقولةَ السياسيّ الأميركيّ هوبير همفري (1911-1978) إنّ "السياسة الخارجيّة هي، واقعًا، سياسةٌ داخليّةٌ، لكنْ مع قبّعة."
صور (جنوب لبنان)
[1]Mark R. Brawle, “Neoclassical Realism and Strategic Calculations: Explaining Divergent British, French, and Soviet Strategies toward Germany between the World Wars (1919–1939),” in: Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, (eds.), Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy (Cambridge University Press, 2009), pp. 75-98
[2] "التنشئة الاجتماعيّة" هي حصيلة الاستجابة للضغوط التنافسيّة وفق معاييرَ محدّدة من خلال التجربة المتراكمة.
[3]Jennifer Sterling-Folker, “Neoclassical Realism and Identity: Peril despite Profit across the Taiwan Strait,” in: Ibid, p.73
[4]Taliaferro, Lobell, and Ripsman, Ibid, pp. 30-31. Andreas Wimmer, “Why Nationalism Works,” Foreign Affairs, Vol. 98, no.2, March/April 2019, pp. 27-34
[5]Norrin M. Ripsman, Ibid, p.186
[6]Ibid, pp. 178-186
[7]Steven E. Lobell, Ibid, pp. 46-47
[8]Lobell, pp. 46-54
[9] بالمجمل، تكون القوى المجتمعيّة معنيّةً بتأثير السياسة الخارجيّة في توازن القوى الداخليّ، السياسيّ والاقتصاديّ؛ فيما التنفيذيّون معنيّون بما يعتبرونه تهديدًا لمصالح الأمن القوميّ المرتبطة بالمستوى الدوليّ والإقليميّ.
[10]Lobell, Op. Cit., 2009, pp. 54-55
[11]Samantha Power, “The Can-Do Power: America’s Advantage and Biden’s Chance,” Foreign Affairs, January/February 2021
[12]Thomas Friedman, “The American Civil War, Part II,” Seattletimes.com, October 2, 2018
[13]Jill Lepore, “A New Americanism,” Foreign Affairs, Vol.98, March 2019, pp. 10-19
[14]Lee smith, “The Thirty Tyrants,” https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/the-thirty-tyrants, February 4, 2021
[15]Andreas Wimmer, Op. Cit, pp. 27-34
[16]Yael Tamir, “Building a Better Nationalism,” Foreign Affairs, Vol.98, March 2019, pp. 48–52
محاضر جامعيّ، وكاتب وباحث سياسيّ متخصّص في العلاقات الدوليّة. صدر له مؤخرًا كتاب بعنوان: ما بعد القتال: حرب القوة الناعمة بين أميركا وحزب الله، وكتاب: الهيمنة الساحرة: اختبارات القوة الناعمة الأميركية في الشرق الأوسط.