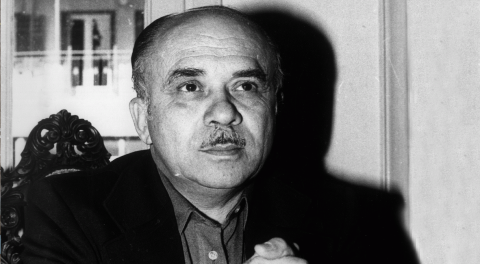بتاريخ 27/5/2021، عقدتْ مجلّةُ الآداب ودارُ الآداب ندوةً رقميّةً مشتركة بعنوان "الترجمة: سياسات، ومستويات، وقضايا إشكاليّة." أدار الندوَة وقدّمها رئيسُ تحرير الآداب سماح إدريس، وشارك فيها (ألفبائيًّا) كلٌّ من: ثائر ديب، ومارك جمال، ومحمّد آيت حنّا، ومعاوية عبد المجيد. وقدّمتْ مديرةُ الدار، رنا إدريس، مداخلةً قصيرةً في الختام. ثم دار نقاشٌ مع الجمهور عبر تطبيق الزووم وصفحتَي المجلة والدار على الفيسبوك.
***
سماح إدريس: أرحّب بكم، باسم مجلة الآداب ودار الآداب، في أول ندوة رقميّة مشتركة بينهما. نحن اليوم أمام عددٍ من المترجِمين العرب المتميّزين، وهم أصحابُ تجربةٍ عريقةٍ في الترجمة. بعضُهم ركّز على الأعمال الفكريّة والفلسفيّة والنقديّة والسياسيّة، والبعضُ الآخر لمع في ترجمة الروايات تحديدًا. بعضُهم ترجم عن الإنكليزيّة، والآخرون تَرجموا عن الإسبانيّة أو البرتغاليّة أو الإيطاليّة أو الفرنسيّة. فإذا أضفنا إلى ذلك أنّهم ينتمون إلى سوريا ومصر والمغرب، فسنزعم أنّنا استطعنا أن نحيطَ بغيرِ جانبٍ من جوانب عمليّة الترجمة إلى العربيّة في الوقت الراهن. نبدأ بالدكتور ثائر ديب من اللاذقيّة الحبيبة.
***

ثائر ديب: سياسات الترجمة: أبعادُ المفهوم وتضاريسُه
لو بقي فهمُ الترجمة متوقّفًا عند بُعدها اللغويّ النصّيّ، ما كانت لتولَد ربّما "دراساتُ الترجمة،" وما كانت لتَنْقُلَ "تنظيرَ الترجمة" من هوامش أقسام اللغة إلى وضعه المركزيّ الحاليّ في حقل الدراسات الثقافيّة والنظريّة النقديّة، وتُحوِّلَه من مجرّد جزئيّةٍ في كتب الأدب المقارن إلى حقلٍ شاسعٍ بات الأدبُ المقارنُ نفسُه جزئيّةً من جزئيّاته. ومن الواضح أنّ حقلَ "دراسات الترجمة" اتّخذ مؤخّرًا أبعادًا ومعانيَ عديدة، وراح يهتمّ اهتمامًا مستجدًّا بحقيقة أنّ الترجمة ليست ترجمةَ نصٍّ فحسب، وإنّما ترجمةَ سياقاتٍ ومفاهيمَ ثقافيّةٍ وسياسيّةٍ وتاريخيّةٍ أيضًا. وبذلك، تبدو الترجمةُ اصطكاكًا لا بين اللغات وحدها، وإنّما بين سياقات بلدانٍ مختلفةٍ وثقافاتٍ مختلفةٍ وأنظمةٍ سياسيّةٍ مختلفةٍ كذلك. كما باتت في زمننا استعارةً أساسيّةً وذاتَ سطوةٍ ترتبط بالتحدّيات التي يطرحها التشظّي الثقافيُّ والسياسيُّ واللغويُّ في بيئةٍ عالميّة.
أستخدمُ تعبيرَ "سياسات الترجمة" في هذا المقام لأشيرَ إلى كلِّ ما تنطوي عليه الترجمةُ زيادةً على بعدها اللغويّ النصّيّ: بدءًا بالمؤثِّرات التي تكتنفها، والمقاصدِ التي ترومها، والمفاعيلِ التي تتأتّى عنها؛ مرورًا بالسياق الذي تجري فيه، وبأسئلته التي تحاول الإجابةَ عنها، وبقضاياه التي تحاول أن تتصدّى لها، وبشكل تلك الإجابة وهذا التصدّي إذ يتأثّران بالتكوين المعرفيّ للمترجِم أو لمؤسّسة الترجمة وبتوجُّههما الإيديولوجيّ اللذيْن يؤثّران في الخيارات والأداء والمقاصد؛ وليس انتهاءً بمدى التطابق بين ما يتوخّاه المترجِمُ ومؤسّسةُ الترجمة من آثارٍ ومفاعيل، وما يتحقّق فعلًا، سواء على صعيد الذات (الأمّةِ المُتَرْجِمَة) أو على صعيد العلاقة بالآخر (الأمّةِ المترجَمِ عنها)، ما إنْ تُنجَز الترجمةُ وتتموضَع في سياقاتها المستقلّةِ عن المترجِم ودوائرِ الترجمة.
ربّما كانت ترجمةُ الكتب المقدَّسة إلى مختلف اللغات، وكذلك ترجماتُها المختلفة في اللغة الواحدة، من أوضح الأمثلة على تأثّر الترجمة بالثقافة والسياسة والتاريخ والاجتماع، وتأثيرِها فيها جميعِها. ومن المعروف أنَّ ترجمة مارتن لوثر للكتاب المقدَّس إلى الألمانيّة لم تقتصرْ على المساهمة في إطلاق شرارة إصلاحٍ دينيٍّ عميق، بل تعدّتْه إلى المساهمة في بناء أمّة، بالمعنى الحرْفيّ للكلمة. كذلك شأنُ ترجمة هذا الكتاب إلى الإنجليزيّة: إنّها قصّةُ انفلاته من قبضة الكهنة إلى أيدي العامّة، وقصّةُ تشكّل اللغة الإنجليزيّة ذاتِها. فعلى الرغم من وصول المسيحيّة إلى إنجلترا منذ القرن الثالث الميلاديّ، بقي الكتابُ المقدّس طوال ألفٍ من السنين طيَّ اللغة اللاتينيّة التي كادت أن تكونَ محصورةً بالكهنة وحدهم. ولذلك، كانت المحاولاتُ الأولى في ترجمة النصوص المقدّسة من لغتيْها الأصليّتيْن - العبريّة واليونانيّة - إلى الإنجليزيّة محلَّ صراعٍ اجتماعيٍّ وسياسيّ، ومحلَّ سجالٍ ومناظراتٍ دينيّةٍ عنيفة، كثيرًا ما اكتنفتْها المؤامراتُ والدسائسُ التي حِيكتْ لأولئك المترجمين، الذين لم يكونوا مجرّدَ "مترجِمين" بقدْرِ ما كانوا (في ترجماتهم وفي مجمل مسيرتهم) حَمَلَةَ مشروع إصلاحٍ دينيٍّ واجتماعيٍّ ساق بعضَهم إلى حتفه.
لكنّ "سياسات الترجمة،" التي كانت موجودةً في الواقع وتُمارَس في كلّ عمليّةِ ترجمةٍ قبل أن يُلتَفَتَ إليها وتُسَمّى بهذا الاسم، لا تقتصر على حوادث الماضي الترجميّة، بل جرت وتجري وستجري على الدوام أيضًا. وهذا ما شهدناه مؤخّرًا، مثلًا، في شأن الترجمة الهولنديّة لقصيدة الشاعرة الأميركيّة السوداء أماندا غورمان التي ألقتْها في حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وكانت بعنوان "التلّ الذي نَصْعد،" وتتحدّث فيها عن مستقبلٍ مأمولٍ للأميركيّين، إنّما ليس من دون أن تذكِّرَ بالأهوال التي عاشها السودُ خصوصًا. فقد كتبت الصحفيّةُ الهولنديّةُ السوداء جانيس دول تعليقًا، نُشر في الصحيفة الهولنديّة Volkskrant في 5/2/2021، رأت فيه أنّ تكليفَ الناشر كاتبةً هولنديّةً "ناجحة" (بيضاءَ، خارجةً على التقسيم الجندريّ الثنائيّ)، هي ماريكه لوكاس رينيفيلد، ترجمةَ القصيدة، هو "تفويتُ فرصة،" وأنّه كان من الأفضل اختيارُ امرأةٍ مثل غورمان، "فنّانةِ إلقاءٍ، وشابّةٍ، وسوداءَ فخورة." وحين انسحبتْ رينيفيلد من المشروع، اتّسع النقاشُ، ورأى كثيرون في تدخّل جانيس دولْ نوعًا من سياسات الهويّة التي أخطأتْ وجهتَها، ونوعًا من "ثقافة الإلغاء." لكنّ هنالك مَن رأوْا أنّ الترجمة لا يمكن أن تكونَ خارج الحاضر وصراعاته، باستلهامها الماضي وتطلّعِها إلى المستقبل، بل هي منخرطةٌ في كلّ هذا، وليست مجرّدَ عمليّةٍ تقنيّةٍ تجري في صفاء.
لا يقتصر حضورُ سياسات الترجمة، بالطبع، على المستوى الظاهر والصارخ كما في المثاليْن السابقيْن، بل يتعدّاه إلى المستوى المجهريّ الذي يحتاج تبيّنُه إلى إمعان نظر، كما في اقتصار ترجمات لويس عوض على مجال الأدب وحده، إبداعًا ونقدًا. فللوهلة الأولى، يبدو هذا الاقتصارُ مدفوعًا باختصاص عوض الأكاديميّ. لكنّ هذا التفسير يَصْعب أن يكون مقْنِعًا، لكون عوض متضلّعًا من التراث الغربيّ كلِّه (فلسفةً وفكرًا وعلومًا وآدابًا وفنونًا وحركاتٍ اجتماعيّة)، وكان ينظر إلى كلّ ذلك في تكامله، بعيدًا عن صنميّة الاختصاص. كما كان يحمل بين جوانحه "شهوةً لإصلاح العالم،" وأراد أن يتسنّمَ سدّةَ "المعلِّم" بالمعنى الذي أُطلق على أمثال أرسطو أو الفارابي. وربّما وجدنا التفسيرَ في مكانٍ آخر لا يتناقض مع دور "المعلّم "هذا، وإنّما يحاول أن يبيّن أنّ هذا المعلّم أراد أن يعلِّم من خلال الأدب والفنّ في المقام الأول. وهذه رؤيةٌ تمثّل لبابًا رئيسًا في فكر عوض. فمنطقُ الفنون والآداب، بحسب عوض، أقوى منطقٍ توسّلتْ به الإنسانيّةُ تحقيقَ حلمها العظيم بالإخاء الإنسانيّ. وما دامت التجاربُ الكبرى لا تُلتمَس في كتابات الاقتصاديّين وعلماءِ الأخلاق والاجتماع والسياسة وحدهم، بل تُلتمس كذلك في أدب الأدباء، فلماذا لا يكتفي المترجِمُ-المعلّمُ بالعمل على هذا المنطق بدلًا من الاشتغال على التجلّيات الأضعف لحلم الإنسانيّة الكبير؟
بإمكان الانكباب على "سياسات الترجمة" لدى عوض أن يَكشفَ أيضًا أنّه، بعد أن اختار الأدبَ لترجمته، قد اختار من هذا الأدب كلَّ ما ينضح بنقد الحياة: بدءًا بأوسكار وايلد، "محطِّمِ الأصنام القديمة" على الرغم من كونه رأسَ مدرسة "الفنّ للفنّ،" وصولًا إلى ت. س. إليوت، "سيِّدِ الهادمين" على الرغم من رجعيّته الأكيدة؛ فما بالكم بشكسبير، بل شيلي أيضًا؟ كما يمكن أن يَكشفَ هذا الانكبابُ أنّ أداءَ عوض في الترجمة، بمعناها الحَرفيّ، قد جمع أسلوبَ المعلِّم، في تقريب الأصل وتوضيحِه، إلى أسلوب الفنّان الخالق، لغةً وبلاغة. وقد يَكشف أيضًا أنّ معارفَه، التي تكاد أن تكون خارقةً في التراثيْن الغربيّ والعربيّ، وفي سياق النص الثقافيّ والتاريخيّ، وسياقِ الترجمة في مصر، فضلًا عن روحه النقديّة، قد تجلّت جميعًا في ما قدّمه لترجماته، أو ذيّلها به، أو كتبه إلى جانبها، بما يَرفع كلَّ قلقٍ قد يكتنف النصَّ المنقول. وقد يَكشف هذا الانكبابُ أخيرًا أنّ هذا الفعل قد ترتّبتْ عليه آثارٌ بالغةُ الأهمّيّة، أبرزُها ما ارتبط بترجمة لويس عوض، منذ أربعينيّات القرن الماضي، من وضعه الأسسَ النظريّةَ لمنهجٍ في النقد يوضح العلاقةَ الأكيدةَ بين الأدب وروحِ العصر؛ وكذلك ما كان لعمله على شيلي وإليوت، ترجمةً وكتابةً، من أثرٍ بالغٍ في الشعر العربيّ الحديث، إذ يُشار إلى تأثير عوض في بدر شاكر السيّاب خصوصًا وشعراءِ الحداثة عمومًا. ولعلَّ الأهمّ من كلِّ ذلك هو أنّ هذا الانكباب يَكشف عمّا يقف وراء جميع هذه الأمور من علاقةٍ تَربط الترجمةَ والمترجِمَ بالأسئلة التي طرحها السياقُ الاجتماعيُّ والثقافيّ الذي عاش واشتغل فيه؛ سياقُ أربعينيّات القرن العشرين، الذي يكاد يُجمَعُ على وصفه بأنّه سياقُ "الأزمة" في الثقافة المصريّة، بل في الحياة المصريّة بأكملها -- وهو السياق الذي اختار فيه عوض، بين الاشتراكيّة الماركسيّة والدعوةِ الثيوقراطيّة، أن يكون (على الرغم من بعض التقلّب اللافت) واحدًا من قلّةٍ قليلةٍ مثّلت امتدادًا لتقاليدِ روّاد النهضة، بمذاقٍ جديدٍ وفي مناخٍ جديد، حاملًا معه ما كان قد حملوه من رهانٍ على الثقافة والتربية المستنيرة وعلى قلّةٍ من المستنيرين تكاد لا تجد مَن يصغي إلى خطابها.
بهذه الروحيّة ذاتها، فإنّ في إمكان سياساتِ الترجمة أن تضعَ موضعَ الدرس والتمحيص مشروعَ طه حسين الترجميّ، مترجِمًا ومشْرِفًا؛ أو ترجماتِ سهيل إدريس ودارِ الآداب للوجوديّة وعلاقتِها بصعود الفكر القوميّ وأزماتِه؛ أو ترجماتِ جورج طرابيشي في تقلّباته من الفكر القوميّ والوجوديّة إلى الماركسيّة فالليبراليّة، ومن حقل الفكر السياسيّ إلى مجالات التحليل النفسيّ؛ أو اليُسْرَ الذي استَقبلتْ به دولُ الخليج ترجماتِ الفكر البنيويّ وما بعد البنيويّ والتأويليّة، قياسًا باستقبالها الوجوديّةَ أو الماركسيّةَ مثلًا؛ أو انتشارَ الترجمات السوفييتيّة والأميركيّة في منطقتنا خلال الحرب الباردة؛ أو انتشارَ مشاريعِ ترجمة الفكر الليبراليّ إبّان الاحتلال الأميركيّ للعراق؛ أو ترجمةَ كتابٍ معيّن، ككتاب فرانز فانون، معذَّبو الأرض، وما تركتْه الإيديولوجيا القوميّة لدى مترجِميْه (سامي الدروبي وجمال الأتاسي) من أثرٍ في ترجمة قسمه الثاني خصوصًا، حيث نقدُ الدولة القوميّة أو الوطنيّة بعد الاستقلال؛ أو دخولَ الرواية كجنسٍ أدبيٍّ جديدٍ في سلسلة الأجناس الكتابيّة العربيّة بفضل الترجمة والتأثّر؛ إلى آخر هذه الموضوعات التي لا نهاية لها ويمكن أن تتناولَها سياساتُ الترجمة.
غير أنّ واحدًا من أهمّ موضوعات سياسات الترجمة هو ما يمكن أن ندعوه "سوقَ التبادل الثقافيّ العالميّ" أو "سوقَ الترجمة العالميّ." فهذه السوق تَحْكمها تبايناتُ القوّة بين اللغات والثقافات، وتسيطر فيها "الكتبُ الرائجة" (best sellers) التي عادةً ما تكرِّسُ قيمَ الثقافة السائدة عالميًّا، فكريًّا وفنّيًّا؛ كما يَحْكمها تخلُّفُنا الثقافيّ على نحوٍ شبيهٍ نوعًا ما بتخلّفنا الاقتصاديّ الذي يجعلنا نستورد أكثرَ ممّا نصدِّر بكثير. وهنا تبدو الترجمةُ قمّةَ جبل الجليد من مؤسّسةٍ كاملة، عالميّةِ النطاق، للإدناء والإقصاء و(سوءِ) الاختيار، تضمّ ناشرين ومموِّلين وجوائزَ ودوريّاتٍ وبرامجَ تسويقٍ وإعلامٍ ومراكزَ ثقافيّةً ومنظّماتٍ حكوميّةً وغيرَ حكوميّة وشِللًا وعصاباتٍ ثقافيّةً ممتدّة (من كتّابٍ ومترجِمين ونقّادٍ محلّيّين ومهاجرين وأجانب) وشخصيّاتٍ تعمل كعقد اتصالٍ بسبب نفوذٍ ما، مادّيّ أو معنويّ، وتُعتَمَدُ "مَراجعَ" في اختيار مَن يمتثلون إلى معايير المؤسّسة المذكورة التي تكاد تغيب عنها القيمُ الأدبيّةُ الحقّة، لا سيّما قيمُ التمرّد الأدبيّ، بما يعنيه من ابتداع أشكالٍ جديدةٍ للقول وسبْرِ العالم.
هكذا يتّضح أنّنا ما إنْ نتكلّمُ على سياسات الترجمة، بل على مفردةٍ من مفردات هذه السياسات، كاختيارِ ما يُتَرْجَم مثلًا، حتى نتكلّمَ على جماع تكوين المترجِم الفرد، اللغويّ والثقافيّ والفكريّ والإيديولوجيّ والنفسيّ، وعلى المؤسّسة والبنية الاقتصاديّة الاجتماعيّة السياسيّة التي تقف وراء ذلك كلّه؛ فضلًا عن الكلام على العلاقة بين ثقافتيْن، على الأقلّ، المُتَرْجَمِ منها والمُتَرْجَمِ إليها، وما يحكمها من موازين قوًى لغويّةٍ وثقافيّةٍ وسياسيّةٍ واقتصاديّةٍ، بل عسكريّة أيضًا. وبذلك لا تعود الترجمةُ تلك العمليّةَ الرائقة التي يقوم بها فردٌ معزول، ولا ذلك الجسرَ الذي يربط بحبٍّ بين الثقافات، ولا ذلك التبادلَ الطوعيَّ بين اللغات في حالٍ من الحياد والوئام، بل تتعدّى ذلك كلَّه إلى أنّها "ترتبط بالتجارة والفتح، بوصفها [أي الترجمة] ممارسةً للعنف،" على حدّ تعبير راناجيت غُها.
لكنّ ارتباطَ الترجمة هذا بالقوّة والسلطة، واستخدامَها في السيطرة على الشعوب و"تعليمِها" وقَوْلَبَتِها، لا يعنيان أنّ هذا هو الدورُ الوحيد الذي أدّته وتؤدّيه وستبقى تؤدّيه في المستقبل. فلقد باتت الترجمةُ، اليومَ خصوصًا، استعارةً أساسيّةً لبعض المهامّ الأشدّ إلحاحًا، كالجمع بين اللغات والثقافات والسياقات السياسيّة المختلفة على نحوٍ يقدِّم تفهّمًا متبادلًا، من دون الاضطرار إلى التضحية بالاختلاف لمصلحة التمثّل والتماثل الأعمييْن. وهي تشير، بهذا المعنى، إلى إبداع خرائطَ ثقافيّةٍ وسياسيّةٍ جديدة، وإقامةِ مناطقَ مشتركة ومواضعَ للتمفصل تحفظ حقَّ الاختلاف والمساواة. كما تشير إلى بقائها في الحاضر، منغمسةً في صراعاته وتعقيداته، تؤدّي الدورَ السابقَ (السلبيّ)، كما تؤدّي دورًا واضحًا بوصفها قناةً مهمّةً للمقاومة وتحرُّرِ العقول والأجساد.
اللاذقيّة
***

محمد آيت حنّا: الترجمة، أو حين تغدو النُّسَخ أصولًا
الاستعارات التي بها تموت الترجمة. ربّما تكون إحدى المشاكل الأساسيّة التي تعوِّق ترجمةَ العمل هي الاستعارات التي تحاول شرحَ الفعل الترجميّ: كالخيانة، والجسر، والبساط الفلامانيّ (التي كان يقول بها ثربانتس)، والبورتريه المرسوم للآخر، والخيمياء المحوّلة (التي كان يقول بها بوجولي). المشكلة الأساس في هذه الاستعارات هي تكريسُها قيمًا ثنائيّةً، وفق نظامٍ تراتبيٍّ يجعل النصَّ في جهةٍ وترجمتَه في جهةٍ مقابلة، ويجعل النصَّ المترجَمَ بالضرورة تابعًا للنصّ الأصل -- وهي ضرورةٌ يفرضها الزمنُ أصلًا، إذ لا يمكن أن ننكر أنّ الأصل أُنتج قبل ترجمته، فكسب نوعًا من السّبق قياسًا إليه.
غير أنّ السؤال الذي يُطرح ههنا هو: هل يكفي هذا السَّبقُ الزمنيُّ لاعتبار الترجمة في مرتبةٍ أقلَّ من الأصل، بل تدهورًا له؟ وهل من مبرِّرٍ أصلًا لمواصلة التفكير في الفعل الترجميّ انطلاقًا من تلك الثنائيّات التي اجتهد الفكرُ المعاصرُ في سبيل خلخلتها وتجاوزها، وأهمُّها ثنائيّةُ النسخة والأصل (التي أفضّل عليها كلمتَي النصّ والترجمة)؟ إنّ مقاربةَ النصّ وترجماته ينبغي أن تتمَّ، بالأوْلى، في إطار شبكةٍ من علاقات القوى والهيمنة. ليست العلاقةُ بين الترجمة والنصّ بالضرورة علاقةَ تضادّ، لكنّها أيضًا ليست علاقةَ توافقٍ وانسجامٍ وتآلف. ثمّة صراعٌ حيٌّ بينهما، لا يَفترض إقصاءَ طرفٍ لحسابِ آخر، لكنّه أيضًا لا ينفي علاقاتِ الخضوع والتبعيّة والهيمنة. ولمّا كانت البداهةُ والرأيُ السائدُ يرجِّحان هيمنةَ النصّ الأصل على الترجمة، إذ يُعتبر الأصلُ أسمى من النّسخة وأتمَّ وأوضح، فإنّ ما يهمُّني هنا هو الوقوفُ عند بعض تجلّيات القوّة والهيمنة التي أمكن فيها الترجمةَ أن تبلغَ درجةَ النصّ الأصل المستقلِّ بذاته. لهذا اخترتُ لهذه الورقة عنوان "الترجمة، أو حين تغدو النُّسَخُ أصولًا." وحتّى لا أبقى في مستوى كلامٍ تنظيريٍّ عامّ، فإنّني أسُوق أمثلةً تاريخيّةً حيّة، تشهد على الصراع بين طرفَي المعادلة، وتستحثُّ فينا التأمّلَ في علاقات القوّة والهيمنة بينهما، وتوضِح كيف أنّ النّسخة قد تهيمن أيضًا على الأصل.
الترجمة في غياب الأصل. لعلّ أوضحَ الأمثلة على حلول الترجمة حلولًا كلّيًّا مكانَ النصّ المترجَم هو مثالُ ضياع الأصل وعدم وجود أثرٍ باقٍ له إلّا في الترجمة. وهذا المثال طبعًا هو أقلُّ الأمثلة دلالةً على انتصار الترجمة، إذ إنّ الهيمنة هنا لا ترجع بالضرورة إلى قوّة النصّ المترجَم وقدرتِه على مقارعة الأصل، وإنّما لأنْ لا بديلَ له. وربّما قد تكون إحدى النماذج الدالّة هنا نصوص الفيلسوف ابن رشد. نعرف أنّ عددًا من نصوص ابن رشد ضاعت، ومنها الضروريّ في السياسة وتلخيص أخلاق أرسطو؛ إذ ضاعت أصولُ هذه الكتب، ووصلتْنا الترجماتُ العبريّةُ لها. وقد شهدنا في السنوات الأخيرة محاولاتٍ لترجمة تلك النصوص إلى العربيّة، للبحث في ما وراء الترجمة العبريّة عن النصّ العربيّ. لقد صارت الترجمةُ هنا بابًا لا مندوحةَ عن المرور منه للوصول إلى الأصل. وذاك ما يحاول القيامَ به الأستاذ أحمد شحلان الذي سعى إلى ترجمة النصّ؛ ترجمة هي في الحقيقة سعيٌ إلى إقامة أصلٍ عن ترجمة، لا خلق نسخةٍ عن أصل.
في غياب الأصل الذي كنّا نملكه، تغدو الترجماتُ، إذن، بمثابة أصولٍ. غير أنّنا ننبِّه مرّةً أخرى إلى أنّ استحقاقَ الترجمة هنا لا ينبع من قدرتها على مقارعة الأصل وإزاحتِه، وإنّما فقط من كونها قد حلّت في الموضع الفارغ. إنّها ما نَقْنع به في غياب الأفضل.
الترجمة استعادةً لِما قبل النصّ. تتمّةً للوضع السابق، تبدو أوضحَ محاولةُ استعادة الأصل عن طريق الترجمة حين يتعلّق الأمرُ بنصوصٍ كتبناها "نحن" في لُغة الآخر. أقصد مثلًا تلك النصوصَ التي كتبها مبدعون أو مفكِّرون عرب بلغةٍ غيرِ العربيّة. ذلك لأنّ محاولةَ ترجمتها تظلّ دومًا محكومةً بسعيٍ إلى استعادةِ ما كانت عليه اللغةُ قبل الكتابة، ويظلُّ المترجِم محكومًا بعيشِ توتّرٍ زمنيّ: فهو يترجِم ما بعد النصّ، لكنّه يستعيد ما كان قبل كتابة النصّ. إنّ مؤلِّفين مثل الطاهر بنجلّون أو كاتب ياسين أو عبد الفتّاح كيليطو لا يكتبون من غير أن تكون للترجمة في كتاباتهم نصيب. ألا يعمل مترجِمُ نصوص بنجلّون إلى العربيّة على نزع غرابةٍ اكتسبتْها الكلماتُ العربيّة، والمغربيّةُ تحديدًا، حين كُتبتْ بالفرنسيّة؟ ألا يعمل مترجِمُ نصوص كيليطو على إعادة كتابتها باللّغة التي كان يُفترض أن تُكتبَ بها أصلًا، أن يُنقذَها من براثن لُغةٍ لم تُكتبْ بها إلّا بقدْرِ ما تُرجمتْ؟ ويصير الأمرُ أوضح حين نقرأ النصّيْن معًا، "الأصلَ" وترجمتَه، من غير أن نضعَ في الحسبان أيّهما هذا أو ذاك. إنّ قارئ كيليطو بالفرنسيّة وترجمةِ عبد السلام بنعبد العالي بالعربيّة لا بدّ من أن يقف على مقدارٍ من الانزياح والاختلاف فرضتْه عمليّةُ استعادة النصّ؛ انزياح واختلاف يوسِّعان النصَّ أكثر ممّا يعملان على خنقه.
في عمليّة استعادة النصّ عبر الترجمة، لا يعود الحديثُ عن المشكل الكلاسيكيّ، أيْ مشكل الخسارة الضروريّة في كلّ ترجمة، وإنّما ينقلب الأمرُ إلى نوعٍ من الإغناء. فالنصّ المترجَم هنا أغنى من الأصل لأنّ المترجِم "يستعيد" ما خسره النصُّ حين كُتب بلُغةٍ يُفترض أن تكون لغةَ ترجمتِه لا لغةَ كتابته.
الترجمة والأصل: ساقان لجسد واحد. الحالة الثالثة التي يمكن أن نتحدّثَ فيها عن علاقات الهيمنة بين النصّ وترجمتِه، وربمّا علاقة التساوي بينهما، هي حالةُ الكتّاب "أصحابِ اللسان المفلوق،" بتعبير كيليطو؛ أيْ أولئك الذين يمارسون الكتابةَ بلغتيْن في آنٍ واحد. والنموذج الذي استَشهِدُ به في هذه الحالة دائمًا، لأنّني اشتغلتُ عليه، هو الكاتبُ الإيرلنديُّ صامويل بيكيت. نعرف أنّ بيكيت كَتب بالإنجليزيّة، وتَرجَم أعمالَه بنفسه إلى الفرنسيّة، لكنّ ترجماته، في الحقيقة، هي إعادةُ كتابة. فهو، أثناء نقل الأعمال إلى لغته الثانية، كان يغيِّر فيها، ويحوِّلها، ويُغْنيها، كما قد يختزلها، ويجرِّب فيها أقصى طاقات اللغة المستقبِلة. السؤال الذي يُطرح ساعةَ ترجمتنا لأعمال بيكيت إلى العربيّة هو: هل نكتفي بترجمة مسرحيّة الأيام السعيدة، على سبيل المثال، من الإنجليزيّة، لأنّها أوّلُ ما كُتب بها، أمْ نترجمُها عن الفرنسيّة لأنّها الصِّيغة الثانية، ومن ثمّ يُفترض أنّها أنضجُ وأكثرُ تحيينًا من النسخة السابقة، أمْ نحن مضطرّون إلى القيام بالترجمة مرّتين، عن الإنجليزيّة ثمّ عن الفرنسيّة؟ وقِسْ على ذلك نصوصَ فالتر بنيامين بين الألمانيّة والفرنسيّة. وإنّي أرى أنّ الترجمة هنا ينبغي أن تعتني بالنصّيْن معًا، لأنّهما صارا معًا في مقام النصّ الأصل الذي يُنتظر منّا أن نترجمه.
الترجمة أو الخطأ المبدع. حالة رابعة من علاقات الهيمنة والصراع بين النصّ وترجمته تستند هذه المرّة إلى سوء الفهم الضروريّ في كلّ إبداع. يتعلّق الأمرُ بأعمالٍ كانت في الأصل ترجماتٍ، لكنّها - بسبب خطأ أو سوءِ فهم - حازت مرتبةَ النصّ الأصل المستقلِّ بذاته، بل قد تصير أقوى منه وأكثرَ فعّاليّةً. تَحْضرني هنا قصيدةُ غوته، ملكُ العفاريت، أو تحديدًا ملكُ النّغت. كان يوهان-غوتفريد هردر قد عمل على جمع أساطير الشمال، فنقلَ، من جملةِ ما نقلَه، حكايةَ ملِك الإلف (العفاريت)، خَطّافِ الأطفال، وهي حكايةٌ قديمةٌ كانت تُحكى، ربّما، تسليةً لمن فقدوا أطفالَهم بسبب المرض، إذ يُقال إنّ ملك الإلف (العفاريت) ينادي أولئك الأطفالَ فيتبعونَه إلى عالمٍ من الوعود. يبدو أنّ غوته أثناء قراءته لهذه الحكاية الخرافيّة قد أخطأ قراءةَ اسم ملك العفاريت؛ فبدلًا من أن يقرأ الاسم Elfenkônig (ملِك العفاريت)، قرأ خطأً Erlenkônig (ملك النّغت)، فاشتعلتْ مخيّلتُه بذكر هذه الشجرة الكئيبة، فخصّها ببالادةٍ شهيرة، لحّنها شوبرت بعد ذلك ببضع سنوات. قصيدة شهيرةٌ جدًّا رَفعتْ نصَّ ملك العفاريت إلى جوٍّ من الرّعب والكآبة، وأقحمتْه مجالَ الشِّعر والموسيقى -- وكلُّ ذلك بسبب خطأ أو سوءِ فهم!
ولنا في هذا الجانب أيضًا مثلٌ شهيرٌ، هو مثلُ ابن رشد الذي - لسوء فهمٍ ثقافيّ - ترجم التراجيديا والكوميديا بالهجاء والمدح، وهو المثالُ الذي عالجه بورخيس في قصّته الموسومة: "بحث أبي الوليد بن رشد."
لقد درجنا على اعتبار الأخطاء انحطاطًا للنصّ وتدهورًا له. ولسنا مخطئين في ذلك، قياسًا إلى أنّ النّسبة الكبرى من الأخطاء الترجميّة تكون أخطاءً غيرَ منتِجة، أخطاءً مسيئةً للنصّ. لكنّ ذلك لا يمنع من أنّ ثمّة أخطاءً ترفع النصوصَ إلى مستوياتٍ لم تكن لتبلغَها في نصوصها الأصل: إنّها أخطاءٌ منتِجة.
الترجمة استقلالًا عن النصّ. وهذه الحالة تخصّ الترجمات التي تستقلُّ بنفسها عن أصولها وتصير نصوصًا يُرجَع إليها بوصفها أعمالًا أصيلةً تستحقّ بدورها أن تترجَم وتُقرأ، لا كترجماتٍ وإنّما كنصوصٍ أصليّة. ولعلّ النموذجَ الأبرز هنا هو ما فعله الشاعرُ الألمانيّ هولدرلين بالشاعر اليونانيّ سوفوكليس. فلقد ترجم الألمانيُّ اليونانيَّ ترجمةً أثارت الكثيرَ من الجدل في زمنه، وما تزال تثيره، إذ اعتبرها الكثيرُ من النقّاد تعسّفًا على سوفوكليس، بل على النّحو الألمانيّ كذلك. غير أنّ الترجمة عند هولدرلين لم تكن مجرّدَ سعيٍ إلى نقل أثرٍ يونانيّ إلى الألمانيّة، وإنّما دفعًا بهذه إلى حدودها القصوى، بحيث تَختبر تجربةَ نصٍّ غريبٍ عنها، تواجه أقصى درجات الغرابة، لكي تتغيّر، تتلاقح من لغةٍ أخرى. والنتيجة أنّ نصَّ هولدرلين صار بدوره نصًّا أصيلًا يُنقل إلى لغاتٍ أخرى. صار يُعتبر نصًّا مستقلًّا: في الإنجليزيّة نعثر على ترجماتٍ لسوفكليس، وترجمةً لترجمة هولدرلين لسفوكليس. وقد تنطبق الوضعيّةُ السابقةُ كذلك على ما فعله بودلير بقصص بو، وكذلك ترجمة مالارميه لقصيدة بو، "الغراب."
الترجمة دخولًا في نسيج اللغة وتحويلًا لها. أعود هنا إلى غوته، وأستعيد استعارةَ بوجولي الذي كان يرى في الترجمة خيمياءَ محوِّلةً للنصّ. عندما استُشير غوته في شأن أنطولوجيا للشِّعر الألمانيّ، اقترح أن تضمّ أيضًا القصائدَ التي ترجمتها الألمانيّةُ عن اللّغات الأخرى، على اعتبار أنّ هذه القصائد لم تعد ترجماتٍ وإنّما باتت قصائدَ ألمانيّةً دَخلت في نسيج اللغة والثقافة الألمانيّتين، وربّما أثّرتْ فيهما تأثيرًا أقوى من ذلك الذي مارسته القصائدُ الألمانيّةُ نفسُها. ولنا هنا أن نتساءلَ أيضًا إذا كنّا سنتحدّث عن الشِّعر العربيّ المعاصر: ما نصيبُ الشِّعر العربيّ الكلاسيكيّ في القصائد العربيّة المعاصرة، وما نصيبُ القصائد التي ترجمناها إلى العربيّة فيه؟
فهنا يتّضح أنّ الترجمة قد تغدو طاقةً محوِّلةً ومحفِّزةً، ومطوِّرةً لثقافتنا ونصوصنا. ولدينا أمثلةٌ كثيرة على ذلك في مجال الفكر والفلسفة؛ ومنها أنّ ترجمةَ هيجل إلى الفرنسيّة أحدثتْ في الفكر الفرنسيّ المعاصر ما لم تحدثْه الكتاباتُ الفرنسيّةُ نفسُها، بما فيها أعمالُ ديكارت.
الترجمة مسارًا جديدًا للنصّ وتحويلًا لتاريخه. أستحضرُ هنا بدايةً نصَّنا الأشهرَ على الإطلاق، ألف ليلة وليلة. نعلم جميعًا أنّ هذا النصّ العجيب كان نصًّا هامشيًّا في الثقافة العربيّة، ولم يتحوّلْ إلى نصٍّ مركزيّ إلّا عقب ترجمته. فجأةً، بعد الترجمة، انقلبت اللّيالي من نصٍّ هامشيّ يكاد لا يُستشهد به في أوساط النّخب، إلى نصٍّ مركزيّ، بل إلى النصّ المركزيّ في الثقافة العربيّة. حتّى إنّ معظمَ العرب صاروا يعتبرونه النصَّ العربيَّ الأكثرَ أصالةً. وهنا نرى كيف أنّ الترجمة تُغيّر من فهمنا لنصوصنا نفسِها.
المثال الثاني الذي أطرحُه هنا بخصوص الترجمة، بما هي انقلابٌ وتحويلٌ للنصّ، بل لتاريخه أيضًا، وللتاريخ بأكمله، هو أنموذجُ الكتاب المقدّس. هل ما فعله مارتن لوثر كان مجرّدَ نقلٍ لنصٍّ مقدّسٍ من لغةٍ عالمةٍ (اللاتينيّة) إلى لغةٍ شعبيّة (الألمانيّة)، أمْ أنّه كان تحويلًا لمسار الثقافة والدين المسيحيّ بأكمله؟ نحن نعلم الآن أنّ هذه الترجمة كانت هي الدافعَ الأكبرَ لنشوء التيار البروتستانتيّ داخل المسيحيّة وتعزُّزه. إنّ ترجمة الكتاب المقدّس في هذه الحالة ليست مجرّدَ نقلٍ له، وإنّما تغييرًا جذريًّا لتاريخه، ولكلِّ ما كان يجرُّه معه حين كان ما يزال محتكَرًا من طرف دائرة اللّغة اللاتينيّة الضيّقة.
الترجمة إزاحةً للأصل. لعلّ هذا الأنموذج هو أكملُ الأمثلة وأوضحُها، وهو حين تزيح الترجمةُ النصَّ الأصلَ، وتلغيه تمامًا، وتحتلّ مكانَه، وتصير هي النصَّ الأصلَ الذي لا يتقبّل أيُّ قارئٍ اعتبارَه "مجرّدَ ترجمة." أستحضرُ هنا كليلة ودمنة، الذي نعتبره اليوم نصًّا عربيًّا، ونكاد لا نقبل أن يجادلَنا أحدٌ في كونه كذلك، على الرّغم من أنّنا جميعًا نعرف أنّه نصٌّ هنديّ، وحتّى حين ترجمَه ابنُ المقفّع فقد احتفظ بأجوائه الهنديّة وأسماء شخصيّاته الهنديّة (دبشليم، بيدبا). لكنْ يبدو وكأنّ ابن المقفّع، حين أقدم على ترجمة كليلة ودمنة، قد أعدم كليلة ودمنة الأصلَ وأحلّ محلّها ترجمتَه.
خاتمة. عبر وقوفنا على مختلف هذه النماذج، يتبيّن لنا كيف أنّ العلاقة الملتبسة بين الأصل والترجمة لا يمكن أن ترتدّ إلى مجرّد استعاراتٍ بسيطةٍ توضِّح الفروقَ، وتكرِّس التباينَ والتباعدَ بين أصلٍ يُفترض أنّه "نقيّ" وترجمةٍ هي بالضرورة "نسخةٌ متدهورةٌ" تمثّل انحطاطًا للنصّ وابتعادًا عنه. إنّ الترجمة حياةٌ للنصّ، حياةٌ ليست بالضرورة أجودَ، لكنّها أجدُّ؛ حياةٌ ترفع النصَّ - كما يقول فالتر بنيامين في مقالته الشهيرة "مهمّة المترجم" - إلى أجواء لم يكن ليبلغَها في وضعيّته الأصل.
الدار البيضاء
***

مارك جمال: العودة إلى الأصل
أودّ أن أتطرَّق إلى إحدى الإشكاليّات التي استوقفَتني غيرَ مرّة في أثناء الترجمة، وهي "العودة إلى الأصل،" وذلك حين يستشهد الكاتبُ الأجنبيُّ باقتباساتٍ عربيّةِ الأصل، فيتعيَّن على المترجِم أن يردَّها إلى العربيّة مرة أخرى. ففي هذه الحالة يكون المترجِم أمام خيارَيْن:
- أن يعيدَ ترجمةَ النصّ عن اللغة الأجنبيّة إلى العربيّة. وهذا ما لا أراه مُستحَبًّا، ويُفقِد الترجمةَ رونقَها، وغالبًا ما يؤدِّي إلى ضياع موسيقى النصّ ومغزاه. بل إنّ إعادة الترجمة إلى العربيّة تصبح غيرَ مقبولة من الأساس إذا كان النصُّ المقصودُ دينيًّا، لا يجوز الإخلالُ بأصله؛ كأنْ يَستشهد الكاتبُ الأجنبيُّ بحديثٍ نبويٍّ على سبيل المثال.
- أن يعود المترجِم إلى النصّ الأصليّ ليستخدمَه بحذافيره، أو بأقرب شكلٍ ممكن، بحسب ما يقتضيه السياق. وهذا ما أميلُ إليه، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي قد تترتَّب عليه كما سنرى.
اخترتُ الاستشهاد بمثالَيْن لتوضيح هذه الإشكاليّة بطريقةٍ عمليّة، وكلاهما ورد في روايةٍ ترجمتُها عن اللغة البرتغالية، هي مُذكِّرات براس كوباس يكتبها بعد الموت للكاتب البرازيليّ ماشادو دي أسيس، الأبِ الشرعيِّ للأدب البرازيليّ:
أ) في أحد فصول الرواية نقرأ المقطع الذي نستطيع ترجمتَه على النحو الآتي:
"وهناك، رأيتُ نظرةَ مارسيلا، وكأنّها تسْخر مني، تلك النظرة التي ألقَت بظلٍّ من الريبة منذ قليلٍ على أنفي، الذي هو في الوقت نفسه أنفُ بَكْبَرَه. مسكينٌ أنتَ يا عاشقَ ألف ليلة وليلة! رأيتُك هناك تجري وراء امرأةِ الوزير، على امتداد الرواق، هي تلوِّح إليك بامتلاكها، وأنت تجري، وتجري، وتجري، حتى رأيتَ نفسَك في وسط زقاق، فصاح عليك الجلّادون وصاروا يضحكون. عند ذاك، خُيِّل إليَّ أنّ رواق مارسيلا هو الزقاق، وأنّ الشارع يقع في بغداد."
بطبيعة الحال، رأيتُ ضرورةَ البحث عن الموضع الذي يَستشهد به الكاتبُ على وجه التحديد، حتى أتمكَّنَ من نقل الاسم بدقّة، وترجمةِ الألفاظ الواردة في الفقرة بما يلائم أجواءَ القصة الأصليّة المشار إليها. وهكذا شرعتُ أبحث عن هذا المدعو "بَكْبَرَه" (Bakbarah) كالإبرة في كومةِ قشّ. فلم أعثرْ له على أدنى أثر. ولكنّي عثرتُ على موقفٍ يكاد يكون مطابقًا في قصّة "مزيِّن بغداد،" وتحديدًا في الليلة الثلاثين من طبعة بولاق الصادرة عام 1279 هجريًّا، غير أنّ بطل القصّة يُدعَى "بَقْبَقْ." من هنا جاء التساؤل: هل هما الشخصُ نفسُه؟ وفي هذه الحالة، كيف تحوَّل بَقْبَقْ إلى بَكْبَرَه؟ بعد البحث، وجدتُ أنّ بَكْبَرَه هو الاسم الذي استخدمه المستشرقُ الفرنسيّ أنطوان غالان، الذي عُرِف بترجمة ألف ليلة وليلة (الصادرة في القرن الثامن عشر)، وقد أعدَّها بما يلائم العصرَ والذائقةَ السائدة آنذاك، مُتدخِّلًا في تعديل الأسماء كي توافقَ الأذنَ الفرنسيّةَ أو الأوروبيّة؛ كما تدخَّل بالإضافة أيضًا. ولعلَّه أدخل تلك التغييرات حتى يضفي الطابعَ الغرائبيَّ "الاستشراقيّ" على القصص.
وبالعثور على الموضع المنشود في ألف ليلة وليلة، سعيتُ إلى كتابة الاسم والألفاظ المستخدَمة في القصّة كما جاءت في الأصل، أي في الطبعة العربيّة من ألف ليلة، وإن اختلف هذا الأصلُ عن النصّ المُترجَم قليلًا. على سبيل المثال، حرصتُ على استخدام "جلّادين" دون غيرها من الخيارات التي ربّما كانت أكثرَ شيوعًا، مثل "صنّاع الجلود" أو "الدبّاغين."
كما أعتقدُ بوجود تماسٍّ بين المثال المذكور والترجمة عن لغاتٍ وسيطة، إذ نرى من خلاله الخطأَ الذي قد يقع فيه المترجِم، لا عن تقصير، بل لمُجرَّد أنه يسترشد بترجمةٍ أخرى قد تكون بعيدةً عن النصّ الأصليّ.
ب) وفي ما يأتي أستشهدُ بمثالٍ آخر على "العودة إلى الأصل،" ورد في المصدر نفسه. فقرب نهاية الكتاب، وجدتُ فقرةً لو ترجمناها حرفيًّا لجاءت النتيجة كالآتي: "ولي أن أستشهدَ بمحمّدٍ العظيم إذ قال: ’لو انقلبَتْ عليَّ الشمسُ والقمر، ما تراجعتُ عن أفكاري‘." لقد توقَّعتُ أن أجد حديثًا نبويًّا بهذا المعنى، واستغرقتُ في البحث، فلم أجدْ شيئًا. وعند ذاك بدأتُ في سؤال الأصدقاء الأوسع اطّلاعًا على الأحاديث النبويّة، حتى أرشدوني إلى المقطع الآتي من الحديث النبويّ: "واللهِ لَو وَضعوا الشَّمسَ في يميني، والقمرَ في شمالِي، على أن أتركَ هذا الأمرَ حتَّى يُظْهرَه اللهُ أو أهلِكَ فيه، ما تركتُه."
ربما كان تقصيرًا من جانبي أنّني لم أعرف الحديثَ المقصودَ فور قراءة الاستشهاد المذكور. ولعلَّ الكلامَ على حصيلة المترجِم المعرفيّة وقدراتِه البحثيّة من الأهمية بحيث يستحقّ أن تُفرَدَ له مقالاتٌ ومقالات. في هذه الحالة تحديدًا، لم أتوصَّلْ إلى المصدر الذي استقى منه المُؤلِّفُ هذا الحديث. ربّما قرأه مترجَمًا إلى الفرنسيّة أو الإنجليزيّة، ثم أعاد صياغتَه من الذاكرة باللغة البرتغاليّة، الأمرُ الذي أدّى إلى تغيير المعنى على النحو الذي رأيناه.
وعلى كلّ حال، أستنتجُ من المثالَيْن السابقَيْن ضرورةَ الحفاظ على النصّ الأصليّ، مهما اقتضى ذلك من البحث والتقصّي. وأرى من واجب المترجم أن يوازن بين احترام الكاتب الذي يَنقل عنه، باعتباره ضيفًا على لغة المترجم، ومراعاةِ القارئ، بوصفه مضيفًا. فلو اعتبرنا اللغةَ موطنًا وبيتًا، لوجب احترامُ أهل البيت والوافدين إليه.
مدريد
***

معاوية عبد المجيد: حقوق المترجِم وأجوره
شهدت الآونةُ الأخيرةُ تضخُّمًا ملحوظًا في سوق النشر العربيّة. ويُعزى السببُ إلى بلوغ كثيرٍ من الدُّور العربيّة سنَّ النضج، وإلى دخولِ دُورٍ ناشئةٍ على الخطّ؛ إضافةً إلى تخصيص بعض الدول ميزانيّاتٍ كبيرةً لدعم الثقافة، عبر فعاليّاتٍ وأنشطةٍ وجوائزَ، نال الجانبُ الأدبيُّ منها نصيبَ الأسد. فمن المعروف أنّ الكتبَ الأدبيّة تثير شغفَ القرّاء، الذين انفتحوا على العالم بفضل نوافذ الإنترنت المتعدّدة، وأقبلوا على مواكبة الأذواق الروائيّة العالميّة، فازداد الطلبُ على ترجمة الروايات الأجنبيّة إلى اللغة العربيّة.
غير أنّ الناشرين العرب وجدوا أنفسَهم في مأزقٍ حيال المهمّة الصعبة. فاللغات الأجنبيّة كثيرة، وآدابُها عريقة، فضلًا عن عدد الأدباء الهائل الذين ينبغي نقلُ نتاجهم إلى لغتنا. ناهيك بأنّهم – أي الناشرين العرب – صُدِموا بمعطًى جديدٍ لم يكن مطروحًا في السابق، هو حقوقُ الملْكيّة الفكريّة: إذ ينبغي التواصلُ مع الوكلاء الأجانب ودُور النشر الأجنبيّة لنيل الأحقّيّة في ترجمة روايات أولئك الأدباء إلى العربيّة. لذا اشتدّ التنافسُ بين الناشرين العرب، الأمرُ الذي ولّدَ جانبًا إيجابيًّا في طبيعة الحال، لكنّه فَرَضَ جوانب سلبيّةً، طبيعيّةً أيضًا، وأدّى بالضرورة إلى اصطلاح كلمة "سوق" على ذلك العمل الثقافيّ.
وفي هذه السوق، برز دَوْرٌ جديدٌ للمترجِم العربيّ، الذي لم يكن يَحترف الترجمةَ في الماضي، بمعنى أنّه لا يعوِّل عليها كلّيًّا لكسب قوت يومه، وإنّما كان يعمل في مهنةٍ أخرى تؤمِّن له بحبوحةً تساعده على إفساح وقتٍ معيّنٍ لترجمة كتبٍ معيّنةٍ تنشرها الهيئاتُ الحكوميّةُ التابعة لوزارات الثقافة العربيّة في معظم الحالات. أمّا اليوم فأصبح يتعامل مع دُور نشرٍ خاصّةٍ، يملكها ناشرون لا موردَ اقتصاديًّا آخَر لهم سوى الدار؛ ما يَفرض عليهم الدأبَ المتواصلَ لإنجاح العمل وضمانِ ديمومته. ومن أجل هذا يوضَع عقدٌ ملزِمٌ، يوقِّع عليه الطرفان (الناشرُ والمترجِم)، وبموجبه تُرسَم آليّةُ التعاون وتُضمَن الحقوق.
لكنّ التساؤلات التي تنبري في أذهاننا هي: ما حصّةُ المترجم من تلك الحقوق؟ وما المقصود بحقوق المترجِم؟ وهل هي موجودةٌ أساسًا؟ وما الوسيلة إلى ترسيخ مفهوم الحقّ هذا؟ وما جدوى المطالبة به؟ هذه الأسئلة مشروعة بقدْرِ ما هي إشكاليّة. وتكاد لا تمرّ فترةٌ إلّا ونشهد على مناكفةٍ بين ناشرٍ ومترجمٍ يدّعيان كلاهما مظلوميّتَه، ويتضامن جمهورُ منصّات التواصل مع أحدهما دون الآخر. كما أنّ المسألة إشكاليّةٌ بالمعنى الأعمّ للكلمة: فهي أقربُ إلى علّةٍ تتكاثر حولها وجهاتُ النظر وتتباين فيها الآراء. والخير أنْ نَصِفَها بالمشكلة التي لا حلَّ لها... في المدى المنظور على الأقلّ.
تبدأ العلّة بالتشكُّل من سببٍ بسيط، وهو أنّ الطرفيْن كليْهما لا يفرِّقان ما بين حقوق المترجم وأجوره. فلنحلّلْ هذين المفهومين إذن. في البداية، لا خلاف على معنى كلمة "أجور." فالكلمة واضحة: هي أجورٌ، مادّيّة في طبيعة الحال. يتّفق الناشرُ والمترجمُ على مبلغٍ ماليٍّ محدّد، مقابل ترجمة كتابٍ مكوّنٍ من عددٍ معيّنٍ من الصفحات. يختلف مفهومُ "الصفحة" من ناشرٍ إلى آخر: فيَقصد بعضُهم الصفحةَ الأجنبيّةَ الواردةَ في النسخة الورقيّة للكتاب من القطع المتوسّط، بينما يقصد آخرون أنّها الصفحة العربيّة المكوّنة من 350 كلمة أو 300 كلمة أو ما شابه. فكما نرى هنا، أدخلنا أنفسَنا في متاهةٍ من صنع أيدينا قبل أن نخوض المتاهةَ المفروضة علينا: مَن الذي وضع هذه التصنيفات؟ مَن الذي حدّدها؟ وماذا تعني كلمة "كلمة" في هذا السياق؟ فنحن نعلم أنّ الترجمان المحلَّف يتقاضى أجرًا كبيرًا نسبيًّا على ترجمة كلماتٍ قليلةٍ في بعض الأحيان (ترجمة بطاقة شخصيّة: اسم الأب، تاريخ الميلاد، تاريخ الإصدار...إلخ)؛ قليلة وسهلة كذلك، ومن المضحك أن نقارنَها بروايةٍ لجيْمس جويْس مثلًا، حيث يتعيّن على المترجِم الرجوعُ إلى أكثر من قاموس، والتذلّلُ أمام أكثر من دراسةٍ نقديّة، وهدْرِ أكثر من ساعةٍ في تصفُّح التاريخ والجغرافيا والفنون والميثولوجيا، في سبيل ترجمة كلمةٍ "واحدة" مرّت على لسان إحدى الشخصيّات. وعليه، فإنّ ما يتقاضاه المترجمُ الأدبيُّ على الصفحة، أيًّا كان الأجرُ وعددُ الكلمات، هو ضئيلٌ جدًّا بالمقارنة مع الجهود المبذولة وأجور مترجمين في مجالاتٍ أخرى.
وفي المقابل، يبرِّر الناشرُ الأمرَ بأنّه إذا صَرف للمترجم ما يستحقُّه فعلًا، على ترجمة روايةٍ لا تقلُّ عن مئة ألف كلمة في العادة، فسوف يعلن إفلاسَه لا محالة ويغلق الدارَ عاجلًا وينصرف عن مهنة النشر إلى غيرها. وهذا ما لا نريدُه، لأنّ دخول الدُّور الخاصّة أحدث نقلةً نوعيّةً لا يُستهان بها.
ننتقل الآن إلى المفهوم الثاني: الحقوق. لهذه الكلمة أكثرُ من وجه، بخلاف الأجور التي لا تعبِّر إلّا عن وجهٍ واحدٍ كما رأينا. فإذا كان الأجرُ مادّيًّا، فإنّ حقوقَ المترجم مادّيّةٌ ومعنويّةٌ معًا. فأمّا المعنويّة فتتلخّص في عالمنا العربيّ في ناحيتيْن:
- الأولى، وضْع اسم المترجِم على الغلاف. يتفرّد العربُ في هذا التقليد الذي يُعَدُّ إجلالًا للمترجِم، وقد توارثوه عبر أجيالٍ تتلمذتْ على أيدي علماءَ كبارٍ مارسوا الترجمةَ فأثْروا الحضارةَ العربيّة ووسّعوا نطاقَ الفكر وأسّسوا مكتبةً تراثيّةً ضخمة. والحقّ أنّ كثيرًا من الدُّور الأجنبيّة تحفظ اسمَ المترجم على الغلاف الخارجيّ هي أيضًا، إلّا أنّ الدُّور التي تكتفي بذكره في الصفحة الداخليّة أكثرُ عددًا. وهذا ما يمنح المترجمَ العربيَّ مكانةً معنويّةً كبيرةً في الاعتراف بدَوْره وجهوده في نقل عملٍ بعينه. ومع ذلك نجد بعضًا من الدُّور العربيّة اليوم تنحو إلى إغفال اسم المترجم عن الغلاف، ولا بدّ أنّ لها مبرّراتِها التي من السخف أن تنحصرَ بتقليد الأجانب في كلِّ ما يفعلون لمجرّد اعتبارهم "متقدّمين"؛ فهذا إحساسٌ بالنقص والدونيّة، عسى أن يتوقّفَ فورًا لكي نحافظَ على ما تبقّى لنا من تقاليدَ حميدةٍ لا تضرّ أحدًا. إذ إنّ هذا الاعتراف المعنويّ، على سذاجته، يرفع معنويّاتِ المترجم، ويمدّه بالشجاعة للاستمرار.
- أمّا الناحية الثانية فهي النُّسَخ التي يخصّصها الناشرُ للمترجم، فهذه لا تتجاوز العَشْر في أحسن الأحوال، وبعضُ الناشرين يشترطون في العقْد أنّ المترجم إذا ما أراد نسخًا إضافيّة فعليه أن يشتريَها، بسعرٍ مخفّضٍ طبعًا. لكنّ في الأمر إهانةً كما أرى. هل تعرفون مترجمًا لا يرى في هذا الأمر إهانةً؟
نأتي على الحقوق المادّيّة، وهي لبُّ القضيّة وأشدُّ تجلّياتها تعقيدًا وإشكاليّة. ينصّ العقدُ المبرَمُ بين الناشر والمترجِم عادةً على أن يتنازلَ المترجِم عن ترجمته تنازلًا نهائيًّا. لا يحقّ للمترجم أن يتصرّف بترجمته بعد أن يسلّمها الناشرَ، في حين أنّ الأخير يحقُّ له أن يتصرّفَ بها كما يشاء لأنّه اشتراها وأصبحتْ ملْكَه: قد يضعها في الدُّرج، أو يهملها، أو يبيعها، أو يؤجَّرها، أو يرهنُها، من دون الرجوع إليك، والأخذِ باستشارتك، أو احترامِ رغبتك في بيع ترجمتك إلى ناشرٍ قد لا تفضّل اقترانَ اسمك بداره! وذلك كلُّه بموجب العقد الذي يضفي الطابعَ القانونيَّ والشرعيَّ على المسألة.
ومن جهةٍ أخرى، قد يحدث أنّ ترجمةَ روايةٍ مّا تصبح غيرَ قانونيّةٍ فجأةً، لأنّ الناشر الجديد الذي اشترى حقوقَ المؤلّف ثانيةً كلّف مترجمًا آخرَ بالعمل على ترجمةٍ جديدةٍ للرواية نفسها. وهكذا تُسحَب الترجمةُ القديمةُ من السوق، ويضيع استحقاقُ مترجمها بوصفه سبّاقًا لنقلها إلى العربيّة. ثمّ إنّ التعاون يغدو محضَ عمليّة بيعٍ وشراء. ومَن قال إنّ الترجمة حِرْفةٌ ما ظلم، لكنّنا نظلم أنفسَنا إذا اعتبرنا صنيعَنا مجرّدَ قطعة أثاثٍ نبيعها لكم وينتهي كلُّ شيء! فالمترجِم يقدّم قطعةً من روحه في كلّ ترجمةٍ يؤدّيها، ولا يجوز أن يتنازلَ عنها بجرّة قلم. وعليه، فإنّ المترجم يتقاضى أجرًا ولكنْ لا حقوقَ له. أو أنّه، بعبارةٍ أخرى، يبيع حقوقَه ضمن الأجر الذي يحصل عليه، وهذا يعني أنّ الأجور منقوصة.
اسمحوا لي أن أضرب مثلًا خياليًّا بعضَ الشيء: تصوَّرْ لو كنتَ مترجمًا أمريكيًّا وكلّفكَ ناشرٌ بترجمة كتاب مقابل أجرٍ مادّيّ مغرٍ، لتتفاجأ بعد الإنجاز أنّكَ ترجمتَ روايةً من عيار مئة عام من العزلة سيُباع منها ما يزيد على عشرين مليون نسخة. فتصوّرْ وضعَكَ لو أنّك استغنيتَ عن الأجر واشترطتَ الحصولَ على نسبةٍ من الأرباح!
ولكنْ، ليست كلُّ الروايات كتلك. وإنّ في اقتصار النظر إلى الموضوع من هذه الزاوية مغامرةً وخيمةَ العواقب على جودة العمل وأخلاقيّاته المطلوبة، رغمًا عن أنفِ مَن أطلق تسمية "السوق" على هذا الميدان الثقافيّ. كما أنّ للناشر حُجّتَه ووجهةَ نظره المختلفة: فهو يرى أنّ شراءَ حقوق المؤلّف الأجنبيّ مكلفٌ جدًّا، ويضطرّه إلى تجديد العقد كلّما انتهت مدّتُه، وبذلك يدفع المترجِمون الثمنَ وتُهضَم حقوقُهم على حساب حقوق المؤلّف. سوى أنّ الناشر في هذا التبرير يتناسى أمرَ الكتب الذي توفّي مؤلّفوها منذ سبعين عامًا وسقطتْ حقوقُهم بموجب القانون: لا كلفة مفروضة على الناشر هنا، فما الذي يُجبر المترجِمَ على أن يتنازل عن ترجمته تنازلًا نهائيًّا؟ فتأتي الحُجّة الثانية، وهي أنّه ليس كلُّ مترجمٍ بارعًا، إذ يضطرّ الناشرُ كثيرًا إلى تكليف مراجعين ومدقِّقين ومحرِّرين للوصول إلى نصٍّ عربيّ مستساغ -- وهذه تكاليفُ باهظةٌ لا يمكن أن تغطّيَها، بشكل كامل، السوقُ العربيّةُ الفقيرةُ والمغيَّبةُ عن ثقافة شراء الكتب. ناهيك بالإعداد، والإخراج، والشحن، والتوزيع، والترويج، والتسويق، والمشاركة في المعارض، والقرصنة، والتزوير، وابتزاز باعة الكتب، وازدياد المنافسة والمزاحمة في هذا الحقل الصعب أساسًا. فما يبدو ازدهارًا للترجمة والنشر ظاهريًّا قد يكون تضخُّمًا أجوفَ يهدِّد بالانفجار في أيّ لحظة، ومن ثمّ انهيار السوق وملحقاتها انهيارًا شاملًا.
وأخيرًا، كان هذا جزءًا يسيرًا من استعراض العلّة والجدل المتواصل بين فاعليها. لن ينتهي الحديث في هذا الموضوع، وربّما لن نصل في المستقبل القريب إلى مجرّد توافقٍ في الرؤى بين الأطراف. فالحلول المنصفة تحتاج إلى تشاورٍ واسعِ النطاق قبل تنفيذها، وهي محضُ تصوّرات لبناء أسسٍ جديدةٍ لسنا متأكّدين من فاعليّتها، وربّما تكون مجديةً إذا توافرت النيّةُ لتطبيقها بموضوعيّةٍ لا تبخس الناشرَ حقّه ولا تغبن المترجِمَ جهدَه. وأرجو أن أكونَ في كلمتي هذه قد أطلعتُ المتابعين على جانبٍ من مشاكلِ عملنا، وأثرْتُ نقطةً للنقاش في موضوعٍ إشكاليٍّ يستحقّ التركيز عليه. كما أودّ أن أشكر أسرةَ مجلّة الآداب ودار الآداب، التي نكنُّ لها فائق الاحترام والتقدير، على رحابة الصدر والجرأة في إتاحة الفرصة للتحدّث بمواضيعَ إشكاليّةٍ من هذا النوع.
فرنسا