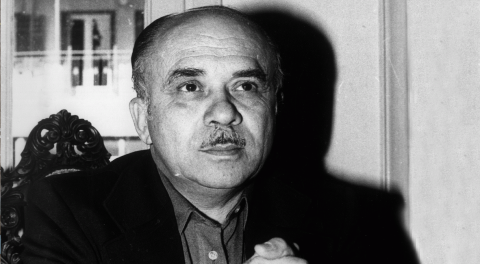باحث في الفلسفة السياسيّة والأخلاقيّة، تونس.

مقدّمة
تحاول المؤسّسات التي تُنظّم العمليّةَ التعليميّة في أغلب المجتمعات إظهارَ نفسها في ثياب "الاستقلال عن كلّ الإيديولوجيّات،" وتنفي عن نفسها أداءَ أيّ دورٍ اجتماعيّ غير "نشر المعرفة"؛ كما تَرفع شعاراتِ "الحياد" و"الموضوعيّة" و"الاستقلاليّة" لتكريس هذه "الحقيقة" التي يبدو أنّها تروق للطبقة المُهيمنة (لأنّها بذلك تُعيد إنتاجَ هيمنتها) وتلقى قبولَ بقيّة الطبقات.
وفي حين سعت البيروقراطيّةُ التي تُدير هذه المؤسّسات إلى فرض تصوّرها المثاليّ عن التعليم بكلِّ ما لها من دهاءٍ مُكتسبٍ عبر التاريخ، حاول العديد من المفكّرين إنزالَ التعليم من عالم المُثل إلى مدار المُجتمع البشريّ، المحكومِ بالصراع والربح والاحتكار وتقسيمِ العمل، وبجملة الأفكار التي تُشرِّع هذا الواقعَ أو تحاول نقدَه وتجاوزَه. وعلى الرغم من أنّ مقالتنا ليست بحثًا نظريًّا، بل محاولة لرصد مُستقبلٍ مُمكنٍ للتعليم في تونس، من خلال استقراء واقعه الحاليّ، فإنّها تستوجب استحضارَ أهمّ الأفكار الفلسفيّة والسوسيولوجيّة التي وضعت التعليمَ في شكله القائم محلَّ مُساءلة.
التعليم والحياد المزعوم
"كان التعليم، في كلّ حقبة، مرتبطًا بالمؤسّسات الأخرى للجسم الاجتماعيّ، بالأعراف والمعتقدات، بتيّارات الأفكار الكُبرى."(1)
ولا شكّ في أنّ الحدّ الأدنى من التدقيق السوسيولوجيّ سيُحيلنا على فهم المؤسّسات التعليميّة في إطار ارتباطها العضوي بالسلطة. ولا أقصد هنا السلطة السياسيّة وحسب، بل كلّ سُلطة مُمكنة في الفضاء الاجتماعيّ أيضًا؛ فالكائن الاجتماعيّ المُشكِّل للمؤسَّسة خاضعٌ، في نهاية المطاف، لمجموعةِ إكراهاتٍ اقتصاديّة وثقافيّة واجتماعيّة ـــــ وهي تُشكّل، في تقديرنا، أنواعًا مُختلفةً من السلطة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المؤسّسات التربويّة حاملةٌ لمُركَّباتٍ بشريّة، ومن ثمّ لعلائقَ ذاتيّة. وعليه، فإنّ كلّ خطابٍ يُبنى على أساس تجريد الفرد في المؤسّسة من كلّ طابعٍ ذاتيّ وإنسانيّ اجتماعيّ إنّما هو يسعى إلى إسقاط فهم لغويّ خطابيّ على واقعٍ ليس محكومًا باللغة وحدها. ولتجاوز هذه المعوِّقات التجريديّة وجب علينا أن نُقوّضَ الفهمَ الماهويّ (2)،ونستعيضَ منه بتشريح ممارسة المؤسّسة في لحظاتها التاريخيّة التي تعتبرها هي نفسُها مُهمّةً، وتُجنِّدُ لها كلَّ أعوانها لتحقيق غاياتٍ تَظهر للوهلة الأولى موضوعيّةً وعلميّةً.

أمّا الحدث الأهمّ في تاريخ المؤسّسات التعليميّة فهو الامتحان؛ ذلك أنّه مُبرِّرُ قيامها وحُجّة جداوها، وهو الذي يُعطيها هيبتَها ومكانتَها. وحيث يُخفق الاختبارُ في تقويم الطلّاب (بالنظر إلى المعايير التي يعتمدها) فإنّه ينجح في نزع الغطاء عن الزعم القائل بـ"حياد التعليم ومؤسَّساته." ولعلّ اختبارَ اللغة العربيّة في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعداديّة النموذجيّة (3) لدورة العام الحاليّ في تونس، وفي جزئه الخاصّ بالتعبير الكتابيّ، يقدِّم لنا خيرَ مثال على ارتباط التعليم بمجموع المؤسّسات الاجتماعيّة الأخرى وبإرادة السلطة السياسيّة ورؤيتها الاقتصاديّة. فقد جاء فيه:
"أتمَّ أحدُ إخوتك الدراسةَ بنجاح، وبدأ يبحث عن عمل في إحدى الإدارات، فحاول والداكَ إقناعَه ببعث مشروع. لكنّه أبدى تخوّفًا من الصعوبات ومن الفشل. أَنتِجْ نصًّا تسرد فيه ما حصل، مُدرِجًا الحوارَ الذي دار بين أفراد العائلة، مُبيِّنًا أثرَه في موقف أخيك."
المعلوم أنّ اختبار اللغة العربيّة مهمّ من أجل تأمين مُعدَّلٍ يُمكِّن التلميذَ من ولوج مصاف "النموذجيين." ونظرًا إلى دور النموذجيين المُستقبليّ في وصفهم جزءًا من البيروقراطيّة العلميّة الخادمة للسلطة، فإنّ السلطة تحرص على أن تأتي إجابةُ الطفل متطابقةً مع تصوّرها للعلاقات الاقتصاديّة داخل المجتمع لناحية التخفيض في كتلة الأجور، والتشجيع على الاستثمارات الخاصّة. وتُبَثّ هذه التصوّرات في سياقٍ منهجيٍّ تقويميّ، يُقصي مَن فضّل النقاشَ لصالح فكرة مواصلة "البحث عن عملٍ في إحدى الإدارات" وتحرمه طقوسَ "التعميد" في كنيسة النموذج (4).
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ السلطة في هذا المثال تحرص على تنبيه الناجحين إلى ضرورة تجاوز فكرة "العمل في مؤسّسات الدولة،" وتُبلغهم ضمنيًّا أنّ مُستقبلَهم لا يُبنى إلّا من خلال إنشاء مشاريعهم الخاصّة.
مؤسّسات التعليم في تونس والأرقام
الأرقام ليست محايدة، بل تعبيرٌ عن واقع غير محايد، وبخاصّةٍ عندما يتعلّق الأمرُ بفهم نشاطٍ كالتعليم؛ إذ يمكن استعمالُ الأرقام لاستخراج استنتاجات تَخدم إستراتيجيّاتِ الدولة. ولهذا الغرض سنُركّز على الأرقام الخاصّة بمؤسّسات التعليم الابتدائيّ والإعداديّ والثانويّ، لأهمّيّة هذه المراحل في بلورة النموذج الذي يُراد له الهيمنة، ولأدوارها في صقل عقل الأطفال، ومِن ورائهم الشباب.
خلال السنة الدراسيّة المُنصرمة (2016 ــــ 2017)، شهدت المؤسّساتُ الخاصّة للتعليم الابتدائيّ ارتفاعًا مُهمًّا عن السنة التي سبقتْها (77 مؤسّسة)، خلافًا للمؤسّسات العموميّة التي تراجعتْ سبعًا. وعلى الرغم من أنّ وزارة التربية لم تذكُرْ في تقاريرها أسبابَ الغلق، فإنّ غالبيّة التونسيين تعرف، من خلال التقارير الصحافيّة، مشاكلَ المؤسّسات العموميّة، وأبرزُها: البنيةُ التحتيّة المهترئة (بعضُ المدارس سقطتْ سقوفُها)، والنقصُ الكبيرُ في طاقم المؤسّسات (بعض المدارسُ لا مدراء فيها ولا معلّمين).
وعلى الرغم من ارتفاع العدد الجُمليّ لتلاميذ المراحل الابتدائيّة والإعداديّة والثانويّة من 2130660 خلال 2015 ــــ 2016 إلى 2143100 خلال 2016 ــــ2017، فإنّ عدد تلاميذ المؤسّسات العموميّة تراجع من 2011641 إلى 1995095 بين السنتين المذكورتين؛ في حين واصلت المؤسّساتُ الخاصّة استقطابَ التلاميذ (من 119019 إلى 138005). فكيف السبيلُ إلى فهم هذه الأرقام بطريقةٍ تُفسِّر واقعَ التعليم واستراتيجيّات السلطة؟
لا شكّ في أنّ حاجة النظام، بعد الاستعمار المباشر، إلى كوادر تَحلّ مكانَ المُعمّرين في صلب جهاز الدولة جعلتْه يتّخذ القرارَ بتوسيع دائرة المتعلّمين. ولمّا لم يكُن من سبيل، في ذلك الحين، إلى حلّ هذا النقص إلّا بإيجاد مؤسّسات تعليمٍ عموميّة تُقدِّم خدماتٍ مجّانيّةً لعموم المواطنين، فقد مثّلت المدرسةُ "مصعدًا اجتماعيًّا،" بحيث يجد المتعلّمُ نفسَه في وضعٍ اجتماعيّ مريح نسبيًّا مقارنةً بمن لم يدخل المدرسة. ولهذا السبب أساسًا دأب التونسيون على إرسال أبنائهم إلى المدرسة. ولكنْ، بعد عقودٍ من تعميم التعليم، حقّقت الدولةُ اكتفاءها من الكوادر، ولم يعد القطاعُ العموميّ قادرًا على استيعاب الحشود الغفيرة التي تتخرّج من المدارس والجامعات في كلّ عام، ولكنّه لم يستطع التخلّي عن المدارس العموميّة لعدّة أسباب، أهمُّها: الإلزامُ القانونيّ بالتعليم حتّى السادسة عشرة، وعدمُ وجود ما يكفي من المدارس الخاصّة لكي تقوم مقامَ المدارس العموميّة، والوضعُ الاقتصاديّ المُزري لأغلب فئات الشعب التونسيّ (ما يعني عجزَها عن دفع رسوم المؤسّسات الخاصّة).
من هنا العددُ الضخمُ لتلاميذ المؤسّسات العموميّة؛ وهو ما يُمثّل اليومَ عائقًا أمام سياسات الحكومة الرامية إلى لَبْرَلَةِ التعليم. ولكنّ تراجعَ هذا الرقم خلال السنوات الفارطة هو نتيجةٌ مباشرةٌ لهذه السياسات، إذ يسعى النظامُ القائم إلى:
ــــ منح المؤسّسات الخاصّة أكبرَ عددٍ ممكنٍ من التراخيص.
ــــ عدم سدّ الشغور في المؤسّسات العموميّة، وهو شغورٌ نجم بشكلٍ رئيسٍ عن تقاعد الكثير من الأساتذة والموظّفين.
ــــ المحافظة على ميزانيّة متدنّية للوزارات ذات العلاقة بسلك التعليم.
ــــ تكريس سياسة الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ (وهي تعني ضمنيًّا رفعَ يد الدولة عن كلّ مشاريع الاستثمار في التعليم ومنحَها إلى "شركاء" من القطاع الخاصّ).
بالإضافة إلى النقاط التي ذكرناها فإنّ المؤسّسات الخاصّة ليست بلا دور في هذه الاستراتيجيّة، بل يتركّز دورُها على إقناع التونسيين بـ"فشل منظومة التعليم العموميّة" و"نجاح منظومة المؤسّسات الخاصّة"؛ ذلك لأنّ الأخيرة، بحسب قولها، توفِّر بنيةً تحتيّةً جيّدة، ولا تُعاني أقسامُها اكتظاظًا، وتعتمد على التكنولوجيّات الحديثة (بعضُ المدارس الخاصّة تفرض على التلاميذ شراءَ ألواح رقميّة للتعلّم). هكذا بدأتْ فكرة "أفضليّة التعليم الخاصّ على العموميّ" تنتشر كالنار في الهشيم في الأوساط الميسورة نسبيًّا. بل اخترقتْ هذه الفكرةُ أيضًا الأوساطَ الأكثرَ شعبيّةً، التي ما زالت تعتبر المدرسة مصعدًا اجتماعيًّا وترى تعليمَ الأبناء استثمارًا في المستقبل.

التعليم ومخاطر اللَبْرَلَة
استنادًا إلى ما تقدّم، فإنّ سياسة الدولة التعليميّة تعتمد لبرلةَ التعليم من خلال لبرلة المناهج ولبرلة المؤسّسات. والواقع أنّ المنحى الأوّل يَخدم الثاني لأنّه يثبِّت مقولةَ "أفضليّة التعليم الخاصّ على العموميّ،" لتتحوّل هذه المقولةُ إلى جزءٍ من وعي تلميذ الحاضر ومُواطن المستقبل. وإذا نجحت السلطة في استراتيجيّتها هذه فستنجح في ضمان هيمنتها الفكريّة خلال عقود قليلة، وستنجح في إنهاء التعليم العموميّ وكلّ مؤسساته، ليتحوّل مجالُ المعرفة إلى سوقٍ مفتوحة للاستثمار.
لكنْ أين يكمن خطرُ هذه الاستراتيجيّة إنْ هي ساعدتْ على خفض نفقات الدولة، وتحسينِ جودة التعليم بمقاييس البنية التحتيّة والإمكانات البيداغوجيّة؟
لتحسُّس خطر هذه الاستراتيجيّة، علينا فهمُ التراتبيّة التي تبنيها مؤسّساتُ التعليم داخلها وخارجها وما بينها؛ وهي تراتبيّةٌ تُقوِّم بها "أفضلَ" التلاميذ و"أسوأَهم،" وتُحدِّد من خلالها المسارَ الذي على كلّ تلميذ أن يسلكَه. وهي تقوم عادةً بتوجيه "النُجباء" إلى شُعَبٍ علميّة، تنتهي بالتوظيف في إحدى المهن ذاتِ القيمة الرمزيّة والاجتماعيّة العالية، مثل الطبّ والهندسة والصيدلة؛ بينما توجِّه الأقلَّ رتبةً ومعدّلًا (وهم الأغلبيّة) إلى شُعَبٍ أخرى لا تدُرّ على المنتسبين إليها غيرَ البطالة.
ومن ثمّ فإنّ تراتبيّة المدرسة لا تبقى داخل المدرسة، بل تنعكس بشكلٍ جليّ على التراتبيّة الاجتماعيّة برمّتها، فتُحدّد لكلّ فردٍ موقعَه داخل هرم مجتمع المنفعة. وفضلًا عن ذلك، فإنّ المؤسّسات المذكورة لا تُصنِّف التلاميذَ فحسب، بل تصنِّف نفسَها أيضًا، إذ تَخلق ــــ بحسب معاييرَ تُحدِّدها بنفسها ــــ ترتيبًا لـ"أفضل" المؤسّسات و"أسوإها." وعليه، يكون الدخولُ إلى مؤسّسةٍ تحتلّ موقعًا متقدّمًا في هذا الترتيب بمثابة ورقةٍ في يد الداخل إليها تُمكّنه من تحقيق موقعٍ أفضل مُسبّقًا في ترتيب الأفراد.
وإذا سحبنا هذا الأمرَ على تعليمٍ مخصخصٍ بشكل تامّ، فإنّ رأسَ المال سيؤدّي دورًا مُهمًّا في لعبة الترتيب هذه، إذ ستَطلب المدارسُ صاحبةُ الترتيبِ الأفضلِ رسومًا أعلى على الراغبين في دخولها. وهذا لا يعني إلّا تمكينَ أبناء الفئات المرفَّهة من تعليمٍ يَضمن مكانتَهم داخل تراتبيّة المجتمع، وجعْلَ أبناء الفئات المُهمَّشة يحاربون من أجل دخول أيّ مدرسةٍ كانت، فقط لكي يَضمنوا لأنفسهم موقعًا داخل السلّم المدرسيّ، ومن ثمّ الهرمِ الاجتماعيّ.
وهذا يعني، في المحصّلة، وجودَ تعليمٍ يعيد إنتاجَ النظام الاجتماعيّ القائم، ويورِّث المكانات: كلٌّ بحسب ما يملك والداه. وهذا ما يَضرب، بشكلٍ فاضح، مبدأ المساواة الذي تقوم عليه المواطَنة.
ولكنّ هذا ليس كلَّ شيء: فلبرلةُ التعليم، وسجنُه في زنازين الربح والمنفعة، سيُحدثان شرخًا عميقًا في وعي التلاميذ، فيحوّلون ــــ هم بدورهم ــــ علاقتَهم بالمعرفة إلى عمليّة حسابيّة تقوم على منطق الربح والخسارة. فإذا ما أدرك التلميذُ الترتيبَ المتدنّي للمؤسّسة التي ينتمي إليها، ووجد أنّ ترتيبَه الشخصيّ داخلها لن يمكّنه مُستقبلًا من استرجاع رأس المال الذي يستثمره والداه في تعليمه ومن تحقيق فائضِ ربح، فإنّه سيختار الانسحابَ من مجال هذا الصراع ليبحثَ عن استثمارٍ آخر يدرّ عليه ربحًا أكبر. وبهذا قد نجد مئاتِ الآلاف من التلاميذ لم يكادوا يتمّون تعليمَهم الثانويّ... هذا طبعًا إذا افترضنا أنّ الدولة حريصةٌ فعلًا على تطبيق قانون إجباريّة التعليم إلى حدود سنّ السادسة عشرة، مع أنّ واقع الانقطاع المدرسيّ يُنبئ بغير ذلك.
خاتمة
حاولنا خلال هذا المقال تشريحَ استراتيجيّة السلطة التونسيّة في ما يخصّ التعليم من خلال اعتماد فهمٍ يمزج بين تاريخيّة المؤسّسة في تونس، وأفعاِلها في الحاضر. وعلى الرغم من قصورنا عن تقديم بديل لإستراتيجيّة السُلطة، فإنّ محاولتنا جاءت في إطار مُساءلة مستقبل التعليم في تونس ورؤية السلطة. وبالنظر إلى استنتاجاتنا نتساءل إنْ كانت هناك نيّةٌ فعليّةٌ في تونس لبناء مُجتمعٍ يقوم على المعرفة؛ أمْ أنّ سياسة التقشّف أتت على الأخضر واليابس، فحوّلت المعرفةَ إلى مجالٍ للسمسرة وحالت دون تعميمها؟
كم سيَخسر المجتمعُ التونسيّ، من عالم وطبيب ومحامٍ ومهندس ومفكّر وشاعر وكاتب، قبل أن تعي السلطةُ أنّ استراتيجية إعادة إنتاج النظام الاجتماعيّ عبر تعليمٍ مدفوعِ الثمن هي خطأٌ تاريخيّ وكبحٌ لإمكانيات تطوّر المجتمع؟ أم أنّ أرباب السلطة لا همّ لهم غير الحفاظ على مكانتهم وتوريثها لأبنائهم، وإنْ كان الثمن هو التجهيل المُمنهج على المدى البعيد؟
تونس
[1] Emile Durkheim, cité par Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction: éléments pour une théorie du système d’enseignement, Les éditions de minuit, Paris, 1970, p 232.
[2] المقصود بالفهم الماهويّ هنا: التحليل الذي يُحدّد فهم جوهر الأشياء كغاية نهائيّة له.
[3] تنقسم مراحل التعليم في تونس إلى أربع: الابتدائيّ (6 سنوات)، الإعداديّ (3 سنوات)، الثانويّ (4 سنوات)، العالي (3 سنوات لتحصيل الإجازة، سنتان لتحصيل الماجستير، 3 سنوات لتحصيل الدكتوراه). وتنقسم مؤسّساتُ الإعداديّ والثانويّ إلى نموذجيّة (يدخلها التلاميذُ من خلال اجتياز مناظرات وطنيّة)، وعاديّة (يدخلها مَن لم ينجحْ في هذه المناظرات أو نجح فيها ولكنّه لم يحقق المُعدّلَ المطلوب).
[4] هذا التشبيه مُقتبس من كارل ماركس: "الاختبار ليس غيرَ التعميد البيروقراطيّ للمعرفة؛ الاعتراف الرسميّ بتحوّل المعرفة جوهريًّا من دنِسةٍ إلى مقدّسة." [ترجمة الكاتب]. وارد في:
Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction: éléments pour une théorie du système d’enseignement, Les éditions de minuit, Paris, 1970, p 168.
باحث في الفلسفة السياسيّة والأخلاقيّة، تونس.