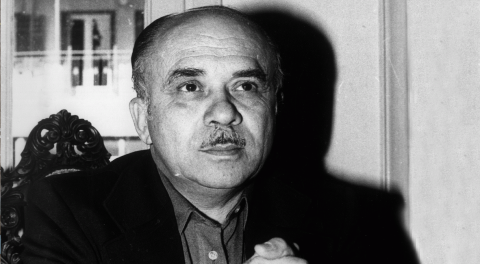حقوقيّ عربيّ، ومحامٍ في المملكة المتحدة. حاز البكالوريوس في الفلسفة والعلوم السياسيّة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، إلى جانب شهادة عليا في القانون من جامعة لندن.

لقد أمست الحربُ مَعْلمًا معتادًا من معالم النظام الدوليّ الحديث. وهي لم تعُد محصورةً في حدودٍ زمنيّةٍ أو جغرافيّةٍ واضحة، بل تَوسَّعَ نطاقُها منذ تسعينيّات القرن الماضي - ولا سيّما بعد أحداث 11 أيلول 2001 - لتُصبحَ حالةً شبهَ دائمةٍ وعابرةً للحدود المعهودة: تشتعلُ حينًا، وتخمدُ حينًا، ولكنّها تبقى مخيّمةً على سمائنا في الحاليْن؛ قصفٌ متقطِعٌ في بلدانٍ متعدّدة، وحصاراتٌ جوّيّةٌ وبرّيّة، واغتيالاتٌ بواسطة الطائرات المسيَّرة وغيرها من آليّات حروب الظلّ الحديثة. فمع ازدهارِ خطاب "مكافحة الإرهاب،" وتبنّيه من قِبل جهاتٍ متنوّعةٍ ومتصارعة، امتدّتْ رقعةُ الحرب لتشملَ الداخلَ والخارجَ على حدٍّ سواء، ولتجعلَ من "أمْننةِ" مجتمعاتٍ بأكملها أمرًا طبيعيًّا، ولا سيّما في منطقتنا العربيّة التي دخلتْ في عين العاصفة.
تزامنتْ هذه الظاهرةُ مع بروزِ ظاهرةٍ أخرى، هي سطوةُ لغة "الإنسانيّة" في الخطاب الرسميّ المتعلّق بالحروب والسياسات الأمنيّة. والمقصود بذلك هو التركيزُ شبهُ الحصريّ على مسألة القانون الإنسانيّ الدوليّ ومتطلّباتِه في ما يتعلّق بالتمييز بين المقاتلين والمدنيّين، وتحديدِ أهدافٍ عسكريّةٍ مشروعة، وغيرِها من المبادئ التي يُفترض أن تَحْكمَ ممارساتِ الأطراف في الحروب والنزاعات المسلّحة. فكأنّ هذا الخطابَ حلّ مكانَ الجدال المبدئيّ المعهود حول "شرعيّة استخدام القوّة" أساسًا استنادًا إلى مفاهيم "العدوان" و"السيادةِ الوطنيّة" و"حقِّ تقرير المصير" وغيرِها من المفاهيم التي طغت على الصراعات الدوليّة في القرن العشرين، ولا سيّما مع صعود حركات التحرّر الوطنيّ ومشروعِ إعادة تكوين النظام الدوليّ بهدف مواجهة هيمنة القوى المستعمِرة الكبرى عليه. وليست منطقتُنا في منأًى عن هذه التطوّرات، إذ شهدت ازدهارَ خطابِ تأليهِ "الشرعيّة الدوليّة" والاتّكالِ على "حسن نوايا" القوى العظمى لتحقيق طموحات شعوبنا في التحرّر والحياة الكريمة.
تزامُنُ هاتيْن الظاهرتين - أيْ توسُّع نطاق الحرب وهيمنة خطاب "الإنسانيّة" في خوضها - يَطْرح تساؤلاتٍ مشروعةً عن وجودِ علاقةٍ بينهما. فهل التركيزُ على "أنسنة" الحروب يُشرِِّع حالةَ الحربِ ذاتها؟ ألن يُعيدَ إنتاجَ علاقات القوّة القائمة في النظام الدوليّ، لكون القوى العظمى هي التي تَمْلك القدراتِ العسكريّةَ المتطوّرةَ التي تسمح لها بالتلويح المتكرّر بـ"دقّة قصفها" و"اهتمامِها العميق" بإنسانيّة الحروب التي تخوضها؟
بصيغةٍ أخرى، هل يُمهِّد التركيزُ على "أنسنة" الحروبِ الطريقَ - بوعيٍ أو بغير وعيٍ - لحربٍ "إنسانيّةٍ" إلى درجةِ أنها ليست في حاجةٍ إلى الانتهاء، كما يتساءل صامويل موين، أستاذُ الحقوق والتاريخ في جامعة ييل الأميركيّة؟[1]

موين: هل يُمهِّد التركيزُ على "أنسنة" الحروبِ الطريقَ لحربٍ "إنسانيّةٍ" لا تحتاج إلى الانتهاء؟
القانون الدوليّ ساحةُ صراعٍ إيديولوجيّ وأخلاقيّ
للإجابة عن هذه التساؤلات، لا بدَّ من العودة إلى أسس القانون الدوليّ وأنظمتِه المتعدّدة المتعلّقة بالحرب واللجوءِ إلى القوّة.
من المفيد أن نتوقّف أوّلًا عند الناشطة الفلسطينيّة وأستاذةِ الحقوق في جامعة رَتْغِرز الأميركيّة، نورا عريْقات، وتحليلِها لمنظومة القانون الدوليّ بأكملها، وهو تحليلٌ ورد في كتابها، العدالة للبعض.[2]
تشير عريْقات إلى انحياز القانونِ الدوليّ، في جوهره، إلى الدول الاستعماريّة الكبرى على صعيديْن مترابطيْن:
- فمن حيث المضمون، ينحدر القانونُ الدوليّ من محاولات القوى الاستعماريّةِ الأوروبيّة، على مدى القرون الثلاثة الماضية، تنظيمَ علاقاتها وترسيخَ مواقعها ضمن المنظومة الهرميّة التي قامت بفضل توازن القوى في مراحلَ تاريخيّةٍ مختلفة.
- أمّا من حيث البنية، فيتّسم القانونُ الدوليّ الحديث بتفاوتٍ مروِّعٍ في قدرات التنفيذ والتطبيق. وهذا يسمح للقوى العظمى بتجاهل متطلّباتِه جهارًا، في حين أنّها تتعمّد فرضَ إرادتها على دول الجنوب العالميّ باسم القانون ذاته.
غير أنّ القانونَ الدوليّ يبقى ساحةَ صراعٍ حتميّةً في المواجهات الإيديولوجيّة والسياسيّة الدوليّةِ الحديثة. فما زال الجميعُ يلجأ إلى لغة "القانون" لتوفير الغطاء الشرعيّ لسياساته الداخليّة والخارجيّة، ولإعادة تكوين النظام الدوليّ على ضوء مبادئه السياسيّة والأخلاقيّة الخاصّة وتصوّراتِه للعدالة الدوليّة. فالقانون ليس كائنًا ثابتًا معزولًا عن عالم الصراعاتِ والخلافات الإيديولوجيّة، بل يتّسم بالتباسٍ حتميٍّ ناجمٍ عن صياغته العامّة وتداخُلِ أنظمته المتعدّدة وممارساتِ الدول المختلفة تجاهه.
هكذا يَظْهر القانونُ الدوليّ، في واقعه، بعيدًا كلَّ البعد عن نموذج المنظومة الأخلاقيّة الثابتة المتماسكة، والقابلة للتطبيق الحياديّ المستقلّ، من دون الغوص في إشكاليّاتٍ سياسيّةٍ وأخلاقيّةٍ شائكة. بل يبدو أقربَ إلى لوحةٍ فسيفسائيّةٍ متناقضة، خاضعةٍ لمحاولات أطرافٍ متنازعةٍ تعريفَها وتأويلَها وإعادةَ تشكيلها بما يناسب مصالحَها ومبادئَها الخاصّة.
نرى ذلك جليًّا حين نتمعّن في جهود حركات التحرّر الوطنيّ وإنجازاتِها في تشريع حقّ الشعوب في مقاومة الاستعمار والأنظمة العنصريّة. وهذا ما نراه في تمرير البروتوكول الأوّل لاتفاقيّات جنيف، وفي حملة مقاطعة نظام الفصل العنصريّ في جنوب أفريقيا. كما نراه في جهود الدول الغربيّة والحركة الصهيونيّة لإعادة تعريف القضيّة الفلسطينيّة بأنّها مجرّدُ صراعٍ حول الحدود الشرعيّة بين حركتيْن "وطنيّتيْن" متنازعتيْن، بدلًا من أن تكونَ قضيّةَ شعبٍ يواجه مشروعًا استعماريًّا إحلاليًّا.
حقُّ استخدام القوة والقانون الدوليّ الإنسانيّ
يَخضع "قانونُ الحرب" لنظاميْن قانونيّيْن متشابكيْن ومتكامليْن: أحكام حقّ استخدام القوة (jus ad bellum) والقانون الدوليّ الإنسانيّ (jus in bello).
يُعنى النظامُ الأوّلُ بتنظيم حقّ اللجوء إلى القوّة في العلاقات الدوليّة أساسًا، بينما يُعنى الثاني بتنظيم الحروب والنزاعاتِ المسلّحة من خلال أحكامٍ أساسيّة: كمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيّين، وحظرِ الأسلحةِ البيولوجيّة والكيميائيّة، وغيرِها من الالتزامات المتعلّقة بحماية حقوق الأفراد في ظلّ الحروب.
يستند "حقُّ استخدام القوّة" إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ويتمحور حول مفهوم "العدوان" الذي يشكّل الركنَ الأساسَ للنظام الدوليّ المولود من رحِم الحرب العالمية الثانية، علمًا أنّ جريمةَ العدوان وُصفتْ في محاكمة نورمبرغ بأنّها الجريمةُ الدوليّةُ الكبرى لكونها تحمل في طيّاتها مجملَ مآسي جرائم الحرب المتنوّعة. وتتضمّن المادّة 2(4) من الميثاق حظرًا واضحًا على استخدام القوّة (أو التهديد باستخدامها) في العلاقات الدوليّة، وتفرض على جميع أعضاء المنظّمة احترامَ مبادئ السيادة الوطنيّة والاستقلاليّة السياسيّة للدول الأعضاء. ووفق الفصل السابع من الميثاق، فإنّ مسؤوليّةَ تحديدِ وجود تهديدات للسلْم، أو أعمالٍ عدوانيّة، تقع على عاتق مجلس الأمن، الذي يحقّ له أن يتّخذَ التدابيرَ اللازمةَ للتصدّي لها إنْ وُجدتْ. إلّا أنّ المادّة 51 تتضمّن استثناءً لهذه القاعدة العامّة، إذ يحقُّ لدولةٍ ما (أو لعدّةِ دول) أن تلجأ إلى القوّة دفاعًا عن نفسها في حال تعرُّضها "لاعتداءٍ مسلّح،" إلى حين اتّخاذ مجلس الأمن التدابيرَ اللازمةَ لحفظ السلْم والأمن الدوليّيْن.
ويعترف القانونُ الدوليُّ كذلك بحقّ الشعوب في تقرير المصير، ما يَكفل للشعوب الخاضعةِ للاستعمار وللأنظمة العنصريّة حقَّ النضال في سبيل التحرير.

القانون الدوليّ يَكفل للشعوب الخاضعةِ للاستعمار والعنصريّة حقَّ النضال في سبيل التحرير
وبالتوازي، حاولتْ بعضُ الدول في العقود الأخيرة - ولا سيّما المملكة المتحدة - أن تكرِّسَ استثناءً عُرفيًّا جديدًا لحظر العدوان، قائمًا على مفهوم "التدخّل الإنسانيّ" أو "مسؤوليّة الحماية،" بحيث يحقُّ للدول الأعضاء التدخّلُ بشكلٍ أحاديٍّ لمنع الكوارث الإنسانيّة والانتهاكاتِ الجسيمة لحقوق الإنسان عند عجزِ مجلس الأمن عن اتّخاذ التدابير اللازمة للتصدّي للخطر. إلّا أنّ هذا المشروع ما زال يواجه رفضًا واسعًا في الأوساط الدوليّة بحيث لا يمكن اعتبارُه جزءًا ولو جنينيًّا من المنظومة الدوليّة.
يتبيّن من هذه النبذة الموجزة أنّ الخلافات المتعلّقة بحيّز "حقّ اللجوء إلى القوّة" في العلاقات الدوليّة تتمحور حول بضعةِ مفاهيمَ جوهريّةٍ، كـ"العدوان" و"السيادة الوطنيّة" و"حقّ تقرير المصير." ويقوم الجدالُ الأبرزُ على المادّة 51 وذريعةِ الدفاع عن النفس. فهل تكْفل هذه المادّةُ، كما تزعم الولاياتُ المتحدةُ مثلًا، حقَّ الدول في استخدام القوّة العسكريّة "استباقيًّا" أمام خطرٍ لم يتبلورْ بعد؟ وما هو التعريفُ الملائمُ لمصطلح "الاعتداء المسلّح" الذي يُحْيي حقَّ الدفاع عن النفس أساسًا؟ وهل ينطبق حصرًا على اعتداءاتٍ تُمْكن نسبتُها إلى دولةٍ ما، أمْ يكفي أن ينطلقَ الاعتداءُ من أراضي الدولة المعنيّة ولو بغير علمٍ أو رضًى منها؟
توسّعُ رقعة الحرب
على مدى العقود الأخيرة شهدْنا جهودًا كثيفةً لتوسيع رقعة "الحرب المشروعة." ومن ضمن الآليّات التي مهّدتْ لهذا التطوّر الزاحف تفسيرُ المادّة 51 من ميثاق الأمم المتّحدة (وغيرِها من الأحكام المعنيّة بجريمة العدوان) بشكلٍ يُرْضي القوى الاستعماريّةَ الكبرى على حساب سيادةِ دولِ الجنوب وشعوبِها التي باتت تعيش في حالة حربٍ معمَّمة.
فمؤخَّرًا، ساد ترويجُ مفهوم "الحرب الاستباقيّة،" كما في حال الاحتلال الأميركيّ للعراق، والغزو التركيّ الأخير لشماليّ سوريا.[3] وأدّت سطوةُ خطاب "مكافحة الإرهاب" إلى ازدهار ادّعاءاتِ "الدفاع عن النفس" لتسويغ التدخّلات والمناوراتِ العسكريّة باسم ضرورة القضاء على خطرٍ مزعومٍ لامرئيّ، بما يبرِّر شنَّ حروبٍ لامنتهيةٍ في الخارج والداخل على حدٍّ سواء.
في ضوء هذا الاحتدام المتقطّع، تلاشت الضوابطُ المعهودةُ للحروب، إذ باتت تُشَنُّ في جبهاتٍ متعدّدةٍ ومتحوّلةٍ على مدى سنين وعقودٍ متواصلة، بحيث لا يمكن الجزمُ بهويّة الأطراف في هذه المواجهة أو تلك، ولا متى بدأت المواجهةُ أساسًا وكيف ستنتهي. لقد ولّى زمنُ الحروبِ التي تُخاض وفق قواعدِ اشتباكٍ وحدودٍ معروفة، إنْ وُجد ذلك الزمنُ أصلًا، وحلّ مكانَه زمنُ الحرب الدائمة.
الحرب الإنسانيّة الدائمة استغناءً عن "الحرب العادلة"
اللافت أنّ الجهات المتحاربة في العالم اليوم باتت حريصةً على التلويح بـ"إنسانيّة" حروبها، والتفاخرِ بـ"دقّة" الأسلحة الحديثة وقدرتِها على التمييز بين العسكر والمدنيّين، ورمي الأعداء بـ"الهمجيّة" لعدم "إنسانيّة" ممارساتهم العسكريّة.
في هذا السياق، لا بدّ من التساؤل إنْ كان الهدفُ المبطَّنُ لسطوة هذا الخطاب "الإنسانيّ" هو تشريعَ حالة الحرب ذاتها، بما يَخْدم مصالحَ القوى الدوليّة الكبرى في سعيها إلى الاستيلاء على الموارد والمنافع الاستراتيجيّة المتنوّعة.
فعلى سبيل المثال، نرى أنّ رسالة المملكة المتّحدة إلى مجلس الأمن الدوليّ، عشيّةَ غزوها العراقَ في آذار 2003، لم تحاولْ ولو مجرّدَ التطرّق إلى مسألة "حقّها" في استخدام القوّة أساسًا، لكنّها حرصتْ على الإشارة إلى التزامها بالقانون الإنسانيّ الدوليّ وإلى عنايتها في تحديد الأهداف العسكريّة تجنّبًا لوقوع ضحايا مدنيّين. فكأنّ الحربَ ذاتَها، ومشروعَ تفكيك الدولة نفسَه، لم يكن لهما أثرٌ مدمِّرٌ هائلٌ في حياة العراقيين اليوميّة![4]
تقاليدُ الحرب وأسسُها الفلسفيّة
من المفيد أن نتوقّفَ هنا عند أطروحة كرمة النابلسي، الكاتبة والأستاذة الفلسطينيّة في جامعة أكسفورد، عن "تقاليد الحرب والاحتلال."[5] هذه التقاليد تتوزّع بين نظريّاتٍ ثلاث: النظريّة العسكريّة (the martial tradition)، المستوحاة من كتابات مفكّرين كمكيافيلي وهوبز؛ والنظريّة الليبراليّة، المتمثّلة في الحقوقيّ هوغو غروتيوس؛ والنظريّة الجمهوريّة، المتمثّلة في الفيلسوف جان جاك روسّو.
1) المدرسة الأولى قائمة على صورةٍ رومانسيّةٍ للحروب والغزوات وديمومتِها، ولها جذورٌ عتيقةٌ تتقاطع مع إيديولوجيّاتٍ عنصريّةٍ تجلّت في خطاب "صراع الأعراق" و"القدَرِ الإلهيّ" للشعوبِ والقادة. هذه المدرسة تَعتبر الحربَ ظاهرةً طبيعيّةً، لا بل فضيلةً، وظيفتُها الفصلُ بين الأسيادِ والعبيد، وتقديمُ وسيلةٍ لتحقيق الخلود والعظمةِ للأفراد والشعوب معًا.
2) وترى النابلسي أنّ الفكرَ الليبراليّ، الذي أسّس لتطوّر القانون الدوليّ الإنسانيّ في مراحله الجنينيّة، تمحورَ حول مفهومَي "المُقاتل الشرعيّ" و"المُقاتل غير الشرعيّ،" ومن ثمّ تنظيم الحروب بشكلٍ "حياديّ" زُعم أنّه في مصلحة المدنيّين عمومًا لأنّه "نأى بهم" عن عالم الدول الكبرى وآثارِ الحروب المدمِّرة. إلّا أنّ "الحياديّةَ" المزعومة في هذه النظريّة مَنحت القوى الاحتلاليّةَ وحدها الحقَّ الحصريَّ في استخدام القوّة، وحظرتْ - من حيث المبدأ - حقَّ الشعوب الخاضعة للاحتلال في المقاومة، وذلك بناءً على فرضيّةِ أنّ الحروب كانت في جوهرها ضمن حيّز الدول الرسميّة دون غيرها. والمُراد من هذه المقاربة كان تنظيمَ علاقات القوى الاستعماريّة الكبرى بعضها ببعض، وتخصيص "مناطق نفوذ" مستقرّةٍ فيما بينها، دونما اكتراثٍ لرغبات الشعوب التي حُكم عليها بالاستسلام أمام اضطهادٍ لا بدّ منه. وانطلقتْ هذه النظريّةُ من تصوّرٍ "أخلاقيّ" قائمٍ على تفضيل الأمن والاستقرار على الحريّة وحقِّ تقرير المصير، بحيث كان على الشعوب المهزومة والمستعمَرة الخضوعُ لواقعها الجديد حفاظًا على تماسك النظام الدولي الجنينيّ والمهدَّدِ أبدًا بالتهاوي.

كرمة النابلسي: "الحياديّة الإنسانيّة" شرّعت الغزواتِ الاستعماريّةَ شرطَ تقيُّدِها بمتطلَّبات "الأنسنة"
بهذا المعنى، فإنّ "الحياديّة الإنسانيّة" (الشكليّة) حملتْ في طيّاتها انحيازًا واضحًا إلى القوى القائمة، وشرّعت الغزواتِ الاستعماريّةَ الكبرى... شريطةَ تقيُّدِها بمتطلَّبات "الأنسنة."
3) في المقابل، انطلقت النظريّةُ الجمهوريّةُ من مبدأ "السيادة الشعبيّة" و"حقّ الشعوب في الحرّيّة وتقرير المصير" في وجه تهديدات الاحتلال والطغيان والاستعبادِ الخارجيّ والداخليّ. أي إنّها ركّزتْ على ضرورة رفع الستار "الحياديّ" من أجل التمعّن في طبيعة الحكم ودوافعِ الغزوات، بغية تشريع اللجوءِ إلى القوّة أو حظرِه على هذا الأساس.
نستطيع أن نستشفَّ في هذا التحليل بذورًا تاريخيّةً للظاهرة التي نتناولها، أيْ هيمنة خطاب "الأنسنة" في خوض الحروب، والاستغناء عن مفهومَي "العدوان" و"السيادة الشعبيّة" اللذيْن طغيا على صراعات القرن العشرين. والحصيلة الطبيعيّة أنّ حالةَ الحرب ذاتها لم تعد نقطةَ انطلاق المعارضة الدوليّة والشعبيّة، بل اقتصرتْ هذه الأخيرةُ على التدقيق في "تفاصيل" خوض الحروب والتنديد بـ"تجاوزاتها."
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى جهود حركات العالم الثالث - المتأثّرة بالفكر الجمهوريّ - في إعادة صياغة القوانين الدوليّة وترسيخ مبدأ "تقرير المصير،" إلى جانب المطالب الحقوقيّة الاجتماعيّة الأخرى التي اصطبغتْ بها ثورةُ العالم الثالث. صحيح أنّ هذه الجهود لم تنجحْ في تغيير قوانين الحرب بشكلٍ منهجيّ في وجه ضغوطٍ خارجيّةٍ هائلة وانقساماتٍ داخليّة، إلّا أنّها خَلقتْ حيّزًا مهمًّا لتكريس فكرة "التحرّر الوطنيّ ضمن إطار الشرعيّة الدوليّة." وما نراه اليوم هو هدمٌ لتلك المفاهيم التي نتجتْ من جهود جيل التحرّر والتكاتف الأمميّ، المتمثّلِ في مؤتمر القارّات الثلاث.[6] وهذه جهودٌ تجب إعادةُ إحيائها في ظروفنا المستجدّة.
الاحتلال الدائم نموذجُ الحرب الدائمة
نعود مجدّدًا إلى كتاب نورا عريْقات للإشارة إلى الدور "الطليعيّ" الذي أدّته دولةُ الاحتلال الإسرائيليّ في رسم ملامح مشروع الحرب الدائمة.
فلقد عمدتْ أجهزةُ الدولة الإسرائيليّة على مدى العقود الماضية إلى تأطير احتلالها بنظامٍ "قانونيٍّ إنسانيّ،" على ما نرى في ادّعائها أنّ اتفاقيّاتِ جنيف لا تنطبق عليها بسبب غياب أيِّ "قوّةٍ سياديّةٍ" سابقة في فلسطين[7] (أيْ بسبب إنكار الاحتلال وجودَ المجتمع الفلسطينيّ بوصفه شعبًا ذا سيادة، كما في قول غولدا مائير: "لا وجودَ للشعب الفلسطينيّ").[8] وهذا ما يمنحها حقَّ شنِّ حروبٍ لامتناهيةٍ على هذا الشعب وسلب أراضيه، في الوقت الذي تُصوِّر فيه أيَّ مقاومةٍ شعبيّةٍ (مهما كانت سلميّةً) بأنّها "إرهاب."
في هذا الصدد تشير عريْقات إلى استنساخ الولايات المتحدة الحججَ القانونيّةَ الإسرائيليّةَ فور إعلان "الحرب على الإرهاب" لتأمين الغطاء الشرعيّ لحروبها المتعدّدة، والادّعاء أنّ هذه الأخيرة تقع خارج نطاق القوانين الدوليّة المتعلّقة بالحروب والاحتلالات.[9]
خاتمة
مع توسّع نطاق الحروب بشكلٍ مريبٍ على مدى السنين الماضية، بات واجبًا أن نُعيدَ النظرَ في سطوة خطاب "الإنسانيّة" الذي قد يؤدّي دورًا خفيًّا في تشريع حالةِ الحرب ذاتِها، وتفريغِها من أيّ مضمونٍ سياسيّ أو أخلاقيّ. لذا، لا بدّ من التمسّك بضوابط القانون الإنسانيّ تفاديًا لتكرار تجربة الحروب الشاملة التي مزّقتْ مجتمعاتٍ بأكملها أو أبادتْها. لكنْ يجب ألّا تَحلَّ متطلّباتُ القانون الإنسانيّ محلَّ الجدال الأوّليّ عن حقّ اللجوء إلى القوة أساسًا، بل لا بدّ من استعادة مفاهيم "العدوان" و"السيادة الشعبيّة" و"حقّ تقرير المصير" لمنع الانزلاق إلى حالة حربٍ معمَّمةٍ وأبديّة. فالتسليم بالخطاب "الحياديّ،" المتمثّل في القانون الإنسانيّ و"مكافحة الإرهاب،" يُسهم في إعادة إنتاج علاقات القوة التي أوصلتنا إلى مآسينا المتعدّدة، على الرغم من شعاراته الرنّانة.
لن تتحقّق آمالُ شعوبنا في التحرير والتحرّر إلا إذا نشأ، من داخل نسيجها الاجتماعيّ، الوعيُ السياسيُّ والاجتماعيُّ المطلوبُ لمواجهة مشاريع الطغيان والاستعمار مباشرةً، مهما طالبنا الطاغيةَ والمستعمِرَ بالتقيّد بضوابط "الإنسانيّة."
لندن
[1] Samuel Moyn, “Civil Liberties and Endless War,” Dissent 62, no. 4 (2015), p. 57-61
[2] Noura Erakat, Justice for Some: Law and the Question of Palestine, Stanford University Press, 2019
[3] Turkey’s 22 January 2018 letter to the UN Security Council
https://undocs.org/en/S/2018/53
[4] Letter from the United Kingdom to the UN Security Council, 21 March 2003
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-letter-united-kingdom-un-security...
[5] Karma Nabulsi, Traditions of War: Occupation, Resistance, and the Law, Oxford University Press, 2005
[6] Karma Nabulsi “A Struggle With History,” The Guardian, 28 Jan 2017
https://www.theguardian.com/books/2017/jan/28/a-struggle-with-history
[7] Erakat, p. 63
[8] Golda Meir, “Golda Meir Scorns Soviets,” Washington Post, 16 June 1969
[9] Erakat, p.191
حقوقيّ عربيّ، ومحامٍ في المملكة المتحدة. حاز البكالوريوس في الفلسفة والعلوم السياسيّة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، إلى جانب شهادة عليا في القانون من جامعة لندن.