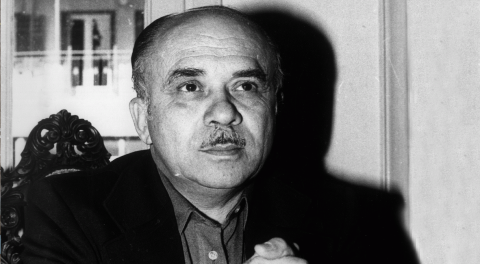حصل على شهادة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من الغرادجويت سنتر- كيوني في نيويورك. يدرّس حاليا في كلية جون جاي. باحث في دراسات الشرق الأوسط والفلسفة السياسية.

بعد مضيّ عام على ثورة 17 تشرين الأول في لبنان، ما زلنا نرى بعضَ الثوّار القدامى يَدْعون، وإنْ بحماسةٍ خفتتْ، إلى مظاهراتٍ لمحاسبة المسؤولين ولتغيير النظام.
منهم مَن طالب بحبس هؤلاء المسؤولين وإجبارهم على الاعتراف بأخطائهم التاريخيّة. ومنهم مَن طالب باستقالتهم جميعًا بلا عنف. ومنهم مَن طالب باسترجاع الأموال المنهوبة. لكنّهم، كلّهم، يُجْمعون على أنّ "الثورة" هي السبيلُ الوحيدُ أمامهم.
والثورة، بالنسبة إليهم، كالعملية الجراحيّة: تستأصل الورمَ، فتعيدُ توزيعَ السلطة في المجتمع بطريقةٍ عادلة، فتنتهي المصاعبُ والمخاوف. أمّا إذا فشلتْ، فعليهم تكرارُها، كما قال أحدُ هؤلاء الثوريّين مؤخّرًا، إلى أن تؤتيَ ثمارَها... أو يموتَ المريض.
في محاضرةٍ ألقاها الفيلسوفُ الفرنسيّ المعروف إيتان باليبار في جامعة كولومبيا سنة 2017 عن "فكرة الثورة: الأمس واليوم والغد،"[1] يَذْكر أنّ اللحظة الثوريّة تَجْمع ثلاثةَ مظاهر سياسيّة أساسيّة: 1) إعادة توزيع السلطة ونقلها من النخبة الحاكمة التي تحتكرها إلى المستبعَدين او المهمَّشين. 2) الانتقال من نظامٍ إلى آخر؛ وعادةً ما يَشْغل هذا الانتقالُ المجتمعَ بأكمله، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا. 3) تعليق قواعد اتّخاذ القرار وأشكالِ التمثيل، إمّا في اتجاه المزيدِ من الديمقراطيّة، أو المزيد من الديكتاتوريّة، أو المزيد من كلتيْهما في وحدةٍ نموذجيّةٍ من الأضداد.
يمكن اعتبارُ المظهريْن الأوّليْن هدفيْن تطمح إليهما الثورةُ. أمّا المظهرُ الثالث، فيمكن اعتبارُه انفتاحًا سياسيًّا محدودًا قد يزحزح الواقعَ ولو خطوةً إلى الأمام إذا استُغلَّ من داخل آليّاتِ الدولة المؤسّساتيّة.
بعبارةٍ أخرى، يجب أن تكون الجماعيّةُ السلبيّةُ، المطالِبةُ بتفكيك النظام (تحت شعار "كلّن يعني كلّن")، مساويةً للجماعيّة الإيجابيّة، المطالِبةُ بتأسيس نظامٍ جديدٍ وطرح مشروعٍ بديل. لكنْ على الثورة، من أجل القيام بذلك، أن تدركَ أهمّيّةَ الانفتاح السياسيّ الذي أنتجتْه، ثم تعمدَ إلى "التحكّم في ذاتها،" وإلى استدرار النتائج بحسب الوضع السياسيّ العامّ، لا في معزل عنه. لذلك يُستحسن أن تتراجعَ الثورةُ بوعيٍ عن التحدّي النهائيّ والشامل للنظام والنخبةِ السياسيّة، وأن تتجنّبَ عن قصدٍ تهديدَ مصالح مَن يُمْكنهم عكسُ هذه العمليّة وكبحُها.
فالثورة هي آليّةٌ لتوسيع الحقوق. والثوّار مجتمعٌ ذاتيُّ التنظيم، لا يهدف بالضرورة إلى ثورةٍ شاملةٍ فوريّةٍ تدمِّر النظامَ القديم، بل قد يهدف أيضًا إلى إصلاحٍ هيكليٍّ تدريجيّ يتحقّق نتيجةً للضغط المنظَّم والمتواصل من الأسفل. ومن وجهة النظر الأخيرة هذه، تصبح الثورةُ علاجًا واقعيًّا طويلَ الأمد، يقوم على ترتيب الأولويّات وتوضيحِها كي تحافظ على الدولة كبنيةٍ تحتيّةٍ لا تتأثّر سلبًا بتغيّرات النظام السياسيّ.

الثورة آليّةٌ لتوسيع الحقوق، والثوّار مجتمعٌ ذاتيُّ التنظيم لا يهدف بالضرورة إلى ثورةٍ شاملةٍ فوريّة
إذا كانت "الديمقراطيّة التوافقيّة" أو "الطائفيّة السياسيّة" هي مبدأ الحكم القائم في لبنان، وعاملًا رئيسًا ساهم في تكوين الدولة اللبنانيّة وتشكيلِ الخطاب السياسيّ والاجتماعيّ في البلاد، فهل يمكن القفزُ فوقها مباشرةً باتجاه مبدأ "المواطَنة" والدولة المدنيّة بشكلها الليبراليّ؟ هل الديمقراطيّةُ الليبراليّة، المدنيّة، اللاطائفيّة، التي تدور حول حريّة الأفراد الذين يتمتّعون بحقوقٍ كاملةٍ على أساس الاستقلاليّة الأخلاقيّة والإنسانيّة، هي ما تستطيع أن تنادي به الثورةُ فقط؟ هل يتطابق هذا النموذجُ مع الطبيعة الاجتماعيّة للبلاد؟ وهل يمكن أن يصبحَ هذا "الحلّ" (أي المطالبةُ بالدولة المدنيّة...) جزءًا من المشكلة؟
من جهةٍ أخرى، هل يشكّل الطابعُ الزمنيُّ للطوائف، وتقاليدُها الجماعيّة، عائقًا، بالضرورة، أمام عمليّة التحوّل الديمقراطيّ؟ هل الطائفيّة السياسيّة، التي تَعتبر الفردَ كائنًا اجتماعيًّا اكتسبَ توجّهاتِه الأخلاقيّةَ وهويّتَه السياسيّةَ ولغتَه من رحم مجتمعِه وطائفته، هي، بالضرورة، سببُ الركود السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ؟ هل تمثيلُ الطوائف في الحكم سيؤدّي بالضرورة، كما قال المؤرِّخ كمال الصليبي، إلى تدهور الحكم "على المستوييْن التشريعيّ والتنفيذيّ، لتصبحَ الدولةُ ساحةً لتسوية الخلافات التقليديّة، المدعومةِ بالعصبيّات الطائفيّة، على حساب المصلحة الوطنية"؟[2] وأخيرًا،هل هذان هما التقليدان المتاحان وحدَهما، دون غيرهما، أمام الثوّار: التقليدُ الليبراليّ الفرديّ الحقوقيّ، القائمُ على أسبقيّة الفرد على المجتمع؛ والتقليدُ الجمعيُّ الطائفيّ، القائمُ على أسبقيّة المجتمع/الطائفة على الفرد؟
في عوائق أمام الديمقراطيّة، تتناول د. أماني جمال، العالمةُ السياسيّةُ الفلسطينيّة-الأميركيّة، أهمّيّةَ المُناخ السياسيّ في تشكيل المشاركة المدنيّة. فترى أنّ وجودَ القنوات التي تتيح المشاركةَ السياسيّةَ يؤدّي دورًا رئيسًا في هيكلة المجتمع والمواطنين على حدٍّ سواء: "سيطوِّر الأفرادُ آراءً ومواقفَ ومعاييرَ وتصوّراتٍ تتأثّر مباشرةً بالسياق السياسيّ الذي يعملون فيه."[3] لذلك، لا تكمن أهمّيّةُ الاتفاقات الدستوريّة اللبنانيّة والتقاليدِ المجتمعيّة، الطائفيّةِ في الحالة اللبنانية، في هيكلة الدولة والفرد والبيئةِ الاجتماعية السياسيّة فحسب، بل تكمن أيضًا في موقعها من عمليّة التحوّل التدريجيّ نحو الديمقراطيّة. فمن المهمّ اعتبارُ هذه التقاليد المجتمعيّة التي توجِِّه المشاعرَ والأفكارَ، وتؤثِّر تأثيرًا كبيرًا في تشكيل البنية السياسيّة اللبنانيّة، مدخلًا من مداخل الوعي السياسيّ، وعاملًا يضعنا على طريق تحقيق التغيير.
لقد أدّى الانهيارُ الاقتصاديّ، الذي تَفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وانفجارِ مرفأ بيروت، إلى تحويل مؤسّسات الدولة اللبنانيّة، ذاتِ البنيةِ التحتيّةِ المتدنّيةِ أصلًا، إلى مؤسّساتٍ شبهِ معدومةِ الفعّاليّة. فارتفعتْ معدّلاتُ البطالة ومعدّلاتُ الانتحار، وفقدت الليرةُ ما يقرب من 85٪ من قيمتها. في غضون ذلك، مازالت الطبقةُ السياسيّةُ مصرّةً على استغلال هذه المصاعب لحساباتها الضيّقة، فنراها تُقارب علاقاتِها ومصالحَها على أسسٍ بعيدةٍ كلَّ البعد عن مصلحة البلاد الوطنيّة. ولقد استخدمتْ هذه الطبقةُ السياسيّةُ كلَّ سهمٍ في جعبتها لقمع انتفاضة 17 تشرين، فخوّنتْها وأمركتْها، وأخذت البلادَ في نهاية المطاف إلى البحر لترسِّم الحدودَ الجنوبيّةَ مع العدوّ الإسرائيليّ، وأرجعتْها عطشانةً.
وبينما يرزح المواطنُ تحت أعباء الأزمات المتتالية، حُلّت حكومةٌ، وعُيّن رئيسٌ جديدٌ فاعتذر، وكُلِّف آخرُ فاعتذر، وكُلّف ثالثٌ فاعتذر أيضًا. إنّ مواقع التمثيل الطائفيّ في السلطة ثابتة، وما على هذه النخبة إلّا أن "تملأ الفراغَ" بالشخص المناسب. النخبة هي مَن يتحكّم بمصائر الناس. أمّا الناخب، المتمسّكُ بالنخبة الطائفيّة وقرارتِها، فلا يضع أيَّ أجنداتٍ أو قضايا سياسيّة، ولا يَخرج بمطالبَ مجتمعيّة، ومعظمُ قنواته المتاحة للمشاركة السياسيّة - المبنيّة على الزبائنيّة والمحسوبيّة طبعًا - وسيلةٌ لـ"أكل العيش" لا غير.

هل الديمقراطيّة النخبويّة، التي تكتفي بـ"تمثيل" الناخبين من دون أن يكون المنتخَبون مسؤولين أمامهم، مصيرُ لبنان؟
لذلك نسأل: هل الديمقراطيّة النخبويّة، التي تكتفي بـ"تمثيل" الناخبين من دون أن يكون المنتخَبون مسؤولين فعلًا أمامهم، هي مصيرُ لبنان؟ ألا يضحّي اختزالُ الديمقراطيّة في أسلوب اختيار القادة (المحدَّدين سلفًا في الحالة اللبنانيّة)، أو في عمليّة تنظيم المنافسة السياسيّة بين النخب الطائفيّة، بالمبادئ الأساسيّة التي تقوم عليها شرعيةُ المفهوم الديمقراطيّ، أيْ حكم الشعب و"اللاحتميّة" السياسيّة، أي "المقعد الخالي"؟[4] فالحقّ أنّ هذا الفراغ في مقعد السلطة يَمنع أيَّ كيانٍ، أشخصًا كان أمْ جماعةً أمْ طائفةً، من ضمان سيطرة مصالحه السياسيّة إلى الأبد. والسؤال: هل تُمْكن مأسسةُ اللاحتميّة السياسيّة في هذه الظروف وتحت هذه الميثاقيّة؟ هل اللاحتميّة ممكنة إذا كانت الطوائفُ، الممثّلةُ في نُخبها، تجلس على مقعدٍ ثابتٍ ومشغولٍ ومكرَّس؟
إنّ حتميّةَ المناصب الرئيسة الثلاثة (رئيس الجمهورية مارونيّ، رئيس مجلس النواب شيعيّ، رئيس مجلس الوزراء سنّيّ) يحوّل الانتخاباتِ من نشاطٍ ديمقراطيٍّ يهدف إلى التمثيل، إلى نشاطٍ ديمقراطيٍّ لاختيار النخبة فقط. فالمنافسة على المركز الثابت نفسِه قد يحصل ضمن الطائفة ذاتِها، لا بين الطوائف؛ وهذا ما يقلِّص دورَ اللاحتميّة السياسيّة في العمليّة الانتخابية، ويضمن احتفاظَ المتنافسين بسلطة الطائفة وخطابِها عبر تقسيمِها أو إخضاعِها (القوات اللبنانيّة والتيّار الوطنيّ الحرّ للموارنة، وحزب الله وحركة أمل للشيعة، وهكذا).
من أجل إعادة صياغة هذه الميثاقيّة (ذات الوجه الديمقراطيّ) لتقاسم السلطة، ولكنْ هذه المرّة على أساس "اللاحتميّة السياسيّة" كمبدأٍ أساسٍ للديمقراطيّة والتحوّل الديمقراطيّ، أقترحُ تفكيكًا جديدًا لاتفاق الطائف يقوم على تناوب هذه المناصب بين الطوائف الرئيسة الثلاث، وذلك من أجل تحقيق المساواة السياسيّة التمثيليّة، أو مشاركةِ الطوائف المذكورة. فإذا كانت قوّةُ الديمقراطيّة تكمن في مقعدها الفارغ، فعلينا تمكينُ الدولة من خلال عدم إعطاء الطائفة نفسها المنصبَ نفسَه.
إنّ إعطاء كلّ طائفة إطارًا زمنيًّا لفترة ولايتها في هذا المنصب أو ذاك سيَسمح بالتداول السلميّ للسلطة بين الطوائف. وهذا الاقتراح سيَخلق فجوةً في العمليّة السياسيّة، بحيث تلتفّ الطوائفُ حول الدولة كي تكتسبَ شرعيّتها؛ ما سيؤدّي إلى تغيير اللغة السياسيّة والأجندات الحاليّة، وإلى تحفيزها بطريقةٍ تُعزِّز اللاحتميّة، من دون أن تُسقطَ التمثيلَ الطائفيَّ في الدولة. ومن أجل تحقيق هذه الصيغة، تجب إعادةُ تشكيل هذه المناصب والتفكير في امتيازاتها الدستوريّة، عبر موازنة تأثيراتِها، وضمانِ عدم تركيز السلطة السياسيّة في منصبٍ واحد.
بكلامٍ آخر: من الضروريّ تطويرُ البنية الطائفيّة الدستوريّة القائمة من أجل تأسيس المطالب في سياقها السياسي-التاريخيّ، وذلك من خلال تدارك ضغطِ المجتمع المدنيّ في نموذجه الليبراليّ (المواطَنة) من جهة، وضغطِ المجتمع الطائفيّ في نموذجه الجمعيّ من جهةٍ أخرى. وهذا ما يؤدّي إلى تعظيم آفاق الانتقال التدريجيّ إلى الديمقراطيّة في المستقبل.
هكذا ستُجهَّز البلادُ لانتقالٍ تدريجيٍّ نحو خطابٍ أكثرَ ديمقراطيّةً: من الطائفيّة ذاتِ الوجهِ "الديمقراطيّ" (الميثاقيّة)، إلى الديمقراطيّة ذات الذوق الطائفيّ (المداورة)، وصولًا إلى الديمقراطيّة على المستوى الوطنيّ.
نيويورك
[1]Etienne Balibar, “The Idea of Revolution: Yesterday, Today and Tomorrow,” International Society for Intellectual History Conference: “Rethinking Europe in Intellectual History,” Columbia University in the City of New York, August 27, 2017.
[2] كمال الصليبي، بيتٌ بمنازل كثيرة: الكيان اللبنانيّ بين التصوّر والواقع (بيروت: مؤسّسة نوفل، 1990).
[3]Amaney A Jamal, Barriers to Democracy: The Other Side of Social Capital in Palestine and the Arab World, Princeton: Princeton University Press, 2009
[4] راجع مقاليْنا السابقيْن في الآداب: http://al-adab.com/desc-author/56880-%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89
حصل على شهادة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من الغرادجويت سنتر- كيوني في نيويورك. يدرّس حاليا في كلية جون جاي. باحث في دراسات الشرق الأوسط والفلسفة السياسية.