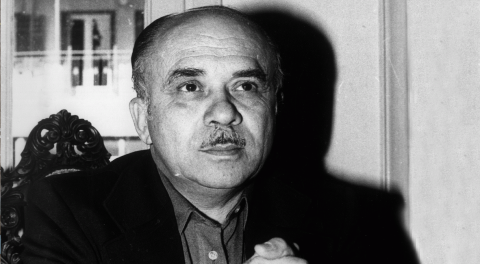اتفق التربويّون وعلماءُ النفس على أنّ وسائلَ الإعلام من أكثر أدوات التغيير قوّةً، لِما لها من سلطةٍ على أفراد المجتمع، وخصوصًا لِما تقدِّمُه من توجيهٍ لمشاعر المتابعين، وما تسوّقُه من قيمٍ وسلوكيّات، خصوصًا في أزمنة الحروب والثورات.
وقد أخذتْ عمليّاتُ التواصل في العالم أشكالًا متشابهةً نسبيًّا، غير أنّ تأثيراتِها تختلف تبعًا للخصوصيّات الثقافيّة والحضاريّة التي تُميّز المجتمعاتِ بعضَها من بعض. ذلك لأنّ وسائل الإعلام على اتصالٍ وثيقٍ بقيم المجتمع التي وُلدتْ فيه، وبسياسة البلد العامّة الذي تسوِّق فيه الأفكارَ، بحيث تأخذ في الاعتبار وجهاتِ نظرِ المواطنين ضمن مواضيعها التسويقيّة.
دورُ الإعلام، إذًا، ليس "نقلَ الحقيقة" فحسب، أو أساسًا، وإنّما التأثيرَ في المتابعين، وإعادةَ إنتاجهم بما يتناسب مع رؤية هذه الوسيلة الإعلاميّة أو تلك، بحيث يمتلكون ركائزَ التفكير "المنطقيّ" والسياسيّ الخاصّ بها - - بملحظ أنّ وسائلَ الإعلام ذاتُ صلةٍ راسخةٍ بالفاعلين السياسيين، خصوصًا في بلادٍ كبلادنا لا تُفصَل فيه السياسةُ عن الحياة اليوميّة على الإطلاق. بكلامٍ آخر: وسائلُ الإعلام هي من الركائز الرئيسة لنظامنا السياسيّ، لأنّ هذا النظام هو في حقيقة الأمر نظامُ اتصالٍ وإعلام. لذا يَستثمر كلُّ طرف سياسيّ (في لبنان أو غيره) في هذا الميدان ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

الإعلام ذو صلةٍ راسخةٍ بالفاعلين السياسيين، خصوصًا في بلادنا
تطوّرتْ هذه الوسائلُ اليوم بصفةٍ معتبَرة، وأصبح تأثيرُها أكثرَ فعّاليّةً في المتابعِين. وذلك يعود إلى سببيْن، هما:
- اعتمادُ المتابِع على هذه الوسائل في تجميع المعلومات بدلًا من التفتيش بنفسه عنها، ومن ثم التمحيص والتدقيق فيها، بما يوفِّر عليه جهدَ القراءة المتأنّية الواعية، ويقدِّم إليه المعلوماتِ "جاهزةً ومعلّبةً" كما تريد تلك الوسائلُ والقيّمون عليها.
- اعتمادُ الإعلام أساليبَ "عاطفيّةً" غالبًا ما تدغدغ انتماءَ المتابعين السياسيّ والطائفيّ والمذهبيّ.
في لبنان، تعكس وسائلُ الإعلام التقليديّة (التلفزيون، الراديو، الدوريّات المطبوعة) التطوّرَ السياسيَّ والثقافيَّ والاجتماعيَّ والاقتصاديّ لمجتمعنا، ولكلّ الأحداث السائدة، ولكنْ بحسب رؤية كلّ مؤسّسةٍ إعلاميّةٍ وغاياتها. وهذا ما ظهر جليًّا خلال ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019. ففي الأيّام الأولى لعبت غالبيّةُ هذه الوسائل دورًا كبيرًا في بثّ أفكار الثورة بين الناس، المتحضّرين نفسيًّا والمتعطِّشين فعليًّا لتقبّلها. غير أنّها ما لبثتْ، في غالبيّتها أيضًا، أن انقسمتْ لاعتباراتٍ سياسيّةٍ وطائفيّة. وبدلًا من أن تشكِّل سلطةً رابعةً، تحاسِب المخطئَ أو الجاني أو الفاسد، أصبح لها دورٌ تسويقيّ يقتصر على تزويد المُشاهد بسلوكيّاتٍ محدّدة وأفكارٍ معيّنة تتلاءم مع رؤيتها السياسيّة أو الطائفيّة أو الحزبيّة.
ولمّا كان الشعبُ اللبنانيّ أصلًا مقسَّمًا إلى طوائفَ و"ثقافات،" والانتماءُ الأوّلُ لدى غالبيّته هو إلى الطائفة أو الزعيم لا إلى الوطن، فقد انقسم المُشاهد اللبنانيُّ هو أيضًا، وغدا يشاهد المحطّات التي تغذّي انتماءَه الحزبيّ و/أو الدينيّ وتَنْصر طائفتَه وزعيمَه في زمن المنافسة الحزبيّة. وتبلور دورُ هذه الوسائل فعليًّا في إعادة إنتاج قوى إنتاج مناسبةٍ لرؤيتها، فسيطرت التبعيّةُ على قيمنا وسلوكيّاتنا، بدلًا من الوعي الوطنيّ والإنسانيّ العامّ.
لكنْ في عصر العولمة، بعد أن سيطرتْ شبكةُ الإنترنت على حياة الشباب اليوميّة، فقدتْ بعضُ وسائل الإعلام التقليديّة تلك جمهورَها من الشباب المثقّف. فهذا الشباب، المواكِبُ للعالم الرقميّ والتكنولوجيا الذكيّة، لم يعد يكتفي بمعايير تلك الوسائل أو يلتزم بشروطها، بل راح يفتّش عن مصدر معلوماته بنفسه، أو عن حقيقة المواضيع التي يقرأها من مصادرها ذاتها لا من مصادرَ ثانويّةٍ أو مجتزأة. هكذا حلّت وسائلُ الإعلام التقليديّة في المرتبة الثانية بعد شبكة الإنترنت من حيث مهمّةُ تسويق القيم الاجتماعيّة والسلوكيّات.
حاولت الطوائفُ تثبيتَ أفكارها والتسويقَ لها على نطاق أوسع في ظلّ صراعها المستجدّ مع الإنترنت. فقصّت على جمهورها المؤمن القصصَ الدينيّةَ والعجائبيّةَ (والخرافيّةَ أحيانًا)، محاولةً إقناعَه بأنّ الأنبياءَ والقدّيسين لا يمكن أن يسمحوا لأيّ مرضٍ أو بلاءٍ بأن يسيطرَ على البلاد أو العِباد. فذهبتْ فئةٌ من المتديّنين إلى تسويق فكرة أنّ الترابَ المأخوذَ من قبر القدّيس شربل هو الشافي من فيروس الكورونا، وجرى نقلُ هذا التراب إلى مستشفى رفيق الحريري الحكوميّ،[1]بحضورٍ إعلاميٍّ وحزبيّ، مهينةً بذلك الطاقمَ الطبّيَّ والعلومَ الطبّيّة والمنطقَ نفسَه. وعمدتْ فئةٌ أخرى، من طائفة أخرى، وتنتمي إلى منطقةٍ فقيرةٍ بائسة، إلى تنظيم مسيرات يوميّة في الأحياء السكنيّة، وراحت تقرأ الأدعيةَ عبر مكبّراتِ صوتٍ تخرق جدرانَ المنازل،[2]على الرغم من تشديد الأطبّاء على عدم الاختلاط ووجوب "الابتعاد الاجتماعيّ" (social distancing) عن الآخرين متريْن على الأقلّ للحدّ من انتشار فيروس كورونا. ودعت فئةٌ ثالثة إلى زيارة المقامات الدينيّة في قم الإيرانيّة، حيث الشفاءُ الأكيد.[3]

عمدتْ LBCI إلى نعت المتخلّفين عن البقاء في منازلهم بأنّهم "بلا مخّ"
هكذا تعدّدتْ "وصفاتُ" فئات المجتمع الواحد، في اليوم الواحد، أمام البلاء الواحد. هذا من دون أن ننسى مَن فتّش عن المعلومات عبر الإنترنت، فوجد أنّ الفيروس لا يصيب "الشبابَ" أبدًا ولا يؤدّي إلى الموت مطلقًا (!)، فخرج مطمئنًّا إلى كورنيش المنارة في نهاية الأسبوع،[4]عملًا بنصيحة وزير الصحّة الأولى "لا داعي للهلع،"[5]وتغافل عن الالتزام بتوجيهات الوزارة اللاحقة أو بتوجيهات منظّمة الصحّة العالميّة، فأسهم - بذلك - في نقل الفيروس إلى بيته وعائلته الممتدّة، معرّضًا المسنّين فيها - بشكلٍ خاصّ - إلى خطر الموت.
تجاهلتْ هذه الفئاتُ حملاتِ التوعية في الوسائل الإعلاميّة اللبنانيّة التي دعت إلى لزوم المنزل شرطًا أساسًا للوقاية. فعمدت المؤسّسةُ اللبنانيّةُ للإرسال (LBCI) إلى نعت المتخلّفين عن الالتزام بأنّهم "بلا مخّ" لأنّهم هدّدوا سلامةَ أنفسهم والآخرين، غيرَ آبهين أو مكترثين.[6]وعلى الرَّغم من أنّ هذا النعت لا يليق بوسيلةٍ إعلاميّةٍ مرموقة، وهو مرفوضٌ تربويًّا وأخلاقيًّا، ولا يدلُّ على احترافيّةٍ أو احترامٍ للآخر، فإنّ أغلبَ الفئات اللبنانيّة صادَقَ عليه لأنّه يتناسب مع دعوات الزعماء السياسيين والحزبيين (على اختلافهم) إلى الحجْر المنزليّ، ولم يتحرّكْ أحد للدفاع عن "حقّ المواطن" في التنقّل أو التنزّه "وفق الدستور،" ولم نقرأْ أيَّ تعليقٍ من جماعة المطالبة بـ"الحريّة الشخصيّة" أو "حقوق الإنسان." والسبب في ذلك لا يعود، بالضرورة، إلى "الوعي الجديد" لدى الجميع أو الغالبيّة، بل إلى الالتزام بنداء الزعيم.
هذا هو بلدي لبنان، وهكذا يجري التسويقُ فيه للأفكار أيًّا كانت، برضًى حزبيّ أو دينيّ، وبغطاءٍ إعلاميّ ممنهَج، بما يزيد من تقوقع كلّ فئةٍ وطائفةٍ وتشبّثها بأفكارها. وأثبت بعضُ اللبنانيّين بجدارةٍ أنّهم "بلا مخٍّ وطنيّ" من حيث اتّباعُهم زعيمَهم، بلا تمحيصٍ أو تدقيقٍ أو روحٍ نقديّة.
عبرا