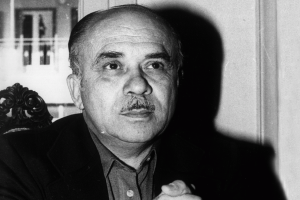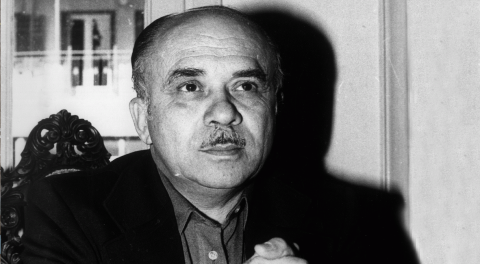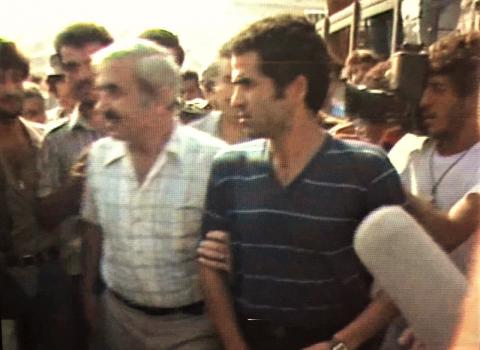شهدت الأسابيعُ الماضية قيامَ حزب الله بالردّ على عمليّتيْن إسرائيليتيْن: الأولى في سوريا حيث استُشهد مقاومان للحزب، والثانية في الضاحية حيث أرسل العدوُّ مسيّرتيْن حالت ظروفٌ تقنيّةٌ (كما قيل) دون تسبُّبهما في وقوع ضحايا لبنانيين. وقد جاء ردُّ حزب الله عبر عمليّتين: الأولى استهدفتْ آليّةً إسرائيليّة في مستوطنة أفيفيم في فلسطين المحتلّة عامَ 48، والثانية عبر إسقاط مسيَّرة إسرائيليّة عبرتْ سماءَ الجنوب اللبنانيّ.
ما سيتطرّق إليه هذا المقال هو جملةُ مواقف، أطلقها صحافيّون وإعلاميّون لبنانيّون وعرب، شكّلتْ جوًّا من التشكيك في جدوى المقاومة، أو سعت إلى ترسيخ ذهنيّةٍ تضرّ بمسعى التحرّر من الصهيونيّة وكيانها. وليس من المبالغة القولُ إنّ هذه المواقف كانت أشبهَ بـ"مُسيّرة إعلاميّة عربيّة،" قد تُفْلح حيث أخفقت المُسيَّرةُ العسكريّةُ الإسرائيليّة، وتحديدًا على جبهة تزييف الوعي، إنْ لم تتصدَّ لها الأقلامُ المعاديةُ للصهيونيّةُ بشكلٍ دائمٍ وواعٍ ومباشر، من دون الخوف من أن تُتّهَمَ بـ"التخوين" و"المزايدة" وكافّةِ مصطلحات الترسانة التطبيعيّة الاستسلاميّة.
***
الموقف الأوّل الذي أطلقتْه المُسيَّرةُ العربيّة هو التشكيكُ في نجاح المقاومة في الردّ. وقد جاء هذا التشكيك حتى بعد نشر الإعلام الحربيّ التابعِ لحزب الله شريطَ فيديو يبيِّن ــ بوضوحٍ ــ الصاروخيْن اللذيْن أصابا الآليّة الإسرائيليّة في مستوطنة أفيفيم. هكذا سمعنا تساؤلاتٍ خبيثةً من نوع: ومَن يؤكّد لنا أنّ الآليّة لم تكن مُسيّرةً بالريموت كونترول؟ أو: مَن يَجزم أنّ جنودًا أصيبوا فعلًا بين قتيل وجريح؟ أو: مَن يَحسم أنّ مَن كانوا فيها ليسوا مجرّدَ دُمًى؟

سمعنا تساؤلاتٍ خبيثةً من نوع: مَن يَجزم أنّ جنودًا أصيبوا فعلًا؟
نحن هنا أمام أمريْن خطيريْن:
- الأول هو استبطانُ الهزيمة الأبديّة؛ كأنّ اللبنانيين والعرب محكومون بالخسارة (لا "محكومون بالأمل" كما كان يردّد الراحل الكبير سعد الله ونّوس)، وإنِ امتلكوا القوّةَ والذكاءَ والإيمانَ والتقنيّاتِ والقيادةَ والتدريبَ المتقَن.
- أمّا الثاني، والأخطر، فهو الخوف من نجاح المقاومة في الردّ، لأنّ نجاحَها سيضرّ بخصومها الداخليين! نعم، ثمّة مَن يعتبر أنّ أيَّ نجاح، ولو طفيفًا، للمقاومة، ضررٌ له. الخضوع لإسرائيل أرحمُ، في عُرفه، من الخضوع لـ "الملالي" و"الهلال الشيعيّ" و"ثقافة الموت."
لا تجنّيَ في ما قلناه. والدليل أنّ ما طرحه ويطرحه، منذ زمن، أعداءُ الردّ بديلًا من مقاومة حزب الله ليس مقاومةً عَلمانيّةً مسلّحةً مثلًا، ولا مقاومةً مدنيّةً تستند إلى المقاطعة ومقاومة التطبيع الثقافيّ والفنّيّ والأكاديميّ مع رعايا الاحتلال ومؤسّساته. كلُّ ما يقترحه أعداء الردّ ("الحزبإلهيّ" كما يسمّونه) هو الركونُ إلى القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، مع أنّ العدوّ هو مَن خرقَه لا المقاومة؛ أو الركونُ ــ في أحسن الأحوال ــ إلى الجيش اللبنانيّ، وحدَه لا شريكَ له، على الرغم من أنّ أعداء الردّ يدركون جيّدًا أنّ هذا الجيش عاجزٌ عن إقامة "توازن ردعٍ" حقيقيّ مع الجيش الإسرائيليّ إلّا بالتحالف مع المقاومة اللبنانيّة. ولا ننسى هنا أنّ أعداء هذه المقاومة يرفضون بشدّةٍ أن يأتوا للجيش بسلاحٍ من إيران أو أيّ عدو من أعداء أميركا، حليفِ الاحتلال الإسرائيليّ.
***
الموقف الثاني البارز للمُسيَّرة الإعلاميّة العربيّة: التقليلُ من شأنِ أيّ ردٍّ لحزب الله، حتى عند "التسليم" (على مضضٍ) بحصوله. طاقمُ هذه المُسيَّرة لا يكفُّ عن تردادِ لازمةٍ لا تتغيّر: "تشرّفنا! وإذا أسقط الحزب مُسيّرة؟ وإذا ضرب آليّة؟ وإذا قتل أو جرح إسرائيليين؟ So what؟ شو حرّر فلسطين؟"
الجدير أنّ بعضَ أعضاء هذا الطاقم وصل به الاستخفافُ بعمليّة أفيفيم حدَّ اعتبارها "مسرحيّةً من إعداد نصر الله ونتنياهو،" وصرّح أنّ نتنياهو قدّم للسيّد نصرالله "فرصةً لتنفيس احتقانه" (بعد العمليتين الإسرائيليتين في سوريا والضاحية).
طاقمُ المُسيَّرة الإعلاميّة العربيّة، هذا، لا يُقرّ بأنّ الانتصار قد لا يكون بالضربة القاضية، بل بتسجيل النقاطِ وتركيمِها. النصرُ النهائيّ في حالة الصراع مع "إسرائيل" سيكون، على الأرجح، تتويجًا لسلسلةٍ من الإنجازات، في مختلف الجبهات، لا العسكريّة وحدها؛ بل قد تكون الانتصاراتُ المعنويّة (مثل إرباك العدو، وإقلاقِه، وإيقافِه على "رجلٍ ونصف" تهيّبًا وتوقّعًا وخوفًا، ...)، كما الانتصاراتُ على جبهة عزْل الكيان (اقتصاديًّا وثقافيًّا وسياحيًّا وأكاديميًّا)، أهمَّ أحيانًا.
لكنْ لو حصرنا كلامَنا في ردّيْ حزب الله الأخيريْن وحدهما، فلن يفوتَنا أن نرى فيهما إنجازيْن بارزيْن على الأقلّ، يُمْكن البناءُ عليهما لاحقًا في مسار التركيم:
- الأوّل، أنّ ضرب الآليّة العسكرية في مستوطنة أفيفيم قد نقل المعركةَ إلى فلسطين المحتلّة عام 1948؛ ما يعني زوالَ أيّ خطوطٍ حمرٍ في مجرى الصراع مع العدوّ، والعودةَ بهذا الصراع إلى مربَّعِه الأول: فلسطين 1948، حيث "الخطيئةُ الأصليّة،" أي كيانُ "إسرائيل" نفسُه. إنّ جرأةَ المقاومة على الضرب في فلسطين 48، ولو عند أطرافِها، تُنذر، في حال تفاقُمِ الأوضاع لاحقًا، بنقل الصراع إلى قلب الكيان ومنشآتِه الحيويّة. مَن يضرب أفيفيم لن يخشى من ضرب تل أبيب.

ضرب الآليّة العسكرية في مستوطنة أفيفيم نقل المعركةَ إلى فلسطين
- الثاني خاصٌّ بإسقاط المسيَّرة الإسرائيليّة في جنوب لبنان. هذا الإسقاط قد يؤدّي، في حال تكراره، إلى سحْبِ هذا السلاح الأمنيّ والاستخباراتيّ من دائرة استهدافِ المقاومة، ومن استهداف شعبِنا عمومًا. وهذا، إنْ حصل، سيكون إنجازًا كبيرًا يسجَّل لصالح المقاومة، أمنيًّا واستخباراتيًّا.
***
الموقف الثالث البارز للمُسيَّرة الإعلاميّة العربيّة هو إدانةُ حزب الله لعدم حصوله على "الإجماع اللبنانيّ" قبل القيام بأيّ ردّ على الاعتداءات الإسرائيليّة. الحقّ أنْ لا مقاومةَ على وجه الأرض تحتاج إلى "إجماعٍ وطنيّ" كي تقاومَ الاحتلال. لو انتظرتْ أيُّ مقاومةٍ في العالم موافقةَ شعبها، بمختلفِ أطيافه (وطوائفه ومذاهبه!)، لَما حملت السلاحَ ابتداءً. إنْ ضَمِنت المقاومةُ إجماعًا أو شبهَ إجماع (لأنّ الإجماع مستحيلٌ في أيّ أمر)، فسيكون ذلك أفضلَ بالتأكيد، لكنّ ذلك ينبغي ألّا يكونَ شرطًا مفروضًا عليها لممارسةِ حقّها السياسيِّ والوطنيِّ والقوميِّ والإنسانيِّ والأخلاقيِّ المشروع. وحين أطلق خالد علوان النارَ على الجنود الإسرائيليين في شارع الحمرا صيفَ العام 1982، لم يكن يحظى بدعم الدولة اللبنانية، أيْ نظام الرئيس أمين الجميّل (خليفةِ أخيه بشير، المتعاملِ طوال سنوات مع العدوّ الإسرائيليّ)، لكنّه استند إلى قوة الحقّ والإيمان بالعقيدة. وشيئًا فشيئًا نمَت المقاومةُ، واستطاعت تحريرَ الأرض، بفضل مقاوِمين ومقاوِماتٍ من شتّى الأطياف، بدءًا من الشيوعيين والسوريين القوميين الاجتماعيين والناصريين. فهل تنتظر المقاومة اليوم موافقة الوزيرة "القوّاتيّة" ميّ الشدياق، مثلًا، كي تَردّ على مَن يستهدفُ جمهورَها ومقاتليها؟!
ومع ذلك، فلا ضررَ من تذكير طاقم المُسيَّرة الإعلاميّة اللبنانيّة/العربيّة بأنّ الحكومات اللبنانيّة المتعاقبة، منذ اتفاق الطائف، لم تتوقّفْ يومًا عن تضمين بيانها الوزاريّ فقرةً تؤكّد حقَّ المواطنين اللبنانيّين (لا الدولة فقط) في مقاومة الاحتلال الإسرائيليّ. وحدَهم وزراءُ "القوات اللبنانيّة" (أحفاد بشير الجميّل، المتعاملِ مع ذلك الاحتلال) هم الذين اعترضوا على الفقرة المتعلّقة بـ"حقّ المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيليّ،"[1] في البيان الوزاريّ الأخير الصادر في شباط من هذا العام (2019)، بعدما رُفض طلبُهم أن تضافَ إليها عبارة "مِن ضمن مؤسّسات الدولة الشرعيّة." تنصّ الفقرة بالحرْف على الآتي:
"أمّا في الصراع مع العدوّ الإسرائيليّ، فإنّنا لن نألوَ جهدُا، ولن نوفِّرَ مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانيّةٍ محتلّة، وحمايةِ وطنِنا من عدوٍّ لمّا يزلْ يطمع في أرضنا ومياهنا وثرواتِنا الطبيعيّة، وذلك استنادًا إلى مسؤوليّة الدولة ودورِها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلالِه ووحدتِه وسلامةِ أبنائه. وتؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيِها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبنانيّ من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حقّ المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيليّ وردِّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة."[2]
***
الموقف البارز الرابع للمُسيَّرة اللبنانيّة/العربيّة في إدانة ردّ حزب الله على الاعتداءات الإسرائيليّة هو ربطُ هذا الردّ بـ"الإملاءات الإيرانيّة" و"المحور الإيرانيّ." حزبُ الله لم ينْكرْ يومًا أنّه في هذا المحور، وجزم أنّه ملتزمٌ بإيران عقْديًّا، لا سياسيًّا فحسب. لكنّ هذا لا يعني أنّ كلّ عملٍ يقوم به، خصوصًا ما يسمّى "العمليّات الموضعيّة،" يحتاج بالضرورة إلى موافقة إيران (أو باقي أطراف المحور).
ولنفترضْ، جدلًا، أنّ ردَّ الحزب في الحالتين (جنوب لبنان ومستوطنة أفيفيم) جاء بعد موافقة إيران، فهل هذا مستنكَرٌ أو مُدان؟ ألا يُفترض بمَن يتغنّى بالسيادة والكرامة، ليلَ نهار، أن يهلّل للردّ على اعتداءاتٍ خارجيّةٍ طاولتْ لبنانَ وجزءًا من شعبه (أمْ أنّ الضاحية ليست جزءًا من لبنان، وسكّانَها ليسوا مواطنين لبنانيين)؟ ألم يكن ردُّ حزب الله مشروعًا بغضّ النظر عن أيّ أمرٍ آخر؟ ألم يكن ردُّه جزءًا من مسيرةٍ ردعيّةٍ طويلةٍ حَمَتْ لبنانَ، منذ عدوان تمّوز 2006 على الأقلّ، من حروبٍ أكيدة؟
ثمّ اليست منطقتُنا اليومَ مقسومةً، عمليًّا، بين محوريْن؟ وهل يمكن أن تكون المقاومة (في لبنان وفلسطين بشكلٍ خاصّ) محورًا في ذاتها، أمْ أنّ عليها التنسيقَ مع أطراف المحور المناهض للمحور الأميركيّ ــ الإسرائيليّ ــ التطبيعيّ العربيّ، أيًّا ما كانت مساوئُ المحور الأوّل وثغراتُه؟ ولنفترضْ، جدلًا من جديد، أنّ حزبَ الله ردَّ تحت إملاءٍ إيرانيّ، فهل يُضيرُه أن ينتقدَه مَن يعمل بإملاء المحور المضادّ، الذي يضمّ أنظمةَ التطبيع والارتهان لدونالد ترامب، فضلًا عن... إسرائيل؟
لكنّ الأهمّ من ذلك كلّه هو أنّ اتّهامَ حزب الله بالخضوع للإملاء الإيرانيّ، حين ردّ على اعتداءات العدوّ، يُغْفل أنّ الصراعَ ضدّ الكيان الصهيونيّ بدأ قبل نشوء الثورة الإسلاميّة في إيران بأكثر من ثلاثين عامًا، وأنّ أيَّ ردّ لبنانيّ/عربيّ على الصهيونيّة لا يحتاج إلى "إملاءات" من أيّ طرفٍ في العالم كي يستمرّ. فهذا الصراع باقٍ لأنّ العدوّ، الذي ارتكب الاحتلالَ والتطهيرَ العرقيّ والعنصريّةَ والمجازر، باقٍ، ويواصل شرورَه التي هي جزءٌ لا يتجزّأ من طبيعته ذاتها. وبالمنطق نفسه، فإنّ مقاومة الاحتلال باقية لأنّ الاحتلالَ باقٍ، لا لأنّ إيران موجودة. قد لا تكون المقاومةُ اليوم بهذه القوّة لولا إيران، لكنّ إيران ليست علّةَ وجودها أو مبتدأَه.

الصراع باقٍ لأنّ العدوّ الذي ارتكب الاحتلالَ والمجازر باقٍ
***
الموقف الخامس للمُسيَّرة العربيّة/اللبنانيّة هو تحريضُ اللبنانيين على حزب الله بسبب ردّه المزدوج في أفيفيم والجنوب. هذا الموقف تمثّله صحافيّةٌ لبنانيّةٌ معروفةٌ حَذّرتْ، قبل أيّام، الرئيسَ اللبنانيّ ميشال عون من الإحجام عن الضغط على حزب الله من أجل تفكيك ما يُزعم أنّه "مصنعٌ لتطوير الصواريخ" في البقاع، وإلّا فإنّ الإدارةَ الأميركيّة ستدعم قيامَ "إسرائيل" بتدميره. وهذه الصحافيّة تدعو رئيسَ الحكومة، سعد الحريري، إلى وقف "التسوية" مع الحزب، وترى أنّ تبرُّؤَه من أفعاله (بقوله لشبكة CNBC: "لا أوافق على تصرّفات الحزب، لكنّنا عاجزون عن كبح جماحِه، ولا نتحمّل المسؤوليّةَ عن هجماته الأخيرة على إسرائيل...")، إنما هو "تهكّمٌ على ذكاء الأميركيين واللبنانيين معًا." بل هي تحرّض الشعبَ اللبنانيّ، وقاعدةَ الحريري الشعبيّةَ نفسَها، ضدّ هذا الحزب: "في نظر الإدارة الأميركيّة، كما في نظر شطرٍ من اللبنانيين، بمن فيهم شطرٌ من قاعدة الحريري الشعبيّة، هذا الكلامُ يعني أنّ رئيسَ الحكومة يترك القرارَ السياسيّ والسياديّ والأمنيّ وقرارَ الحرب والسلْم لحزب الله."
وبالروحيّة التحريضيّة عينها، يحثّ أكثرُ من صحفيّ وإعلاميّ لبنانيّ وعربيّ جمهورَ حزب الله على التمرّد عليه. وحجّةُ المحرِّضين هي أنّ ردَّ الحزب على الاعتداءات الإسرائيليّة سيؤدّي بالجمهور إلى الموت والتهجير والخرابِ والرعب. ويشعر القارئ، أثناء قراءة عيّناتٍ من كتابات هؤلاء المحرِّضين (ولا سيّما في مواقعَ مموّلةٍ من قطر والسعوديّة ووزارة الخارجيّة الأميركيّة)، أنّهم يريدون لهذا الجمهور أن يبقى خاضعًا للبلطجة الإسرائيليّة أبدَ الدهر. بل وصل الأمرُ ببعض الصحافيين اللبنانيين أن عدّوا اللبنانيين المؤيّدين لردّ المقاومة مصابون بـ"متلازمة ستوكهولم" بسبب تعاطفهم مع "خاطفيهم" (!). بيْد أنّ هؤلاء الصحافيين الأفذاذ يتناسوْن أنّ جمهورَ المقاومة مستعدٌّ للتضحية ودفعِ الأثمان الباهظة دفاعًا عنها لأنّه يؤمن بها ويثق بقيادتها، ولأنّه ــ في المقابل ــ لا يعوّلُ لحظةً على الشكاوى الرسمية الديبلوماسيّة والدموع السنيوريّة، ويَحتقر الاستسلامَ وحفلاتِ الشاي المرجعيونيّ.
***
الموقف السادس البارز للمُسيَّرة اللبنانيّة/العربيّة هو تحويلُ الأنظار عن مقاومة إسرائيل، باتجاه مَكامن الخلل في الدولة والمجتمع في لبنان والعالم العربيّ. ضِمن هذه المكامن يَمْثل موقعُ حزب الله، المشاركِ في الحكومات اللبنانيّة المتعاقبة، والمساهمِ بقوّةٍ في ثقافة المجتمع اللبنانيّ، المليئةِ بالمساوئ والشرور.
لكنْ، هل يمْكن إدراجُ هذا الموقف، بالضرورة، ضمن المُسيَّرة المذكورة؟
الحقّ أنّ المطالبة بإصلاح "الداخل" من أجل تحسين شروط المواجهة مع "الخارج" موقفٌ قديم، وجليلٌ، ومحترم، وذو جذورٍ ضاربةٍ في فكر "عصر النهضة" عمومًا، ومفكِّري ما بعد هزيمة العام 67 خصوصًا. باختصار، يقول دعاةُ تقديم إصلاح الداخل على مقاومة "إسرائيل" (والاستعمار) إنّ هذه المقاومة لن تُفلحَ في مسعاها ما لم تتخلّصْ من مساوئ الداخل، بما في ذلك العنصريّة والطائفيّة والمذهبيّة والفساد وكلّ ما يَحُول دون ترسيخ الهويّة الوطنيّة الجامعة.
غير أنّ هذا الموقف قد يصبح ضارًّا بالمقاومة، وقد يتساوق مع ترسانة الدعاية المعادية، المسيَّرة أميركيًّا ومن طرفِ بعض المنظّمات غيرِ الحكوميّة المموَّلة خارجيًّا، حين تجري صياغتُه على النحو الآتي: "لا لمقاومة إسرائيل قبل محاربة الديكتاتوريّة والطائفيّة والعنصريّة..."؛ أو: "لن تنجحَ مقاومةُ إسرائيل ما لم ننجحْ أوّلًا في إلغاء الديكتاتوريّة والطائفيّة والعنصريّة..."
إنّ محاربة مكامن الضرر والخلل في مجتمعنا هدفٌ نبيلٌ في ذاته، بغضّ النظر عن أثره الإيجابيّ في عمل المقاومة، وهو واجبٌ على كلّ وطنيّ وتقدّميّ. لكنّ هذا الهدف، في الحقيقة، هو في قلب مقاومة إسرائيل، وربّما يجدر بنا أن ننظر إلى المقاومة - - كفكرةٍ وغايةٍ ومشروعٍ استراتيجيّ - - في وصفها كذلك. فالكيان الصهيونيّ هو أبرزُ تجسيدٍ للديكتاتوريّة (ضدّ السكّان الأصليّين)، والطائفيّة (ضدّ "الأغيار")، والعنصريّة (ضدّ العرب واليهود الشرقيين والفلاشا)، والنهب (للأرض والمياه والنفط والغازِ والتراثِ والطعام والأزياء والموسيقى...)، ولخرْقِ السيادة (أرضًا وبحرًا وجوًّا) في منطقتنا العربيّة. ومن ثمّ، فمقاومتُه هي انتصارٌ لكلّ الغايات النبيلة المضادّة. وأمّا تباهيه بنُصرة المثليين والنسويّات والبهائيين واليزيديّات والأمازيغ والأكراد والموارنة والدروز...، فهو من باب "الغسيل الورديّ" و"الغسيل الإثنيّ" و"الغسيل النسويّ" - - أيْ من باب تغطية جرائمه وعنصريّته ضدّ شعبٍ بأكمله عن طريق تملّق شعوبٍ آخرى أو أقسامٍ منها. كذلك الأمرُ بالنسبة إلى تباهي كيان العدوّ بحدائقه العامّة ومحميّاته الطبيعيّة، المقامةِ على أرضٍ مسروقةٍ ومطهَّرةٍ عرقيًّا من سكّانها الأصليين - - وهو ما يُعرف في أدبيّات مقاطعة إسرائيل بـ"الغسيل الأخضر."
بكلامٍ آخر: لا يمكن أن نكون ضدّ الديكتاتوريّة والطائفيّة والعنصريّة والنهب والاستملاك، ثمّ "تؤجّلَ" مقاومةَ الممثّل الشرعيّ والأبرز لهذه الشرور جميعًا - - ونعني الكيانَ الصهيونيّ، القابعَ على بعد أمتارٍ قليلةٍ منّا! هذا طبعًا ناهيكم بأنّه لا يمكن أن نكون مع "حقوق الإنسان،" ونؤجّلَ في الوقت ننفسه عودةَ مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في بلدنا، وفي مخيّمات البؤس تحديدًا، إلى حين الخلاص من آفاتنا الداخليّة.
على أنّه ينبغي أن يكونَ من قبيل تحصيل الحاصل أنّ ذلك لا يعني أن ننكفئَ عن نقد المقاومة، وحزبِ الله ضمنًا، تحت شعار "لا صوتَ يعلو فوق صوت المعركة" (علمًا أنّ هذا الشعار صحيح، ويعبّر عن إيمانٍ بالوطنيّة والمواطنيّة الحقّة، حين نكون في قلب المعركة فعلًا، كما نحن الآن في لبنان على الأقلّ، ولا نستخدمُه لتغطية فسادنا وقمعنا). فنقدُ المقاومة، من المنطلق التي ذكرناه للتوّ، هو جزءٌ عضويٌّ وحيويّ من المقاومة نفسِها.
***
لقد كشفت الأسابيعُ الماضية، إذًا، عن وجود إعلام لبنانيّ/عربيّ لا يتورّع عن استخدام كلّ الأسلحة المتاحة (السخرية، التشويه، التحريض، التأليب، الإحراج، نقل رسائل التهديد،...) من أجل تقويض مقاومة "إسرائيل" لحساب الرضوخ للقوة الصهيونية وسياساتِ التطبيع العربيّ، لا لحساب تجذير المقاومة وتمتينِها وتعميمِها. التحدّي أمامنا، نحن أنصارَ فلسطين ومقاومةِ الصهيونية، ثقافيّ، لا عسكريّ فقط: ألّا نسمحَ بتحويل قاتلِنا إلى ضحيّةٍ معتدًى عليها، ولا بتحويل مقاومتِنا إلى طرفٍ ينتهك "سيادة" هذا العدوّ وسلامةَ "أراضيه،" وألّا نشاركَ في مراسم الانتشاء بقتل أصحابِ الحقّ.
كنتُ في صدد كتابة خاتمةٍ لهذه الافتتاحيّة حين استمعتُ إلى نشرة الأخبار الصباحيّة، فلفتتني ثلاثةُ أنباء: الأول هو هربُ نتنياهو من تجمّعٍ انتخابيٍّ لحزب الليكود في أشدود، وذلك حين دوّت صافراتُ الإنذار إثر تعرّض المستوطنة لقصفٍ صاروخيّ فلسطينيّ. والثاني هو إسقاطُ مُسيَّرة إسرائيليّة جنوب قطاع غزة البطل على يد "سلاح القنّاصة" في كتائب الشيخ الشهيد عزّ الدين القسّام (ابن جَبلة السوريّة!)، وذلك أسوةً بما فعله أبطالُ الجنوب اللبنانيّ قبل أيّام. والثالث هو إقالةُ ترامب لمستشار الأمن القوميّ جون بولتون، "كبيرِ الصقور" في الإدارة الأميركيّة، ورأسِ حربةِ فرض العقوبات على إيران وكوريا الشمالية، وصديقِ "ثورة الأرز" اللبنانيّة.
حقًّا، يبدو أنّنا نسير في اتجاه غدٍ أفضل!
بيروت