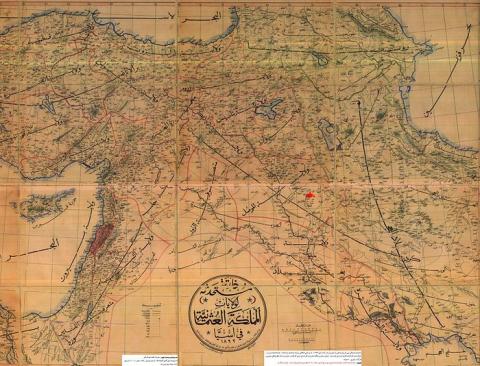هذه المقالة تحاول النبشَ في الماضي بغيةَ قراءة عشرات التصاوير في الألبومات المحفوظة في بطن الأرشيف الرقميّ لأهمّ المكتبات العالميّة، وهي ألبوماتٌ متاحةٌ لحسن الحظّ على الشبكة العنكبوتيّة. إنّها محاولةٌ تتغيّا تَلامُحَ الصورة التي التقطتْها عدسةُ باسكال صباح؛ والاقترابَ من قابليّتها للدراسة السوسيو-أنثروبولوجيّة، باعتبارها وثيقةً تاريخيّةً، وعلامةً بارزةً على ذائقة عصرها، فضلًا عن أنّها إشارةٌ دالّةٌ إلى رؤية المصوّرِ الجماليّة.

***
باسكال صباح Pascal Sébah) 1823 -1886) مصوّر فوتوغرافيّ مولود في اسطنبول، لأبٍّ سريانيّ كاثوليكيّ من"الديار السوريّة" (على الأرجح من لبنان الحاليّ)، وأمٍّ أرمنيّة. كان في السادسة عشرة حين نشرتْ دوريّةُ تقويم وقايع الرسميّة سنة 1839 نبأَ اختراع الفرنسيّ لويس داغير آلةَ التصوير الفوتوغرافيّة.
التصوير الضوئيّ حرفةٌ حداثيّةٌ مدينيّة تزامنتْ ممارستُها في الولايات العثمانيّة مع التغيّرات الاجتماعيّة الطارئة على المدينة، في القرن التاسع عشر، بفعل عواملَ رئيسةٍ أبرزُها: سيرورةُ الإصلاح والتحديث، وتأثيرُ الاحتكاك بالفكر والثقافة الغربيّيْن، وتوسّعُ سوق الرأسماليّة، والحَراكُ التجاريّ لدى الفئات الوسطى في المدن العثمانيّة. وعليه، فإنّ المدينة، التي ازدهرتْ فيها سلعةُ الصورة الفوتوغرافيّة، شكّلت الفضاءَ الذي دار فيه السجالُ على التاريخ؛ والتفاوضُ على التجديد؛ ومحاولةُ تجاوزِ النسق القروسطيّ المتكلِّس والوهنِ السياسيِّ الذي ارتبط بما يُعرف بـ"المسـألة الشرقيّة."
ومع ذلك، فإنّه لم يكن في إمكان باسكال صباح افتتاحُ استوديو "الشرق" للتصوير الضوئيّ، والتدليلُ على منتَجِه وسط اسطنبول سنة 1857، ثم وسط القاهرة التي دَشنّ فيها الاستديو الثاني سنة 1873، لولا بضعةُ ظروفٍ رديفةٍ في سيرة التصوير الفوتوغرافيّ. أوّلُ هذه الظروف شغفُ شخص "السلطان" بالاختراع الجديد، لِما لاقتْه الصورةُ من هوًى في نفسه، علاوةً على إدراكِه دورَها كأداةٍ برغماتيّةٍ حداثيّةٍ ملائمةٍ في صناعة الخطاب السلطويّ. وهذا ما أربك الطريقَ أحيانًا أمام محطِّمي الصور الساخطين، الرافضين صنعةَ التصوير وغيرَها من المِهنِ "الكبائر" المرتبطةِ بـ"أهلِ البِدَعِ" و"هراطقةِ" المحاكاة والتشخيصِ و"المضاهاةِ في الخلق."
هنا لا بدّ من الإشارة إلى أهمّيّة عوامل سابقة، غير مباشرة، أثّرتْ في تقبّل التصوير الضوئيّ، منها: خروجُ رسمٍ زيتيّ يمثّل "السلطانَ" من فضاء القصر الخاصّ إلى الفضاء العامّ، وتعليقُه على جدار إحدى الثكنات العسكريّة سنة 1836؛ في تأكيدٍ على ترادُفِ "أنا" السلطان مع كيان الدولةِ وسياسةِ "التنظيمات،" المعمولِ بها في هيكلةِ الجهازِ العسكريّ والمؤسّساتيّ. كما أنّ لخروج السلطان (الخليفة) برسمه إلى العلن، من خلف ستْره والحِجاب، إشهارًا يقول بعصرنة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وإنْ على نحوٍ "صُوَريّ" لا يمسُّ جوهرَ سدّة الحكم في حقيقة الأمر والتاريخ.
وبناءً على ازدهار السياحة الثقافيّة والتجاريّة، ووفودِ المبعوثين المرسَلين لدراسة "الشرق،" وحجيجِ الأراضي المقدَّسة، وصلتْ آلةُ التصوير إلى العاصمة العثمانيّة، وراحتْ تكتسبُ مكانةً خاصّةً؛ فهذا الاختراع قادرٌ على تثبيت الزمن في "تصويرةٍ" تُستعاد دومًا وأبدًا. وهذا ما دفع جريدةَ الحوادث، التي أنشأها الصحفيُّ وتاجرُ الأخشاب الإنكليزيّ وليم نوسوورثي تشرتشل، إلى نشرِ مقالٍ تصدَّر صفحتَها الأولى عام 1841، عن هذا الابتكار وأهمّيّته. وتوازى ذلك كلُّه مع تدفّق المصوِّرين الفوتوغرافيين إلى العاصمة من مختلف أنحاء أوروبا، وأخذتْ أغلبُ صورهم تقتفي أثرَ الرسم التشكيليّ الاستشراقيّ، بل تتبدّى أمام المصوِّرين المحلّيّين أسوةً بنموذجٍ معياريّ حول كيفيّة رؤية الواقع وتأطيرِ الظواهر البصريّة في المطارح العثمانيّة المختلفة. وعليه، لم يكن مستغرَبًا أن يَفتتح المُصوِّرُ اليونانيّ Vassilaki Kargopoulo استوديو له سنة 1850 في اسطنبول، وتبِعه السريانيُّ باسكال صباح كما ذُكر، ثمّ الألمانيُّ راباخ Rabach الذي افتتح محلَّه سنة 1856، وفيه عمل الأرمنيُّ عبد الله فيشين، قبل انفصاله عنه وافتتاحِ استديو "عبد الله فرير" مع إخويْه (هوسيب وكيفورك) سنة 1858.
وبتوجيه عدسة هذه المقالة المقرّبة نحو التاريخ الاجتماعيّ لتفهّم سبب انتشار مهنة التصوير بين المسيحيّين، يمكن القولُ إنّ النظام الذمّيّ كان وراء اقتصار وظائف الدولة على المسلمين، ما جعل المكوِّنَ المجتمعيَّ المدينيَّ من الأقلّيّات يتّجه في كسب الرزق إلى التجارة والعمارة والترجمة والصيرفة والصنائع والحِرَف المتنوّعة في سوق العمل، التي أمستْ في مرحلة الأفول متعالقًة مع صراعاتٍ اقتصاديّةٍ عالميّةٍ حَوّلت الأمبراطوريّة إلى كيانٍ متصدّعٍ، تنهشه التدخّلاتُ الأوروبيّةُ و"الامتيازاتُ الأجنبيّة." بيْد أنّ "التنظيمات" المتتابعة، وصولًا إلى "الخطّ الهمايونيّ" (1856) الذي ألغى التمييزَ على أساس الدين، جاءتْ بمثابة محاولةٍ إنقاذيّةٍ من قِبل السلطان لإبرام عقدٍ اجتماعيّ جديدٍ مع الرعيّة، ولغضّ النظر عن مفهوم "أهل الذمّة" لصالح "الجامعة العثمانيّة،" كي يستطيع مواجهةَ الحسّ القوميّ الانفصاليّ الذي طفق ينتشر بين المجموعات الإثنيّة.
هكذا دعمتْ السلطةُ، ولو شكليًّا، رابطةً حداثيّةً وطنيّةً مشتركةً، وكان لهذا الأثرُ الأهمُّ في الصورة التي أنجزها باسكال صباح - - وهو مصوّرٌ من "التابعيّة العثمانيّة،" مارس مهنتَه وأرّخ لسرديّات عصره الكبرى في مرحلة احتضار "الرجل المريض." وفي فلكِ هذه الفكرة الجامعة تدور معظمُ صوره؛ ولعلّ أهمَّها - تمثيلًا لهذه السرديّة - ألبومُ الألبسة التقليديّة العثمانيّة، المنجَزُ بتمويلٍ حكوميّ، كي يُقدَّمَ أثناء المشاركة الإمبراطوريّة في المعرض الدوليّ سنة 1873. وقد أقيم هذا المعرضُ في مدينةٍ أوروبيّةٍ، أبوابُها بالغةُ الدلالة في الذاكرة التاريخيّة: فيينا.
من خلال هذا الألبوم (29x37 سم) الموسوم بالفرنسيّة Les Costumes Populaires de la Turquie أرادت السلطةُ التباهي بالكثرة الكوزموبوليتيّة، ورمزيّةِ التخوم القصيّة لأراضي السلطان، و"غرائبيّة" القدرة على التوازن مع احتواء الكلّ اللامتجانس، والقول أوّلًا وأخيرًا: ما أعظمَكِ أيّتها الأمبراطوريّةُ العثمانيّة!
وكان صباح عند حُسْنِ الظنّ الحكوميّ. فقد أنجز في الاستوديو، حيث جرى التصويرُ كما يبدو، عملًا حِرَفيًّا رفيعَ المستوى، والتقط صورًا توثيقيّةً لأزياء الجماعات العثمانيّة (العِرْقيّة، والدينيّة، والمِلليّة، واللغويّة، والبدويّة، والحضريّة، والصوفيّة، والجندريّة، والطبقيّة...). حتى إنّ التصاوير تحتفظ بطاقتها السيميولوجيّة الجماليّة إلى يومنا هذا، فضلًا عن قولها المعرفيّ وروامزِها الجماليّة الهويّاتيّة، البالغةِ الأهميّة، لمختلف الأزياء التقليديّة في الولايات العثمانيّة في منتصف القرن التاسع عشر. كما أنّها جاءتْ متوافقةً بذكاءٍ مع ماهيّة موضوع المعرض: "الثقافة والتربية."
من جانبٍ آخر، لا بدّ من التنويه إلى أنّ انتشارَ طُرُزٍ تعود مرجعيّتُها إلى الزيّ الأوروبيّ (مثل السترة الرجاليّة، وكسواتٍ نسائيّةٍ مختلفة، وإحلالِ الطربوش أو القبّعة محلَّ العمامة)، كان وراء بداية تحوّل الزّيّ التقليديّ إلى فولكلور ماضويّ؛ وهو موضوعٌ عملتْ صورةُ صباح الفوتوغرافيّة على تسجيله في هذا الألبوم، وفي غيره من الصور التي كرّر التقاطَها، استجابةً لازدياد طلب الزبائن الأجانب عليها. فقد كان من عادةِ السيّاحِ الزائرين، آن تحينُ عودتُهم إلى بلادهم، حملُ تَذْكارٍ معهم، يبغون به استعادةَ ما احتوتْه الذاكرةُ أثناء تطوافهم في فضاءات "الشرق." وكثيرًا ما خضع إنجازُ التَذكار لسيرورةِ أسطرةٍ، وتأطيرٍ في كادر "العجيب الغريب،" كي يساعدَ الزائرَ على استحضارِ ما شاهده افتراضًا بأمِّ العين. وربّما كانت أشهر هذه الأعاجيب صورة تُلتقط للزائرين الأوروبيّين مرتدين اللباسَ التقليديَّ، وخصوصًا الزائرة الأوروبيّة التي جذبها حجابُ المرأة المسلمة وأرادت إخضاعَه للاختبار حسّيًّا برؤية نفسها داخل الصورة في لبوسِ "حرْمة" عثمانيّة. وهذه الصورة يمكن العثورُ عليها في مجموعات صباح وغيرِه من مصوِّري المرحلة، لأجنبيّاتٍ زرنَ الاستديو لهذا الغرض، مدشّناتٍ بذلك موضوعًا خصبًا في خطاب الهيمنة والدراسات الجندريّة ما بعد الاستعماريّة في الصورة الفوتوغرافيّة.
* * *
بالعودة إلى ألبوم معرض فيينا، أقول: حين ثبّت صباح الأزياءَ التقليديّةَ ولابسيها في صورةٍ، فإنّه كان يوثّق لحظةً تشير إلى تغيّر الأحوال وانقلابِها. ذلك أنّ هذا التوثيق يوعز برداءٍ آخذٍ في المغيب باتجاه الفولكلور؛ رداءٍ حُكِم عليه بالأرشفة المتحفيّة الرسميّة، أو بالعرض والطلب السياحييْن.
زُوِّدتْ كلُّ صورةٍ في ألبوم الأزياء بشرحٍ تفصيليّ لكلّ زيّ (الطراز والنسيج)، وبتعليقٍ كاشفٍ عن العادات والطقوس وأعرافِ الجماعة الإثنيّة في المناطق الجغرافيّة المتعددة. وقد كَتب الشرحَ الفنّان عثمان حمدي بك (1842-1910)، والباحثُ الفرنسيُّ المقيم في اسطنبول فيكتور ماري دي لاوناي (1822 أو 1823-؟).
مع اسم الرسّام وعالم الآثار عثمان حمدي بك، الذي كان له دورُ الريادة في تشييد المؤسّسةِ الثقافيّةِ الحداثيّة (المتحف، وأكاديميّة الفنون الجميلة، وهيئة التنقيب عن الآثار) وفي إدارتها، نكون قد وصلنا إلى مرجعيّةٍ جماليّةٍ مهمّةٍ في صورة باسكال صباح. ذلك أنّ صلتَه بهذه الشخصيّة التنويريّة، بعد عودتها من الدراسة في باريس، تدلّ على مؤثّراتٍ في تكوين الصورة التي التقطتْها عدستُه.
على الرغم من الانشغالات الإداريّة والعمل البحثيّ، لم ينقطعْ حمدي عن ممارسة الرسم. وقد اتّسمتْ لوحاتُه بأسلوبٍ أكاديميٍّ استشراقيٍّ شديدِ الخصوصيّة؛ فقد وظّف الشكلَ المألوفَ في اللوحات الاستشراقيّة الرومانسيّة لنقض الخطاب الاستشراقيّ، وذلك من خلال شحن مرتسَمات اللوحة بالتفكير النقديّ. ففي عمله المعنون "محراب" (1901) مثلًا، تجثو سيّدةٌ ترتدي فستانًا تقليديًّا على مسند القرآن، منتصبةَ الجذع، وظهرُها إلى محرابِ مسجد، بينما الكتبُ المقدَّسة والتفاسير متناثرةٌ أرضًا تحت قدميْها. هذه صورةٌ بليغةٌ عن أسِّ الحداثةِ أو الدولة المدنيّة، سواء أحالت الشخصيّةُ المرسومةُ على امرأةٍ فاعلةٍ في التاريخ، أو على استعارة الدستور، أو على "الجامعة العثمانيّة" المأمولة. ويبدو أنّ حمدي تعاون مع صباح في التقاط صورٍ لبعض موديلاته أثناء التحضيرات للرسم. وهذه عادةٌ مألوفةٌ، وتكافلٌ مثمرٌ بين الصورة الضوئيّة والرسم حينئذٍ، لدى بعض الفنّانين (ولا سيّما الواقعيّين والانطباعيّين في باريس).
إنّ التملّي في العديد من صور صباح ولوحاتِ حمدي يدعو إلى القول بإمكانيّة عقد دراسةٍ مقارنةٍ بينهما بغية تعقّب نقاطِ التأثّر والتأثير، في سياق رومانسيّةٍ متبدّيةٍ لديهما. ولعلّ أهمََّ المؤثِّرات الخاصّة بصباح تظهر في توزيع الشخوص وكيفيّةِ تقديهم، زرافاتٍ وفُرَادى وتثنيةً، في الصورة الواحدة. فقد عمد إلى مَوْضَعَتِهم مراعيًا شرطيْن أساسيْن: تحقيق التوازن الأكاديميّ في مكوِّنات الصورة؛ والإيحاء أنّ الشخوص كانوا منهمكين في لحظةٍ دراميّةٍ عابرةٍ حين "فاجأتْهم" عدسةُ الكاميرا. بل يمكن القولُ إنّ الصورة تشي بحرص صباح على تصوير الشخوص كما لو أنّهم في رسمٍ تشكيليّ، أو فوق ركحٍ مسرحيّ يؤدّون أدوارَهم وراء الجدار الرابع، غافلين عن المتفرِّج، حتى في الحالات التي يتطلّعون فيها إلى عدسة الكاميرا.

جماعة من بدو سورية
* * *
كان تحديثُ "المدينة" العثمانيّة يجري على قدم وساق؛ ولعلّ هذا ما حفّز الأعمالَ التصويريّة البانوراميّة للحاضرة خارج الاستوديو. وأشهرُ أعمال باسكال صباح، في هذا السياق، التصاويرُ المستقلّةُ التي التقطها من أعلى برج غلاطة القروسطي (ارتفاع 66.90 مترًا)، ليشكّل اجتماعُها، على التوالي، صورةً بانوراميّةً لاسطنبول. ويبدو أنّ ذلك راقه، فوجّه عدستَه الراصدة إلى اسطنبول من برج بايزيد (ارتفاع 85 مترًا). كما قام بعمل بانوراما للقاهرة من اصطفاف خمس صورٍ متتابعة. ومن رحابة هذا التصوير البانوراميّ، تفرّعتْ تنويعاتٌ شتًى، أهمُّها المنظرُ المدينيّ، أيْ تصويرُ الأبنية وعمرانِ المؤسّسة الحداثيّة، مثل المدارس في مدن الولايات المختلفة (بغداد، حلب، بيروت، دمشق..)، والكلّيّات العسكريّة، والمشافي، والقصور السلطانيّة، ومختلف الممتلكات الأميريّة، فضلًا عن الآثار المكتشفة الذي تربط الحاضرَ العثمانيَّ بعراقة الماضي الفينيقيّ والرومانيّ والبيزنطينيّ والفرعونيّ... وهي صورٌ يُمْكن قراءتُها بمثابة دعايةٍ تشدِّد على سمة تواشج الماضي التليد مع الحداثة في الأمبراطوريّة العثمانيّة، وكبروباغاندا تحاول ردمَ الهوّة بين تقدّم "الغرب" وتأخّر "الشرق."
ومن صورة الكلّ البانوراميّة، ومنْظرِِ العمارة الحضريّة المتحضِّرة، التقط صباح صورًا تعقّبَتْ الجزئيَّ واليوميَّ الذي يساكن أحياءَ المدينة. وإلى هذه الصور تنتمي مجموعةُ المِهن الشعبيّة والمستحدَثة. فقد رصدتْ عينُ الكاميرا الأدوارَ الاجتماعيّةَ للمِهن و"الصنائع" في المركز والهامش المجتمعي: بائع السجاجيد المتجوّل، ممثّل (حرفة حداثيّة بامتياز)، راقصات، دراويش، بائع كعك، فلّاح، حمّال، شحّاذ، ضابط، معلّم عربيّ، معلّم تركيّ، كاهن، سقّاء، أب برفقة ابنه البكْر (النسب البطريركيّ)، ثلّة من البدو، راهب، غانية، متصوّفة، نسوة يدخّنّ النرجيلةَ باسترخاء، صورة شخصيّة للسلطان، صورة شخصية لخَصيّ السلطان.. ومعها حاول التقاطَ أحاسيس الفرد والجماعة، في الاستديو أو خارجه؛ وهي أحاسيسُ مَنْ يُوشك على الانخراط في فعل الحياة والعمل.
في أغلب تصاويره تجاهلَ الموديلُ، أو مؤدّي الدور الاجتماعيّ المذكور أعلاه، عدسةَ الكاميرا، ومن ثمّ حدقةَ المتلقّي الناظر؛ إذ وَضع صباح هذا الأخيرَ في ركن "البصبصة" أو التلصّص على الصورة. من ذلك يمكن فهمُ سبب تشظّي بصر الشخوص في كثيرٍ من الصورِ الجماعيّة، في اتجاهاتٍ مختلفةٍ تتجاهل الكاميرا أو تنظر إليها بلا اكتراث، تاركةً الحرّيةَ للمتلقّي في الإبصار، كما الاستبصار.

عالمة مصريّة
* * *
مع كرور الأيّام على استديو "الشرق،" تلقّى باسكال صباح في الفترة الواقعة بين 1877 و1878، توجيهًا من "الإرادة السنيّة" بإنجاز صورٍ لمعاناة العثمانيين، خصوصُا النسوة، آنَ دورانِ رحى الحرب بين روسيا القيصريّة والأمبراطوريّة العثمانيّة، بسبب تصاعد الميول الانفصاليّة لدول البلقان والقوقاز. ويجد هذا النوعُ من الصور تبريرَه في السرديّة الدعائيّة الرسميّة، لاسيّما الموجّهة إلى الخارج؛ ويبدو أنّ أحد هذه التصاوير نُشر في دوريّة Le Monde Illustré الفرنسيّة. وهذا التوظيف الأداتيّ، للصورةِ والمصوّرِ، يأتي انسجامًا مع رؤية السلطان عبد الحميد الثاني الذي أدرك أهمّيّةَ التصوير الفوتوغرافيّ عندما قال: "كلُّ صورة هي فكرة. أحيانًا، تستطيع صورةٌ واحدةٌ أنْ تكون سياسيّةً وعاطفيّةً أكثرَ من مئات الصفحات المدبَّجة. لهذا، أفضّلُ اللجوءَ إلى الصورة عوضًا من المستندات المكتوبة."
من هذه الأعمال الصورةُ الموسومة "امرأةٌ مسلمةٌ مع طفلها المريض" (1877). وفيها امرأةٌ بائسةٌ جالسةٌ على كرسيّ في الاستوديو، ورأسُها مائلٌ نحو الأسفل، ساهمةَ النظر مستكينةً؛ بينما الرضيعُ في حضنها، بأثماله الرثّة وقدميْه العاريتيْن، ينظر إلى عين الكاميرا وكأنّه يخاطب الناظرَ على الجانب الآخر من الصورة. وبهذا وضع صباح حمولةَ رسالةِ الصورة على كاهل الطفل الصغير، مُنحِّيًا الأمَّ عن الخطاب والبلاغة. يا لَذكاءِ هذه الصورة الدعائيّة المبكّرة في تاريخ التصوير الضوئيّ!

سيّدة مسلمة مع صغيرها المريض (1877)
* * *
سافر صباح في أرجاءِ البلاد، ملتقطًا صورًا للبلاد والعباد في الفضاء الخارجيّ، مدلِّلًا على حِرفيّةٍ عاليةٍ، وقدرةٍ على التحكّم بصنعة الضوء والتقاطِ اللحظة المرغوبة. ومن هذه الصور تبرز صورةٌ أعتبرُها من أوائل تصاوير "المنظر الطبيعيّ" في تاريخ ثقافتنا في المرحلة العثمانيّة، وهي الصورة الموسومة بـ"الصحراء" (1868). وفيها يبدو تركيبٌ لثلاث صور "نيغاتيف" منفصلة. والنتيجة صورةٌ قويةٌ في مؤثّرها التصويريّ، ومنظورها المبسَّط.
تمثّل الصورةُ المذكورة هيكلًا عظميًّا لجَمَلٍ (رمزيّة الموت) في البعد الأوّل الأقربِ إلى الناظر، يليه في الوسط جَمَلٌ آخرُ محتضِرٌ (البرزخ الفاصل بين الحياة والموت)، وفي العمق عند خطّ الأفق قافلةٌ من الرُّحَّل تمتطي الإبل (تبدو كأنّها تتبادل النظرَ مع المشاهد). ما أشدَّ إيجازَ هذه الصورة بكلّ القولِ الأنطولوجيّ الذي تنطوي عليه! لعلّ صباح هو مَن شرع بهذه الصورة "فنَّ النزوات،" أي المنظرَ الفانتازيَّ الذي يُطْلِق فيه المصوِّرُ الفنّانُ الحُرّيَّةَ لجنيّاتِ مخيّلته الذاتيّة، ولا يُعنى بدقّة تسجيلِ الواقع أو مطابقتِه حرفيًّا في لقطةٍ واحدة، بل يعيد تركيبَه و"منتَجتَه" وفق تصوّراتِ ما يريد قولَه جماليًّا.

الصحراء (1868)
* * *
سأختتم المقالةَ بالحديث عن صورتيْن مفردتيْن لباسكال صباح، كنتُ قد شاهدتُهما ضمن المقتنيات التي تعود إلى أحد المتاحف الأوروبيّة:
- الأولى (1885) صورة موحية بكلّ وضوح العري الذي فيها. إنها صورةٌ توعِز وتومئ. صورةٌ تتعرّى من الحُجُب لتؤوِّل سيرةَ اللذّة في تاريخ الفضاء الخاصّ، فضلًا عن العامّ لكونها صورةً تباع في السوق. من المرجَّح أنَّها أوّلُ صورةٍ من صور العري في تاريخ الثقافة العربيّة في المدار العثمانيّ. وربّما أنجزها صباح كسلعةٍ تُعرَض على السيّاح، متتبِّعًا بذلك خطى الاستشراق. إلّا أنّ تفاصيلَ السيّدتيْن فيها تشير إلى احتمالٍ آخر.
فثمّة سيّدتان عربيّتان تجثوان فوق سجّادةٍ بكاملِ عريهما. إحداهما مستلقيةٌ أفقيًّا، على نحوٍ تتبدّى فيه بوضوحٍ تفاصيلُها الجسديّةُ كافّةً. وهي تعرض جسدَها، وتنظر بلامبالاةٍ إلى جهةٍ ما خارج الكادر، متجاهلةً المتفرِّجَ تجاهلًا تامًّا. أمّا الصبيّة الأخرى، فينتصب جذعُها خلف زميلتها عموديًّا، متحرِّرًا من الستر، في حين تنظر إلى عين الكاميرا مباشرةً، ومن خلالها إلى المُشاهِد، بلامبالاةٍ، ممسكةً بيدها اليمنى دفَّ الرقص.
- أمّا الصورة الأخرى (1885)، فنصفيّةٌ لمرأةٍ شبهِ عارية، تقف أمام ستارةٍ شرقيّة، ترفع ذراعيْها بمنديلٍ كما لو أنّها انتهت من الاستحمام. رأسُها مائلٌ إلى الأسفل؛ الأمر الذي يجعل زاويةَ مقلتها الهادئةِ المغويةِ ترتفع لتنظر إلى عين كاميرا فاجأتْها في لحظةٍ حميمة.
لعلّ نظرةَ اللامبالاة والهدوء المغوي في العيون فعلُ ذاتٍ مقاومةٍ بشكلٍ من الأشكال، لا ذاتُ سلبٍ. لعلّها تستبطن دعوةً إلى قراءة تاريخنا المهمَل.

هامش: هنا رابطُ ألبوم الألبسة العثمانيّة، المنجَز بمناسبة معرض فيينا (1873)، لمن يريد الاطّلاعَ على الأزياء التقليديّة التي شكّلتْ جزءًا من هويّة الثقافة العربيّة أثناء العصر العثمانيّ: https://archive.org/details/lescostumespopul00osma/page/238/mode/2up