أستاذ في كلية التربية - الجامعة اللبنانية. له أبحاث في مجال التربية والمواطنيّة وشؤون المجتمع المدنيّ، ومنشورات في دوريات علميّة، وكتب منها: وطن بلا مواطنين (2009) وأبناء الطوائف (2007).
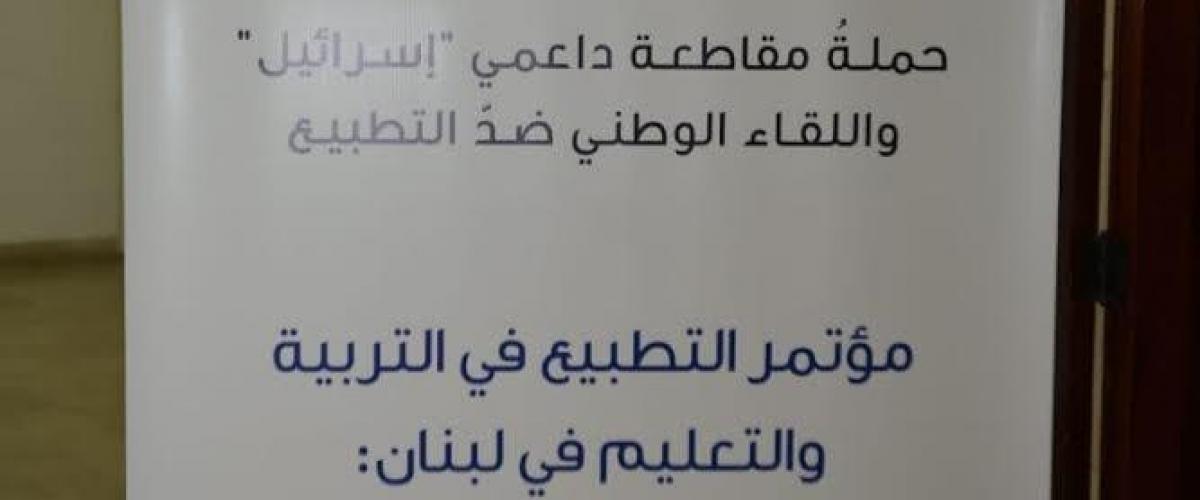
في هذه الورقة، سأجولُ على مجموعة التباساتٍ تشوب عملَ بعض الجمعيّات ومنظّماتِ المجتمع المدنيّ العاملة في قضايا الشأن العامّ في لبنان، لا سيّما القضايا المعنيّة بتقديم المعرفة السياسيّة واكتسابِها وعلاقتِها بوعي الخطر الصهيونيّ ومناهضةِ التطبيع مع "إسرائيل."
الالتباس الأصليّ
يقول المستشار فريدريش إيبرت، مهندسُ فكرة "المجتمع المدنيّ،" إنّ "قضايا المجتمع وحاجاتِه أكبرُ بكثيرٍ من أن تُتركَ للحكومات وحدها." هذه العبارةُ الشهيرة تؤسِّس كلَّ فلسفة المجتمع المدنيّ، وأطره، وآليّاتِ اشتغاله. هكذا يُفترض أن تنهضَ منظّماتُ المجتمع المدنيّ وجمعيّاتُه ومؤسّساتُه بدورٍ متمِّمٍ للدولة ولعملها، من دون أيّ انتقاصٍ لهذه الدولة وسيادتِها، أو أيِّ تشويشٍ عليها، أو منازعةٍ لها. وفي المقابل، يُفترض ألّا تَنْسبَ الجمعيّاتُ ومنظّماتُ المجتمع المدنيّ لنفسها ما هو حصريٌّ للدولة، بمؤسّساتِها ووظائفِها الأمنيّة والاجتماعيّة. ويمكن التدليلُ على تلك الفلسفة من خلال الإطلالة على الإطار الجيوسياسيّ الذي أنبتَ فكرةَ "المجتمع المدنيّ" في كنف الدول الوطنيّة التي تمتلك، في الأساس، عناصرَ قوّةٍ متعدّدةً وكافيةً (ديموغرافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا)، شأن أوروبا الغربيّة تحديدًا.
إذًا، الدولة، مهما كانت قويّةً، غيرُ قادرةٍ على أداء كلّ الأدوار التي تتطلّبها قضايا المجتمع وحاجاتُه؛ فتأتي الجمعياتُ ومنظّماتُ المجتمع المدنيّ لتؤازِرَها و"تتمِّمَ" أدوارَها، كما يُفترض، لا لتَطرحَ نفسَها بديلًا أو منافسًا، خصوصًا في المجتمعات حيث الدولةُ ضعيفةٌ أو ناشئةٌ أو فاشلةٌ أو متعثّرة.
لكنْ في لبنان، يقفز التباسٌ أصليٌّ إلى الواجهة كلّما طُرحتْ إشكاليّةُ الأطر التي يقوم عليها المجتمعُ المدنيُّ، وآليّاتُ اشتغاله، وعلاقتُه بالدولة ووظائفِها. فيغدو المجتمعُ المدنيُّ اللبنانيّ، بجمعيّاته ومنظّماتِه في الأعمّ الأغلب، أقربَ إلى الالتفاف على وظائف الدولة من استكمالها. بل هو يعمل بأجنداتٍ خارجيّةٍ عديدة، وبتمويلٍ أجنبيّ ينافس الموازناتِ المحلّيّةَ بقوّة.
قبل نشوء الدولة اللبنانيّة، كانت المنظّماتُ والجمعيّاتُ الناشئة تُعنى بالصدقة والإحسان والتبرّعات، والتصقتْ بها الصفةُ الطوائفيّةُ الدينيّة لأنها كانت في يد السلطات الدينيّة. وعندما نشأت الدولةُ اللبنانيّة، نتيجةً لإسقاطٍ استعماريّ، دخلتْ هذه الجمعيّاتُ في تنافسٍ مع مجالات عمل مؤسّسات الدولة، وأحيانًا بأجنداتٍ مضادّةٍ لأجندة هذه الدولة. وهذا، في زعمي، أكبرُ التباسٍ، ويمكن أن يضيءَ على جملةِ التباساتٍ لاحقة.
إذًا، ارتبطتْ هذه الجمعيات، من خلال صفتها الدينيّة الأصليّة، بمصادرِ تمويلٍ خارجيّةٍ ذاتِ سقوفٍ عالية. مثلًا، التمويلُ الآتي من المجلس الثقافيّ البريطانيّ، أو الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة (USAID) التي تهتمّ بالتعليم، هائل.[1] الوكالة المذكورة دفعتْ 800 مليون دولار في سبيل تطوير الإستراتيجيّة التربويّة والمِنح الجامعيّة في لبنان، أي إنّها صرفتْ ثلاثةَ أضعاف موازنة الجامعة اللبنانيّة السنويّة كلّها بعديدِها وعدّتِها وأساتذتِها وطلّابِها وموظّفيها وكادرِها! وقبل ذلك، خلال العام 2007 وحده، دفعت الوكالةُ 5 ملايين دولار من أجل مشاريع تربويّة مختلفة.[2]
فإذا كانت هذه الأموالُ "متمِّمةً" لرؤية الدولة المانحة، وفق الفلسفة التي تقوم عليها فكرةُ "المجتمع المدنيّ" في بريطانيا أو الولايات المتحدة، فهي لا تتّفق بالضرورة مع رؤية الدولة التي تصرف فيها المنظّماتُ والجمعياتُ الأموالَ الممنوحةَ لها. وهي غيرُ منسجمةٍ بالضرورة مع حاجات المجتمعات المحلّيّة.
إشكاليّة تخريج الالتباسات في المصطلحات
إنّ الدعمَ والتمويلَ والتمكينَ وبناءَ القدرات، جميعَها مشاريعُ موجَّهة، لا يمكن فصلُها عن الأموال التي تُدفع من أجل تحقيق التوافق مع أجندات المموِّلين ومصالحِ دولهم، لا من أجل التكامل مع عمل الحكومات والمجتمعات المحلّيّة. بيْد أنّ الأمر يستدعي تخريجَ المصطلحات وبسطَها وتشريحَها للتبصّر في الأجندات المرافقة لها، ولتأمين وعي المجتمعات المحلّيّة بخطورة هذه المشاريع الوافدة إليها تحت غطاءٍ منمَّق، فيكون المرءُ غالبًا أمام مصطلحاتٍ ملتبسة: غَضّةٍ في المظهر ومَضّةٍ في الباطن.
من هذه النصطلحات على سبيل المثال: "التربية على المواطنة الحاضنة للتنوّع الدينيّ" و"قبول الآخر" و"التعامل مع الآخر المختلف" و"منع التطرّف العنيف" و"التربية على السلام" و"حلّ النزاعات بالطرق السلميّة،" وغيرها من المصطلحات التي يجري الترويجُ لها من أجل إشاعة معرفةٍ سياسيّةٍ متساهلةٍ مع وعي الخطر الصهيونيّ، وتمرير المشاريع المؤدّية إلى التطبيع معه.
من قاموس المصطلحات الملتبسة
أ - "المواطنة الحاضنة للتنوّع الدينيّ" و"قبول الآخر." هذه صيغة ملتبسة، ومحطُّ جدل، ومثارُ ريبة، تُروِّجها "مؤسّسةُ أديان" بتمويلٍ بريطانيّ/أميركيّ ضخم. وقد أَسَرَتْ من خلالها كلًّا من وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربويّ للبحوث والإنماء في لبنان، وانطلقتْ بها من لبنان إلى العراق...[3]
صيغة "المواطَنة" هذه تبدو في ظاهرها لطيفةً، نظيفةً، خفيفةً، مطواعةً: تتوخّى بناءَ جسورٍ للتلاقي، ولكنْ دائمًا بين المختلفين دينيًّا من أبناء الوطن الواحد، وبمبالغةٍ مهولةٍ تنتهي إلى تأبيد عناصر هويّاتهم الدينيّة المختلفة، على الرغم من رابطتهم القوميّةِ الجامعة.
على أنّ هذه الصيغة، المندفعةَ بفعل الأموال التي تُصرَف عليها، تَستكمل سياقًا تاريخيًّا كان الأب سليم عبّو اليسوعيّ من أبرز المنظِّرين له في أبحاثه عن التعدّديّة، وأسماها "المواطَنة الفارقيّة" (Differentiated Citizenship)، محاولًا التوفيقَ بين المساواة في الحقوق الممنوحة للمواطنين الأفراد بحسب المقاربة المدنيّة للمواطنة، وحقوقِ الجماعاتِ الطائفيّة التي ينتمون إليها في المجتمعات المتعدّدة دينيًّا التي لم يشهدْ سياقُها الاجتماعيّ تبلورًا لمفهوم "المواطَنة" القائمة على أساس الفرد. هكذا تكون للمواطنين من الدين نفسه حقوقٌ متماثلةٌ سياسيًّا ومدنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، بيْد أنّ الدين يصبح عاملًا للتفريق في هذه الحقوق ين المواطنين المنتمين إلى أديانٍ مختلفة. وهذه الخلفيّة، المناقضةُ تمامًا للمقاربة المدنيّة للمواطَنة، تدعم الصيغةَ الطائفيّةَ وسياسةَ المحاصصة القائمة في النظام اللبنانيّ، حيث الحقوقُ السياسيّةُ متمايزةٌ بين اللبنانيّين، وكذلك حقوقُهم المدنيّةُ بسبب اختلاف أنظمة الأحوال الشخصيّة داخل الطوائف الدينيّة.
إذًا، فإنّ "المواطَنة الحاضنة للتنوّع الديني" تُلْحِق منظومةَ المواطَنة بالانتماء الدينيّ، فيصبح الوعيُ الدينيُّ للجماعات منطلقًا لحيازة الأفراد حقوقَهم، كلّ بحسب ذلك الانتماء. ويستتبع الوعيُ الدينيُّ وعيًا ثقافيًّا واجتماعيًّا، وصولًا إلى الوعي القوميّ: فيَغْرق المسيحيُّ في خصوصيّته الدينيّة ويحوِّلها إلى وعيٍ ثقافيّ واجتماعيّ وقوميّ ("الوطن المسيحيّ")، ويَغْرق الشيعيُّ في شيعيّته في حالها القصوى وصولًا إلى امتدادها الجيوسياسيّ العابر إلى حدود إقامة دولة الولاية، ويَغرق السنّيّ في سنّيّته متماهيًا مع "مملكة الخير" أو "الخلافة العثمانيّة،" وهكذا. وجميعُ هذه المشاريع تقدِّم التبريرَ "الوجوديَّ،" ولو عن غير قصدٍ أو وعي، لديمومة الكيان الإسرائيليّ الذي قام - هو الآخر منذ البداية - بتحويل الوعي الدينيّ اليهوديّ إلى وعي ثقافيّ واجتماعيّ، وصولًا إلى وعي قوميّ داعٍ إلى إنشاء وطنٍ بصفةٍ دينيّة (لا قوميّة) للمنتمين إلى الدين الواحد. وعلى هذا المنوال، قد تصبح المنطقةُ الممتدّةُ من فلسطين إلى العراق، مرورًا بلبنان وسوريا، "إسرائيليّاتٍ" دينيّةً ومذهبيّةً.
ب - "منع التطرّف العنيف." راجت هذه الصيغةُ لدى منظمة الأمم المتّحدة للعلم والتربية والثقافة (اليونيسكو)، وغزت برامجَ الإعداد والتدريب وبناءِ المهارات، لا سيّما لدى الجمعيّات ومؤسّسات التعليم العالي.[4] وقد ارتبطتْ هذه الصيغة بتعريف "الإرهاب" بشكلٍ استنسابيّ، ولغاياتٍ مشبوهة، ما يجعلها سيفًا مُصْلتًا على حركات المقاومة والتحرّر الوطنيّ، خدمةً لمشاريعَ سياسيّةٍ مغايرة.
هكذا تقف الأجنداتُ السياسيّةُ للدول النافذة لتصادِرَ حقَّ الشعوب في الدفاع عن نفسها وتقريرِ مصيرها. وتُلفي هذه الشعوبُ نفسَها إزاء تهمةٍ جاهزةٍ بالتطرّف والعنفِ والإرهاب، مع أنّه يستحيل أن تكون حركاتُ المقاومة والتحرّر في منأًى عن استخدام القوّة في الدفاع المشروع عن النفس والأرض ضدّ مَن يعتدي وينهب ويقتل! وهو ما يجعل صيغةَ "منع التطرّف العنيف" وصفةً جاهزةً لوأد تلك الحركات عبر التربية، لصالح قوى الاستعمار والهيمنة.
ج - "التربية من أجل السلام" و"حلّ النزاعات بالطرق السلميّة." جرى الترويجُ لهذه الصيغة بموازاة مؤتمر مدريد (1991) ووعود "السلام" القادم إلى المنطقة مع بدء المفاوضات العربيّة-الإسرائيليّة ومشاريع "حلّ" القضيّة الفلسطينيّة وشرعنة الكيان الصهيونيّ والتطبيع معه.
وعلى الرغم من تعثّر مسار المفاوضات والتفريط بالحقوقِ العربيّة، وعودة الانتفاضة (2000)، فإنّنا نجد جمعيّاتٍ كـ"جمعيّة أديان" لا تزال تستقي دعمَ المؤسّسات الدوليّة المانحة العاملة على خطّ ترويج السلام والتطبيع مع العدوّ الصهيونيّ. هكذا دعمت السفارةُ البريطانيّةُ في بيروت مشروعَ الشراكة بين "جمعيّة أديان" والمركزِ التربويّ للبحوث والإنماء من أجل إطلاق مشروع "التربية على السلام الإيجابيّ وحلّ النزاعات."[5]
لاحقًا، سُوّقتْ فكرةٌ مؤدّاها أنّ هذه المشاريع تَخْدم "بناءَ السلْم الأهليّ" وتَضْمن الأمنَ المجتمعيّ من خلال تجنّب النزاعات واكتسابِ مهاراتٍ للتعامل معها وحلّها.
نحن نرى أنّ ذلك المسعى خبيث، ويخفي نوايا مبيّتةً، ويقدّم وصفاتٍ مقبولةً في الظاهر ولا تستدعي الاستنفارَ، ولكنّها ذاتُ مرامٍ بعيدةٍ وتدعو إلى التوجّس. فالسلْم الأهليّ غيرُ السلام مع العدوّ الصهيونيّ، وحلُّ النزاعات الداخليّة غيرُ حلّ النزاعات القائمة في المنطقة. فما نعانيه ليس محضَ "نزاع عربيّ-إسرائيليّ،" بحسب توصيف المؤسّسات المانحة، ولا يتطلّب مجرّدَ "ربط نزاع" أو "فكِّ اشتباك"... وسط إعراضٍ كاملٍ عمّا تختزنه القضيّةُ الفلسطينيّة من حقوقٍ مسلوبةٍ للعرب، وعنصريّةٍ دينيّةٍ يهوديّة، ومصالح استعماريّةٍ غربيّة.
وقد انجرّ المركزُ التربويّ للبحوث والإنماء في سياقٍ يجعل منه منفِّذًا لدفتر شروط الجهات المانحة. فقد طوّع خطابَه في بُعده السياسيّ نحو رفض إدراج عبارة "العداء للكيان الصهيونيّ،" وربطَ هذا العداءَ بالعداء لكلّ مَن يعتدي على السيادة اللبنانيّة. وهكذا لم يعد الصراعُ مع هذا الكيان عداءً وجوديًّا، بل بات صراعَ حدودٍ أو نفوذٍ وتنازع، ريثما يحين أوانُ الحلّ "السلميّ" معه.
***
أخيرًا، فإنّ الجمعيّات ومنظّمات المجتمع المدنيّ في لبنان مصابةٌ بحالة إنكارٍ شديدةٍ تجاه وعي الخطر الصهيونيّ ومناهضة التطبيع. وهي تستثمر في استعراضٍ كلاميٍّ يعمِّق الهوّةَ بين الكلمة والأشياء، فتلتبس المعاني عن قصد، وتنتفخ المصطلحاتُ ليصبحَ ظاهرُها دسمًا وباطنُها سمًّا يسعى إلى تجرّع التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ رويدًا رويدًا، في ظلّ تدفّق المال الكثير وتلاقي المصالح والنفوذ.
بيروت
[1] تُراجع التقاريرُ السنويّة وموازناتُ الصرف على المشاريع المنفّذة على موقعَي المجلس الثقافيّ البريطانيّ والوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة.
[2] المصدر المذكور سابقًا.
[3] مراجعة موقع مؤسسة أديان على الإنترنت.
[4] موقع المكتب الإقليميّ لليونيسكو - بيروت: برنامج منع التطرّف العنيف.
[5] موقع مؤسّسة أديان، مصدر مذكور سابقًا.
أستاذ في كلية التربية - الجامعة اللبنانية. له أبحاث في مجال التربية والمواطنيّة وشؤون المجتمع المدنيّ، ومنشورات في دوريات علميّة، وكتب منها: وطن بلا مواطنين (2009) وأبناء الطوائف (2007).










