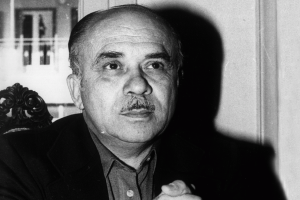اتفاقيّاتُ التطبيع العربيّة التي تتالت قبل شهورٍ وأسابيعَ من رحيل ترامب عن الحكم في الولايات المتحدة تُثْبت أمرًا نسيناه أو تناسيناه: أنّ ما كنّا قبل عقود، زمنَ عبد الناصر و"الحكيم" ووديع وغسّان، نعتبره رجعيّةً عربيّةً متحالفةً مع الإمبرياليّة والصهيونيّة، هو فعلًا رجعيّةٌ عربيّةٌ متحالفةٌ مع الإمبرياليّة والصهيونيّة. "فضيلةُ" الاتفاقيّات الأخيرة أنّها قدّمتْ إلينا دليلًا إضافيًّا - ونهائيًّا كما نأمل - على هذا الأمر، الذي كان بعضُنا يتمنّى أن يكون محضَ "خطأ إيديولوجيّ" سبّبه انتماءُ تلك الرجعيّة إلى رابطة "العروبة" التي تَجْمعنا بها.
اليوم نعي تمامًا، وأكثرَ من أيّ وقتٍ مضى، أنْ لا شيءَ يَجْمعنا بهذه السلالات العائليّة التي تتحدّثُ العربيّة، وتكتبُ بالعربيّة، وتصلّي بالعربيّة، وتتناولُ طعامًا عربيًّا، لكنّها لا تنتمي إلى مشاعر الغالبيّةِ الساحقةِ من العرب وتطلّعاتِها، وإنّما هي محضُ "جاليةٍ" من المستعمِرين أو المستوطِنين أو المغتصِبين المحلّيّين.
علينا اليومَ، أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى بالتأكيد، إعادةُ تصويب فهمنا لـ"العروبة" بحيث لا يستند أساسًا إلى روابط الدم واللغةِ والدينِ والتراث، بقدْر ما يستند إلى عنصر التصدّي - فعلًا لا قولًا - للعدوّ المشترك، "إسرائيل": مَن يطبّعُ، ثمّ يتواطأ، وبعدها يتحالفُ، مع هذا المحتلّ العنصريّ المجرم، بعيدٌ كلَّ البعد عن العروبة، ولو انتمى إلى أعرق القبائلِ العربيّة، وتسلسلَ من ذريّةِ النبيّ محمّد، واعتمَر الكوفيّةَ، وفخّم ألفاظَه العربيّة، ووصف نفسَه براعي الأماكنِ المقدّسة وحامي حِمى المسلمين.
هذا ليس كلامًا عاطفيًّا، مع أنّ أنظمةَ الخيانة تستحقّ أقسى مشاعر الغيظ تفجّرًا. الأنظمة التي طَبّعتْ مع العدوّ سرًّا، وعلى استحياءٍ، طوال عقود، ها هي تطبّع اليومَ معه بكلّ "فخرٍ،" وعلى رؤوس الأشهاد، وتريدُ من الناس العاديّين أن ينْحُوا نحوَها كأنّها مثالٌ يُحتذى! وهي قد انتقلتْ مؤخّرًا من طور التطبيع إلى طور التحالف الشامل والمعلَن مع "إسرائيل" وأميركا ضدّ شعبِ فلسطين، وضدّ كلّ مَن يدعمُه بالسلاح والتدريبِ والموقف، عربيًّا كان أو غيرَ عربيّ، مؤمنًا أو ملحِدًا أو زنديقًا أو لاأدريًّا.
والتطبيع لا يعني، كما ظنّ البعض، إعادةَ العلاقات إلى طبيعتها؛ فالعلاقات مع العدوّ لم تكن في الماضي طبيعيّةً كي "تعودَ" كذلك. وإنّما يعني جعلَ ما ليس طبيعيًّا - بحسبِ التاريخِ والتربيةِ والعادةِ والفطرةِ والحسِّ السليم - يبدو وكأنّه طبيعيّ، بل كأنّه منطقيٌّ وحداثيٌّ ومنتمٍ إلى روح العصر أيضًا. وهذا ما فعلتْه الأنظمةُ المطبِّعة، التي لا علاقةَ لها بالمنطق والحداثةِ وروحِ العصر (إلّا من أكثر الوجوهِ استهلاكيّةً وتبعيّةً وبهرجةً فارغةً)، طوال سنواتٍ من الضخّ الإعلاميّ، قبل أن تبلغَ قعرَ الخيانة الشاملة. وهو ما يفضي إلى نتيجةٍ واحدةٍ جليّةٍ، بعيدةٍ عن كلِّ ما قد يُوهِم بالقرابة الدينيّة أو العائليّة أو اللغويّةِ أو المصلحة المشتركة، وعن كلّ "جسور" سعد الدين إبراهيم العتيقة: أنّ هذه الأنظمة هي في معسكر العدوّ، وينبغي اعتبارُها كذلك.
***
إذًا، "فضيلةُ" الخيانات العربية الجديدة أننا كنّا "في غَفْلةٍ" من سرّيّتها، فجاءت الاتفاقيّاتُ العلنيّةُ الجديدة لتكشفَ الغطاءَ عنّا كي يكون بصرُنا اليومَ حديدًا (بحسب التعبير القرآنيِّ البليغ). وهذه الرؤيةُ "الحديدُ" ينبغي أن تكونَ بدايةَ التغيير الجذريّ المنشود. لكنْ يجب أن يُرافِقَ ذلك تأكيدُ ثلاثة أمور:
الأوّل، أن نتخلّى جميعًا عن وهمٍ يقول إنّ الأنظمة المطبِّعة دعمتْ فلسطينَ ذاتَ يوم. فالدعمُ الماليّ الذي قدّمتْه في الماضي، بل تقدِّمُه في الحاضر أحيانًا، لم يكن موجَّهًا آنذاك، وليس موجَّهًا الآن، إلّا نحو قسمٍ محدودٍ جدًّا من الفلسطينيّين، وبهدفٍ يزدادُ جلاءً يومًا بعد يوم، ألا وهو: تكريسُ نهجٍ فلسطينيٍّ موالٍ لتلك الأنظمة، يُفضي إلى التنازل عن حقّ العودة وعن تحرير كامل فلسطين. كلُّ أموال النفط هدفتْ إلى شقّ الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة من أجل تكريسِ خطّ التفريط والاستسلام، و/أو جرِّها إلى خدمة سياسات النظام المموِّل.
والثاني، أنّ "تحريرَ فلسطين" ينبغي ألّا يقتصرَ على التعاطف والتضامن اللفظيّيْن مع شعبها داخل فلسطين، بل يعني أساسًا أن نكون "فلسطينيّين" حيث نحن: فنجرِّمَ التطبيعَ من داخل مجالسِنا التمثيليّة، ونقاطعَ الشركاتِ والمؤسّساتِ الداعمةَ للعدوّ في أسواقنا، ونقفَ بصلابةٍ ضدّ أيِّ استباحةٍ لحقوق الفلسطينيّين المدنيّة والسياسيّة في ممارساتنا بذريعة الخوف من "التوطين" (حالة لبنان تحديدًا)، ونبنيَ تحالفاتٍ شعبيّةً داخليّةً للدفاع عن "القضيّة الفلسطينيّة" في وصفها قضيّةَ كلِّ واحدٍ منّا: أسراها أسرانا، وشهداؤها شهداؤنا، وأطفالُها أطفالُها، وحريّتُها حريّتُنا.
والثالث، أنّ موقَفنا من أنظمة التطبيع والخيانة ينبغي ألّا ينسحبَ على الشعوب في الأقطار التي تَحْكمُها. فهذه الشعوب، في غالبيّتها الساحقة، كما أثبت أكثرُ من استطلاع رأيٍ وبرنامجِ "كاميرا خفيّة،" تَرفض التطبيعَ والسلامَ مع العدوّ، ولكنّها لا تملك حيلةً أو أداةً لتغيير الوضع المفروضِ عليها. والسببُ يعود إلى القمع الطويل والشرس، الذي لا بدَّ من أن يشتدَّ إحكامًا من الآن فصاعدًا بفعلِ توثيقِ عُرى التعاون الأمنيّ والاستخباراتيّ مع نظامَي الإرهاب الدوليّ والإقليميّ في الولايات المتحدة والكيان الصهيونيّ. وعليه، فإنّ نبذَنا لـ"عروبة" الأنظمة المطبِّعة يوجِب توثيقَ العلاقات مع الشعوب وحركات التحرّر داخل الأقطار التي تحْكمها.
***
هناك، إذًا، ضرورةٌ ماسّةٌ للاستثمار الفكريّ والنضاليّ والشعبيّ في عروبةٍ جديدة، تكون بوصلتُها فلسطينَ والعداءَ لمديمي احتلالها (أو احتلالِ أيِّ جزءٍ منها) ولو كانوا "عربًا." لا شيءَ ينبغي أن يَجمعَنا، كعربٍ نسعى إلى الخلاص من الاحتلال والاستعمار، بـ"عربٍ" آخرين يتحالفون مع الاحتلال والاستعمار لمجرّد هجْسِهم بحماية عروشهم، أو لرغبتهم في إخراجِ أنفسهم من "قائمة الإرهاب" التي زجّهم بها أصلًا زعيمُ الإرهاب في العالم (حالة السودان). وهذه العروبة الجديدة، ذاتُ البوصلة الفلسطينيّة التحرّريّة الواضحة، أقربُ إلى أن تكونَ - ولو مجازًا - هويّةَ مواطنٍ إيرلنديٍّ أو إسبانيٍّ يَرفع علمَ فلسطين في المدرّجات الرياضيّة العالميّة، من هويّة مواطنٍ سعوديٍّ أو إماراتيٍّ يَرفع علمَ "إسرائيل" حين يصل إلى فلسطين المحتلّة "سائحًا" (خفِّفِ الوطءَ!) أو يصلّي في المسجد الأقصى وهو يَعْلم أنّ الاحتلالَ يمنع أهالي فلسطين (والقدسِ نفسِها) من الصلاة فيه.
على أنّ هذه البوصلة الفلسطينيّة لا تقود إلى إهمال التغيير الداخليّ من أجل العدالة الاجتماعيّة والخلاص من الفساد والتبعيّة والاضطهاد والعنصريّة. فالعملان متكاملان، على ما كرّرنا عشراتِ المرّات. غير أنّ الحديث في هذا المقال يتناول تحديدَ معنى العروبة في سياق التطبيع والخيانة العلنيّ المستجدّ.
***
غير أنّ هذه العروبة الجديدة تحتاج إلى حاملٍ يروِّجها وينافحُ عنها ويُظهِّرُها مشروعًا "مُغْريًا" للناس العاديّين. جائحةُ كورونا الثقافيّة والإعلاميّة والتربويّة سبقتْ بَلْواها الصحّيّة. لقد عمّ وباءُ التطبيع، منذ عقودٍ، منابرَنا الثقافيّةَ والتربويّةَ والإعلاميّةَ وصفحاتِ التواصل الاجتماعيّ. وهذا ليس مَجازًا الآن، وإنّما حقيقة نلمسُها يوميًّا:
- مع كلّ مثقّفٍ يبرِّر السلامَ مع الكيان الصهيونيّ بضرورات الاقتصاد والانفتاح والعولمة والواقعيّة وحوارِِ الأديان والثقافات، وبحجّة "تفوُّق" خصوم أميركا والكيان الصهيونيّ (مثل إيران وكوبا وفنزويلا) في الشرور والمظالم.
- ومع كلّ منهجٍ تربويّ يُسْقط فلسطينَ من التدريس بذريعة عدم الرغبة في "تسييس" التعليم، أو بدعوى "إشكاليّة" طرح القضيّة الفلسطينيّة في المُناخ السياسيّ المحلّيّ (حالة لبنان).
- ومع كلّ نشرةِ أخبارٍ تؤجِّل الكلامَ على الحدث الفلسطينيّ اليوميّ الدامي إلى نهايتها (الدقيقة 25 مثلًا)، وكأنّ فلسطين تنتمي إلى كوكبٍ آخر؛ أو تتعاملُ مع خارطة فلسطين وكأنّها خارطةُ "إسرائيل." والأمرُ عينُه ينطبق على كلّ برنامجٍ سياسيّ يستضيف محلّلًا إسرائيليًّا بزعم الحرص على الاستماع إلى "الرأي الآخر."
- ومع كلّ منشور على وسائل التواصل الاجتماعيّ يعلن أنّ "لبنان أوّلًا" أو "الأردن أوّلًا" أو "مصر أولًا"...، وأنّنا "تعبنا" من حمل فلسطين فوق ظهورنا، وأنّ السلامَ حقيقةٌ بشريّة راسخة، وأنّ زمنَ النضال المسلّح والمقاطعة المدنيّة ولّى وانقضى، إلى ما هنالك من شعاراتٍ حُفرتْ (وحفرناها بأنفسنا أحيانًا) في أذهاننا على مرّ السنوات، حتى بات نقضُها يتطلّب عملًا تربويًّا وإعلاميًّا وثقافيًّا جادًّا وقاسيًا؛ ذلك لأنّه لا يمكن الركونُ إلى الفطرةِ والحسِّ السليم وحدهما وسط هذا الضخّ الإعلاميّ التطبيعيّ الممنهجِ والمسعور.
بكلامٍ آخر: الكورونا الشاملة التي تكاد تخنقُنا لم تكن من عمل الأنظمة وحدها، وإنّما شارك كثيرون منّا في تعميمِ مقولاتها واستبطانِها، كلٌّ في مجاله، حتى أوهَمْنا أنفسَنا أنّها من المسلَّمات أو البديهيّات التي لا مَحيدَ عنها. بل إنّ قسمًا منّا رَوّج أنّ التغييرَ الفعليّ لا يمكن أن يتمَّ إلّا من طرف "الدولة" (الأنظمة)، مع أنّ هذه هي المسؤولةُ الأولى عن حال البؤس والذلّ التي بلغناها. غيابُ "الدولة" عن مسؤوليّتها لا يعني أن نَهْجرَ مسؤوليّاتِنا، وإلّا بتنا عوْنًا لهذه الدولة الفاشلة والقامعة التي ننتقدها، وحليفًا لداعميها الدوليّين.
الحمْل ثقيلٌ على كلّ واحدٍ فينا، لكنّ إلقاءَه عن ظهورنا، بدلًا من التشارك في حمله، يزيدُ من وطأته مع الأيّام، ويفاقمُ من إطباق الأنظمة على أنفاسنا.
***
فلسطين فكرةٌ لا جغرافيا، وأفقٌ للمواجهة لا للتكيّف، ومجازٌ للحلم لا وصفةٌ للتبرير. والنضالُ من أجل تحريرها هو نضالٌ من أجل تحرير أنفسنا من الشلل والكسلِ والأنانيّة، ومن أجل تجديد فهمنا للأخوّة والحبّ... والعروبة.
بيروت