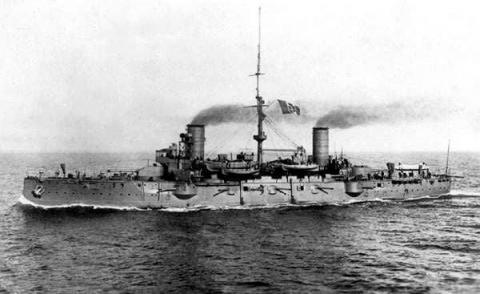"لا طائل من علاقتنا": بهذه العبارة المُحبِطة أنهيتُ دردشتي معه قبل أن أخرجَ من حسابي على الفيسبوك. بعد يومين فقط دار بيننا حوارٌ آخر انتهى على هذا النحو: "أنتَ سفينتي التي أنتظر." هكذا كانت أحاديثُنا، أشبهَ بأحاديث المراهقين: نتخاصم ونتصالح عدّةَ مرّات في اليوم. كانت الرسائلُ تروح وتجيء بيننا، لتغزلَ حكايتَنا شالًا من الوعود والأماني. لكنّ الكلمات كانت سببًا للخصام وسوءِ الفهم أيضًا: فالكلمة المكتوبة تعجز في كثير من الأحيان عن نقل المراد منها؛ ورُبَّ كلمةٍ تقولها لشخصٍ وجهًا لوجه مع ابتسامة خفيفة تعطي معنًى لا يتّفق ومعناها الحقيقيّ لو أرسلتَها عبر الإنترنيت. وهذا ما كنتُ أطلق عليه مصطلح: "جفاف الكيبورد،" وهو ما كان يُظهرنا أشبهَ بالمراهقين كما قلت.
هو في منتصف السبعين. متزوّج، وله أولاد، ويكبرني بأكثر من عشرين سنة. وأنا متزوّجة منذ خمس سنوات، لكنْ لا أولادَ لي. كتبتُ له يومًا: "أحبُّ زوجي، لكنني أحبّكَ أيضًا." فسألني: "كيف سيتّسع قلبُكِ لكليْنا؟" ورددتُ: "لا تسأل." ولم يعد إلى هذا السؤال. "الحياة تتسرّب من بين أصابعي" ــــ هكذا عبّر ذاتَ مرة ــــ "وما بقي أمامي أقلُّ ممّا مضى، ويخيفني هذا الأمر." فهمتُ كلامه جيّدًا لأنني أحترم ضعفَ الإنسان، وأحترم ضعفي ولا أخجل منه. ولطالما تساءلتُ: "لماذا يُطلب منّا أن نكون شجعانًا أو أقوياء؟" وأذكر أنّ أحد أساتذتي في الجامعة أجاب عن سؤالي حين قال في إحدى المحاضرات: "إنّ الإيديولوجيّات، على اختلاف أنواعها، هي ما يحشرنا في الزاوية ويجرّدنا من صفاتنا الإنسانيّة الأصيلة." لذلك عندما حدّثني عن خوفه فهمتُه، واحترمتُ هذا الخوف.
***
يا لَهذا الفيسبوك كيف جمعنا! لفت انتباهي اسمُه، جواد، حين رأيتُ إحدى صديقاتي تضع إشارةَ إعجابٍ على بضعة كلماتٍ كان قد نشرها على صفحته، فيها الكثيرُ من الرومانسيّة، مع خاتمةٍ طريفةٍ توحي بالذكاء. دفعني فضولي إلى قراءة المزيد، فدخلتُ إلى حسابه. لم أجد له صورةً أو ما يعرِّف بشخصيّته أو اسم عائلته، لكنّ الاسم أمسكَ بي وكبّلني. أعجبني ما قرأتُ، وزاد من فضولي. وعلى غير عادتي في التعامل مع الغرباء أرسلتُ إليه طلبَ صداقة، وإذْ به يقبل الطلبَ على الفور.
بدأتِ الحكايةُ بسلامٍ وشكرٍ منّي لقبوله طلبَ الصداقة. وجاءني الردُّ مقتضبًا: "أهلًا." كظمتُ غيظي وكتبتُ له: "قرأتُ بعضَ كتاباتكَ وأعجبتني." وجاء الردُّ أقبحَ ممّا سلف: "شكرًا." قلتُ في سرّي: "دعني أتأكّد أنّكَ لستَ جوادًا الذي أظنُّه؛ وسأنسفكَ Block يخفيك عن وجه الأرض." لكنني أرسلتُ إليه: "شكرًا مرّةً أخرى. بالتوفيق." وكي لا أقرأ ردًّا أكثر فجاجةً خرجتُ من حسابي على الفور.
في صبيحة اليوم التالي طالعتْني هذه الرسالة: "صباح الخير. دخلتُ إلى حسابكِ ووجدتُ أنّكِ سيّدة ظريفة وجميلة وذكيّة. شكرًا لأنّكِ دعوتني إلى صداقتك؛ الأمر الذي يحيّرني فعلًا. أهناك ما أجهله؟" شعرتُ بالفرح: إذًا هو ليس فظًّا كما بدا البارحة. لكنْ بماذا أردّ؟ كيف سأعرف إنْ كان هو "جواد" الذي أبحث عنه من دون إثارة ريبته؟ بقينا أسبوعًا نتراسل بشكل خفيف، وبدأتُ أطرح الأسئلة تمهيدًا للسؤال الفصل. فبعد أن أجابني بلا تردّد على أسئلة من نوع "ماذا تحبّ من الموسيقى؟ من الطعام؟ المشروب؟..." سألتُه: "ماذا تفعل في هذه الحياة؟" تلكّأ قليلًا ثم كتب: "أعيش." كان جوابًا مراوغًا. فألححتُ: "أقصد ما هي مهنتك؟" وانتظرتُ ممسكةً قلبي بيديّ، فكتب: "كنتُ مدرِّسًا." "والآن؟" "لم أعد كذلك." "وماذا كنتَ تُدرّس؟" "فيزياء."
لا أذكر أنني شعرتُ يومًا بكلّ هذه المشاعر مجتمعةً: خوفٌ، وارتباكٌ، وخجلٌ، وإثارةٌ، وفرح، بالإضافة إلى عجز عن الحركة داهمني ثوانيَ. انتبهتُ إلى أنّ الدموعَ بدأتْ تتساقط من عينيّ فوق لوحة المفاتيح. وخلال لحظات عدتُ تلك المراهقةَ العاشقةَ المتيَّمة. عادتْ خفقاتُ قلبي إلى الجنون. ماذا يحصل لي؟! لماذا أشعر هكذا؟ فكّرتُ كثيرًا وقرّرتُ: سيكون لي سرّي الخاصّ. وما المرأةُ من دون أسرار؟ سأصنع شرخًا صغيرًا يسمح لي بالمرور إلى الخارج. سأتعامل مع الأمر كأنّه حلم. ما هي مسؤوليّتي تجاه أحلامي؟
صرتُ أكثر جرأةً في رسائلي. لاحظ ذلك وكتب لي: "أشعر أنّ شيئًا قد تغيّر." فأجبتُه: "إحساسُكَ في مكانه." ومن ضمن هذه التغيّرات أنني صرتُ أرسل له قلوبًا حمراء، وبدأتْ أحاديثنا تأخذ مسارًا شخصيًّا، ودخلنا إلى منطقة العواطف وإرسال القبلات. بعد شهرين كتب لي: "أشعر أنّكِ ستقولين لي اليوم شيئًا مهمًّا." إنّه يحرِّضني على المبادرة؛ هكذا فهمتُ الرسالة. ولم أخيّب ظنّه، فكتبتُ له: "أحبّكَ." وخرجتُ بسرعة قبل أن أرى الردّ. بعد ساعة شعرتُ بالندم، وابتعدتُ عن الإنترنيت ثلاثة أيّام. وفي اليوم الرابع استجمعتُ شجاعتي وفتحتُ حسابي لأجدَ هذه الرسالة:
"لا أخفيكِ سرًّا أنّني فوجئتُ. ولن أكذبَ عليكِ؛ لقد شعرتُ بالإطراء. وأُعجبتُ بكِ؛ فليس من السهولة أن تتجرّأ امرأةٌ وتبادرَ إلى قول هذه الكلمة. والحقيقة أنني كنتُ أنتظرها. ما أروعَ أن أعيش هذه المشاعرَ اليوم. لا أعرف بماذا أجيبك. ولا أعلم إنْ كان الحبّ الذي تتكلّمين عنه هو الحبّ الذي يتكلّم عنه الناس. الشعراء والأدباء يتغنّون بالحبّ بغضّ النظر عن العمر والظروف. ولكننا لسنا في قصيدةٍ هنا. لسنا بيتين من الشعر لامرئ القيس أو عمر الخيّام."
لسببٍ ما توقّف عن الكتابة ليضيف بعد ساعات:
"أشعرُ بالحلاوة تغمرني كلّما قرأتُ اسمَكِ أو رأيتُ صورتَكِ. أشعر أنني عدتُ مراهقًا ينتظر طلوعَ القمر ليختلي بنفسه ويستمعَ إلى أغاني عبد الحليم وأمّ كلثوم ومحمد عبد الوهّاب."
وتوقّف هنا أيضًا، ليعود في اليوم التالي ويكمل:
"أين أنتِ؟ هل دفعكِ خجلُكِ إلى الاختباء؟ هذا لن ينفعَكِ. ستعودين إلى كلماتي هذه. وستتعجّلين في القراءة بحثًا عن كلمة ’أحبُّكِ‘. لا بدّ أنكِ تتساءلين إن كنتُ أبادلكِ المشاعرَ ذاتها. لن أكتب لكِ شيئًا. سأنتظركِ... إلى اللقاء."
قرأتُ الرسالة ولم أردّ عليها. كان online ولاحظ وجودي. سمعتُ صوتَ منبِّه، وظهر أمامي مستطيلٌ يقول: رسالة من جواد. فتحتُها وقرأتُ: "أحبّكِ." وانخرطتُ في البكاء.
***
بعد هذه الكلمة بدأنا مرحلةً جديدة، وباتت رسائلُنا مليئةً بالعواطف وكلماتِ الحبّ والغرام، إلى جانب النقاشات الجريئة حول الأنثى والرجل والمجتمع والخيانة والعائلة والأولاد. لم يكتب لي شيئًا لا أعرفه، لكنّ كلامه كان يدعو إلى الارتياح. سرّني أنّ هناك الكثير مما نتّفق عليه من المفاهيم والأفكار. لم أشعر معه أنني أقوم بفعل منافٍ للأخلاق، حتّى حين تشاركنا كلماتِ الحبّ والجنس وانجرفنا مدفوعين بمشاعرنا الجنونيّة إلى عدّة لقاءات جنسيّة افتراضيّة شعرتُ فيها بلذّةٍ لم أشعر بها من قبل. وقررتُ أن أحتفظ لنفسي بهذه الفسحة الصغيرة بعيدًا عن الكون: هنا سأقول ما لا أتجرّأ على قوله. هنا سأعبّر عن أعمق مشاعري. هنا سيكون بيتي الصغير الدافئ الحميم. هنا حيث أعطيته ثقتي كاملةً، حيث تسقط كلّ المفاهيم والنظريّات.
ــــ ماذا تسمّي الذي بيننا؟ سألني مرّةً.
ــــ ماذا تسمّيه أنتَ؟ سألته بدوري.
ــــ أيكون ملجأًً لنا؟
ــــ وهل نحن في حرب؟
ــــ في حالتنا... ربّما.
كانت تزعجني هذه الاجابات، فأعبّر عن ذلك بكلمات قاسية، ثمّ أندم وأعتذر. لا أريد أن أخسره. لا أريد لهذا السحر أن ينتهي. لم أفكّر في فارق العمر بيننا. لم أفكر في وضعنا العائليّ. لم أفكر في أيّ شيء. فلقد اكتفيتُ من التفكير والحسابات. اكتفيتُ من نفاق المجتمع والقيل والقال، ورميتُ نفسي في لجّة الماء. وها أنا أسبح سعيدة رغم كلّ شيء.
***
بعد طول انتظار طلبتُ مقابلته. وكتبتُ له: "بما أنك لم تبادرْ، فها أنا أطلب ذلك منك... أريد أن أراك." بقيتُ عدّة دقائق أنتظر، قبل أن يصلني ردُّه: "رؤيتي لن تجلبَ لكِ المسرّة". أجبته: "آمل ان لا تكون رؤيتي كذلك بالنسبة إليك." واتفقنا على لقاء.
لا يعرف عنّي سوى أنّني امرأةٌ أُعجبتْ به وتواصلتْ معه عبر هذا الفضاء؛ في حين أنّه كان جزءًا من أحلامي ومشاعري عدّة سنوات:
فهو أستاذي طوال المرحلتين الإعداديّة والثانويّة. الأستاذ الجميل الأنيق الذي كنّا نعشقه ــــ نحن البنات ــــ ونبقى طوال الدرس شارداتٍ بحركاته وهمساته. وكلّما تجوّل بين مقاعد الصف كنّا نتضاحك خفيةً، ونسرق مِن وراء ظهره بأنوفنا الصغيرة بقايا رائحةِ عطره، ونمثّل حالةَ الإغماء عشقًا.
كنتُ أعرف أنّ رفيقاتي معجباتٌ به بشدّة، لكنّي كنت مريضةً به: أفكّر فيه ليلَ نهار. أكتب اسمَه على هوامش دفاتري وكتبي بأحرفٍ سريّة اخترعتُها من أجله فقط. أسرقُ بقايا قوالب الطباشير الصغيرة التي يرميها جانبًا في نهاية كلّ درس. أتكلّم عنه مع مَن ألتقيهم وأسألهم بشغف: "أتعرفون الأستاذ جواد؟" ثمّ أبدأ بسرد الحكايات. بعضُها لا أصلَ له؛ وبعضها حقيقة، لكنني أضيف إليها ما يتفتّق عنه عقلي من أكاذيب طفوليّة مضحكة: "الأستاذ جواد أذكى شخص في العالم. كان يدرِّس في أهمّ الجامعات في أمريكا"؛ "الأستاذ جواد فاز في مسابقة العالم بالفيزياء!"؛ "كذلك قابله مرّةً رئيسُ البلاد ودعاه إلى الغداء في بيته"؛ "عندما زار الأرجنتين استقبله رئيسُها ودعاه إلى البقاء هناك للاستفادة من ذكائه، لكنه رفض ..."
كنتُ أحبّه بكلّ جوارحي من دون علمه. وكنتُ أتخيّل نفسي معه: نتمشّى على شاطئ البحر، ونجلس في المقهى، ونحْضر الحفلات، وفي نهاية السهرة نأوي إلى فراشنا حيث أترك لخيالي أن يسرحَ ويمرحَ بلا رقيبٍ أو حسيب. كنتُ مستعدّةً للدخول في معركة شدّ شَعْر مع أيّة فتاةٍ تذكره بسوء. وفي كلّ مساء أبكي في سريري لمعرفتي أنْ لا شيء من أحلامي سيتحقّق. كنتُ أعاتبه في سرّي لأنه لا يعبّر لي عن حبّه، بل أغضب وأصرخ في وجهه. ثمّ أشعر بالندم، وألوم نفسي: مَن أنا ليحبّني؟ ما أنا بالنسبة إليه إلّا طفلةً تحفظ، أو لا تحفظ، الدرس.
كنت في الصف الثاني ثانوي عندما دخل القاعة ورأيتُ في إصبعه دبلةَ الخطوبة. "صباح الخير أيّتها الفراشات،" قال كعادته. ولم أعرف ما حصل بعدها. استيقظتُ على صوت المديرة وهمساتِ رفيقاتي الخبيثات. كانت المديرة تمسح وجهي بمنديلٍ باردٍ وتسألني إنْ كنتُ بخير. لم أردّ عليها، بل قمتُ مترنّحة،ً وتوجّهتُ إلى باب المدرسة الخارجيّ، ومن هناك إلى البيت، تاركةً خلفي حقيبتي. لم أذهب إلى المدرسة طوال أسبوع، وكنتُ في حالةٍ يُرثى لها. استدعى أبي طبيبَ العائلة، فوصف لي الكثير من المقوِّيات. أخيرًا، وبطريقةٍ ما، فهمتْ أمي أنّ مشكلتي عاطفيّة، فجلستْ معي وكلّمتني ذلك الكلامَ الذي لا جدوى منه.
عندما عدتُ إلى المدرسة تجنّبتُ النظر إلى عينيه أو يديه خلال الدرس. وعندما سألني عن سبب غيابي قلت: "ظروف." وبدأ مستوايَ يتدهور في مادّة الفيزياء وغيرها. صرتُ أتعمّد عدم الإجابة عن بعض الأسئلة في المذاكرات، فتأتي علاماتي متدنّيةً، وأشعر أنّني أنتقم منه بهذه الطريقة. بعد عدّة أسابيع دعاني إلى غرفة الإدارة، وكنّا وحدنا. سألني عن سبب إهمالي، فبكيتُ على الفور، وبدأتُ أشهق. لن أنسى نظراته في تلك اللحظة ما حييتُ. الحقيقة أنّ تلك النظرات هي التي أبقته في ذاكرتي وقلبي إلى اليوم. هي التي حفرتْ عميقًا وأودت بي لاحقًا إلى جلسات العلاج النفسيّ. كانت نظراتِ اعتذار. لم يتكلّم كثيرًا، ولم أتوقّف عن البكاء، إلى أن مدّ يديْه ووضعهما على كتفيَّ ليهدّئني. فارتميتُ في حضنه وضممتُه إلى صدري بقوة. بقي جامدًا تحت وطأة المفاجأة. فقمتُ بما كنتُ أحلم به: تطاولتُ على أصابع قدميّ وقبّلتُه فوق شفتيه قبلةً طويلةً أضرمت النارَ في جسدي الفتيّ. لم يتفاعلْ معي، لكنه ضمّني إلى صدره برهةً، ثمّ أبعدني بهدوء شديد، وخرج من الغرفة من دون أن ينبسَ بحرف.
كانت تلك آخرَ مرّةٍ أراه فيها. وبعد أيّام قليلة عرفتُ أنه طلب نقلَه من المدرسة. هكذا اختفى من حياتي حبّي الأوّلُ الحقيقيّ، وشريكي في قبلتي الغراميّة الأولى، وسببُ حزني ورسوبي في صفّي تلك السنة.
***
عندما ركنتُ سيّارتي وترجّلتُ منها رأيته جالسًا على مقعدٍ قرب باب الحديقة حيث تواعدنا. شعرتُ بالرهبة وعادت إليّ مشاعري القديمة. كان شخصًا غيرَ الذي عرفتُه: أصغرَ حجمًا وأقلَّ أناقةً. كان يضع نظّارةً طبّيّة، ويحمل في يده باقةً صغيرةً من الزهر البرّيّ ــــ قدّرتُ أنّه جمعها من الحديقة ذاتها. عندما لاحظ وجودي وقف مبتسمًا وتقدّم نحوي. ومع كلّ خطوة كنتُ أزداد توتّرًا، إلى أن صار أمامي تمامًا ومدّ إليّ يدَه بباقة الزهر قائلًا بمرح: "ها نحن أخيرًا." فأجبتُه في سرّي: "يا لَلهول!" ثم سمعتُ نفسي أردِّد خلفه بطريقةٍ مضحكة: "ها نحن أخيرًا."
ــــ يا لَجمالكِ!
كنتُ أحفظ هذا الصوتَ، وهذه النبرة، وهذه الكلمة. هكذا كان يقول لي حين كنتُ أجيبه عن سؤالٍ تعجز عنه رفيقاتي في الصفّ، فأَحمرُّ خجلًا. ابتسمتُ وشكرتُه، بينما كنت أداعب وريْقاتِ باقة الزهر. جلسنا على مقعدٍ آخرَ في زاوية الحديقة، بعيدًا عن أعين المارّة، وبدأنا حديثًا استمرّ ساعةً من الزمن. عرفتُ أنّه سافر خارج البلاد لعدّة سنوات، ثم عاد فتزوّج ورُزق بصبييْن يتابعان تعليمهما في أمريكا: أحدُهما يدرس الطبّ البشريّ، والآخر اختصّ كوالده في علوم الفيزياء. سألتُه عن زوجته، فقال إنّها ماتت قبل عدّة سنوات. لم أسأله كيف ماتت. كنتُ أريد أن أعرف: أهي نفسها التي خطبها في ذلك الوقت، أمْ واحدة أخرى؟ فسألتُه إنْ كان قد تزوّج أو خطب أكثرَ من امرأة خلال مسيرة حياته. استغرب سؤالي، لكنه قال: "لم أفعل. إنها المرأة الوحيدة في حياتي.". إذًا هي التي ماتت. "بتستاهل!" لم أستطع منعَ نفسي عن ترديد هذه الكلمة في ذهني، وأشعر اليوم بالخجل كلّما تذكّرتُ ذلك.
بقي يتكلّم طوال الوقت. وكنتُ في منتهى السعادة. حدّثني عن ولديه اللذين باع أرضَه كي يساعدَهما على السفر، وكيف قضى الأسابيعَ الأخيرة من حياة زوجته المريضة متنقّلًا معها من مشفًى إلى مشفى، وكيف ماتت فجرَ أحد الأيّام وهي بين ذراعيه. قال: "كانت تبتسم حين فارقت الحياة." عندها فقط شعرتُ ببعض التعاطف، فقلت: "رحمها الله. لا بدّ أنها ماتت سعيدةً لأنها كانت معك." فابتسم ولم يقل شيئًا.
بعد فترة قصيرة من الصمت قال لي: "بيتي قريب من هنا. هل تقبلين دعوتي إلى فنجان قهوة هناك؟" لم أتردّد، وقلت: "لنذهبْ. أريد أن أرى كيف تعيش." فضحك بأعلى صوته قائلًا: "عيشة الكلاب." في السيّارة سألني: "ما الذي جعلكِ تراسلينني؟" فكذبتُ: "كلماتُك التي تكتبها." "لكنني لستُ كاتبًا ولا شاعرًا!" شعرتُ أنني محاصرة، فهربتُ من الحديث وشتمتُ السائق الذي تجاوزني. "لا تهربي،" قال ضاحكًا، "لم يفعل شيئًا المسكين." أبقيتُ على جوابي الأول: "كلماتك التي تكتبها." عندها استسلم قائلًا: "ما أسعد حظّي إذًا!"
وصلنا البيت خلال دقائق وصعدنا الدرجَ إلى الطابق الخامس. في الطابق الثالث شعرتُ أنني سألفظ أنفاسي من شدّة التعب، بينما كان ينتقل من درجةٍ إلى أخرى برشاقةِ قرد. ضحكتُ في سرّي وأسفتُ على نفسي: "ماذا تركتُ لعمر السبعين؟"
كان البيت صغيرًا، مكوّنًا من: صالون أنيق مرتّب؛ وغرفةٍ صغيرة تغطّي جدرانَها الكتبُ والكثيرُ من اللوحات الفنيّة؛ وغرفةِ نوم؛ ومطبخٍ مفتوح على الصالون؛ وحمّامٍ صغير يقع في نهاية الممرّ. بعد جولة قصيرة قمتُ بها أثناء انشغاله بتحضير القهوة عدتُ إلى المطبخ، فلفتت انتباهي مجموعةٌ من الأدوية على الطاولة الصغيرة. رآني أتفحّصها فقال: "هذا ما يبقيني على قيد الحياة." أجبته: "صعودُك الدرجَ بتلك الطريقة لا يوحي أنك في حاجةٍ إليها." "لا تخدعنّكِ المظاهر،" قال وهو يصبّ القهوة. سألني من جديد عن حياتي واهتماماتي؛ أسئلةً أجبتُه عليها سابقًا أثناء دردشتنا عبر الانترنيت. لكنني عدتُ وسردتُ له كلَّ ما أراد معرفتَه. كان يصغي بانتباه كأنه يستمع إلى محاضرة في النظرية النسبيّة أو علم الفلك والثقوب السوداء. أحببتُ إصغاءه وعبّرتُ عن ذلك، فقال باسمًا: "كلامك أهمّ من كل علوم الفلك والفيزياء." ضحكتُ معه قائلةً في سرّي: "يا لَهَبل الرجال."
تأكّدتُ بعد قليل أنّ السعادة التي تغمره تكمن في فكرة لقائه بامرأة، لا في لقائي شخصيًّا، علمًا أنّه أصرّ على إظهار عكس ذلك. لا أشكّ في أنّه معجب بي، وأنه أحبّني، لكنّ جوهر الأمر ليس كذلك. فسببُ سعادته يكمن بالدرجة الأولى في تعرّضه ــــ وهو في هذه السنّ ــــ للتحرّش من قِبل امرأة صغيرة، جميلة، تقع في حبّه، وتطلب لقاءه، ولا تحتاج إلّا إلى دعوة بسيطة كي تكون في بيته.
وكنتُ سعيدةً بدوري، ولكنْ لأسبابٍ أخرى. فقد كنتُ أسحب من فم الزمن لحظاتٍ حُرِمتُها، ومشاعرَ افتقدتُها. كنتُ أستعيد جزءًا من حياتي ظننتُني فقدتُه إلى الأبد. وهذا ما جعلني أكتب إليه في ذلك اليوم: "أنتَ سفينتي التي أنتظر." لم يفهم كلامي حينها. وكيف له أن يفهم؟ كنتُ شاردةً أنظر إليه وهو يتكلّم ولا أسمع ما يقول. كنتُ أبحث في عينيه عن تلك النظرات التي حفرت اسمَه في قلبي عندما كنّا في المدرسة؛ عن لمسته حين ضمّني في ذلك اليوم المشؤوم. كان يتكلّم بمرح، ويمرِّر كلماتِ الغزل المشاكسة. وكنتُ أغوص أكثر في عينيه. في تلك اللحظات، قرّرتُ أن لا أخبرَه مَن أنا، أن أحتفظَ بسرّي الصغير، وأتركَه يعيش هذه السعادة، معتقدًا أنني لا أعرفه إلّا من خلال الفيسبوك وأنني أعجبتُ بكلماته وبشخصه. هذا ما كان يسعده، ولن أحرمه هذه السعادة ما دام ماضيّ لا يعني له أيَّ شيء.
لاحظ شرودي فمدّ يده ووضعها فوق يدي بهدوء. وكانت تلك الحركة كافيةً كي أقوم من مكاني وأسحبَه خلفي إلى غرفة النوم.
***
مساءَ ذلك اليوم فتحتُ حسابي ووجدتُ رسالة منه:
"بعد مغادرتكِ فكّرتُ بالانتحار. فماذا أريد من الحياة أكثر وأنا في هذا العمر؟ لا تخافي لم أفكر بالانتحار بشكل جدّيّ؛ إنّه تعبير مجازيّ لا غير. ولا أعلم إنْ كان من اللائق أن أشكرَكِ على كرمكِ. شكرًا لكِ. شكرًا لأنوثتكِ. شكرًا لجمالك. شكرًا لشجاعتكِ. شكرًا لكلماتكِ. لا أعلم ماذا أكتب أيضًا. لا أعلم ما الذي دار في بالك بعد خروجكِ من باب بيتي. ولكنْ، بعيداً عن كلّ ذلك، وبغضّ النظر عن أيّ شعور، أريدكِ أن تعرفي أنني لن أحمّلكِ أيّة أعباء جرّاء الذي حصل بيننا. لن ألومكِ على شيء. أفهم وأقدّر الصراعَ الذي سينشب في داخلكِ. أريدكِ أن تتصرّفي بما يمليه عليكِ واقعُكِ. قولي ابتعدْ، ولن تسمعي بي مرّة أخرى.
ملاحظة: لا تزال أغطية السرير تعبق برائحتك."
قرأتُ كلماتِه والدموعُ تملأ عينيَّ. وكتبتُ له ردًّا مختصرًا: "أيّها المجنون، إن ابتعدتَ سأقتلك." ثم أغلقتُ جهازي وأخرجتُ من درج خزانتي الصرّةَ الصغيرة التي أحتفظ بها من تلك الأيّام البعيدة. فتحتُها ونظرتُ إلى بقايا قوالب الطباشير التي كنتُ أجمعها من خلفه. كانت مئةً وستًّا وخمسين قطعةً من كلّ الألوان. استرجعتُ تلك المشاعر الرائعة. وفجأةً تغيّرتْ حالي وشعرتُ بالغضب من جديد: كيف لم يفهم أنني أحبّه؟ كيف لم يلاحظ نظراتي ولهفتي وارتباكي كلّما كلّمني؟ كيف لم يحبّني؟!
***
زرتُه في بيته عدّة مرّات. تعرّفتُ إليه أكثر. أحببتُه أكثر. وفاجأني في أحد الأيّام بأنْ أعطاني نسخةً عن مفتاح البيت، وصرتُ أذهب أثناء غيابه، فأطبخ له ما يحبّه من الطعام، وأقوم بالترتيب، ثم أجلس لأقرأ. وحين يتأخّر وأضطرّ إلى الذهاب، كنتُ أترك له ورقة على باب البرّاد أكتب فيها شيئًا ممّا قرأتُه. واكتشفتُ فيما بعد أنه يجمع هذه الوريْقات ويضعها في علبة كرتونيّة صغيرة، فصرتُ أنتقي المقاطع التي أختارها بعنايةٍ أكبر. ضحكَ عندما ذكرتُ له ذلك وطلب منّي كتابة شيء من أفكاري، فلم أستطع لأنني لا أملك موهبةَ الكتابة، وتابعتُ نقل ما أراه مناسبًا من الكتب التي أقرأُها. والغريب أنّ الورقة الوحيدة التي تركها معلّقةً على باب البرّاد، واكتفى بالقول إنّها أعجبته عندما سألته عن السبب، كانت تلك التي تحوي أبياتًا من الشعر نقلتُها من طوق الحمامة لابن حزم، وقد ذكّرتني بتلك اللحظات التي عشتُها معه في المدرسة حين قبّلتُه تلك القبلة:
وسائلٍ ليَ عمَّا لي من العُمُرِ .... وقد رأى الشيْبَ في الفوديْنِ والعُذُرِ
أَجَبْتُهُ: ساعةٌ. لا شيءَ أحسبُهُ .... عُمرًا سواه بحكم العقل والنظرِ
فقال لي: كيف ذا؟ بيِّنْهُ لي، فلقد .... أخبرتني أشنعَ الأنباءِ والخَبرِ
فقلتُ: إنّ التي قلبي بها عَلِقٌ .... قبّلتُها قبلةً يومًا على خَطَرِ
فما أعُدّ،ُ ولو طالتْ سِنيَّ، سِوى .... تلك السويْعةِ بالتحقيقِ مِن عُمُري
بقينا على هذه الحال عامًا كاملًا. كانت حياتي تسير بسلاسة. والحق أنني كنتُ أخاف هذه السعادة: فالحياة الواقعيّة لا تحتمل هذا السلامَ الذي كان يغلّفني، والفرحَ الذي يعتمل في صدري. لا تحتمل سباحتي ضدّ التيّار. لا تحتمل تحليقي خارج السرب. شعور غريب يقول لي: سيأتي مَن يطعنُكِ في الظهر. سيأتي مَن ينزع عن وجهكِ تلك الابتسامةَ الخفيّة ويعيدكِ إلى زوايا الحزن. ولم يخطر في بالي أنّ هذا الحزن سيأتي أبكرَ ممّا تخيّلتُ.
استيقظتُ صبيحة أحد الأيّام، وجريًا على عادتي فتحتُ حسابي على الفيسبوك وأرسلتُ إليه: "صباح الخير. سأخرج إلى عملي بعد قليل، وسأتصل بكَ بعد ساعة. إنْ لم أجدْكَ مستيقظًا فسأذهب إليك وأسحبكَ من السرير. أحبّكَ أيّها الكسول."
كانت الساعة السابعة صباحًا، وكانت السماء ملبّدةً بالغيوم. عندما وصلتُ إلى حيث سيّارتي، رأيتُ شابًّا يترجّل عن درّاجته الهوائيّة ويلصق على الجدار المقابل ورقةَ نعوة، برز فيها اسمُه، جواد أمير المنصف، بخطٍّ عريض، تعلوه آياتٌ قرآنيّة و"ننعى إليكم فقيدَنا الـ..."
لا أعرف كيف وصلتُ إلى المشفى أو مَن نقلني إلى هناك. فقد وجدتُ نفسي موصولةً بعدّة أسلاك تربطني بجهاز صغير لا يتوقّف عن الصفير. كانت أمي إلى جانبي، كذلك أبي وزوجي وأختي. لا أحد منهم يعرف ما حصل، ولا فهم لماذا صرختُ بمجرّد استعادتي وعيي. وبدوري أصبتُ بالذعر حين عرفتُ أنني بقيتُ فاقدةً الوعيَ يومين كاملين. واختلطت الأمورُ في ذهني: هل ما رأيتُه حقيقة؟ هل مات جواد حقًّا؟ مَن سأسأل؟
كانت هذه الأفكار تتزاحم في رأسي وتجعلني أبدو كالمجنونة في نظر عائلتي. ووجدتُني وحيدةً بطريقة لم أشعر بها قبل اليوم. وعدتُ إلى البكاء والصراخ، وصرتُ أنتفض محاولةً التخلّصَ من الأسلاك. لكنْ فجأةً ظهرتْ إحدى الممرِّضات وحقنتني بمادّة مخدِّرة. وخلال ثوان شعرتُ أنني أفقد الحسَّ بجسدي، وبدأتُ أغيب عن الوعي. بقيتُ على هذه الحال يومين آخرين، وفهمت أنني سأبقى هنا لمدّةٍ أطول إنْ لم أحسن التصرّف. لذا، حين استعدتُ وعيي من جديد، تمالكتُ نفسي وتوقّفتُ عن البكاء، بل تبادلتُ أطرافَ الحديث مع أمّي وزوجي وتناولتُ وجبة من الطعام. وهكذا، بعد ساعات قليلة، خرجتُ من المشفى، لأجد أبي وأختي وحماتي في انتظاري في البيت. لم أكن في مزاج يسمح لي بالتعامل مع أيّ شخص، فطلبتُ وضعي في سريري وتركي هناك.
بقيتُ أسبوعًا كاملًا لا أغادر البيت، ولا أتجرّأ على فتح حسابي على الفيس بوك. وفي اليوم الثامن استيقظتُ باكرًا، وخرجتُ إلى حيث رأيتُ ورقةَ النعوة، فقرأتُها من جديد والدموعُ تملأ عينيّ، وعرفتُ أنه مات جرّاء احتشاء في عضلة القلب؛ ذلك القلب الذي سكنتُه سنةً كاملةً بعيدًا عن هذا العالم بكلّ ما فيه؛ القلبِ الذي كان ملاذي ومعبدي وملعبي وحديقتي وشرفتي، ونافذتي على كونٍ غيرِ هذا الكون.
بعد أسبوع آخر قررتُ الذهابَ إلى المقبرة والبحثَ عنه. أخذتُ معي الصرّةَ التي جمعتُ فيها بقايا قوالب الطباشير. وخلال نصف ساعة كنتُ أسأل الحارس عن قبر الأستاذ جواد أمير المنصف. كان القبر لا يزال ترابًا تعلوه أكوامُ الزهر. جلستُ قربه. أزحتُ عنه أكاليلَ الزهر الذابلة، وفككتُ صرّةَ الطباشير، ثم أخذتُها واحدةً تلو الأخرى وشكّلتُ منها كلمة "أحبّكَ" فوق تراب القبر وأنا أتمتم كأنني أصلّي: "ها نحن أخيرًا... ها نحن أخيرًا..."
عندما عدتُ إلى البيت وجدتُ زوجي في انتظاري والقلقُ بادٍ عليه. وقبل أن ينطق بكلمة قلتُ بصوتٍ هادئ وبكلّ برود: "أريد الطلاق." وأضفتُ في ذهني: "لن أخونَه معكَ بعد اليوم."
اللاذقيّة