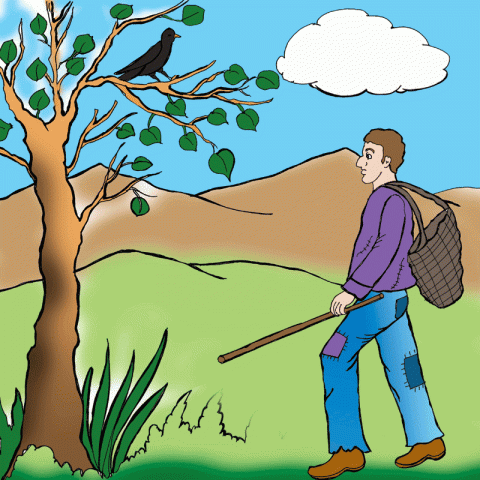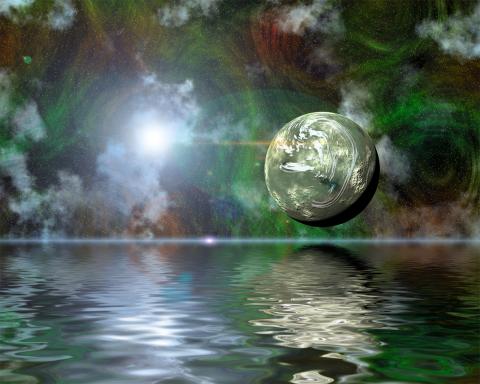شاعر وكاتب وعضو في "حركة الشباب الفلسطينيّ".(PYM) تبحث كتاباتُه السياسيّة، وأطروحةُ الدكتوراه التي قدّمها، في كيفيّة استخدام الشعوب الخاضعة للعنصريّة والكولونياليّة وسائلَ خلّاقةً لمقاومة مشاريع الدولة في المراقبة والتحكّم البوليسيّ.

نقلها إلى العربيّة: سماح إدريس
يوم الاثنين في 25 أيّار (وهو "يوم التذكار الوطنيّ" Memorial Day في الولايات المتحدة)، اتّصل أحدُ الموظّفين العاملين في مخزن Cup Foods، في مِنيابولِس الجنوبيّة، بالشرطة، زاعمًا أنّ زبونًا كان يحاول أن يدفع ثمنَ ما اشتراه بورقةٍ نقديّةٍ مزيَّفة من فئة العشرين دولارًا. جاء شرطيّان إلى أحد الأماكن المخصّصة لرَكْن السيّارات مقابلَ ذلك المخزن، فوجدا جورج فلويْد، وهو أميركيٌّ من أصلٍ أفريقيّ، وملامحُه تتطابق مع وصف ذلك الموظَّف، جالسًا في سيّارته المركونة. إلى هذين الشرطيّيْن، انضمّ شرطيّان آخران، هما تو ثاو (Tou Thao) ودِرِكْ شوفِنْ (Derek Chauvin)، فأجبرا فلويْد على الخروج من سيّارته، واقتاداه إلى سيّارة الشرطة عند زاوية الشارع. خلال دقائق، عمد شوفِن إلى قتل فلويْد بأنْ جَثا على عنقِه حتى فقد وعيَه، على الرغم من صراخ الشهود المحيطين الذين صوّروا الحادثة.
كالعادة في مثل هذه الحالات، سعت شرطةُ مِنيابولِس، أوّلَ الأمر، إلى تبرير استخدام القوّة القاتلة، زاعمةً أنّ فلويْد حاول أن يقاومَ توقيفَه. غير أنّ هذا الاختلاق تناقض بوضوحٍ مع شريطِ فيديو صوّره فتًى في السابعة عشرة من عمره، وانتشر بسرعةٍ فائقةٍ على وسائل التواصل الاجتماعيّ، فاستدعى نداءاتٍ فوريّةً تطالب بطرد رجال الشرطة المتورّطين وتوقيفهم. ومنذ تلك الحادثة، طُرد هؤلاء فعلًا، ويواجه شوفِن اتّهاماتٍ بالقتل قد تصل عقوبتُها الى اثنتيْ عشرة سنةً من السجن في حال الإدانة. غير أنّ عائلةَ فلويْد أوضحتْ أنّها تريد أحكامًا أقسى بكثيرٍ عليه.
أدّى التأخيرُ في التعامل مع القضيّة إلى مفاقمة الغضب على امتداد البلاد: فقد استغرق توجيهُ الاتهامات الأوّليّة إلى شوفِن ثلاثةَ أيّام كاملة. كما أَصدر تقريرُ التشريح الأوّل، الذي قام به مركز Hennepin County Medical Examiner، حُكمًا غريبًا، ألا وهو "عدمُ العثور على آثارٍ جسديّة" تُثْبت تعرُّضَ فلويْد للاختناق - - وكأنّنا نحتاج إلى طبيبٍ ليُفْهمنا أنّ الجَثْوَ بالرُّكبة على عُنق رجلٍ طوالَ ما يزيد عن سبع دقائق سببٌ مباشرٌ وواضحٌ للاختناق، بل للموت! ولحسن الحظ أنّ حُكم المركز تناقضَ مع استنتاجاتِ خبيريْن جديديْن كلّفتْهما عائلةُ فلويد بالتحقّق من ملابسات الجريمة.
في تصعيدٍ سريع، انضمّت الى الاحتجاجات مدنٌ في طول الولايات المتحدة وعرضِها. غير أنّ المسؤولين في السلطة، لسوء الحظّ، أرادوا أن يَحْرفوا مسارَ الغضب الجماعيّ، فعمدوا إلى فرض إجراءاتٍ عقابيّةٍ متعدّدةٍ ضدّ المعارضين، بدلًا من أن يوجِّهوا طاقاتِهم إلى معالجة الفوارق السياسيّة والاجتماعيّة الهائلة التي أدّت إلى تأجيج المقاومة الحاليّة. فمع كتابة هذا المقال، كان منعُ التجوّل قد فُرض على شيكاغو وبٍفِرلي هِلْز، واستدعت تكساس وكولورادو الحرسَ الوطنيّ. أمّا السياسيّون أمثال ميتش ماكونل (Mitch McConnell)، فقد صمّموا على إضافة الملحِ إلى جرح الظلم، فشجبوا بعبارات التملّق ما وصفوه بـ "عنف" التظاهرات الصاخبة "الذي لا معنى له" أكثرَ ممّا شجبوا القتلَ الفعليَّ والمُثْبَتَ الذي ارتكبه رجالُ الشرطة.

ما ينبغي أن يدينَه أصحابُ الضمير ليس "عنفَ" المحتجّين، بل القوّة اللّامتكافئة التي تمارسها الشرطةُ الأميركيّةُ
لئن كان مفهومًا أن ينزعجَ المشاهدون من متابعة تقاريرَ تصوِّر متظاهرين يقتحمون المبانيَ ويُحْرقون المخازنَ ويسرقون محتوياتِها، فإنّ صبرَهم يكاد ينفد من مَشاهد رجال الشرطة وهم يتوحَّشون ضدّ الأبرياء ويقتلونهم بلا محاسبة. ويكاد صبرُ المشاهدين يَنفد أيضًا من "جهازَ العدالة الجنائيّة" الذي يَهْرع، بسرعة الضوء، إلى ملاحقة المدنيّين الأميركيّين وإدانتِهم – وهم في العادة مدنيّون أميركيّون من أصحاب البشرة غير البيضاء – لكنّه لا يتصرّف على هذا النحو حين يتعلّق الأمرُ بأحد موظّفي هذا الجهاز بعد أن أُعطيَ إذنًا بممارسة العنف متى شاء أو رغب. حتى مَن يؤمنون إيمانًا مطلقًا بنظام العدالة الأميركيّة، عليهم أن يُقرّوا بأنّ من واجب منفّذي العدالة المفترَضين أن يَخضعوا لأرفعِ المعايير وأدقِّها، وأن يقوّموا الأمورَ بأقصى سرعةٍ وحياديّة. لكنّ ما جرى خلال الشهور القليلة الماضية، وربّما خلال العقود المتعدّدة الماضية، يوحي بأنّ ذلك أبعدُ ما يكون عن الواقع في الولايات المتحدة، "أرضِ الأحرار."
الحقّ أنّ ما ينبغي أن يدينَه ويقاومَه أصحابُ الضمير في العالم ليس "عنفَ" المحتجّين، بل القوّة اللّامتكافئة التي تمارسها الشرطةُ الأميركيّةُ، والدولةُ الأميركيّة التي تدعم هذه الشرطةَ. وما يُقلق، بشكلٍ خاصّ، أنّ بعضَ المغرِّدين أَبلغوا أنّ عناصرَ شرطة لوس آنجلس أوقفوا تشغيلَ آلاتِ التصوير المعلَّقة على أجسادهم (body cameras)، وأنّ وكالة ICE [وكالة أميركيّة حكوميّة لفرض قوانين الهجرة والجمارك] استُدعِيتْ، بما يوحي أنّ الشرطة قد تستخدم القوّةَ القاتلة.
بحلول الاثنين، الأوّل من حزيران، قُتل ديْفيد ماكاتي (David McAtee)، وهو مديرُ مطعمٍ من أصولٍ أفريقيّة، على يد عناصر شرطةٍ كانوا قد أوقفوا تشغيلَ آلات التصوير المعلّقة على أجسادهم، قبل أن يفتحوا النارَ في لويفِلّ (كنتاكي)؛ لاحقًا، بعد الظهر، "أُعفي" مديرُ الشرطة "من مهامّه." وكانت الشرطةُ في لويفِلّ (كنتاكي) قد أطلقت النارَ في 13 آذار على بريونا تيْلور (Breonna Taylor)، وهي عاملةٌ في طبّ الطوارئ كانت تطمح إلى أن تصبح ممرِّضةً، فقتلتْها وهي نائمةٌ في منزلها. هنا أيضًا لم يكن ثمّة تقريرٌ مصوَّرٌ يُثْبت الأعذارَ التي قدّمتْها الشرطةُ لتبرير الغارة [على منزلها].
مغرِّدٌ آخر كتب أنّ محافظَ لوس آنجلس، غارسيتّي (Garcetti)، أغلق كلَّ مراكز فحص Covid-19 انتقامًا من التظاهرات، بحجّة أنّ لوس آنجلس "لن تتسامحَ مع إحراق سيّارات الشرطة." أنْ نَصِفَ ما فعله هذا المحافظُ بالتصرُّف الوحشيّ الذي لا يمكن فهمُ أبعاده ولا يلائم مَن يُفترض أن يعملَ لخيْرِ مواطني محافظته، فذلك سيكون وصفًا لا يراعي الحقيقةَ كاملةً. فالواقع أنّ ما فعله غارسيتّي هو تسليحٌ للصحّة العامة بالثأر كي تكون عقابًا - - وهذا ما يمكن عدُّهُ حربًا بيولوجيّةً تتقاطع مع استبداد القانون العرفيّ الوحشيّ.

كتب مغرِّد أنّ محافظَ لوس آنجلس أغلق كلَّ مراكز فحص Covid-19 انتقامًا من التظاهرات
قد تنطبق هذه الأوصافُ جميعُها على تصرّفات الشرطة، لكنّ المؤكَّد أنّ هذه التصرفات ليست مفاجئة. فالولايات المتحدة، على ما يعلم كثيرون من مسحوقي عنفها العنصريّ، أو كما يعلم متظاهرون نزلوا إلى الشوارع مؤخّرًا ليقاوموا ذلك السحقَ، قد كانت منذ زمنٍ بعيدٍ، ولا تزال، دولةً بوليسيّةً عنصريّةً مكّنتْ عناصرَ شرطتها من التعامل بأكثر الوسائل قسوةً ووحشيّةً مع القابعين في أسفل التراتبيّة العنصريّة الرأسماليّة الأميركيّة. سنة 1966، كتب الكاتبُ الأميركيّ من أصول أفريقيّة، جايمس بالدوِن (James Baldwin)، مقالةً لمجلّة The Nation الأميركيّة بعنوان "تقرير من الأراضي المحتلّة." هذه المقالة (التي نحتاج إلى قراءتها اليومَ أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى) كانت تشريحًا قاسيًا للمعاملة غيرِِ الإنسانيّة التي اتّسمتْ بها السياسةُ البوليسيّةُ المفرِطةُ تجاه المدن المفصولة و"المُغتْيَتة" عرقيًّا (ghettoized) في أميركا. كتب بالدْوِن:
"الشرطة هي، ببساطة، أعداءُ هذا الشعب المستأجَرون. وجودُها هو من أجل إبقاء الزنجيّ خاضعًا، ومن أجل حماية مصالح البِيض، ولا وظيفةَ أخرى لديها. كما أنّ الشرطة ــ حتى في بلدٍ يرتكب الخطأَ الفادحَ حين يساوي الجهلَ بالبساطة ــ جاهلةٌ بشكلٍ مذهل؛ ولأنّها تعرف أنّها مكروهةٌ، فهي خائفةٌ على الدوام. لا يمكن أن نصلَ إلى تفسير وحشيّة الشرطة بمعادلةٍ أصحَّ من هذه."
على الرغم من أنّ الأميركيين من أصلٍ أفريقيّ هم جزءٌ من شعب الولايات المتحدة، فإنّ بالدوِنْ وَصف هارلِمْ، ذاتَ الأكثريّةِ الأفريقيّة-الأميركيّة، بأنّها "أراضٍ محتلّة." وهو قارن سكّانَها الأفارقةَ-الأميركيين، الذين يعيشون بشكلٍ يوميّ تحت عنف الشرطة المنفلت، بالفيتناميّين الذين يدافعون عن أنفسهم في وجه الاعتداءات الاستعماريّة. كما لاحظ أنّ وحشيّةَ الشرطة تجاه المَعازل المُفقَرة التي يقطنُها السودُ وأصحابُ البشرة السمراء هي "برميلُ بارودٍ" لتأجيج الانتفاضات. ويبدو لي أنّ هذه الانتفاضات لم تكن يومًا "بلا معنى"؛ ذلك لأنّها جزءٌ لا يتجزّأ من سنواتٍ طويلةٍ من الإفقار والذلّ المتراكميْن اللذيْن فرضتهما مؤسّسةٌ تحظى بترخيصٍ لممارسة العنف متى شاءت. ولسوء الحظ، فإنّ الدولة غالبًا ما تفاعلتْ مع هذا الوقع المزري بزيادة العنف وتوسيعه:
فبعد انتفاضة 1965 في واطس (وهي ضاحيةٌ في جنوب وسط لوس آنجلس)، عَزَتْ تقاريرُ متتاليةٌ سببَ الاضطرابات إلى الفقر والبطالة الحادّيْن. وفي العام 1968، أكّدتْ لجنةٌ كُلِّفتْ بدراسة الظروف التي أدّت إلى سلسلةٍ من الانتفاضات على امتداد الولايات المتحدة، عقب اغتيال مارتن لوثر كينغ جونيور، أنّ العنصريّةَ المُمأسسة قد خَلقتْ أميركتيْن: واحدةً سوداءَ، والأخرى بيضاءَ. ومع ذلك، فإنّ "التغييرات" الأساسيّة الوحيدة التي أنجزتْها الدولةُ استجابةً لتلك الانتفاضات قد كان وما يزال "صقلَ" أجهزتِها الرقابيّة والتسلّحيّة: ففي نهاية الستينيّات برز أوّلُ فريقٍ من فِرَق SWAT [فريق الأسلحة أو التكتيكات الخاصّ] ردًّا على قيام "حزب الفهود السود" بتسيير دوريّات لحراسة الأحياء وضمانِ عدم ارتكاب الشرطة أعمالًا وحشيّة عنصريّة وعدم كتابتها تقاريرَ تنميطيّةً عنصريّة (racist profiling). وإلى اليوم، تُواصل الدولةُ إحلالَ المراقبة العنصريّة المفرِطة مكانَ الحلول الجذريّة لمعالجة الإفقار العِرقيّ؛ وولايةُ مينيسوتا حيث عاش جورج فلويْد هي مركزٌ مهمٌّ لبرنامج CVE [برنامج "مواجهة التطرّف العنيف"]، التابعِ لدائرة الأمن الوطنيّ، وهو برنامجٌ يقدّم أموالًا حكوميّةً من أجل كتابة تقاريرَ تنميطيّةٍ عن الجاليات المسلمة.
لكنّ الأفعال الوحيدة التي تدينها الحكومةُ رسميًّا بوصفها "عنفًا" هي تلك التي توجَّه إلى الأملاك الباهظة الكلفة. وفي هذا الصدد يكتب البروفيسور ألفونسو بينكني (Alphonso Pinkney) في دراسةٍ بعنوان "الطريقة الأميركيّة للعنف،" وهي دراسةٌ ألهمتْها، إلى حدٍّ ما، ردودُ فعل الدولة على انتفاضات أواخر الستينيّات من القرن العشرين:
"أن يدمِّرَ أو يخرِّبَ السودُ مِلْكيّةً قيمتُها 15مليون دولار، فذلك كان، من نواحٍ عديدةٍ، تعدّيًا أخطرَ بكثيرٍ مِن قتلِ 26 شخصًا وجرحِ أكثر من 1100 على يدِ من استُدْعُوا لإعادة النظام. إحدى خاصّيّات المجتمع المادّيّ هي انحدارُ الكائنات البشريّة؛ في الولايات المتحدة تُعتبر المِلْكيّةُ الخاصّةُ، في الواقع، أعلى قيمةً من الحياة البشريّة."

أفعالُ الدولة في أميركا توحي أنّ قيمةَ حياة الإنسان يقرِّرُها لونُ بشرته ورصيدُه في المصرف
اليوم، نادرًا ما يَسمع متابعو الأخبار الأميركيّة كلمةَ "العنف" لوصف أيّ شيءٍ باستثناء تدمير الأملاك أو تخريبها. نادرًا ما يسمعون - هذا إنْ سمعوا على الإطلاق - استخدامَ هذه الكلمة للتعبير عن قتل إنسان، ما دام مرتكبو هذه الجرائم أناسًا كلّفتْهم الدولةُ حمايةَ الأرصدة ومصالحِ رجالِ الأعمال الأغنياء والسياسيّين القامعين. وهم على الأرجح لن يسمعوا كلمةَ "العنف" في وصف تعدّيات الشرطة على الصحافيّين، وتَشمل: إطلاقَ القنابل المسيلةِ للدموع عليهم، ورشَّهم بالفلفل، وإطلاقَ النار عليهم، بل إصابتهم بالعمى الجزئيّ. بعد كلّ العقود التي تلتْ مقالةَ بالدْوِنْ، توحي أفعالُ الدولة في أميركا - أكانت أفعالًا استباقيّةً أمْ ردودَ فعل - أنّ قيمةَ حياة الإنسان ما زال يقرِّرُها لونُ بشرته أوّلًا، ورصيدُه في المصرف ثانيًا ــ ووفق هذا الترتيب تمامًا. وإذا أخذنا سجلَّ دونالد ترامب الثابت لجهة مشاعره العنصريّة وعدائيّته للمعارضين المختلفين المعدومي الامتيازات، فإنّ تهديدَه باستخدام الجيش في كلّ أماكن الاحتجاجات، بموجب "مرسوم مكافحة التمرّد للعام 1807،" تحريضٌ على حربٍ عِرقيّةٍ مسلّحة!
في هذه الأثناء قد يتوقّع المطَّلعون على الأخبار الأميركيّة أن يَسمعوا إصرارًا متكرّرًا على سرديّةٍ تقول إنّ الاحتجاجات "بدأتْ محقّةً" لكنّها ما لبثتْ أن "تصاعدتْ،" فـ"سيطر عليها محرِّضون خارجيّون" أكثرُ تصميمًا على تحقيق غاياتهم المادّيّة الشخصيّة من تحقيق العدالة لضحايا العنصريّة الأميركيّة المُمأسسة الجُدد. هذا تمامًا ما حصل حين ردّت الشرطةُ والحرسُ الوطنيّ على انتفاضات فيرغوسين (ولاية ميزوري) سنة 2014 بعد أن قتلت الشرطةُ مايْكل براون، وهو أميركيٌّ من أصلٍ أفريقيّ، في الثامنة عشرة من عمره؛ فقد جرى وصفُ المحتجّين آنذاك بـ "قوّات العدوّ" (enemy forces). والحقّ أنّ هذا الاتهامَ اختلاقٌ "مريحٌ" يَسمح للدولة بتفادي أيِّ مسؤوليّةٍ أو محاسبةٍ عن غضب المواطنين المعارضين؛ وهو أيضًا تعبيرٌ ملطَّفٌ [ولكنّه] خطيرٌ لوصف اتّجاهٍ محتملٍ إلى استخدام أساليبِ قوّةٍ أكثرَ عدوانيّةً ممّا يُستخدم اليوم: أساليبَ مخصّصةِ لـ"الأعداءَ الخارجيين." هنا نرى، على نحوٍ قارسٍ، كيف يؤدّي تعبيرُ بالدوِنْ، "الأراضي المحتلّة،" معنييْن متغايريْن.
يبقى علينا أن ننتظر لنرى إنْ كانت الدولةُ الأميركيّةُ ستّتخذ أيّ إجراءاتٍ ذاتِ قيمة ردًّا على قتل الشرطة لجورج فلويْد. غير أنّ التاريخ لا يقدِّم لنا أيَّ إجابةٍ مشجِّعة. ذلك أنّ تعزيز قوّة الدولة العقابيّة، ورفْعَ مستوى المقموعين، نادرًا ما يكونان أمريْن متوافقيْن. لقد آن الأوانُ لمحاسبةِ مَن يشعرون بضرورة إطلاق الإدانات الفوقيّة والمتعالية لغضب الناس المحِقّ.
ختامًا، نحتاج إلى القول انْ لا شيء اسمُه "دولة بوليسيّة عادلة،" مثلما أنّه يَنْدر أن يحدث شيءٌ اسمُه "احتجاجٌ مُتْقَن" (perfect protest). الاستنتاج الثاني هو من حقائق الحياة العمليّة، مثلما أنّ الاستنتاجَ الأوّل غالبًا ما يكون من حقائق الموت. وفي ضوء ذلك، يبقى واجبًا على كلّ مَن تهمّهم العدالةُ فعلًا أن يدعموا بعضهم بعضًا من خلال خياراتٍ اجتماعيّةٍ تكون بديلًا للشرطة والقوّة العسكريّة. ذلك ما ينبغي أن تعنيه، الآن وأكثرَ من أيّ وقتٍ مضى، كلمةُ "الالتقاء" أو "الاجتماع" (coming together).
الولايات المتحدة
شاعر وكاتب وعضو في "حركة الشباب الفلسطينيّ".(PYM) تبحث كتاباتُه السياسيّة، وأطروحةُ الدكتوراه التي قدّمها، في كيفيّة استخدام الشعوب الخاضعة للعنصريّة والكولونياليّة وسائلَ خلّاقةً لمقاومة مشاريع الدولة في المراقبة والتحكّم البوليسيّ.