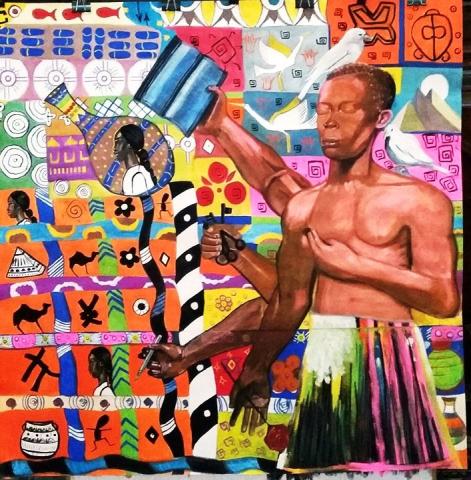أومليت إمّ فادي وأهْوة إمّ طارئ.
كلُّكم أوجعتم قلبي يا أصدقائي.
ليتني لم أعرفْكم. ليتكم لم تسْحروني!
وللمدنِ ألفةٌ خاصّةٌ، غير العاطفة التي تربط أبناءَها بها. فالمدن، كأمكنة، تبتكر روائحَها وغوايتَها للغريب بطريقةٍ غامضة. وقد تُختزل تلك الألفةُ بمكانٍ صغيرٍ، أو مَلْمحٍ بسيطٍ، أو امرأةٍ عابرةٍ، أو واقعةٍ عاديّةٍ لا تلفت الأنظار.
تقول صديقةٌ بيروتيّة:
ـ الحمد لله أنّك زائرٌ دائمٌ لبيروت، ولستَ مقيمًا فيها.
ـ لماذا؟
ـ كي تتمتّعَ باكتشافها في كلّ زيارة، وتبقى عاشقًا لها طوالَ العمر.
الملامح التي تُدهشني كلّما زرتُ بيروت قد لا تُدْهش ساكنيها، لأنّهم - ببساطة - قد اعتادوها، حتى أصبحتْ بالنسبة إليهم غيرَ مرئيّةٍ، أو مكرَّرةً، أو يوميّة.
أكثرَ من مرّةٍ حاولتُ أن أكسرَ نظريّةَ صديقتي البيروتيّة. لكنّني لم أتمكّنْ من ذلك لأنّ أطولَ مدّةٍ لي في بيروت كانت شهرًا.
اعتدتُ، في كلّ زيارةٍ إلى بيروت، الإقامةَ في فندق موزارت. الفندق صغير، وهو يقع على ناصية شارع الحمرا من جهة الروشة، حيث ينحدر الطريقُ قليلًا ويتفرّع إلى مسْربيْن: اليسار صعودًا باتّجاه الروشة، واليمين نزولًا حيث محطّةُ تعبئة البنزين وفندقُ موزارت.
لم يكن الفندقُ في الحقيقة استثنائيًّا، لكنّه نظيفٌ وحميمٌ ويتمتّع بكافيتيريا صغيرةٍ تُطلّ على الشارع الهادئ نسبيًّا، حيث يخفّ زحامُ الحمرا، ويتراجع صخبُ السيّارات وهديرُ الباعة.
قد لا تصدِّقون أنّ تلك الكافيتيريا الصغيرةَ والحميمةَ، ذاتَ الترّاسِ الصيفيّ المغطّى ببعض العرائش، هي التي تجعلني اختارُ هذا الفندقَ، على الرغم من أنّ أصدقاء كثيرين دعوْني إلى فنادقَ أكثرَ رفاهيةً؛ فأنا لا أحبّ الإقامةَ في بناياتٍ تقع على شوارع صاخبةٍ وأزقّةٍ مكتظّة.
في كافيتيريا فندق موزارت المهادنة، اعتدتُ تناولَ فطوري الصباحيّ. هناك، أتمتّع بطعم الزيتون البلديّ، واللبنةِ الطازجة، والزعترِ الجبليّ - - تلك الأشياء التي أفتقدُها طوالَ العام في هولندا، إلى أن تحين زيارتي إلى بيروت. ولعلّ الأمر الذي زاد من حميميّة الفطور الصباحيّ هو وجودُ إمّ فادي، بكسر الألف، لا بضمِّها، كما يحلو لها أن تسمّي نفسها.
وإمّ فادي، هذه، سيّدةٌ في الخمسين، قُتل زوجُها في الحرب الأهليّة، وهاجر أبناؤها إلى أمريكا والبرازيل. لكنّها سيّدةٌ ضاحكةٌ وفكهةٌ وحيويّةٌ، على الرغم من ذلك كلِّه. تعرّفتُ إليها ذاتَ صباح عندما وجدتُ، على مائدة الفطور، البيضَ المسلوقَ الذي لا أحبِّذُه، فسألتُها عن إمكانيّة عمل "أومليت" خاصٍّ لي، ولو تطلّب ذلك دفعَ ثمنه. ابتسمتْ أِم فادي وقالت:
ـ ائعُودْ (اِجلسْ) بالمحلّ يللي بتحبّو، وهلّأ جاييك الأومليت.
من يومها، صارت أِمّ فادي تعمل لي الأومليت خصّيصًا كلّما رأتني داخلًا. مرّةً بالزبدة، وأخرى بالزعتر، وثالثةً بالمربّى، لكنّه يبقى في جميع الحالات أومليت إمّ فادي الذي لا يُضاهى، والذي لا آكلُه إلَا في بيروت. هذا ناهيكم بالزيتون البلديّ، والمناقيش بالجبنة. وهي في كلّ مرّةٍ تضع على الطاولة كاسةً صغيرةً فيها بضعُ حبّاتٍ من الزيتون الأخضر المشقوق المنقوع بالزيت، وتطلب منَّي - بابتسامتها المهادنة - تذوُّقَه:
ـ دِئْلي هالزيتونات.
***
للأمّهات في بيروت رائحةٌ مميّزةٌ وسحرٌ خاصّ. أو قل إنّ لهنّ هالةً سحريّةً، لا يُدرَكُ كنهُها، وتشعرُ معها - أنت الغريب على وجه الخصوص - بالانتماء إلى تلك المدينة الكبيرة.
مرّةً، كنتُ أسير سريعًا في جولتي الصباحيّة المبكّرة في الشوارع الخلفيّة المجاورة لفندق موزارت. التبستْ عليّ الأزقّةُ المنحدرةُ كلُّها باتجاه الروشة. وأنا في غمرة حيرتي، لمحتُ سيّدةً مسنّةً تجلس في شرفة بيتها الصغيرة، شبهِ الأرضيّة، تحت ظلّ شجرة، وهي تتناول قهوتَها. اقتربتُ منها على استحياء:
ـ صباح الخير، مَدام.
ـ أهلين، صباح النّور.
ـ أيّ الطرق توصل إلى الحمرا؟
ابتسمت السيّدة وقالت:
ـ من وين الشبّ؟
ـ من العراق.
ـ أهلا وسهلا والله. مبيِّن عليك تعبان شويّ.
ـ نعم. اعتدت الخروج بجولة صباحيّة قبل تناول فطوري، فلقيت الأزقّة في صعود متواصل.
ـ طيّب برومْ برومْ حدّي، تا أعملك أهْوة، وتاخُدْ نفسَكْ شويّ.
قلتُ متردّدًا بخجل:
ـ لا شكرًا لك مَدام. عليّ العودة إلى الفندق.
ـ يا عمّي بروم شو بيكْ؟ هيّيتو الفندق هونيك. شرابْ أهِوْتَك وروحْ.
بقيتُ متحيّرًا أمام إصرار السيّدة الطيّبة. لكنّني "برمْتُ" وجلستُ إلى طاولتها الصغيرة، بينما دخلتْ لتحضِّر لي فنجانَ قهوة.
كانت ريحُ الصباح النديّة تداعب أغصانَ الشجرة الوارفة فوق رأسي، فتثير حفيفًا طريًّا، وتبعثر نسماتِ الهواء العليلةَ من حولي. ناهيك برفيف العصافير العابثة في قلب الشجرة، وزقزقتِها الآسرة. تساءلتُ في سرّي: أيّ صباح رحيم هذا، وأيّ عزلةٍ حميمة، وأيّ قناعةٍ وطيبةٍ ورضًى لدى تلك السيّدة!
وإذ بصوتها يأتيني من الداخل:
ـ أهِوْتك حلوِه مش هيك؟
فهتفتُ باندهاش:
ـ نعم حلوه.
وعندما عادت ووضعت الفنجانَ الصغيرَ على الطاولة أمامي، سألتُها بتردّد:
ـ كيف عرفتِ أنّ قهوتي حلوة؟
ـ أي بعرف. كلّ العِرائيّة (العراقيين) بيشربوها حلوة.
ـ ذلك لأنّنا غُشماء في شرب القهوة!
ـ لا. لأنّكم بتحبّو كلّ شي حلو. أبو طارئ (طارق) كان يشربها هيك، فديت اللي خلأو.
لم أعلِّقْ، ولم أسألْها عن "أبو طارئ" هذا، على الرغم من الفضول الذي انتابني. ارتشفتْ من فنجانها، ووضعتْه على الطاولة، ثم أطلقتْ زفرةً طويلة. بدا أنّها قرأتْ ما يجول في خاطري، فقالت مبتسمةً:
ـ زوجي أبو طارِئ كان عِرائي.
ثم صمتتْ قليلًا كأنّها تريد رؤيةَ وقعِ الخبر عليّ، قبل أن تردف:
ـ استشهد بفلسطين!
كانت امّ طارق، وهذه هي كنيتُها التي عُرفتْ بها فيما بعد، تَنْشط في العمل الفدائيّ من بيروت أبّان السبعينيّات. آنذاك، تعرّفتْ إلى أبي طارق، الذي لم تشأ ذكرَ اسمه كاملًا لعهدٍ قطعتْه على نفسها بأن لا تبوح بأسرار التنظيم، على الرغم من مرور أكثر من خمسين سنةً على استشهاده!
وكان أبو طارق شابًّا عراقيًّا متحمّسًا، أسمرَ البشرة، وذا شعرٍ طويل "ملفلف" على رأي امّ طارق، ولحيةٍ طويلة. وكان قد ترك دراسةَ الهندسة في جامعة بغداد، وجاء إلى بيروت متطوِّعًا في العمل الفدائيّ. وذاتَ ليلةٍ صيفيّةٍ رائقة، في مكانٍ ما من المرتفعات التي تحيط بالنبطيّة في جنوب لبنان، احتفى بهما رفاقُهما وأعلناهما زوجًا وزوجةً وفق الشرعيّة الثوريّة، على الرغم من اختلاف دينيْهما، بعد قصة حبٍّ سريعةٍ تشابكتْ براعمُها حول قلبيْهما الغضّيْن.
على أنّ تلك الليلة التي دخلا فيها خيمةَ عرسهما كانت الليلةَ الأولى والأخيرةَ: فقد تسلّل أبو طارق في الفجر التالي مع ثلّةٍ من رفاقه نحو الجليل، ليفجّروا خزّانَ وقودٍ كان يتجهّز منه جيشُ الاحتلال. وحدثتْ مواجهةٌ بطوليةٌ بين الفدائيّين السبعة وعشراتِ الجنود الإسرائيليين، سطّر فيها الفدائيّون ملحمةً بطوليّةً، واستُشهدوا بعدها جميعًا.
تلك الليلةُ البعيدة، الممزوجةُ باللوعة واللهفة والحبّ والذكريات، أثمرتْ "طارق" الذي كان نسخةً طبقَ الأصل من أبيه... سوى أنّ لونَ بشرته أبيضُ، وقد ورثه من أمّه.
***
ذاتَ يوم، أثناء قيلولتي في غرفتي بالفندق، اتّصلوا بي من الاستقبال، وأخبروني بوجود ضيوفٍ يودّون مقابلتي.
استغربتُ الأمر، إذ لم يعرفْ بمكان إقامتي في فندق موزارت سوى القليلين جدًّا من الأصدقاء، وهؤلاء أغلبُهم يعرفون رقمَ هاتفي. ارتديتُ ملابسَ صيفيّةً خفيفةً ونزلتُ. لم يكن في صالة الاستقبال أحد. وعندما سألتُ موظّفة الفندق، أخبرتني أنّ فتاةً تجلس في الكافيتيريا تودّ مقابلتي. وهناك، هرعتْ نحوي صبيّةٌ حسناءُ غايةٌ في الجمال والرقّة، ذاتُ شعرٍ أسودَ مجعّدٍ ومنفوش، حول وجهها البيضويّ الجميل مثل هالةٍ سحريّة، وقوامٍ ممشوقٍ زاده فتنةً قميصٌ رياضيٌّ من دون كمّيْن، طُبعتْ عليه صورةُ الثائر جيفارا.
اقتربتْ منِّي مبتسمةً وهي تمدّ يدَها لتصافحَني. وما إن استقرّتْ كفُّها الصغيرةُ في كفّي، حتى قالت بحماس:
ـ أهلين إستيز محمّد. أنا ريم طارئ.
رحّبتُ بها ترحيبًا حارًّا، وجلسنا نتبادل أطرافَ الحديث في مكاني الأثير في ركن الكافيتيريا تحت شجرة الصفصاف الصغيرة، والدهشةُ لا تفارقُني. ورحتُ أتساءلُ في سرّي: أيعقل أن تكون هذه الملاكُ حفيدةَ أمّ طارق، صديقتي الفدائيّة المتقاعدة وسيّدةِ العصافير والقهوةِ الصباحيّةِ الرائقة؟ وإذا كانت كذلك، فكم أخذتْ من أبيها وجدّها أو جدّتها يا ترى كي ترثَ هذا الجمالَ كلّه؟
انتشلني من دهشتي صوتُها الرقيق:
ـ ستي قالت إمرئي (مُرّي) لعند استيز محمّد في الأوتيل وادْعيه على العشا الليلة عنّا، إزا ما في عندو التزيم تيني (التزام ثانٍ).
***
كان أبو جورج الشوفير يَسكن في إحدى الضِّياع القريبةِ من بيروت. وقد نقلني ذاتَ ليلةٍ ماطرةٍ من مطار رفيق الحريري إلى فندق موزارت، فصار صديقي: كلّما احتجتُ إليه أتّصلُ به فيَحْضر، أحيانًا من الضيعة البعيدة، خصّيصًا كي يساعدَني على قضاء بعضِ المشاوير.
ذاتَ يومٍ، سألتُه إنْ كان يعرف محلًّا يبيع زعترًا جيّدًا لآخذَه معي إلى هولندا فيكفيني مؤنةَ الشتاء هناك، ولا سيّما أنّني لا أتخيّلُ يومي من دون حضور الزعتر والزيت واللبنةِ والبيض على مائدة فطوري الصباحيّ.
ـ هلّأ شو بدّك فيهم هيدول المحلّات؟ كلّن بيغشّو!
ـ حسنًا يا أبو جورج. وما العمل إذًا؟
ـ لا تعتلْ همّ. أنا بجبلك شويّة زعترات من اللي ألْبك (قلبك) بيحبّن من عنّا من الضيعة.
أُسقِط في يدي، ولم أشأ أن أخبرَه بأنّني أريد كمّيّةً كبيرةً تكفيني شتاءً كاملًا، وأنّني أريدُه من النوع المُلوكيّ، بحسب رأي المَدام، مخلوطًا بالسمسم المقليّ والسمّاق والفستقِ الحلبيّ، بمقاييسَ محسوبةٍ لا يعرفها إلّا المتخصّصون في الزعتر. لكنّني أذعنتُ لرغبته في النهاية، وأعطيتُه مائة دولار ثمنَ الزعتر الذي سيُحْضره لي. وعلى الرغم من أنّه استكثر المبلغ ورفض استلامَه أوّلَ الأمر، إلّا أنّني أصررتُ على أن يأخذه.
***
كان فندق موزارت يتمتّع بميزاتٍ فريدةٍ في الواقع. من هذه الميزات أنّ مصبغةً صغيرةً يديرُها حسن، ابنُ الضاحية الجنوبيّة، لا تبعد عنه أكثرَ من مائة متر، وأنّ محلَّ "مناقيش أبو فادي" لا يبعد عنه سوى مائتيْ متر، وما بينهما تقع "أسواقُ الرائد" التي أبتاعُ منها العرقَ والخيارَ واللبنَ البلديّ والثلجَ والليمون. في هذه الأسواق تعمل ياسمين، وهي فتاةٌ سوريّةٌ صودف أنّها تحبّ رواياتِ حنّا مينه. وهناك أيضًا تعمل سامنتا، وهي عاملةُ خدمةٍ فلبينيّة، تتكلّم الإنجليزيّة بطلاقة. ناهيك بمكتبةٍ صغيرةٍ أشتري منها الصحفَ، لا تبعد أكثرَ من خمسين مترًا عن الفندق.
ذاتَ معرضِ كتابٍ في بيروت، زارتني ياسمين وسامنتا، فابتعتُ نسخًا من رواياتي وأهديتُهما إيّاها، بالإضافة إلى نسخةٍ من رواية ايلينا فيرّانتي، صديقتي المذْهلة. ثم دعوتُهما إلى تناول فنجان قهوة في كافتيريا المعرض. هناك، لمستُ امتنانَهما وسعادتَهما، لاسيّما حين اعتذرتُ من مراسلة BBC التي طلبتْ إجراءَ لقاءٍ معي عن روايتي الأخيرة بحجّة "انشغالي مع ضيوفي."
***
في جولةٍ جبليّةٍ بسيّارةٍ مستأجَرة، شعرتُ بالجوع، فبحثتُ عن مطعم في الأرجاء، إذ طالما سمعتُ عن مطاعمَ جبليّةٍ في لبنان تقدِّم أشهى المأكولات البلديّة. فلم أجد أيًّا منها.
ثمّ اهتديتُ إلى عريشةٍ من العنب، تحتها أريكةٌ وطاولةٌ صغيرةٌ، وقربهما كُدّستْ صناديقُ كوكاكولا فارغة.
ركنتُ السيّارةَ ونزلت. وحالما جلستُ، حضرتْ سيّدةٌ مرحة، رحّبتْ بي بحرارة، فشكرتُها وطلبتُ منها وجبةَ طعام - - أيَّ وجبةٍ أسدُّ بها جوعي إلى حين نزولي إلى بيروت.
ابتسمت السيّدة، وعادت أدراجَها إلى الداخل. وبعد لحظات، حضر رجلٌ عجوزٌ غايةٌ في التهذيب، بشاربٍ جبليٍّ معقوف، ووسامةٍ قديمةٍ ارتسمتْ بقاياها على ملامحه المتناسقة. رحّب بي ترحيبًا حارًّا. وسرعان ما أحضرت المرأةُ طبقَ سلطة كبيرًا وصحنَ زيتون. غاب العجوزُ في الداخل من جديد، في حين ظلّت المرأة تحدّثني عن الطقس وهواءِ الجبل الذي يشفي العليلَ، وهي تقلّب حزمةَ زعترٍ أخضر مشرورٍ على دكّةٍ قريبة. دقائق، وعاد العجوزُ وهو يحمل دورقًا صغيرًا وقدحيْن، وضعها أمامي على الطاولة، وقال بفرح:
ـ دِئلي هالعَرْقات.
وراح يسكب لنا العرقَ الممزوجَ بالماء ـ "متلّت" ـ في القدحيْن الصغيرين. وبعد نصف ساعةٍ من السمَر وحديثِ الرجل عن أخطاء صدّام حسين وخيانةِ العرب وبيعِ فلسطين، أحضرت السيّدة طاجن دجاجٍ محمَّرًا بالفلفل والباذنجان. فكان مساءً لن يُمحى من ذاكرتي ما حييتُ - - نظرًا إلى روعة المنظر المُطلّ على المتوسّط من بعيد، ونعومةِ الهواء العليل، ولذّةِ ذلك العرق، وطاجنِ الدجاج بالفلفل والباذنجان، وطيبةِ ذلك العجوز وتلك السيّدة المرحة زوجتِه.
عندما هطل المساءُ وحانت ساعةُ النزول إلى بيروت، أخرجتُ محفظتي طالبًا الحسابَ. كنتُ منتشيًا غايةَ الانتشاء، حتى لا أقولَ سكرانًا. ضحك الرجل والمرأة وتبادلا النظرات، وارتسمتْ ملامحُ الدهشة على وجهيْهما. ثم أعادا محفظتي إلى جيبي، ودفعاني إلى السيارة دفعًا، وطلبا مني المغادرةَ والقيادةَ بحذرٍ في المنعطفات.
قال العجوز وهو يودِّعني مبتسمًا:
ـ هيك عرفت الطريق إلْنا. أنا أسمي فوزي العتال، أبو سامي. مرحبًا بك في أيّ وقت.
نزلتُ الجبلَ بتأنِّ وأنا ألوم نفسي على الحماقة التي ارتكبتُها حين ظننتُ أنّ ذلك البيتَ المهادنَ الرابضَ في عطفة الجبل مَطعم.
***
لم يعرف الجميعُ سرَّ الدّمِ النازفِ من رأس ريم: أكان دمَها، أمْ دمَ الجرحى الذين ساعدتْهم؟
فعلى الرغم من أنّ أحدَ المُسعفين تفحّص رأسَها غيرَ مرّةٍ من دون أن يرى أثرًا لأي جرح، فقد استمرّ الدّمُ في التدفّق.
طبيبةٌ شابّةٌ طلبتْ من ريم الكفَّ عن إحضار الجرحى، والاستلقاءَ على سرير الفحص. وعندما لم تجد مكانَ النزف هي أيضًا، طلبتْ من مساعِدةٍ قريبةٍ إحضارَ ماكنة حلاقةٍ لإزالة الشعر. لكنّ ريم رفضتْ حلقَ شعرها، وطلبت منهم تضميدَ رأسها إلى حين انتهائها من مساعدة الجرحى الذين تكدّسوا أمام المستشفى.
كانت الضمادةُ تمتلئ بالدم الذي بات يسربل وجهَ ريم وكتفيْها. وبدأتْ قوّتُها تخور، وعزيمتُها تضعف، حتى انهارت مغميًّا عليها.
سارعت المساعِدةُ إلى تفحّص رأسها. لكنّ كثافةَ شعرها الجميل حال دون معرفة مكانِ الجرح، قبل أن تُضطرّ إلى حلاقة مربّعٍ صغيرٍ فوق أذنها اليمنى. كان جرحًا غايةً في الصغر، لكنّه عميق، كما لو أنّه ثقب شريانًا في جانب رأسها.
نظّف المسعِفون الجرحَ من بقايا الزجاج، وضمّدوه بقطعة شاشٍ وشريطٍ لاصقٍ لأنّهم لم يستطيعوا رَتْقَه لصغر حجمه.
في المساء، عندما استيقظتْ ريم من غيبوبتها، سألتْ - أوّلَ ما سألتْ - عن جدّتها أمّ طارق التي ما فتئتْ تهاتفها منذ ليلة امس.
***
في فندق موزارت أخبرني الأصدقاء بأنّ إمّ فادي لم تأتِ منذ ثلاثة أيّام. حين هاتفتُها في اليوم الرابع، جاءني صوتُها واهنًا:
- الحمد لله، نحنَ بخير. شويّة جروح بالوجّ والرَّأْبة. بس البيت تكركَب، وانقلب فوْآني تحْتاني. الله ستر. ما مشيت للأوتيل والله من تلاتيّام؛ قالوا ما في نُزَلا، كلّن هربوا. مين بيجي لبيروت بهيك وَئِتْ؟
ـ فداكِ الأوتيل والنُزَلا يا إمّ فادي. المهمّ صحّتك. سلامتك ألف سلامة.
فجاءني صوتُها، باكيًا هذه المرّة، بعد أن نفدتْ ذخيرتُها من التظاهر بالقوّة:
ـ ولكْ ليش عم بيصير فينا هيك؟ ليش؟ ما بدّي إفئِد إيماني بالعدرا، بس والله كتير هيك. كتير يا ربّي!
وبعد تنهّدٍ ونشيج، أردفتْ:
ـ بعتذر يا محمّد. عن جدّ بعتذر. وجّعتلك ألْبك. ما أبشعني!
***
أوجعْتِ قلبي يا إمّ فادي. أوجعتم قلبي، أنتِ وبيروتُ والأصدقاء والأماكنُ والذكريات وطيبةُ النفوس والناس الملائكة التي تمشي على الأرض. كلُّكم أوجعتم قلبي يا إمّ فادي. فأنا لا أتخيّل وجهَكِ الصبوحَ الأبيضَ، مثلَ شريحة الجبنة، يُمزِّقُه الزجاج. لا أتخيّل بيروتَ، ابنةَ الآلهة، التي تدلّي قدميْها في المتوسّط بغنجٍ ودلالٍ منذ قرون، تُمزَّق بهذه الطريقةِ البشعة.
لا أتخيّلُ العالمَ من دون بيروت. ولا أتخيّلُ بيروتَ من دون فندق موزارت. ولا فندقَ موزارت من دون كافتيريته الحميمة. ولا كافتيريته تلك من دون ابتسامتِكِ ونكاتِكِ والأومليت بالزعتر من يديْكِ الرقيقتيْن ونفَسِكِ الطيّب.
أوجعتم قلبي يا أصدقائي الطيّبين في بيروت. كلُّكم أوجعتم قلبي بنبلكم وجمالِكم.
أوجعتِ قلبي يا إمّ طارئ وأنت تتباهَيْن ببقايا الحُسن القديمِ في وجهك حين تشربين قهوتَكِ تحت شجرة الدرّاق الوارفةِ في الصباحات الرائقة لتُحْيي ذكرى أبي طارئ وملامحه ووجهه الوسيم وأنفاسه العطرة التي تعيشين على ذكراها.
أوجعتَ قلبي يا أبا جورج وأنا أبحث عن وجهِكَ بين الوجوه الملهوفة التي تظهر في التلفزيون وهي تبحث عن أحبّائها. أتخيّلُكَ وأنت تحتضن لينا الغاليةَ بين ذراعيْكَ، وتمسح الدماءَ والترابَ عن وجهها الجميل، لأنّها - لحسن الحظ - لم تكن وقتَها أمام النافذة، بل في فراشها تستمع إلى فيروز. نعم أوجعتَ قلبي يا أبا جورج؛ فليتك لم تُحضرْ تلك الحقيبةَ الكبيرةَ المعبّأةَ بالزعتر والزيت والفستق والسمّاق والسمسم والعسل البلديّ، لتُقْنعني بأنّ كلَّ هذا بمائة دولار يا صديقي.
أوجعتَ قلبي يا أبا سامي وأنت تنظر - بعينيْن باكيتيْن من فوق الجبل - إلى حبيبتك بيروت تأكلها النّارُ وتجتاحها عاصفةُ الفراغ المهول. نعم أنتم بخيرٍ "فوْق،" لكنّكم متلهفون على أبنائكم وبناتكم الذين يسكنون بيروتَ ويعملون فيها، لعلّ اتّصالًا من أحدهم يطمْئن قلوبَكم الملتاعة.
كلُّكم أوجعتم قلبي يا أصدقائي في بيروت. فبيروت ليست ككلّ المدن. ليست كلُّ المدن في ظهرها شامٌ، وتنبت في خاصرتها فلسطينُ الجريحة. ليس في كلّ المدن فيروزُ، ولا كلّها خَطَتِ العذراءُ على أديمها وسهولِها وجبالِها وخطرتْ فوق بحرها. ليس في كلّ المدن صخرةُ طانيوس، ولا سنُّ الفيل، أو عينُ الرمّانة، أو مار مخايل، أو الجمّيْزة. وأخيرًا، ليس في كلّ المدن ريمُ الصبيّة، التي اغتسل الجرحى بعرقها الطَّهُور، وتخضّبتْ جدرانُ المستشفيات وأسرّتُها بدمائها وهي تصرخ في وجهِ مَن يحاول إسعافَها:
ـ ولكْ تركْني مُوت، بس خلّيني ساعِدْ هالعالم هَيْ!
هولندا