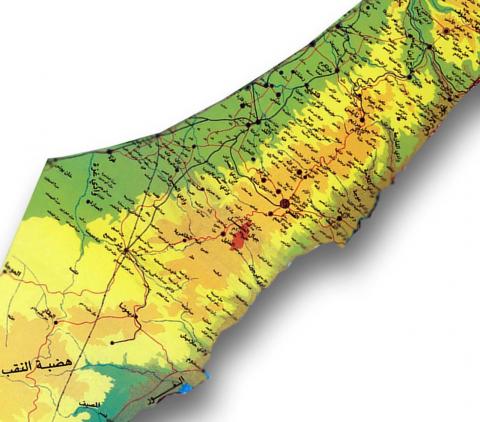يدّعي بعضُ الناس امتلاكَهم قدراتٍ خاصّةً تجعلهم قادرين على قراءة أفكارِ الآخرين. "سالي" مِن هؤلاء، وقد كانت لها نجاحاتٌ لا يمكن تجاهلُها، كما حصل في إحدى المرّات حين كنّا في المقهى عند بداية تعارفنا. فقد لاحظتُ أنّها تنظر إلى عينيّ مباشرةً، ثمّ وجدتُها تُخرج من حقيبتها دفترًا صغيرًا، وتكتبُ فيه بعضَ الكلمات، قبل أن تُغلقَه وتُسلّمني إيّاه قائلةً، وهي تشيرُ إلى الطاولة المجاورة، حيث مجموعةٌ من الصبايا والشباب:
- اخترْ أيّ شخصٍ من هذه المجموعة.
- الفتاة ذات الشّعر الأسود المُنسدل والنظّارة الحمراء، قلتُ من دون تفكير.
وما إنْ نطقتُ بهذه الكلمات حتّى تهلّلَ وجهُ سالي، وقالت بثقة:
- افتحِ الدفتر.
فتحتُه وقرأت: "ستختار الفتاةَ ذاتَ النظّارة الحمراء."
وجدتُ نفسي عاجزًا عن الكلام للحظات. لكنني عدتُ سريعًا إلى المنطق والعقل وقلت لها:
- هذا لأنّكِ تعرفين أنني أحبُّ الشَّعرَ الأسودَ المُنسدل. لقد ذكرتُ لكِ هذا قبل دقائق (وكان لسالي مثلُ هذا الشعر).
لكنها لم تهتمّ لكلامي، بل سحبتِ الدفترَ من يدي، وكتبتْ شيئًا آخر، ثمّ طوتِ الورقةَ التي كتبتْ عليها، وأغلقت الدفتر وناولتني إيّاه قائلةً:
- ماذا تُريد أن تشرب؟
***
التقيتُ سالي أوّلَ مرّة في بيت أحد الأصدقاء. سحرتْني من النظرة الأولى، ولم أستطعْ رفعَ عينيَّ عنها؛ الأمرُ الذي لفتَ انتباهَها، فجلستْ قربي وهمستْ في أذني:
- لماذا تُراقبُني؟
أكّدتُ لها أنّني لا أراقبها. لكنها عادت تسألني وهي تشدّد على كلّ حرف:
- لـ .. ــما.. ذا ... تــُـــراقبني؟
- لأنكِ جميلة، قلت.
وشعرتُ في تلك اللحظة أنّ المستقبل يكشف أوراقَه لي، وقرأتُ على إحداها كلمة "أحبُّكِ."
وفي ذلك المقهى (وكان قد مضى على لقائنا الأول حوالي الشهر، التقينا خلاله عدّة مرات)، وبعد سؤالها لي وهي تبتسم عمّا أريد أن أشرب، سمعتُ صوتًا في رأسي يخاطبني: "هيّا قُلها، قُلها!" لكنّني جبنتُ، وتراجعتُ في اللحظة الأخيرة، وعدتُ إلى اللعبة التي كانت تلعبها معي، فاستبعدتُ من ذهني كلَّ المشروباتِ التي أحبُّها، ثم قلتُ بنبرةٍ فيها الكثيرُ من التحدّي:
- نسكافيه بالحليب.
فوجدتُها تُشير بسبّابتها إلى الدفتر، وفي عينيها نظرةٌ غريبةٌ لم أفهم فحواها إلّا حين فتحتُه وقرأتُ: "وأنا أحبّكَ أيضًا!" رفعتُ رأسي ونظرتُ إليها غيرَ مصدّق، فوجدتُها تُغمضُ عينيها كمن يقول: "نعم، هذا صحيح." وبحركةٍ خرقاء، غيرَ عابئ بكل مَن حولنا، اقتربتُ منها وضممتُها بقوّة، ثم طبعتُ قبلةً طويلةً على شفتيها. بادلتني الضمَّ والقُبلَ باللهفة ذاتها. ولم ننتبه إلّا وصبيُّ المقهى يكحُّ قربنا ويسألنا:
- أتشربون شيئًا؟
- نسكافيه بالحليب، قلنا بصوتٍ واحد. وكانت المرّة الأولى في حياتي التي أتذوّقُ فيها هذا المشروب.
***
لا موقفَ حاسمًا لديّ تجاه هذا النوع من القدرات. ولأنني أعتبرُ أنّ العلمَ مرجعيّتي الفكريّةُ الوحيدة، فقد كنتُ أقولُ دائمًا: متى أَثبتَ العلمُ بشكلٍ قاطعٍ إمكانيّةَ حصولِ مثل هذه الأمور، فسأؤمنُ بها. أمّا قبل ذلك، فهي بالنسبة إليّ أفعالٌ مُبهمة.
وكان هذا الرأي يزعجُ سالي، التي عجزتْ عن إثباتِ قُدراتها "الخارقة" مئةً في المئة. فقد كانت، مقابلَ كلّ نجاح، تفشل عدّةَ مرّات. وهذا يُعتبر علميًّا دليلًا على ضعف أيّ فكرةٍ أو نظريّة. لكنّ سالي، التي لا تعرف اليأس، كانت تُفاجئني دومًا بدفترها الصغير وهي تدسُّه في يدي، ثم تسألني عن شيءٍ ما، وتبدأ التحديقَ في عينيّ محاولةً إيصالَ رسالتها عبر الأثير. وعندما تفشل (وهذا ما كان يحصل غالبًا) كانت تضع اللومَ عليّ لأنني "لم أركّزْ معها." وكم مرّةٍ شعرتُ بها تلكزني في خاصرتي، ونحن في المسرح أو السينما أو في باص النقل الداخليّ، لتشيرَ برأسِها وعينيها إلى أحدِ الأشخاص قائلةً: "انظرْ كيف سيحكُّ أذنَه اليمنى بعد لحظات!" ثم تركّز نظراتِها عليه، وتأمره في ذهنها بأن يفعلَ ما تريد، وإذ بالشخص المقصود يحكّ أذنَه فعلًا بحركةٍ عفويّة، أو يلتفت إلى الوراء كأنّ أحدًا ناداه. هكذا كانت تجاربُ سالي تنوس بين النجاح والفشل. وكان ذلك يجعلها متوتّرة، لا تعرف ماذا تريد.
***
عندما توطّدتْ علاقتُنا، سألتُها مرّةً عن معنى اسمها، فذكرتْ لي تعريفًا (أظنّه خاصًّا بها): إنّه اسمُ علمٍ مؤنّث، من أصلٍ عربيّ، ويعني"الفتاة التي تعيش في عالمٍ من الخيال، ناسيةً كلَّ ما يُؤرِّقُها ويُحزنُها." صحيحٌ أنّ لسالي ما يُؤرّقُها ويُحزنُها - - وهو ما لا يتوافقُ مع معنى الاسم الذي تحمله. لكنها كانت - بحقّ - تعيشُ في عالمٍ من الخيال، وكانت تريدني أن أُشارِكَها عالمَها هذا، المليءَ بالتجاربِ والمحاولات لإثباتِ قدرة العقل البشريّ على التواصل عن بعدٍ مع عقول الآخرين، وعلى نقل الرسائل إليهم، والإيحاءِ إليهم بالقيام بأفعالٍ بسيطةٍ خارجةٍ عن إرادتهم. وكلّما سألتُها عن سرّ هذه القدرات كانت تقول بغنج: "إنّه الحبّ!" ولم أفهم ما علاقةُ الحبّ بهذه الأمور. لكنّها سالي، التي تقول ما يحلو لها، وعلى الآخرين أن يفكّروا كما يحلو لهم. وكنتُ من الذين شكّوا في صحّة عقلها في بداية الأمر.
***
بعد ثلاثة أشهر من العيش في حبٍّ ووئام، بدأت الخلافاتُ تدبّ بيننا. وكانت في معظمها تتمحور حول هواجسها وطاقاتها الغريبة، التي تُصرّ على إقحامها في أدقّ تفاصيل حياتنا. وصرتُ أرفض مشاركتَها تجاربَها: فمن غير المعقول أنْ أجلسَ أمامها نصفَ ساعةٍ وهي تحدِّق بي كي تُوصلَ إليّ رسالةً ذهنيّةً مفادُها أنَّ عليّ الذهابَ إلى المتجر لشراء علبة متّة! وكنّا نبقى أحيانًا على خصامٍ لعدّة ساعات، بل لعدّة أيّام في مثل هذه الحالات، قبل أن يتراجعَ أحدُنا عن "تناحته" (وغالبًا ما كنتُ أنا مَن يتراجع). وفي إحدى المرّات، وبمجرّد احتضاني إيّاها واعتذاري إليها عن كلماتي الجارحة التي تلفّظتُ بها في لحظة غضب، أخرجتْ من جيب سترتها دفترَها الصغير وناولتني إيّاه لأقرأ في إحدى أوراقه: "ستأتي اليوم ظهرًا وتضمُّني وتعتذر إليّ وتقبّلني." فما كان منّي إلّا أن مزّقتُ الورقةَ ورميتُها في وجهها، ثم خرجتُ من البيت ولم أعدْ إلّا بعد أسبوع، وبعد تدخّل صديقتها المقربّة، مع وعودٍ بألّا تُشْركَني في تجاربها وعوالمها الغريبة.
***
مضت الأمورُ على أفضل حال بعد ذلك، ولمدّة عام تقريبًا. إلى أن جاء يوم وطلبتْ إليّ مرافقتَها إلى العيادة النسائيّة. وهناك زفّتْ إلينا الدكتورة البشرى: "المدام حامل." أذكر أنني شعرتُ بالدوخة، وكدتُ أفقد الوعيَ. وأذكر كيف نظرتُ إلى سالي ووجدتُها تبتسم بسعادةٍ ما بعدها سعادة. وقبل أن أفتحَ فمي قالت لي وهي تكزّ على أسنانها:
- لا تحلمْ بالإجهاض.
فسارعتُ إلى الخروج من المبنى كي لا أقوم بأيّ فعلٍ أخرق.
فلقد كنّا اتفقنا على أن نعيش معًا من دون زواج لفترةٍ من الزمن، إلى أن تتحسّن أوضاعُنا المادّيّة. وقد جعلتُها تُقْسمُ لي، غيرَ مرّة، بأنّها لن تقوم بأيّ ألاعيب كي تَحْبل، لكونها كانت تحلم دومًا بأن تكون لها بنتٌ تُشْبهها. وكنتُ في كلّ مرّة أذكّرُها باتفاقنا، وأشرحُ لها بالتفصيل المملّ ماذا سيحصل إذا وجدتْ نفسَها حُبلى. وكنتُ واضحًا وصريحًا كحدّ السيف: "عليكِ أن تختاري بيني وبين الجنين!" لذا شعرتُ بالخيانة عندما رأيتُها تبتسم بتلك الطريقة، ثم تصرُّ على الاحتفاظ بالجنين. لذا اتّخذتُ قرارًا بالابتعاد عنها، واختفيتُ من حياتِها نهائيًّا. وبمصادفةٍ غريبة (لا مجال للحديث عنها الآن) استطعتُ السّفرَ بعد أسابيع قليلة إلى ألمانيا، حيث بدأتُ حياتي من جديد هناك.
***
قاومتُ لأشهرٍ اشتياقي إليها. وقاومتُ فضولي الذي كان يأكلني لمعرفة مصير الجنين. كنتُ واثقًا بأنّها سعيدةٌ به على الرغم من خسارتها لي، وبأنّها ستجد طريقةً للاحتفاظ به، لأنّها قالت لي مرارًا: "هَبْني ولدًا وارحلْ إنْ شئتَ." كنتُ أحيانًا ألوم نفسي لأنني تخلّيتُ عنها، وأحيانًا ألومها على أنانيّتها لكونها فضّلتْ عليّ كتلةً من اللحم لا شكلَ لها ولا روح.
خلال الأشهر الأولى من وجودي في تلك البلاد، كانت تحصل معي أشياءُ غريبة: كأن أستيقظَ في منتصف الليل على صوتها وهي تنادي باسمي؛ أو أشعرَ أنّ أحدًا لمس كتفي وأنا أجلس وحيدًا في البيت؛ وأحسستُ غيرَ مرّةٍ أنّ هناك من يُمسكُ يدي وأنا أجتاز الشارع، فأجفل وألفتُ أنظارَ المارّة بسلوكي الغريب. ورويدًا رويدًا تكفّلتِ الظروفُ ببناءِ جدارٍ يفصل بين حياةٍ عشتُها وأخرى أعيشُها. ومع الوقت، وبعد أن اعتدتُ هذا الأمرَ، صارت سالي تدعوني كلّما تذكّرتُها إلى ممارسة التركيز الذهنيّ على الناس، وإرغامِهم على حكّ آذانهم أو مؤخّراتهم. فصرتُ أتسلّى بفعل ذلك. وكم كنتُ أضحكُ حين تنجح التجربة. ولم أعد أستهجن الفكرة، وإنْ كنتُ أعزو ما يحصل إلى "المصادفات" لا أكثر.
***
بقيتُ في الخارج ستَّ سنوات متواصلة. لم أزرْ فيها البلدَ مرّةً واحدةً. وخلال هذه الفترة تعرّفتُ إلى أكثر من فتاة، وكنتُ حريصًا على عدم إنجاب الأطفال. والغريب أنني كلّما نسيتُ سالي كانت تومض ذكراها في وجداني بطرقٍ غريبة: كأن أسمعَ - وأنا في طريقي صباحًا إلى العمل - امرأةً تتكلم عبر الهاتف المحمول وتذْكر اسمَ سالي عدة مرّات؛ أو كأن أقرأ اسمَها على علبة كرتون مرميّةٍ قرب بيتي على الرصيف؛ أو كما حصل آخر مرة حين فتحتُ المذياعَ، فخرج لي صوتُ المذيع يحدّثني عن مغنّية كنديّة تدعى "سالي جونز" انضمّتْ إلى "داعش" وقُتلتْ بقصف جوّيّ على أسوار الرقّة.
وهكذا، كلّما ظننتُ أنني نسيتُها، كان يسقط اسمُها في بحر ذاكرتي كحجرٍ ملتهبٍ يهزّ روحي بعنف، فأصاب بالحنين، وتتّسع دوائرُ الذكرى وتتداخلُ، ليصل تأثيرُ أمواجها المضطربة إلى قلبي، فيرتعشُ ظنًّا منه أنّني قد قابلتُ مَن أهوى.
***
قرأتُ خلال تلك السنوات كلَّ ما وقع بين يديّ من كتبٍ عن التخاطر، والاستبصار، وتحريكِ الأشياء عن بُعدٍ باستخدام قوة العقل، وعن انتقال المادة، والتخفّي. وقرأتُ كذلك عن الإسقاط النجميّ، وغير ذلك من غرائب الأفكار. وتأكّدتُ أنّ الأمر مثلما كنتُ أعتقدُ: مجرّد أفكارٍ وتجاربَ لا ضوابطَ لها ولا قواعد ولا قوانين. لكنّها مثل الحبّ: كانت تحصل كلّ يوم.
وبعد صراع طويل مع أفكاري تأكّدتُ أنّ سالي كانت معي طوال الوقت بطريقةٍ يصعب عليّ شرحُها. إذ كيف سيَفهم أيُّ أحدٍ عندما أقول: "وجدتُ أفكاري تتناغم مع موسيقى داخليّة مجهولة المصدر"؟ وكم سأبدو رومانسيًّا حالمًا إنْ أخبرتُ أحدًا بأنّ شيئًا غريبًا بدأ يحصل لي، يُشبه إلى حدٍّ كبير المشاعرَ التي تعتملُ في نفس المرءِ حين يلتقي بمن يُحبّ: فرحٌ غامرٌ، واضطرابٌ في دقات القلب، وابتسامةٌ لا تفارقُ الشفاهَ، وشعورٌ بالخِفّة حتى يكاد المرءُ يرتفع عن الأرض وهو يبتسمُ بلا سبب!
أخيرًا، في أحد الأيّام، وبعد جلسة شرودٍ طويلة، بدأتُ أسمع صوتَ جرسٍ صغيرٍ كالذي كنتُ أسمعُه في المدرسة، وهو يعلنُ أنّ وقتَ الاستراحة قد انتهى. لكنّ صوته صار يعلو ويعلو، يومًا بعد يوم. وفجأةً حلّ صمتٌ عظيمٌ، لم يشغلْه سوى صدى ذلك الجرس، تخالطه همساتٌ مبهمةٌ استطعتُ بسهولةٍ تمييزَ إحداها. كان هذا صوتَ سالي. نعم إنّه صوتها الذي أستطيع تمييزَه من بين ألف صوتٍ وصوت. ووجدتُ نفسي أبتسم رغمًا عني. وعرفتُ أنّه قد آن الأوان كي أعودَ إلى البلاد لأواجهَ ماضيّ بكلّ ما فيه من ذنوبٍ وندوبٍ وأحلام.
***
نمتُ ليلتها كما ينام الأطفال. واستيقظتُ على إحساسي بقبلةٍ فوق شفتيّ؛ قبلةٍ لطيفة من شفاهٍ طريّةٍ، نديّةٍ، جعلتني أبتسمُ قبل أن أفتحَ عينيّ وأبدأ الغناء: "على بلد المحبوب ودّيني .. زاد وجدي والبعد كويني..." وهكذا عدتُ إلى بلدي على جناح الشوق (كما يقال في القصص والروايات)؛ ذلك الشوق الذي اقتحمني فجأةً بعد تلك السنوات، وهزمني، وحطّم قلاعي، ومزّق أشرعتي. ورغم ذلك كنتُ سعيدًا بهزيمتي، ومتشوّقًا لأرمي برايتي تحت قدميْ حبيبتي.
لم أعرف كيف سأبحث عنها، أو كيف سأقابلها. ولم أتجرّأ على سؤال أحد عنها. بقيتُ يومين متتاليين بعد عودتي أفكّر في طريقةٍ للقائها. لم أكنْ أعلم إنْ تزوّجتْ أو سافرتْ خارج البلاد. بالإضافة إلى أنّ أخبار الموت اليوميّ على الشاشات وعبر مواقع التواصل الاجتماعيّ كانت تفتح الباب على كلّ الاحتمالات.
بقيتُ تائهًا ومُربكًا خلال هذين اليومين. ثمّ من فرط يأسي وشعوري بالخوف من المجهول، خطرتْ لي فكرةٌ لم أكن أظنّني سألجأ إليها يومًا. دخلتُ غرفتي ثم أغلقتُ البابَ على نفسي. جلستُ مغمضَ العينين أستحضرُ صورةَ سالي بانتظار رسالةٍ منها. ولم أغيّرْ من وضعيّتي إلّا بعد ساعة، حين شعرتُ بتيّارٍ خفيفٍ يجتاحُ جسدي، رافقه صوتُ طرقٍ على الباب.
وما إنْ فتحتُ عينيَّ حتّى وجدتُ البابَ يُفتح وتُطلّ منه طفلةٌ صغيرةٌ ترتاحُ على كتفَيْها ضفيرتان شقراوان تُحيطان بوجهٍ ملائكيّ، تبرز منه عينان زرقاوان، وأنفٌ صغيرٌ منمنم، فوق شفتين كرزيتيْن تفترّان عن ابتسامةٍ جمّدتني في مكاني وأنا أكاد لا أتنفّس!
ثمّ رأيتُ سالي تدفعُ الصغيرةَ أمامها بلطفٍ وتدخل الغرفة، وهي تطفو على غمامةٍ من النور وتسبح. وقفتُ مبهوتًا لأحتضنَ الطفلةَ التي وجدتُها فجأةً بين ذراعيّ تقول، وهي تلثغ:
- عرفتُ أنّكَ ستعود. كتبتْ ذلك الماما في الدفتر.
اللاذقيّة