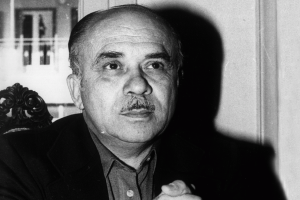يتبارى لاعبو كرة القدم من فريقين متنافسيْن، وقد يسجِّل أحدُهم أهدافًا في مرمى خصمه ويفوز عليه. في نهاية المباراة قد يصافح لاعبو الفريق المنتصر لاعبي الفريق المهزوم، وقد يتعانقون، وربّما يتبادلون القمصانَ المخضَّبة بالتعب والعرق، دلالةً على الاحترام والمودّة، ثمّ يذهب كلٌّ منهم إلى غرفة تبديل الملابس، قبل أن يتلقّوا التباريكَ أو المواساة من مشجِّعيهم. يجري ذلك كلُّه على الرغم من أنّ المباراة شهدتْ، قبل دقائق على الأرجح، تصادمًا مريعًا بين اللاعبين، وشتائمَ، وربّما ضرباتٍ راموسيّةً، أو نطحاتٍ زيدانيّةً، أو عضّاتٍ سواريزيّةً.
تلكم هي الأساسيّاتُ التي يُفترض أن يتربّى عليها اللاعبون في أيّ ميدانٍ رياضيّ. قد تختلف البروتوكولاتُ المرعيّة بين ميدانٍ رياضيّ وآخر، ولكنْ يُتوقّع أن تكون "الروحُ الرياضيّة" هي السائدة بين الفرق المتنافسة.
غير أنّ هذه ليست حالَ المتفرّجين في كثير من الأحيان، وأركّز هنا بشكلٍ خاصّ على مشجّعي المنتخبات الوطنيّة، أي القادمة من بلدانٍ مختلفة. فهؤلاء المشجِّعون يأتون بحمولاتٍ مسبّقةٍ كثيرة، سياسيّةٍ وقوميّةٍ وعنصريّةٍ وطائفيّةٍ وطبقيّة.
من البدهيّ أن تنحازَ غالبيّةُ المشجِّعين إلى فِرقها الوطنيّة. هذه سنّةُ الحياة؛ فالمرء عادةً ما يشعر أنّه أكثرُ قربًا إلى ابن جلدته ووطنِه وحيِّه منه إلى الأبعدين. بل يُتوقّع كذلك أن ينحازَ أبناءُ هذه المدينة أو القرية إلى الفريق القادم منها. وهذا الأمر ينطبق على المشجِّعين "الحقّاويّين" القلائل؛ فهؤلاء في الواقع يَطمسون، عامدين متعمِّدين، مشاعرَهم الوطنيّةَ أو القوميّة حيال فريقهم المحلّيّ أو منتخبهم القوميّ، وينحازون إلى أداء خصومهم الجميلِ والأنيقِ والمحترِف.
***
بيْد أنّ ما يَلفت النظرَ أمورٌ أخرى ليست بتلك البدهيّة. أوّلُها انحيازُ مواطنين عرب إلى فِرقٍ غير عربيّة. يجري ذلك على الرغم من أنّ الفرقَ العربيّة لم تكن قد خسرتْ بعدُ، أو خرجتْ من المونديال إلى غيرِ رجعة. في الأسباب التي يقدِّمها كثيرٌ من هؤلاء لا بدّ من أن نَشتمَّ شيئًا ـــ قليلًا أو كثيرًا ـــ من احتقار العرب وتمجيدِ "الآخرين." ولن نَعْدمَ أن نَسمعَ منهم تعبيراتٍ من نوع: "أصلًا العرب جحاش ما بيطلع من أمرهم شي،" و"العرب جرَب،" و"كلّ حياتنا خسرانين ما وقفتْ هلّق عالفوتبول،" و"الألمان شعب الماكينات،" و"إنّهم الألمان أيّها الأغبياء"، و"الفوتبول انخلق للبرازيل،"...
هؤلاء، بأقوالهم تلك، يَعكسون دونيّةً عميقةً تسري في دواخل عشرات آلاف العرب أو أكثر. وهذه الدونيّة لها ما يبرِّرُها للأسف الشديد، وهو تراجعُنا منذ عقودٍ على غالبيّة المستويات السياسيّة والعلميّة بشكلٍ خاصّ. ولكنّها غيرُ مبرَّرةٍ على الإطلاق حين تأتي في سياقٍ تاريخيّ "حتميّ" مزعوم؛ أيْ حين تأتي وكأنّ "تاريخَنا" قد فَرَضَ علينا الهزيمةَ الدائمة، أو كأنّ قدرَنا هو أن نبقى مهزومين خانعين إلى أبد الآبدين بسببٍ من "تاريخنا" المزعومِ ذاك.
***
الأمر الثاني اللافت هو مساواةُ بعض المشجِّعين الفرقَ الرياضيّةَ بأنظمةِ دولها. هذه المساواة، أو المماهاة، لها هي أيضًا ما يبرِّرُها، إنْ شئنا الموضوعيّة. فالأنظمة، في كثيرٍ من الأحيان، تُغدق المالَ والأوسمةَ و"العطايا" على الفِرق الوطنيّة لأنّها تَعتبر فوزَها تلميعًا لصورتها هي (أيْ لصورة الأنظمة) وتعزيزًا لمكانتها في "المجتمع الدوليّ."
والحقّ أنّ هذا الأمر لا يخصّ الأنظمةَ العربيّةَ وحدها، ولا الحقبةَ المعاصرةَ فقط. فعلى سبيل المثال، حاول هتلر وغوبلز استغلالَ انتصارات الملاكم الألمانيّ ماكس شملينج من أجل الترويج للنازيّة ولنظريّتها الخرقاء عن تفوّق العِرق الآريّ (مع أنّ شملينج لم ينتسبْ إلى الحزب النازيّ قطّ على ما قيل)؛ كما استغلّ موسوليني استضافةَ بلاده لكأس العالم سنة 1934 من أجل الترويج لنظامه في إيطاليا. ولا حاجة بنا إلى التذكير بما تبذله حكوماتُ العالم اليوم من أجل استضافة كأس العالم في أيّ مجالٍ رياضيّ.
غير أنّ ذلك كلَّه لا يعني أنّ المنتخبات الرياضيّة "تمثّل" حكوماتِها، ولا يعني أنّ كلَّ فرد في هذه المنتخبات داعمٌ لحكومته. ومماهاةُ بعضنا بين المنتخب والنظام، وخصوصًا في ما يتعلّق بالوضع العربيّ، خطيرٌ لأكثر من سبب. الأول أنّ هذه المماهاة غيرُ حقيقيّةٍ أصلًا؛ فمثلما أنّ "الشعب" غيرُ النظام، فإنّ المنتخب (الذي ينتمي إلى ذلك الشعب)، أو بعضَ أعضائه على الأقلّ، غيرُ النظام.
قد يُحجم أفرادُ المنتخب (وأفرادُ الشعب عامّةً) عن التعبير عن ضيقهم بالنظام خوفًا من سطوته المعروفة وعقابِه المتوقَّع. لكنّ دورَنا، كجمهور واعٍ وكمعلّقين غيرِ غوغائيين، هو أن نفترضَ على الدوام عدمَ المساواة بين الطرفيْن.[1] وهذا الافتراض لن يكونَ من نسج الخيال في كلّ الأحوال؛ فلا شكَّ في أنّ الأنظمة العربيّة، بشكلٍ عامّ، لا تحظى بدعم غالبيّة شعوبها، خصوصًا حين تتنكّر للثوابت القوميّة والوطنيّة.
ثم إنّ مساواتَنا المنتخبَ الرياضيّ بنظام الحُكم، هنا أو هناك، وإدانتَهما معًا، سوف يَجرّان جمهورَ المنتخب إلى المزيد من الالتصاق بالنظام. وهذا أمر معروف، ويدخل ضمن آليّات الدفاع عن النفس من عدوانٍ "خارجيّ." فحين نقول إنّنا ضدّ المنتخب المصريّ لأنّنا نكره نظامَ عبد الفتّاح السيسي، فماذا سنتوقّع أن تكون ردّةُ فعل جمهور هذا المنتخب (أو غالبيّتِه الساحقة)؟ إنّنا، في واقع الأمر، لن نكون قد دفعناه دفعًا إلى أحضان نظامه، فحسب، وإنما دفعناه أيضًا إلى أن يناصبَنا، ويناصبَ شعبَنا (نحن غيرَ المصريين)، العداءَ، خصوصًا مع "كفاءة" وسائل الإعلام المصريّة (أو غيرِها) في استدرار عواطف الناس "الوطنية" الضيّقة.
***
الأمر الثالث والأخير متعلّق بالثاني، ولكنه يستحقّ تنويهًا خاصًّا، وهو يتناول التعاملَ العدائيّ الذي يمارسه كثيرٌ من المشجِّعين العرب حيال كلِّ ما يمتّ إلى دول الخليج، والجزيرةِ العربيّة تحديدًا، بصلة. هكذا وَجدنا، مؤخّرًا، عداءً فجًّا، من قِبل كثير من العرب، للمنتخب السعوديّ في المونديال الروسيّ. وقد برّر هؤلاء موقفَهم بحزمةٍ من الأسباب، أبرزُها: رفضُهم الحربَ التي يشنّها النظامُ السعوديُّ على اليمن، وإدانتُهم للتحالف السعوديّ ــــ الأميركيّ المتنامي، وشجبُهم لخطوات التطبيع المتسارعة بين الحكم السعوديّ والكيان الصهيونيّ، ومعارضتُهم لوقوف الحُكم السعوديّ موقفَ التأييد الصارخ والعمليّ لأطرافٍ سوريّةٍ (وغيرِ سوريّة) تناصب النظامَ السوريَّ وحلفاءه الإقليميين العداءَ.
ولكنْ، هل هذه الأسباب كافيةٌ لمعاداة المنتخب السعوديّ في مباريات كرة القدم؟
إذا كان الردُّ إيجابيًّا، فلماذا لم يعادِ أولئك العربُ المنتخبَ المصريّ؟ ألا يحاصِر النظامُ المصريّ قطاعَ غزّة منذ أعوام، ويُسهم في تجويع أهلنا هناك؟ هل ألغى النظامُ المصريّ اتفاقيّةَ كامب ديفيد، التي شكّلت البدايةَ الفعليّة لخروج أهمّ دولة عربيّة من دائرة الصراع مع العدوّ الإسرائيليّ؟ هل أغلق النظامُ المصريّ السفارةَ الإسرائيليّة في القاهرة؟ هل تعامل بديمقراطيّةٍ و"ليونة" مع معارضيه؟
وخارج مناسبة المونديال الأخير في روسيا، لماذا لا نرى هذا العداءَ موجّهًا ضدّ المنتخب الأردنيّ، مع أنّ النظام الأردنيّ لا يقلّ تطبيعًا مع العدوّ منذ العام 1994 عن أيّ نظامٍ آخر، ويَسمح لمن يشاء من الأردنيين بالعمل داخل فلسطين المحتلّة، ويشتري غازًا "إسرائيليًّا" هو في الواقع غازٌ مسروقٌ من ثروات شعبنا الفلسطينيّ، ويمارس القمعَ (المدروس) تجاه معارضيه؟
وهل جرّم النظامُ التونسيّ أو النظامُ المغربيّ التطبيعَ، على ما تطالب القوى الوطنيّةُ والقوميّةُ والتقدميّة في هذين البلدين؟ وهل نظامُ المغرب، تحديدًا، وتاريخيًّا، أقلُّ تطبيعًا مع الكيان الصهيونيّ من أيّ نظامٍ عربيّ آخر؟ لماذا، إذن، لم يُثِر أولئك العربُ مسألةَ العداء للفريقيْن الرياضييْن المغربيّ والتونسيّ في المونديال على هذه الخلفيّة "القوميّة" المزعومة؟
بل هل نرى ذلك العداءَ موجَّهًا إلى أيّ فريقٍ رياضيّ فلسطينيّ، كي لا نقول إلى أيّ مغنّ فلسطينيّ، مع أنّ نظام محمود عبّاس، المنتهيَ الصلاحيّة، "ينسِّق أمنيًّا" مع الاحتلال، ويشارك في فرض العقوبات على قطاع غزّة، وتخلّى (مع سابقه نظام عرفات) عن 78% من فلسطين التاريخيّة، وما زال متمسّكًا حتى اللحظة بـ"عمليّة السلام"؟
نعم، هناك فارقٌ بين الوضع في المملكة السعوديّة من جهة، وبين الوضع في مصر والأردن وتونس والمغرب وفلسطين ضمن أراضي 67 من جهةٍ أخرى، وهو أنّنا نستطيع أن "نَسمع" صوتَ المعارضة في هذه البلدان الأخيرة أكثر ممّا نسمع صوتَها في السعوديّة. لكنْ، مَن منّا لم يَسمعْ بتظاهرات القطيف، وبالشيخ نمر النمر، على سبيل المثال لا الحصر؟ ومَن منّا لم يسمع بعبد الرحمن منيف، وناصر السعيد، وعشرات المثقفين المعارضين الآخرين في الجزيرة العربيّة؟
والحديث يطول في هذا الشأن. لكنْ لا مناصَ من القول إنّ تضعضعَ الفكر القوميّ التقدّميّ العربيّ هو أحدُ أهمّ أسبابِ تشكّلِ ما يُشْبه "النزعاتِ العنصريّةَ" بين العرب أنفسِهم. صحيح أنّ ذلك الفكر لم يكن قادرًا، في عزّ أيّامه، على إشاعة جوٍّ من الأخوّة العربيّة المنشودة، لكنّه كان قادرًا، إلى حدٍّ ما، على "إحراج" العصبويّة الإقليميّة، ولجمِ النزعات القطْريّة والانعزاليّة (كالفينيقيّة والفرعونيّة وهلمّجرًّا). وإنّ الحاجة إلى بعث القوميّة العربيّة، وتجديدِها، وتعميقِها، ومأسستِها، ومدِّ الجسور بينها وبين القوميّات المجاورة على قاعدة العداء لـ"إسرائيل،" تغدو أكثرَ إلحاحًا من أيّ وقتٍ مضى، خصوصًا أنّ غيابها المستمرّ ينعكس سلبًا، وبشكلٍ يزداد خطورةً، على مشاعر الجماهير العربيّة، بعضِها تجاه بعض.
بيروت
[1] من نافل القول إنّ ذلك التمييز في "إسرائيل" لا يعنينا كثيرًا كفلسطينيين وعرب. فهي، بغضّ النظر عن وجود أصوات معارضة فيها، كيان احتلاليّ وإحلاليّ واستيطانيّ وعنصريّ، ومن واجبنا أن نقاطعَها على كلّ المستويات السياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة والبحثيّة والرياضيّة والفنيّة... أيًّا كان نظامُ حكمها.