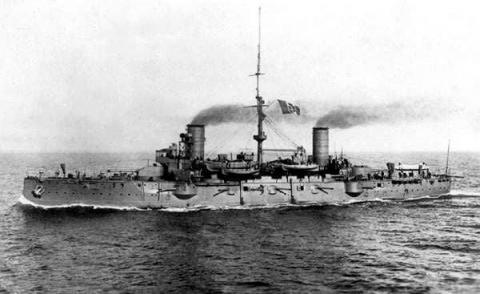"الدولة التي لا تستطيع الاحتفاظَ باستقلالها الماليّ لا تستطيع أيضًا الاحتفاظَ باستقلالها السياسيّ"... خالد العظم، رئيس وزراء سوريا الأسبق[1]
***
منذ أكثر من نصف قرن، توجّه مسؤولون لبنانيون، برئاسة وزير الخارجيّة آنذاك حميد فرنجيّة، إلى فرنسا، للتفاوض على مديونيّة الدولة. غير أنّ الفارق كبير بين أسباب تلك الزيارة وزيارةِ المسؤولين اللبنانيين اليوم: وهو أنّ لبنان آنذاك كان الدولةَ الدائنةَ لا المَدينة.
قد يصعب تصوّرُ سيناريو كهذا في عصرٍ أصبحتْ فيه مديونيّةُ لبنان المرتفعة صفةً ملازمةً لاقتصاده السياسيّ، ومدخلًا لتبعيّة هذا الاقتصاد المتزايدة لقوًى ماليّةٍ محلّيّةٍ وخارجيّة. لكنّ الديْنَ العامّ، أو الديْنَ السياديّ، ليس قدرًا تفرضه قوانينُ السوق، أو ضروراتُ التنمية، كما يُرَوِّج رعاةُ الدَّيْن أنفسُهم، من سياسيين واقتصاديين ومصرفيين؛ بل هو نتاجٌ لظروفٍ تاريخيّةٍ متغيّرة، ولخياراتٍ سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ متعمَّدة.
ولعلّ استذكارًا سريعًا لتجربة لبنان مع فرنسا بُعيْد فترة الاستقلال أن يسلِّط الضوءَ على تفريط الطبقة الحاكمة في لبنان، عبر التاريخ، لسيادته الماليّة، بغضّ النظر عمّا إذا كان لبنان دائنًا أو مَدينًا. ولا يمكن فهمُ دور هذه الطبقة في تدعيم السيادة الماليّة أو إضعافِها من دون فهم عنصريْن رئيسيْن يتحكّمان في تاريخ الديون السياديّة (أي الديون المتوجّبة على حكومات الدول) التي باتت من أهمّ أدوات السيطرة غير المباشرة بين الدول في النظام النيوليبراليّ الحاليّ:
ـ أصل الدَّيْن العامّ.
ـ دور العامل السياسيّ في تمديد هذا الديْن، أو إعادةِ تمويله، أو تصفيتِه، لمصلحة هذه الفئة أو تلك.

ولعلّ استذكارًا سريعًا لتجربة لبنان مع فرنسا يسلِّط الضوءَ على تفريط الطبقة الحاكمة في لبنان، لسيادته الماليّة
أصلُ الدَّيْن: التنمية أمِ الحرب؟
نتيجةً للاقتراض المفرِط بحجّة "إعادة الإعمار" بعد انتهاء الحرب الأهليّة (1975 ـــ 1990) تراكمتْ ديونُ لبنان الراهنة. ومع مرور الوقت وسوءِ الإدارة، تحوّلتْ هذه الديونُ الى مَصدرٍ للهدر والاستنزاف عبر خدمة الديْن العامّ ــ ــ أيْ عبر تجيير جزءٍ يسيرٍ من إيرادات الدولة لدفع الفوائد المترتّبة على هذا الديْن. وتواجه الطبقةُ الحاكمةُ في لبنان هذا المأزقَ بالهروب الى الأمام، وتحديدًا: بإعادة تمويل الدَّيْن من خلال مؤتمرات من صنف باريس ٤ وأخواتها، التي جلبتْ مزيدًا من تبعيّة لبنان لدائنيه، أكانوا مصارفَ محليّةً أمْ جهاتٍ مانحةً غربيّة.
وعلى الصعيد العالميّ أيضًا، ارتبطتْ أزماتُ الدَّيْن العامّ منذ سبعينيّات القرن المنصرم ببرامج التنمية في بلدانِ "العالم الثالث،" وبعجز هذه الدول عن تحمّل أعبائها. وقد يعطي ذلك انطباعًا أنّ الدَّيْن العامّ غالبًا ما يتأتّى عن الظروف الاقتصاديّة المحيطة بشروط التنمية والإعمار وسياساتِ الدولة الاقتصاديّة المرتبطة بهذه العملية ــ ــ وهذا صحيحٌ في كثيرٍ من الأحيان. لكنّ التاريخ يزخر بحالاتٍ كانت فيها استدانةُ الدولة (أو السلطةِ الحاكمة) تتمّ لأهدافٍ سياسيّة، وعلى رأسها شنُّ الحروب. ومن هذه الحالات، على سبيل المثال لا الحصر: اقتراضُ مَلك إنكلترا ويليام الثالث لدعم حربه على فرنسا أواخرَ القرن السابع عشر، واستحصالُ السلطنة العثمانيّة في منتصف القرن التاسع عشر على أول قرضٍ أجنبيّ أثناء حرب القرم لمواجهة روسيا، واستدانةُ واشنطن لتمويل حربها على العراق في أوائل القرن الحادي والعشرين.
أمّا في حالة لبنان والمنطقة العربيّة، فقد استغلّت الدولُ الأوروبيّة، أثناء الحرب العالميّة الثانية، سلطاتِها الانتدابيّة لتمويل حروبها من خزينة الدول التي تستعمِرها؛ تمامًا كما جنّدتْ مئاتِ الآلاف من شعوب هذه المستعمرات لخوض معاركها العسكريّة. ولقد كانت أعباءُ الحرب العالميّة الثانية هي سببَ استدانة فرنسا من لبنان حينها. فقد فرضت الدولُ المستعمِرة، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا، قوانينَ تسمح لها بمراكمة ديْنٍ عامّ على حساب الدول الدائنة أو المؤسّسات الماليّة التي تمثّلها؛ ذلك أنّها سمحتْ لمصارفِ إصدارِ العملة في هذه الدول، كبنك سوريا ولبنان (وهو مصرفٌ خاصٌّ بإدارةِ فرنسيّ، خلافًا لما قد يوحي به الاسم)، بطباعة العملة المحلّيّة لتمويل نفقات جيوش الحلفاء، مقابلَ سنداتِ خزينةٍ للحكومة المستعمِرة تصدر في عاصمة البلد المستعمِر، كلندن وباريس. ومعنى ذلك أنّ باريس كانت تقترض من بنك سوريا ولبنان عبر إصدار سندات خزينةٍ، مودَعةٍ في حساب البنك في باريس، على أن تكون هذه السنداتُ بمثابة تغطية (ضمانة) لطباعة العملة المحليّة (الليرة)، التي كانت فرنسا تقترض منها لدفع النفقات المحليّة لجيوشها.[2]
بكلام آخر، كانت باريس هي صاحبةَ القرار في تحديد قيمة دَيْنها وشروطِ هذا الدَّيْن على لبنان وسوريا. ومن الطبيعيّ أن يكون لذلك تأثيرٌ في قيمة العملة المحلّيّة للبلديْن، التي كانت حينها عملةً موحَّدةً (الليرة السوريّة اللبنانيّة) مربوطةً بالفرنك الفرنسيّ.
لكنّ القصّة لم تنتهِ هنا. ففي العام ١٩٤٤، ونتيجةً لتدهور سعر صرف الفرنك الفرنسيّ، اضطُرّت فرنسا إلى توقيع اتفاقيّةٍ مع لبنان وسوريا، برعايةٍ بريطانيّة، تَضمن قيمةَ تغطية الليرة السوريّة اللبنانيّة بالجنيه الإسترلينيّ بدلًا من الفرنك الفرنسيّ. ولم يمرّ عامان على الاتفاقيّة حتى تملّصتْ باريس منها، في ظلّ مخاوفَ من انهيارٍ متزايدٍ للفرنك. اعترضتْ بيروت ودمشق، لكنهما فضّلتا التفاوضَ مع باريس بدلًا من اللجوء إلى القضاء الدوليّ في لاهاي للمطالبة بحقوقهما. وقد أسفرت المفاوضات، التي انطلقتْ في العاصمة الفرنسيّة في ١ أكتوبر ١٩٤٧، عن تسويات للدَّيْن مختلفةٍ في الحالتين اللبنانيّة والسوريّة، وذلك نتيجةً لاختلاف الاستراتيجيّة التفاوضيّة لكلٍّ من السلطتين اللبنانيّة والسوريّة كما سأبيّن أدناه؛ وهذا ما يعكس دورَ الحكومات السياسيّ، بمعزل عن الظروف الاقتصاديّة، في تحصيل الحقوق الماليّة للدول، وبالتالي حماية سيادتها الماليّة، أي استقلال قرارها الاقتصاديّ.
منطق القوة غير منطق السوق: عنجهيّة المَدين وتبعيّة الدائن
قد يبدو بدهيًّا أن يَفرض الدائنُ شروطَه على المَدين. هذه هي الحال في ما يخُصّ قروضَ صندوق النقد الدوليّ، أو الدولِ المانحة للبنان. لكنّ العكس كان صحيحًا في حالة الدَّيْن المستوجب على فرنسا في الأربعينيّات، على الرغم من كون لبنان هو الدائنَ لا المَدين. فقد حاولتْ فرنسا أن تقايضَ الديْنَ اللبنانيَّ بشروطها هي: كمثلِ مقايضته بممتلكاتٍ فرنسيّةٍ تخلّت عنها (من دون أن تكون للبنان يدٌ في بيع هذه الممتلكات لها في المقام الأوّل)، أو على اعتبار أنّ من واجب لبنان دفعَ نفقات جيشها فيه.
وقد فَصَّل جورج عشي[3] الشروطَ غيرَ المتكافئة التي حاولتْ فرنسا فرضَها على لبنان وسوريا أثناء المفاوضات. ومن هذه الشروط ما يرتبط بشكلٍ مباشرٍ بتصفية الدَّيْن: كاشتراط تجميد صرفه لعدّة سنوات، وتقسيطِ المبالغ التي ستُصرف بعدها. ومنه ما لا يرتبط بالديْن بشكلٍ مباشر، لكنه يمسّ بالسيادة الماليّة: كفرض إجراء المعاملات بالفرنك الفرنسيّ بين لبنان أو سوريا والمناطق التابعة لكتلة الفرنك الفرنسيّ، والسماحِ بحريّة نقل الأموال من لبنان وسوريا إلى فرنسا مقابل إخضاع نقل الأموال في الاتجاه المعاكس لأنظمة القطْع الفرنسيّة. هذا وأصرّت باريس على أخذ ضماناتٍ للإبقاء على الامتيازات التي كانت تتمتّع بها الشركاتُ الفرنسيّة تحت الانتداب.
أدّى التباينُ في وجهات النظر بين الوفديْن اللبنانيّ برئاسة فرنجيّة، والسوريّ برئاسة خالد العظم، إلى توقيع اتفاقيّة منفردة بين لبنان وفرنسا في ٣١ كانون الثاني ١٩٤٨ ــ ــ وهو ما أثار استياءَ السوريين. وقد قبِل الوفدُ اللبنانيّ بمعظم الشروط الفرنسيّة، مع بعض التعديلات، في ما يخصّ المهلَ المطروحةَ ونسبةَ الديْن المضمون. فبموجب الاتفاق، لم يُسمح للبنان بسحب أيٍّ من الأموال المستحقّة له قبل العام ١٩٥٢ إلّا في حال سداد ديونٍ عليه إلى فرنسا؛ كما التزم لبنان بعدم تعديل نظام القطْع اللبنانيّ ونظام تصدير الرساميل إلى فرنسا من دون موافقة الأخيرة.
وفي المقابل، استأنف السوريون المفاوضاتِ بعد انقطاعٍ أدّى إلى اتفاقيّة العام ١٩٤٩، التي استطاعت من خلالها دمشقُ البدءَ بصرف جزءٍ من التغطية فور نفاذ الاتفاق، وبات نظامُ القطْع السوريّ (بما في ذلك تصديرُ الأموال إلى فرنسا) خاضعًا لقرار السلطات السوريّة فقط.
أمّا في ما يخصّ امتيازاتِ الشركات الفرنسيّة، فقد اعترف الطرفان اللبنانيّ والسوريّ بقانونيّتها، لكنّ لبنان تعهّد بتعديلها من خلال الاتفاق مع الشركات المعنيّة، في حين أكّد السوريون أنّ هذه الامتيازات ـــ مع حفظ حقّ أصحابها في الاعتراض القانونيّ ـــ تخضع للتشريع السوريّ.
لم تقتصرْ تبعاتُ هذين الاتفاقيْن المنفصليْن على علاقة لبنان وسوريا بفرنسا، بل تعدّتها إلى تفجّر العلاقة بين البلدين حول مستقبليْهما الاقتصاديّ، وأدّت في نهاية المطاف ـــ عبر التفاعل مع عواملَ أخرى ـــ إلى الانفصال الجمركيّ بينهما سنة ١٩٥٠. وقد ساهم مديرُ مصرف لبنان وسوريا حينها، رينيه بوسون، في تأجيج الخلاف، وذلك عبر سياساتٍ نقديّةٍ استنسابيّةٍ تجاه سوريا ولبنان، لا مجال لتفصيلها هنا.
الجدير ذكرُه أنّ العامل السياسيّ كان فاعلًا في الصراع من أجل السيادة الماليّة بين البلدان الثلاثة. وليس في ذلك خروجٌ على القاعدة التاريخيّة؛ فشروطُ الديْن (قيمتُه ومعدّلُ الفائدة وتاريخُ الاستحقاق وطبيعةُ الجهة المانحة) هي انعكاسٌ لطبيعة الهيمنة العسكريّة أو السياسيّة أو الإيديولوجيّة بين الطرفين، بقدرِ ما هي انعكاسٌ للظروف الاقتصاديّة المحيطة بهذه الديون. ذلك أنّ المَدين، على الرغم من واجباته الماليّة تجاه الدائن، قد يتصرّف بعنجهيّةٍ حيال الأخير، كما فعلتْ فرنسا مع لبنان بعيْد إعلان استقلاله. والدائن، على الرغم من حقوقه على المَدين، قد يتصرّف بتبعيّةٍ تجاه الأخير، كما فعل لبنانُ حينها؛ بعكس ما فعلتْ سوريا مع فرنسا. لذلك، فإنّ القول إنّ الأطرافَ المَدينة، شأنَ لبنان اليوم، عاجزةٌ عن تحسين الشروط أو تغيير قواعد اللعبة، "ما دام المنطقُ الاقتصاديّ هو الذي يفرض شروطَه،" إنّما هو قولٌ مُضلِّل، وينمّ عن جهلٍ أو تجاهلٍ لمبادئ الحفاظ على استقلال الدول الماليّ.
لقد كانت الطبقة الحاكمة في لبنان إبّان الاستقلال، كما هي اليوم، سبّاقةً في التساهل مع سيادتها الماليّة، في حين لا تنفكّ تتغنّى بمبدأ السيادة وتحتفي به. لذلك، لن يكون مستغربًا أن يحاول مَن يهلِّل لباريس ٤ أن يقْنعنا، من الآن فصاعدًا، بأنّ "قوّة لبنان في دَيْنه."
لندن
[1] مذكرات خالد العظم، مجلد ٢، ص ١١٥ (الدار المتحدة للنشر، ١٩٧٣).
[2] سند الخزينة هو صكُّ دَيْن تتعهّد الحكومةُ بموجبه بدفع المبلغ المتَّفق عليه إلى صاحب السند عند تاريخ الاستحقاق المذكور على السند.
[3] النظام النقديّ في سوريا (مطبعة جامعة دمشق، ١٩٥٩).