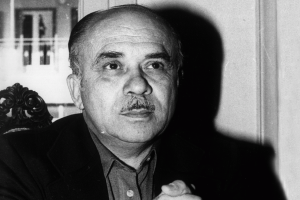على امتداد عقود، صدع رؤوسَنا دعاةُ "الواقعيّة" بأنّ السلام سوف يأتي بالخيرات، وأنّ الولايات المتحدة، "على علّاتها" (كما يقولون إيهامًا بالموضوعيّة)، ستكون راعيًا متوازنًا في عمليّة السلام الجارية منذ عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين. اليوم، "صُدم" أولئك الدعاةُ بعد قرار الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب نقلَ السفارة الأميركيّة من تل أبيب إلى القدس، والاعترافَ بالقدس عاصمةً لدولة إسرائيل، خلافًا للقانون الدوليّ.
لكنْ، هل "صُدم" الواقعيون فعلًا؟
طوال عقود، وأثناء جلسات التفاوض، التي زعموا أنّها كانت "شاقّةً ومنهكة،" كانوا يروْن بأمّ أعينهم ازديادَ أعداد المستوطنين اليهود، وزيادةَ المستوطنات والوحدات السكنيّة الإسرائيليّة، وضمَّ أجزاء متتالية من القدس إلى السيطرة الإسرائيليّة. ولم يتوقّف قادةُ العدوّ يومًا عن التشديد على يهوديّة دولة إسرائيل. وطوال هذه العقود، كان الرؤساء الأميركيون، على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، يؤكّدون التزامَهم بأمن إسرائيل ودعمِ إسرائيل. فلماذا، وكيف، "صُدم" الواقعيون؟
إنّ أوّلَ ما يُفترض أن يميِّزَ الواقعيين من المثاليين هو التزامُهم بالحقائق الصلبة. وقد اتّضح منذ اتفاقيّة أوسلو، بل منذ اتفاقيّة غزّة ــــ أريحا وما قبلها، أنّ الواقعيين كانوا أكثرَ الواهمين. ولو أنّ وهمَهم اقتصرَ عليهم، لهانت المصيبة! فالحال أنّهم نقلوا وهمَهم إلى شعبهم عبر وسائلِ إعلام مزيّفة، ورشوا أتباعَهم بالمناصب، وحوّلوا مناضلين سابقين إلى موظّفين لديهم، ودفعوا بمناضلين آخرين إلى رتبة "ناشطين" في منظّماتٍ غير حكوميّة مموّلة من الخارج. وحين فشل الوهمُ والإيهامُ في إطفاء جذوة النضال لدى الشعب الفلسطينيّ، تحوّل الواقعيون إلى متعاونين مباشرين مع المحتلّين، فأنشأوا وإيّاهم أقذرَ شراكةٍ يمكن تخيُّلها في العالم: "التنسيق الأمنيّ" معه؛ وهو ما عنى أنّ جزءًا من المقاومين السابقين تحوّل إلى متعاملٍ مع الاحتلال ضدّ المقاومين الحاليّين. فأمعنوا في شقّ الشعب الفلسطينيّ، مدّعين أنّ ذلك في مصلحته ومصلحةِ "الوحدة الوطنيّة"! وكأنّ ذلك لم يكفِهم، فأنشأوا لجنةً "للتواصل مع المجتمع الإسرائيليّ،" بدلًا من أن يُنشئوا لجانًا للتواصل مع شعبهم في فلسطين المحتلّة عام 1948، ولدعم إنتاجه السينمائيّ والفنّيّ والأدبيّ، ولمساعدته على الصمود في وجه الأسرلة ومقاومتِها.
اليوم، تَفرض الواقعيّةُ الثوريّة عزلَ الواهمين المضلِّلين بعد عقودٍ من التحكّم بمصير شعبنا الفلسطينيّ. ولعلّه من المفيد أن نكرِّر ما ذكرناه في غير مكان: وهو أنّ مسارَ أوسلو أو مسار "عمليّة السلام" لم يُضِرّ بقضيّة فلسطين وحدها، بل عزّز أيضًا مُناخَ الاستسلام والتطبيع في الوطن العربيّ بشكلٍ عامّ. صحيح أنّ "القضيّة الفلسطينيّة" ينبغي ألّا تنحصرَ بالفلسطينيين وحدهم، لكنّ قلةً من غير الفلسطينيين (عربًا ودوليين) يمكن أن تقتنع بمواصلة نضالها وبتطويرِه ضدّ إسرائيل حين يتقاعس عن ذلك مَن يُفترض أن يتصدّرَ هذا النضال.
لقد آن أوانُ محاسبة هذه الفئة المتحكّمة بشعبنا وقضيّته تحت ذرائع "الواقعيّة" وأنّ "أوسلو هي الممرّ الإجباريّ للتحرير." هذه الفئة وضعتْ كلَّ بيضها في سلّة "الراعي الأميركيّ النزيه،" فجاء ترامب ورفس هذه السلّةَ مع بيضها في وجهها ووجهِ كلّ المراهنين عليه. ولا يجدي اليومَ إيجادُ أيّ تبريرٍ أو أعذارٍ مخفّفة لهذه الفئة؛ فإذا كان صحيحًا أنّ الأنظمة العربيّة تخاذلتْ، أو خانت، أو طبّعتْ، أو انشغلتْ بحماية رؤوسها، فإنّ ذلك لا يعفي السلطةَ الفلسطينيّةَ من مسؤوليّتها الكبرى عن نحر القضيّة الفلسطينيّة على مذبح الأوهام والأكاذيب والمناصب والرشاوى ومظاهرِ "السيادة" الخادعة.
ولقد آن أوانُ محاسبة هذه الفئة التي رمت كلَّ منتقديها بالمزايدة، أو الرومنسيّة، أو العبثِ بالوحدة الوطنيّة. ومن واجب كلّ غيور على أشرف قضيّةٍ في العالم الإسهامُ في حلّ هذه السلطة من أساسها. فتغييرُها، مجرّدُ تغييرها، بتطعيمها بشخصٍ أو شخصين أو ثلاثة، لن يجدي فتيلًا لأنّ الفكرة/البذرة فاسدةٌ من أصلها: بذرةَ إنشاء "سلطة وطنيّة،" ومن موقعٍ بالغِ الضعف والاختلال والتفكّك، متعاونةٍ مع الجلّاد، بعد تأخير كلّ الأمور الجوهريّة (كقضيّة اللاجئين، والقدس،...) إلى أجلٍ غير مسمّى، وبعد الموافقة على ترك قسمٍ كبيرٍ من الشعب الفلسطينيّ (أيْ فلسطينيي 48) يواجه مصيرَه وحده.
اليوم ستحاول السلطةُ أن "ترْكب" على موجة الغضب الفلسطينيّ/العربيّ المتنامي لكي تجيّرَها في صالحها، لا في صالح الناس وقضيّتهم. وقد تستغلّ انتفاضةً جنينيّةً جديدةً لتحسِّن شروطَ التفاوض (ألم يحدث ذلك من قبل؟). واجبُنا جميعًا، لا واجبُ الفلسطينيين وحدهم، عدمُ السماح بذلك الاستغلال، وإلزامُ أيّ طرفٍ فلسطينيّ يشترك في العمل الميدانيّ ضدّ الاحتلال الموافقةَ على الخطوط الآتية: وقفُ المفاوضات، حلُّ السلطة، العودةُ إلى ثوابت "الميثاق الوطنيّ الفلسطينيّ،" تفعيلُ عمل منظّمة التحرير، توسيعُ هذه المنظّمة لتشمل فصائلَ وشخصيّاتٍ مناضلةً أخرى، التمسّكُ بخيار الكفاح المسلّح، إضافةُ "المقاطعة" أسلوبًا رئيسًا آخرَ للكفاح، التنسيقُ مع قوى المقاومة ومناهضةِ التطبيع في الوطن العربيّ والعالم.
اليوم فرصةٌ أخرى لتجديد الثورة الفلسطينيّة، وتجديدِ العقليّة الثوريّة العربيّة الراكدة. فالتجديد الفعليّ والحقيقيّ هو الذي لا يسلِّم بمنطق العدو كي يتكيّفَ معه ويبنيَ استراتيجيّته على أساس ذلك. لكنّها فرصة ضروريّة أيضًا للوقوف في وجه كلِّ مَن يَطمح إلى تحويل الهبّة الفلسطينيّة الحاليّة إلى حلقةٍ أخرى من "إعادة تدوير" البؤسِ نفسِه.
بيروت