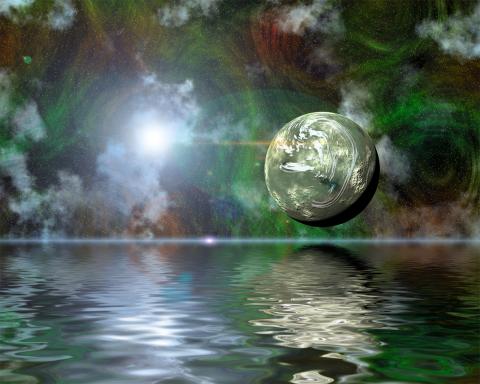صحافيّ وأكاديميّ فلسطينيّ.

خلق الحَراكُ العربيّ الذي انطلق سنة 2011 جدلًا سياسيًّا تجاوز حدودَ الدول التي حصل فيها، وحدودَ المجال السياسيّ (بالمعنى المباشر) إلى المجالات الاجتماعيّة والثقافيّة والإعلاميّة. وضمن الحقل الإعلاميّ، تغيّرتْ خريطةُ الإعلام الكلاسيكيّ إلى حدٍّ ما، وبرزتْ أنماطٌ جديدةٌ في قراءة هذا الحَراك وتبعاته. وبالتوازي مع ذلك، احتلت وسائلُ التواصل الاجتماعيّ مساحةً واسعةً من الاهتمام، بعد أن باتت وسيطًا إعلاميًّا وميدانًا للتعبير وإعلان المواقف والاحتجاج، بحيث شهدْنا سيلًا من النقاشات والمواقف اليوميّة عبرها.
هذا كلُّه جعل من الإعلام، والإعلامِ الجديد، موضوعًا حيويًّا مستجدًّا للدراسة والتحليل، ولمحاولة فهم آثاره في المجتمع والسياسة - - وهي آثارٌ تجاوزتْ بكثيرٍ حدودَ ما كان عليه الأمرُ خلال عقودٍ مضت. فالجمهور لم يعد مجرَّدَ متلقٍّ للمحتوى الإعلاميّ، وإنّما امتلك أيضًا دَورَ صياغته ونشرِه وفرضِه على الأجندة العامّة. ومن ثمّ نشأتْ علاقةٌ جديدة، شائكةٌ ومعقّدة، بين الإعلام والإعلام الجديد والجمهور، لا سيادةَ فيها لطرفٍ على آخر، ولا يمكن حصرُها ضمن ثنائيّة السلبيّات والإيجابيّات.
نحاول في هذه الورقة تفكيكَ هذه العلاقة، وفهمَ أدوار كلّ طرفٍ فيها، ومعرفةَ كيفيّة تشكّل الوعي الجماهيريّ أو "الرأي العامّ" تجاه الواقع السياسيّ المتحرّك بفضل هذه الوسائط الجديدة والقديمة. فهل استطاع الإعلامُ الرقميّ تحريرَنا من هيمنة الإعلام الكلاسيكيّ، ولاسيّما المعبِّر عن الأنظمة العربيّة؟ وهل ساعد التدفّقُ المذهلُ للمعلومات على قراءة مختلفة للواقع السياسيّ؟ لكنْ، قبل كلّ ذلك، ما هي ميكانيزماتُ العمل الإعلاميّ؟
ميكانيزمات العمل الإعلاميّ وعلاقته بالحقل السياسيّ الاجتماعيّ
الظروف التي تَحْكم العملَ الإعلاميّ أعقدُ ممّا قد تبدو عليه لكونه غيرَ مفصولٍ عن السياقات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والتطوّر التكنولوجيّ. بمعنًى آخر: لا تُمْكن دراسةُ الإعلام وكأنّه مجرّدُ مؤسّسةٍ ووسائطَ ومحتوًى. وقد طوّر الفيلسوفُ الألمانيّ يورغن هابرماس، في كتابه التحوّل البنائيّ للفضاء العامّ: دراسة في بنية المجتمع البرجوازيّ، مفهومَ "الفضاء العامّ،" فاعتبره أساسًا لفهم علاقة السلطة بالمجتمع، وماهيّةِ الطبقات والشرائح الفاعلة، وكيفيّةِ تبلور النشاط السياسيّ العامّ فيه. الفضاء العامّ عند هابرماس مرتبط ارتباطًا عضويًّا بواقع المجتمعات المادّيّ ضمن مرحلة زمنيّة محدّدة، ولا مفرّ من فهم تحوّلات هذا الواقع من أجل فهم ميكانيزمات العمل الإعلاميّ والتوجّهات الجماهيريّة.
 \
\
الظروف التي تَحْكم العملَ الإعلاميّ أعقدُ ممّا قد تبدو عليه
يتعامل هابرماس مع الصحافة كمؤسّسةٍ رئيسةٍ في هذا الفضاء: فقد منَحتْه قوّةً سياسيةً، وساهم تطوّرُها في توسعته وإضافة ديناميكيّةٍ جديدةٍ عليه، وأخرجتْه من الحيّز النخبويّ في فترة معيّنة في أوروبا، وأدخلتْ إليه الطبقةَ الوسطى بفاعليّةٍ أكبر. وفي مرحلة الدولة الليبراليّة، اكتسبت الصحافةُ وظائفَ اقتصاديّةً وتجاريّة، وظهرتْ أدوارُها الترفيهيّة مع ظهور التلفاز بشكلٍ خاصّ، وتأثّرتْ بظهور الإعلان، الذي شكّل - بدوره - "وعيًا" خاصًّا للجمهور، إذ فقد هذا الأخيرُ "حكمَه الذاتيّ" ليصبح موضوعًا يمكن التلاعبُ به وفرضُ الهيمنة السياسيّة عليه والتعاملُ معه كمحض مستهلك. وقد فرض تطوّرُ الدولة الليبراليّة ظهورَ "تقنيات إدارة الرأي العامّ." لذلك كلّه تمثّل الصحافة، لدى هابرماس، مدخلًا إلى التعرّف إلى التحوّلات البنيويّة المادّيّة، التي تتغيّر وتكتسب أدوارًا جديدة نتيجةً لتغيّر الواقع وشروطه. وكأنّ هابرماس يقول إنّ فهمَ الواقع المادّيّ يمثّل شرطًا لفهم ميكانيزمات العمل الإعلاميّ، والعكس صحيح.
حتّى الشرط التكنولوجيّ غيرُ متحرّر من الشرط المادّيّ، وإنّما هو أحدُ عناصره. وقد كثّف عالِمُ الاتصال الكنديّ شارل ماكلوهان دورَ الوسائط التكنولوجيّة في المجتمعات في مقولته الشهيرة: "الوسيلة هي الرسالة،" إذ رأى أنّ كلّ وسيط إعلاميّ/اتصاليّ/تكنولوجيّ يُظهر/يُحدث تحوّلًا جوهريًّا في بنية المجتمع، وفي سيكولوجيا الجمهور، وتنجم عنه أنماطٌ اجتماعيّة وسلوكيّة وتفاعليّة جديدة. وعليه، فإنّ محاولة فهم المحتوى الإعلاميّ لا تستقيم من دون فهم الوسيلة نفسها وما تُحْدثه من تحوّلاتٍ بنيويّة. ومن التبسيط والتسطيح التعاملُ مع وسائل التواصل الاجتماعيّ وكأنّها مجرّدُ قنواتِ اتصالٍ وتعبير، أو كأنّ حدودَ علاقتنا بها أنّنا "نستخدمها"؛ فهذه الوسائل خَلقتْ، أو ربّما في طريقها إلى أن تخلق، معنًى ونمطًا جديديْن للعلاقات الاجتماعيّة. ومع استخدامها وسيلةً لتنظيم الحَراكات والنشاطات السياسيّة، فإنّها قد فرضتْ أشكالًا ومعانيَ جديدةً للنشاط السياسيّ ذاتِه، ولأدواته، ولمجالاته، وللناشطين فيه.
عقدُ التسعينيّات والانفجار الإعلاميّ
شهد عقدُ التسعينيّات جملةً من التطوّرات الهائلة والسريعة في الحقل الإعلاميّ. فقد ظهرت القنواتُ التلفزيونيّة الفضائيّة، الإخباريّة والترفيهيّة، والرسميّة والخاصّة، بأعدادٍ كبيرة. وجرى توظيفُ الإنترنت في العمل الصحفيّ، فظهرت المواقعُ الإلكترونيّة التي باتت مصدرًا للخبر والرأي والتحليل. وأنشأت الصحفُ الورقيّة مواقعَ خاصّةً بها، ما ساعدها على الوصول إلى القارئ العربيّ خارج حدود القطْر أو الوطن العربيّ. وانتشرت الإذاعاتُ الخاصّة، وتوفّرتْ لاحقًا إمكانيّةُ متابعتها عبر الإنترنت.
كلُّ هذه التطوّرات جاءت دفعةً واحدةً، خلال عقدٍ واحدٍ من الزمن. وهو ما أثار جدلًا بين المتابعين والمختصّين عن أثر ذلك في مستقبل الإعلام، وفي المجتمع والمواطن العربيّ. وساد اعتقادٌ آنذاك أنّ التحرّر، ولو بمقدارٍ معيّن، من هيمنة الإعلام الرسميّ، قد حصل أخيرًا، وأنّ القنوات والوسائط الإعلاميّة العابرة للقطْريّة ستوصل المجتمعاتِ العربيّةَ بعضَها ببعض، فتتبادل شؤونَها وشجونَها الداخليّة. وقد مثّل ظهورُ قناة الجزيرة تحديدًا، في منتصف التسعينيّات، علامةً فارقةً بثّتِ الأملَ في تبلور"إعلامٍ ناقد" لا "ناقل" فقط، يتّسع صدرُه لأصواتٍ طالما كانت مهمَّشةً. وسرى اعتقاد أنّ ذلك كلَّه لا بدّ من أن يعمِّق - بشكل أو آخر - الهويّةَ العربيّةَ ويعزّزها.
خلال العقد ذاته، وبالتوازي مع كلّ ما شهدَه حقلُ الإعلام العربيّ، طرأتْ تحوّلاتٌ سياسيّةٌ عالميّة وعربيّة جذريّة. فقد دخل العالمُ هذا العقدَ مخلِّفًا وراءه اتحادًا سوفييتيًّا يتفكّك وينهار، في مقابل توسّع الهيمنة الأمريكيّة إلى حدّ فرضها نفسَها قطبًا أوحدَ. وعلى الصعيد العربيّ، تراجعتْ خطاباتٌ إيديولوجيّة كبرى، قوميّةٌ ويساريّة، حكمت الوعيَ والسلوكَ العربيّيْن عقودًا، وفقدتْ مركزيّتَها وقيادتَها للنظام السياسيّ، لصالح أنظمةٍ ملكيّةٍ وعائليّة. ومع تراجُع تلك الخطابات، تراجعتْ كذلك كلُّ تجلّياتها وأدواتها المؤسساتيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والإعلاميّة.
انتهاء حقبة وبدء حقبة جديدة
لا يمكن فصلُ ظروف تشكّل الحقبة العربيّة الجديدة وخطابها عن تطوّر الليبراليّة والثقافة الاستهلاكيّة على المستوى الدوليّ. ثلاثة مبادئ، سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة، شكّلت الجزءَ الأبرزَ من ملامح المرحلة الجديدة وخطابها. وضمن هذه البيئة جاء التطوّرُ الإعلاميُّ المذهل. وعبر هذا التطور تمْكننا قراءةُ توجّهات الإعلام العربيّ، وميكانيزماتِ عمله، وعلاقته بالجمهور.

مثّل ظهورُ "الجزيرة" علامةً فارقةً بثّتِ الأملَ في تبلور إعلامٍ ناقد
ارتبط تطوّرُالإعلام بالتطوّر التقنيّ. ففي التسعينيّات، كانت ملْكيّةُ التكنولوجيا، المُكْلفة في حينه، إحدى أدوات الهيمنة على وسائل الإعلام، وبخاصّةٍ التلفزيونيّ، الذي كان الأكثرَ استقطابًا للجمهور. لذلك كان مَن يملك رأسَ المال هو الأقدرَ على نشر الخطاب الذي يريد. وهنا ظهر العديدُ من القنوات، ببرامجَ ومضامينَ يصعب حصرُها. ومع ذلك، يمكن رصدُ هيمنة خطابيْن رئيسيْن على الإعلام الفضائيّ تحديدًا.
- الأول هو الخطاب ذو المحتوى التجاريّ الترفيهيّ الاستهلاكيّ. وانسجامًا مع هذا النمط الإعلاميّ، تعزّزت سلطةُ الإعلان التجاريّ، فأخذ يعمل - أكثرَ من ذي قبل - على بناء الواقع والتصوّرات الذهنيّة المحكومة بشرط الاستهلاك.
- الثاني مثّلتْه الفضائيّاتُ الدينيّة، بكلّ تبايناتها الطائفيّة. وهو ما يدفعنا إلى وصف انفجار الوسائل والمضامين الإعلاميّة هذا بـ"فوضى الخطابات،" في حين فضّل آخرون وصفَه بـ"التنوّع والاختلاف."
نجد صعوبةً بالغةً في تسمية الإعلام في تلك الحقبة بـ"العربيّ،" وإنّما كان إعلامًا مصريًّا أو تونسيًّا أو سعوديًّا...، يعبِّر عن النظام السياسيّ القُطْريّ، ومحكومًا بشرط السوق. وشرطُ "السوق" هنا جعَلَ المدينةَ والمجتمعَ الحضريَّ ونمطَ الحياة البرجوازيّة تهيمن على المضامين الإعلاميّة الأخرى، على حساب الريف والمجتمعِ الزراعيّ والطبقاتِ المهمَّشة والفقيرة. كان إعلامًا موجَّهًا إلى الناس الأقدر على الاستهلاك والاندماج في "روح العصر الجديد،" مع ضرورة الإشارة إلى وجود هيمنة خليجيّة ظهرتْ على الإعلام والسياسة معًا منذ ذلك الحين.
كانت العولمة الاقتصاديّة والثقافيّة هي عنوانَ تلك المرحلة على مستوًى دوليّ، وأخذتْ تكتسح دولَ الجنوب تحديدًا، فارضةً عليها قيمًا وأنماطَ حياةٍ مختلفة. وهنا انسجم التحوّلُ السياسيّ في البلاد العربيّة مع التطوّر الإعلاميّ، وبات الثاني - بقصدٍ أو من دونه - أداةً في يد الأوّل، ويؤسّس لثقافةٍ ووعيٍ ينسجمان مع توجّهاته. وساعدَه في ذلك تراجعُ فاعليّة المؤسّسات القاعديّة والنقابيّة والحزبيّة والشعبيّة في معظم البلاد العربيّة. وفي المقابل، هيمنتْ أشكالٌ جديدةٌ من المؤسّسات والأطر التي تنسجم، أو لا تتعارض، مع المرحلة المعولمة بثقافتها وقيمها: فاحتلّت الثقافةُ الاستهلاكيّة والقيمُ المعولمة الفضاءَ العامَّ، وساهمتْ في تشكيل قوًى اجتماعيّةٍ تنتمي إلى الراهن وتتحكّم به وتحتكم إليه.
تجدر الإشارةُ إلى أنّ الأيّام الأولى من الثورة المصريّة (2011) مثّلتْ بدايةَ استرداد هذا الفضاء العامّ محلّيًّا، وأخذتْ قوًى اجتماعيّةٌ شبابيّة سياسيّة تتبلور خارج هيمنة "الفضاء الليبراليّ الاستهلاكيّ." إلّا أنّ ذلك سرعان ما انتهى لأسبابٍ لا محلّ لسردها هنا.
وهذا يدفعنا إلى طرح الأسئلة الآتية: ماذا لو كان الإعلامُ بهذا التطوّر والقوّة في فترة توفَّر فيها للعرب مشروعٌ سياسيّ وخطابٌ إيديولوجيٌّ يعبّران عن الإرادة العامّة للأمّة؟ هل كان يمكن أن يكون (أي الإعلام) أداةً نقديّةً تصحيحيّةً تسهم في إنقاذ النظام السياسيّ من نفسه، أمْ أنّ هذا النظام كان سيهيمن عليه ويحوّله إلى مجرّد بوقٍ إيديولوجيّ غير نقديّ؟
"القُطريّة" في المعالجة الصحافيّة للواقع العربيّ
تبلور الخطابُ الإعلاميّ القُطْريّ ابتداءً من عقد التسعينيّات، ولكنْ عبر مراحل زمنيّة حكمتْها طبيعةُ تحوّلات النظام السياسيّ نفسه. فكان هنالك اهتمامٌ بالغٌ بمتابعة القضيّة الفلسطينيّة (الانتفاضة الثانية)، وتحرير جنوب لبنان (2000). وكثيرًا ما كانت تجري مخاطبةُ عواطف الشارع العربيّ، والاهتمامُ برصد توجّهاته وتفاعله.
مع ازدياد شرذمة النظام الرسميّ العربيّ، لوحظ توغّلُ الإعلام العربيّ في النزعة القُطْريّة. فقد تنبّهت الأنظمةُ العربيّة إلى دور الإعلام وإمكانيّاته الجديدة في تلك المرحلة، فتبنّتْ وسائلَ إعلاميّةً جديدةً بأنماطٍ وسياساتٍ تحريريّةٍ مختلفة. ولعلّ ظهورَ قناة العربيّة السعوديّة عام 2003، لمواجهة قناة الجزيرة القطَريّة، تُعدّ المثالَ الأبرزَ على ذلك. هكذا، غادرْنا التسعينيّات تحت راية "المناكفات الإعلاميّة القُطْريّة."
الظاهرة الأكثر إثارةً هنا هي بدءُ استخدام "المثقّف العربيّ" في هذه المناكفات، وذلك من خلال استضافته واستكتابه في وسائل الإعلام، تحت مسمَّيات "خبير" و"محلّل" و"مختصّ." وجرى تطويعُه وتدجينُه ليكون أداةً في صياغة وعي الجماهير وفق مقاييس النظام السياسيّ القُطريّ ومتطلّبات المرحلة، بعيدًا عن دوره النقديّ المفترض. وهذا ما سيكون مقدّمةً لاستخدامه لاحقًا في نشر الخطاب الطائفيّ وتعزيزه. وفي سبيل ترسيخ هذا الوعي الزائف، بدأتْ موجةُ تطويع التاريخ لصالح الموقف الرسميّ العربيّ الحاضر في برامجَ ووثائقيّاتٍ إعلاميّة كثيرة.
هذه التحوّلات جميعُها مسّت آليّات معالجة القضيّة الفلسطينيّة بشكلٍ خاصّ. وكانت "عمليّة السلام،" في بداية التسعينيّات أيضًا، بمثابة ذريعةٍ مناسبةٍ لقطاع واسع من الإعلام العربيّ من أجل إحداث خلخلةٍ في مسلَّمات هذه القضيّة وكيفيّة طرحها. وقد بدأتْ هذه الخلخلة الإعلاميّة بمحاولة هذا القطاع تحويلَ القضيّة إلى قضيّة "محلّيّة،" دورُ العرب فيها مجرّدُ "التعاطف" و"التضامن." ثمّ عمد الإعلامُ المذكور إلى تحويل "إسرائيل" في الوعي العربيّ إلى "رأي آخر،" ينبغي أنْ نسمعَه ونفهمَه ويفهمَنا، بعد أن كانت عدوَّ العرب الأوّل.
هنا تجدر الإشارةُ إلى أنّ إستراتيجيّةَ استضافة الإسرائيليّ على الإعلام العربيّ مرّت بمراحلَ ثلاثٍ رئيسة:
أ) استضافة "السياسيّ،" الذي يتحدّث في قضيّة سياسيّة، كالمفاوضات.
ب) استضافة العسكريّ، ليتحدّث خلال عدوان مدمِّر على قطاع غزّة على سبيل المثال، أو لـ"يعلّق" على حرق طفل فلسطينيّ في بيته، أو قتل طفل آخر وهو في طريقه إلى مدرسته؛ وكأنّ القتل والحرق مجرّدُ رأي يَحتمل الاختلافَ والقبول!
ج) مؤخّرًا، بدأتْ ظاهرةُ استضافة الإسرائيليّ المؤرِّخ والأكاديميّ، ليتحدّث في تاريخيّة "الصراع" والمكان. وكأنّ وجودنا في حدّ ذاته بات وجهة نظر.

هنالك رأيٌ واسعٌ اليوم يعتبر أنّ "هزيمة" رأي "الضيف" الإسرائيليّ إنجازٌ ضروريّ
وعلى الرغم من الرفض الشعبيّ العربيّ الظاهر للإسرائيليّ ولاستضافته، فإنّ علينا مراقبةَ الأثر التراكميّ الذي لا يَظهر بوضوح في الغالب لأوّل وهلة. وهذا الأثر نجده، على سبيل المثال، في الانقسام الذي تشهده النقاشاتُ حول هذه الاستضافة. فهنالك رأيٌ واسعٌ اليوم يعتبر أنّ "هزيمة" رأي "الضيف" الإسرائيليّ إنجازٌ ضروريّ. وإذا كانت الجزيرة أوّلَ من دشّن هذا التوجّه، فهو لم يتوقّفْ عندها، بل تحوّل إلى ظاهرة إعلاميّة ضمن المنظومة المهيمنة.
لم نُردْ من سردنا السابق اختزالَ الواقع - - فهذا غير ممكن. ولكنْ أردنا القولَ إنّ عواملَ عدّة، ذاتيّةً وموضوعيّةً، تراكمتْ على مدى ثلاثة عقود، ساهمتْ في بناء معانٍ كثيرة وتصوّراتٍ متنوّعة ومتناقضة عن الواقع السياسيّ العربيّ وقضاياه الوطنيّة الكبرى. لم تعد هنالك قراءاتٌ مركزيّة تستند إلى مرجعيّات إيديولوجيّة رئيسة. وفي المقابل، تجذّرت الثقافةُ الاستهلاكيّة، فعزّزتْ فردانيّةَ المواطن العربيّ، وحكَمتْ جزءًا غيرَ يسيرٍ من وعيه وسلوكه. وهذه المعاني والتصوّرات ستزداد تشظّيًا بعد "الربيع العربيّ" والدخولِ إلى عصر وسائل التواصل الاجتماعيّ. وهي جميعُها عوامل ستسهم في تحديد ملامح المرحلة الراهنة، التي ستلعب وسائلُ التواصل الاجتماعيّ تحديدًا دورًا محوريًّا فيها، كما فعلت القنواتُ الفضائيّة في التسعينيّات، لنصلَ هذه المرّة إلى ما نسمّيه لاحقًا بـ"الحقائق الفرديّة" على ما سنوضح بعد قليل.
وسائل التواصل الاجتماعيّ وإعلامُ ما بعد "الربيع العربيّ"
مع الثورة التونسيّة والمصريّة، بدا الصراع وكأنّه بين أنظمةٍ وشعوب. ولكنْ سرعان ما تعقّدت الأمور، فظهر استقطابٌ حادٌّ بين محوريْ "مقاومة - اعتدال." وهذا الاستقطاب نفسُه لم يعد بهذا الوضوح، إذ اختلط الخطابُ السياسيّ بخطابٍ جديدٍ طائفيّ؛ أو لنقل إنّه في حقيقته خطاب وصراع سياسيّ - طبقيّ ولكنّه اتّخذ "تمظهرًا طائفيًّا" كما يقول مهدي عامل.
الإعلام هنا أخذ دورًا تابعًا ومكمِّلًا للسياسة في تحقيق هذه التحوّلات وترسيخها، على حساب نقدها. وهذا شبيهٌ بدورالتابع الذي اتّخذه في المرحلة السابقة، ولكنْ هذه المرّة بسرعةٍ ووضوحٍ وفجاجةٍ أكبر.
ساهمت الطفرةُ الجديدة من تطوّر تقنيّات الاتصال في تحديد جزءٍ غير يسير من الاستراتيجيّة الجديدة للعمل الإعلاميّ، ويمكن عنوَنةُ هذا الجزء بـ"التضليل والاستقطاب." فقد شاعت ظاهرةُ تبنّي وسائل الإعلام لخطابٍ محدّدٍ بوضوح، ومن دون مواربة، وعملتْ على تحشيد الناس خلفه بكلّ السبل الممكنة، وكأنّ مسمّى "الثورة" منح الإعلامَ "مبرِّرًا أخلاقيًّا" لفعل ذلك على حساب المهنيّة. لم تعد تقنيّاتُ التلاعب و"إدارة الرأي العامّ،" كما أسماها هابرماس، محصورةً في نطاق كيفيّة صياغة المعلومة والرسالة الإعلاميّة وتقديمها وتحليلها، وإنّما عمدتْ إلى إغراق السوق بكمٍّ هائلٍ من المعلومات والمعلومات المضادّة، ولم تعد تشترط دقّة الخبر وصحّتَه.
هكذا لجأ قطاعٌ مهيمنٌ من الإعلام، وبوعي مسبَّق، إلى اعتمادِ ما يكتبه أو يسجّله المواطنون في وسائل التواصل الاجتماعيّ وكأنّه "مادّة إعلاميّة،"من دون محاولة التحقّق من دقّته! وقد ساهم ظهورُ موجة جديدة من الوسائل الإعلاميّة المكتوبة والإلكترونيّة والتلفزيونيّة بعد العام 2011، واعتمادُ عددٍ لامحدودٍ من "الخبراء" و"المحلّلين" و"الناشطين،" في إغراق السوق بقراءاتٍ لانهائيّةٍ للحدث والواقع السياسيّ. لم يعد هنالك معنًى، أو معاييرُ، لِما يسمّى، في لغة الإعلام، بـ"قادة رأي." أصبح كلُّ مَن يتطوّع للتعبير عن وجهة نظر الوسيلة الإعلاميّة جديرًا بأن يُمنح هذه الصفةَ ويُعطى هذا الدورَ. وقد أسهم المقابلُ المادّيّ الذي يتلقّاه أولئك "المتطوّعون" في تكاثرهم إلى حدّ التخمة. وكأنّ هدف الإعلام لم يعد شرح الواقع وتحليله، بقدر ما بات تعويمَ هذا الواقع وتذريرَه.
في المقابل، بات كلُّ مواطن جزءًا من عمليّة التعويم والتذرير هذه، بقصدٍ أو من دون قصد. فبالتوازي مع وسائل الإعلام الكلاسيكيّة، وبالتداخل والتشابك معها، تدفّق سيلٌ لانهائيٌّ من الصور والفيديوهات، والأخبار والمعلومات، عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، التي يصعب دائمًا التحقّقُ منها ومن دقّتها. وهنالك "صفحاتٌ وهميّة" على الفيسبوك، على سبيل المثال، يتمّ إنشاؤها لتكون جزءًا من هذه العمليّة. لم تعد هنالك مصادرُ واضحةٌ لِما يمكن أن يكون "مادّةً إعلاميّة." وهذا بدوره أوجد أيضًا سيلانًا لامتناهيًا من القضايا التي تظهر وتُناقَش وتَشْغل الناسَ لفترة محدودة، ثمّ تموت، لتظهرَ مكانها قضايا جديدة. وبات كلُّ قول، لكلّ فرد في هذا الفضاء، رأيًا يمكن أن يُناقَش، بغضّ النظر عن استناد ذلك الرأي إلى أيّ معلومةٍ صحيحة، وبصرف النظر عن منطلقات هذا النقاش أو "عقلانيّته."
هكذا جرى "تذويتُ" القضايا، وتذويتُ الآراء والمواقف. بمعنًى آخر: أصبحت الحقائقُ فرديّة. وهذا أوجد حالةً من اللايقين. وربّما هذا كلّه أوجد أيضًا ظاهرةً مفادُها أنّ الفرد بات يبحث عن الوسيلة الإعلاميّة وصفحات التواصل الاجتماعيّ التي تُسمِعه ما يريد وما يؤمن به، لا ما قد يوصله إلى الحقيقة أو إلى ما هو منها قريب - - وهو سلوكٌ يُفترض أنّه يتعارض مع زمن "تحرّر المعلومة."
***
بطبيعة الحال، لا يمكننا حصرُ دور وسائل التواصل الاجتماعيّ، وطبيعةِ علاقتها بالإعلام، في ما سبق. ولا نذكر ذلك بهدف تبيان "سلبيّة" هذه الوسائل في وجه مَن يعتقد بـ"إيجابيّتها"؛ فمنذ البداية بيَّنّا أنّه لا يمكن حصرُ التطوّر التقنيّ والتكنولوجيّ ضمن هذه الثنائيّات. وهذا أيضًا لا يعني أنّه ليس هناك إعلامٌ مختلف، واستخدامٌ مغايرٌ لوسائل التواصل الاجتماعيّ، بل يعني أنّ هناك منظومةً إعلاميّةً مهيمنة على الجمهور ومحكومةً بالشرط الماديّ. وإذا كان هدف هذه المنظومة ما قبل "الربيع العربيّ" تشكيل رأي عام قُطْريّ متحرّر من وعي السرديّات الكبرى التي تربّى عليها، ومهيّأ للدخول في عصر العولمة والاستهلاك، فإنّ هدفها ما بعد "الربيع العربيّ" هو ألّا يكون هنالك رأيٌ عامٌّ أصلًا، وإنّما آراءُ مجموعاتٍ وأفرادٍ، كثيرة ومتناقضة، لنصل مرحلة "موت الواقع" على حد تعبير جان بودريار.
يبقى أنْ نقول إنّ مخاطرَ هذه الحالة الإعلاميّة والجماهيريّة تتمثّل، في أحد وجوهها، في تعقيد ظروف تشكّل قوًى اجتماعيّة خارج هذه الهيمنة، وقادرةٍ على نقضها. وفي المقابل، فإنّ تغيير هذه الحالة لا ينحصر في تغيير الإعلام وحده، وإنّما يتطلّب اختراقَ السياق المادّيّ والتأثيرَ فيه أيضًا.
رام الله
صحافيّ وأكاديميّ فلسطينيّ.