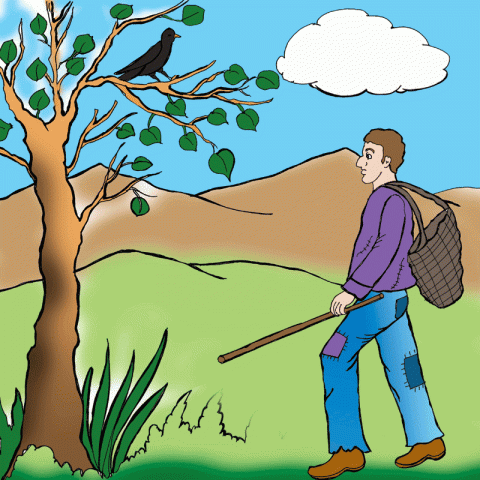كاتب عربيّ من فلسطين المحتلّة ويقيم في الخارج.

هل نحن مُقبلون على حربٍ فلسطينيّةٍ داخليّة، أو على ما يُسمّيه البعضُ "حربًا أهليّةً"؟
هذا السؤال يوظِّفه البعضُ لخدمة أهدافه الضيّقة، ويرميه فزّاعةً في وجه الشعب الفلسطينيّ. فهناك مَن يريد لشعبنا أن يَقبل بشروط العدوّ الصهيونيّ، فلا يقاومَه؛ أن يقبلَ "الواقع،" فلا يتصدّى للحالة الداخليّة المأزومة؛ وكلُّ ذلك بذريعة "الحرص على الوحدة الوطنيّة"!
وفي المقابل، هناك مَن يريد لشعبنا الذهابَ إلى المعركة الخطأ، يدفعه دفعًا إلى خلطِ الحابلِ في النابل، حتى يَدخلَ بقدميْه إلى مطحنة التدميرِ الذاتيّ.
وفي الحالتين ألغامٌ كثيرةٌ، وموتٌ محقَّقٌ، ومشروعٌ لا يَخدم إلّا العدوَّ وحُلفاءه وعُملاءه.
***
غير أنّ السؤال أعلاه يظلّ مشروعًا إذا جرى تناولُه بالاستناد إلى التجربة التاريخيّة للشعب الفلسطينيّ، وإذاأُخِذ بعمقٍ وجدّيّةٍ ووُضعَ في سياقه الطبيعيّ.
فالشعوبُ وحركاتُ التحرّر من الاستعمار جَرّبتْ مثلَ هذه الحروب الداخليّة أو الأهليّة. وهي لم تصلْها فجأةً، ودونما مُقدِّماتٍ تتراكمُ أو شروطٍ تُلازمها. كما أنّها لم تصل إلى حالة الطلاق مع خصمِها السياسيِّ في الداخل لأنّها "ترغب" في حروبٍ ونزاعاتٍ جديدةٍ تُضاف إلى عذابها اليوميّ على يد المُستعمِر. فالحقّ أنّ الأكثريّة الساحقة من الشعب تسعى إلى حالة استقرارٍ طبيعيّة، وتُفضِّل إدارةَ خلافاتها الداخليّة وفق آليّاتٍ ديموقراطيّةٍ سلميّةٍ إذا استطاعت إلى ذلك سبيلًا. غير أنّ الغليانَ الداخليّ يصل أحيانًا إلى استحالة التعايش بين برامجَ وطبقاتٍ وقوًى اجتماعيّةٍ مُتنافرةٍ، ويبلغ التناقضُ بينها نقطةَ الانفجار واللاعودة.
وعلى الرغم من "خصوصيّة المكان والزمان" لكلّ شعبٍ وساحةٍ وبلد، فإنّ قراءةَ الرفيق الشهيد مهدي عامل وما كَتبه عن الحرب الأهليّة في لبنان تبقى مرجعًا فكريًّا وتاريخيًّا مهمًّا لمعرفة جوهر الحروب الطائفيّة و"الأهليّة" وأصولِها ودورِ القوى المحلّيّة والخارجيّة فيها. لقد أراد مهدي أن يقول لنا إنّ ما يجري أبعدُ من صراعٍ شكليٍّ بين الطوائف والزعماء والفصائلِ والقبائل، إذ هناك طبقةٌ عابرةٌ مسيطرةٌ تحصد الربحَ كلَّه، وهي مستعدّةٌ لأن تحصد معها أرواحَ البشر.
ثمّة صورةٌ أخرى، في لبنان نفسِه، قد تبدو بعيدةً عن صورة الحرب الأهليّة، وذلك حين نبحث مثلًا في دور "جيش لبنان الجنوبيّ" وعملاءِ الاحتلال الإسرائيليّ وأعوانِه في "منطقة الحزام الأمنيّ،" وكيف تعاملت المقاومةُ معهم باعتبارهم جزءًا لا يتجزّأ من قوّات العدوّ وأهدافًا مشروعةً لنيران المقاومة. إنّ حضورَ العدوّ الصهيونيّ في المعركة جعل الأمرَ يبدو وكأنّه خارج حسابات "الحرب الداخليّة" في لبنان؛ وهذا ما سهّل على المقاومة مهمّتَها في حسم المعركة وتحقيقِ النصر والتحرير فيما بعد.
إنّ قراءةَ تجاربِ شعوبٍ وحركاتِ تحرّرٍ في الصين وفيتنام وكوبا والسودان والفيليبين وكولومبيا وإيرلندا وجنوب أفريقيا وغيرها مسألةٌ ضروريّةٌ من أجل استخلاص الدروس ورؤيةِ التقاطعات والاختلافات. كذلك الأمرُ بالنسبة إلى تجربة الشعب الفلسطينيّ نفسِه، والصراعِ الداخليِّ في مجتمعه، وكيف كانت قوًى محلّيّةٌ فلسطينيّةٌ (ولا تزال) تعطِّل مسيرةَ كفاحه الوطنيّ التحرّريّ مذ رستْ بوارجُ نابليون الحربيّةُ قُبالة أسوار عكّا في العام 1799.
ربّما وجب المزيدُ من التدقيق اليوم في معنى "الحرب الداخليّة." فالحرب الداخليّة، في معظم الأحيان، لا تنفصل عن الصراع في منطقةٍ أو إقليمٍ ما. والحالة الفلسطينيّة ليست استثناءً. ثمّ إنّ أسبابَ الصراعات الداخليّة موجودةٌ دائمًا، وعناصرَها تشتعل تحت الرَّماد. وهذه الحرب لا تعني، دائمًا، العنفَ أو الصراعَ السياسيَّ الحادّ والواضح. الحربُ الداخليّة تجسيدٌ لصراعٍ بين كتلٍ وطبقاتٍ وخياراتٍ سياسيّةٍ ومراكزِ قوًى. إنّها كثيرًا ما تكون حربًا بين الأكثريّة الشعبيّة، وبين أنظمةٍ وهياكلَ أسَّسَ لها الاستعمارُالحديثُ، و"تركها" لنا تَحْكم بقدْرِ ما يريدها أن تَحكم: فهي أداتُه وسلاحُه ودرعُه، لا يقرِّرُ مصيرَها إلّا الشعبُ الثائرُ، أو المستعمِرُ نفسُه إذا اندحر.
هذه حقيقةُ الصراع، وقوانينُ التطوّر والتناقض، في أيّ مجتمعٍ تسود فيه طبقةٌ تؤسِّس لنظام القمع بديلًا من الحوار، ولا تَعتبر مواجهةَ العدوّ الخارجيّ أولويّةً وطنيّةً. إنّ أيَّ نظامٍ يَسْلك طريقَ العسف والاستغلال والاحتكار والإفقار والإقصاء هو نظامُ الأقليّة الحاكمة، وسيصل في علاقته بالشعب إلى النقطة الحرجة، فيصطدمُ حينها حتمًا بالأكثريّة الشعبيّة التي خسرتْ كلَّ شيء ولم يعد لديها ما تخسرُه.
الثوّار في الفيليبين يقاتلون اليوم "أبناءَ جِلْدتهم" بالسلاح، لكنّهم يُدركون أنّهم يقاتلون أدواتِ الإمبرياليّة وشركاتِ النهب في بلادهم. الفيليبيون عاشوا 400 سنة تحت نِير المستعمِر الإسبانيّ، الذي "سلّمهم" إلى احتلالٍ أمريكيٍّ مُباشر منذ العام 1898. وظلّ هذا الواقعُ ماثلًا إلى اليوم، وإن اختلفتْ آليّاتُ نظام الهيمنة والنهب.
ويَعرف الشعبُ الجزائريّ كيف عَمَد الاستعمارُ إلى تأسيس "كتائب الحركيّين،" وهي كتائبُ مسلّحةٌ من الجزائريين العملاء كانت تعمل في خدمة المستعمِر الفرنسيّ وتقوم بارتكاب الجرائم في حقّ الشعب.[1] وهي صورةٌ طبق الأصل عن "فصائل السلام الفلسطينيّة."
وهذه الأخيرة، أيْ "فصائلُ السلام،" شكّلتْها بريطانيا في فلسطين، وأشرف على تدريبها وتسليحها الضابط أوكونور في منتصف الثلاثينيّات من القرن الماضي، وشاركتْ في القضاء على الثورة الفلسطينيّة الكبرى سنة 1936،وفي التمهيد لاحقًا لـ"نكبة" 1947- 1948. وكانت تقودُها شخصيّاتٌ من عائلاتٍ إقطاعيّة، ومن الأثرياء الذين ربطتهم علاقاتٌ وثيقةٌ بالقوى الإمبرياليّة والرجعيّة في المنطقة، منهم فخري النشاشيبي وفخري عبد الهادي وغيرُهم، بزعامة راغب النشاشيبي، زعيمِ "حزب الدفاع الوطنيّ." وقد أسّس الجنرال البريطانيّ تشارلز تيغارت منظومةً أمنيّةً كاملة من هذه الكتائب، وأنشأ مراكزَ عسكريّةً للشرطة في المدن والمناطق الحدوديّة عُرفتْ بـ"المقاطعات،" وظلّت تُشكّل أحزمةً أمنيّةً لحماية المستعمر البريطانيّ-الصهيونيّ من هجمات الثوّار. ثم جرت تصفيةُ العميل فخري النشاشيبي في العراق سنة 1941، في حين قُتل فخري عبد الهادي في قرية عرّابة (قضاء جنين) سنة 1943.[2]
وقبل تشكيل السلطة الفلسطينيّة في العام 1994، أسّس الكيانُ الصهيونيّ منظومةً عُرفتْ بـ "شبكة روابط القرى." كما أسّس غيرَ ذلك من روابط تحت أسماءٍ ويافطاتٍ تعمل كلُّها في خدمة مشروعه. لكنْ لم تعد ثمّة حاجةٌ إلى هذه جميعِها بعد تأسيس كيان اوسلو وأجهزته؛ فالمستعمِر يعمل دائمًا على إنشاء نظام واسطة (حزام) بينه وبين الشعب من خلال سلطةٍ محلّيّةٍ تابعة.
ما حصل من اشتباكاتٍ مسلّحةٍ بين قوًى فلسطينيّةٍ في العام 1935، وفي الأردن ولبنان بعد انطلاقة العمل الفدائيّ، بل في غزّة سنة 2007، كلُّها زفراتٌ تجسِّد هذا الصراعَ الداخليَّ الفلسطينيّ: بين نهجٍ ونقيضِه، بين طبقاتٍ ومصالحَ متصارعة. لم تكن المسألة "شخصيّةً" بين الشيخ عزّ الدين القسّام والزعيم راغب النشاشيبي، ولم تكن كذلك بين الشهيد وديع حدّاد والملك حسين في الأردن. ومن ينطق بغير ذلك إنّما يروِّج أحاجيَ وخراريفَ تنفع الذين يستسهلون الأجوبةَ الجاهزةَ والسريعة.
***
نعم، ثمّة حربٌ فلسطينيّةٌ موجودةٌ دائمًا، تخبو نارُها وتصعد، وفق موازين القوى وتوتُّرِ مستوى الصراع الطبقيّ في الداخل. هذا هو القانون منذ أن اعتلى سُدّةَ "القيادة" زعماءُ الإقطاع والبرجوازيّة الكبيرة، وصولًا إلى حفنة كومبرادور من محاسيب الاحتلال والرأسمال في رام الله وعمّان ونابلس. وبغضّ النظر عن الأسباب التي دفعتْ إلى هذا الواقع، وهي بلا شكٍّ مهمّةٌ وينبغي تناولُها في مقالاتٍ مستقلّةٍ لاحقة، فإنّ الحقيقة الجوهريّة الثابتة هي أنّ هناك أقلّيّةً فلسطينيّةً تتربّع على سدّة القرار السياسيّ، وتحتكرُه بالقوّة والمال المنهوب والدعمِ الخارجيّ الأميركيّ والأوروبيّ والرجعيّ العربيّ وبفضل التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال، وهي مستعدّةٌ من أجل الدفاع عن مصالحها أن ترتكبَ الجرائمَ السياسيّة. هذه القوى حالت دون تحقيق النصر، وأجهضتْ أكثرَ من انتفاضةٍ شعبيّة، وساومتْ على ما تبقّى من أرضٍ وحقوق، ودمّرتْ ما تحقّق من إنجازاتٍ وطنيّة.

هذه الثروات مسروقةٌ من الشعب الفلسطينيّ: إنّها حقوقُه المنهوبةُ منذ 72 عامًا على الأقلّ
وهذه الحرب ليست حربًا بين مناطق، ولا بين طوائف، ولا بين داخلٍ وخارج، ولا بين يمينٍ ويسار، ولا بين يمينٍ ويمين، ولا بين غزّة وضفّة، بل هي جزءٌ طبيعيٌّ من الحرب الكبيرة: بين شعبٍ غالبيّتُه تحت الاحتلال وفي المنافي ويريد أن يحرِّر أرضَه ونفسَه، وبين خَدَمِ الاستعمار. إنّها جزءٌ من صراعٍ أكبر بين أمّةٍ-حضارةٍ يجري سحقُها يوميًّا من المحيط إلى الخليج، وبين مشاريعَ وقوًى إمبرياليّةٍ وصهيونيّةٍ ورجعيّةٍ تريد أن تبتلع ثروةَ الشعوب.
الغضبُ الشعبيّ المكتوم في صدور المخيّمات الفلسطينيّة على نحوٍ خاصّ، وفي أحزمة البؤس والفقر، ليس "حسدًا" ممّن يسكنون القصورَ ويكدِّسون ثرواتِهم في البنوك النفطيّة والأجنبيّة، بل سببُه أنّ هذه الثروات أموالٌ مسروقةٌ من الشعب الفلسطينيّ: إنّها حقوقُه المنهوبةُ والمنتهَكةُ منذ 72 عامًا على الأقلّ.
***
لكنْ، إذا كانت لسكّان القصور وأصحابِ المصارف سلطتُهم وأجهزتُهم، فأين سلطةُ المخيّم والطبقات الشعبيّة؟ ما هو مشروعُها السياسيّ البديل؟ وما هي القوى التي تعبِّر عنه اليوم؟
الأرض الفلسطينيّة التي جرت المساومةُ عليها هي ملْكٌ جماعيّ للشعب الفلسطينيّ. الثروات الطبيعيّة فيها ملْكيّةٌ جماعيّة. الغاز المنهوب من بحر فلسطين ملْكيّةٌ جماعيّة. ومنظّمةُ التحرير الفلسطينيّة ومؤسّساتُها ملْكيّةٌ جماعيّة، لكنّها صودرتْ، بل اختُطفتْ، وأصبحتْ مزرعةً خاصّةً لحفنةٍ من المستسلمين والتجّار الذين باعوا القضيّةَ والأرضَ والشعبَ. ويدرك شعبُنا أنّ شبكةَ الصهاينة والسماسرة والحراميّة، الممتدّةَ من تلّ أبيب إلى القاهرة وعمّان وصولًا إلى رام الله، هي التي تنهب ثرواتِه وتبيعُها، وهي ذاتُها التي تنسِّق أمنيًّا مع الكيان الصهيونيّ وتعقد معه معاهداتِ السلام والصلح (كامب ديفيد، وادي عربة، أوسلو)، وهي ذاتُها التي تُقصي 99 % من الشعب وتحرمه ممارسةَ حقّه في تقرير مصير قضيّته الوطنيّة بإرادته الشعبيّة الحُرّة.
***
هل نحن مقبلون، إذًا، على حربٍ فلسطينيّةٍ داخليّة؟
هذا ما لا يتمنّاه أيُّ وطنيٍّ غيورٍ على وطنه وقضيّتِه وشعبه، وهذا ما سيسعى إلى تفاديه دومًا. لكنّ التمنّي غيرُ الحقيقة. والحقيقة هي أنّنا نسكن في قلب هذه الحرب، لم نغادرْها يومًا واحدًا، وإنِ اختلفَ التعبيرُ عنها من مرحلةٍ إلى أخرى، من دون أن يأخذ شكلَ الحسم الشعبيّ العنيف حتى اللحظة الراهنة. وإلى أن يحرِّرَ الشعبُ الفلسطينيّ صوتَه وإرادتَه الوطنيّة، وتسودَ طبقاتٌ شعبيّةٌ ونهجٌ بديل، فستظلّ شريحةٌ فلسطينيّةٌ مستسلمةٌ (ومنحطّةٌ) من الأقلّيّة تَحْكم، وتَرْسم، وتَعْقد الصفقاتِ، وتبيع إنجازاتِ الشعبِ ومكتسباتِه، باسم الشعب، دونما حسيبٍ أو رقيب.
كندا
كاتب عربيّ من فلسطين المحتلّة ويقيم في الخارج.