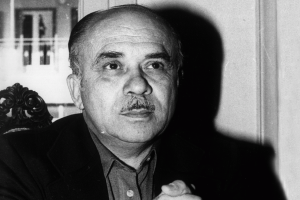هذا سؤال يُقلق جميعَ الحريصين على أهلنا في غزّة بشكلٍ خاصّ، وفي فلسطين عمومًا. فثمّة خشيةٌ لدى كثيرين من أن تذهب تضحياتُ الفلسطينيين "سدًى" كما يقولون، أو أن يتمّ استغلالُها لخدمة أهدافٍ منقوصة أو زعاماتٍ مأزومة. وتجاربُنا في السابق تبرِّر لنا الوقوعَ في مثل هذه الشكوك والخيبات. ألم "يجيَّر" الصمودُ الأسطوريّ في بيروت سنة 1982، والانتفاضةُ الأولى سنة 1987، لنيل مقعدٍ هزيلٍ في مفاوضات مدريد، أو لحيازة دويْلةٍ بائسةٍ بلا سيادة على أقلّ من 22% من فلسطين؟
الثقة، أو استعادةُ الثقة، بمصير أيّة خطوةٍ تغييريّةٍ أو ثوريّة (من أصغر عمليّةٍ عسكريّة إلى أضخم مواجهةٍ شعبيّة أو عسكريّة)، لا تتأتّى إلّا في وجود قيادةٍ تحظى برضى الناس. فمن دون هذه القيادة يبقى الناسُ عرضةً للخيبات المتواصلة، وعرضةً لفقدان الحماس لأيّة دعوةٍ إلى تحرّكٍ جديد. من دون هذه القيادة الموثوقة شعبيًّا سيتحوّل كلُّ تحرّكٍ وطنيّ إلى فعلِ مرارة، وستتحوّل القصيدةُ "الوطنيّةُ" نفسُها إلى ندبةٍ ومرثيّة.
ولكنْ، هل هناك وصفةٌ سحريّةٌ للقيادة الموثوقة؟ هناك معايير بالتأكيد، أبرزُها: السجلُّ النظيف، وطهارةُ الكفّ، والتمسّكُ بالثوابت (رغم التكتيكات الذكيّة)، والتحالفاتُ المبدئيّة، وترتيبُ الأولويّات. وربّما أضفنا: الكاريزما، وسلاسةَ اللغة، وتماسكَ الخطاب.
لكنّ القيادة الموثوقة لا تكفي من دون حزبٍ أو تنظيمٍ تستند اليه، فيَضمنُ لها الحشدَ الجماهيريّ، وإمكانيّةَ "رفع السقف" إذا اضطُرّ إلى المواجهة، أو إمكانيّةَ الانحناء قليلًا إذا اضطُرّ إلى الانكفاء الموقّت. والقيادة الموثوقة، وهذا هو الأهمّ، لا تكفي من دون برنامج عملٍ واضح، يَرسم الهدفَ النهائيّ الذي يصبو إليه الشعبُ والحزبُ، ويحدِّد الأهدافَ المرحليّةَ القابلةَ للتحقيق من دون التنازل عن ذلك الهدف النهائيّ.
***
نقول ذلك كلَّه وعينُنا على ما يجري في فلسطين منذ سنوات، من تركيباتٍ وتعقيداتٍ واختلالاتٍ ومعوِّقاتٍ تطاول مختلفَ جوانب العمل الوطنيّ:
ــــ ففي قطاع غزّة حصارٌ إسرائيليّ غاشم، بمشاركةٍ رسميّةٍ مصريّة، وتواطؤ دوليّ. وهو مضروبٌ منذ أعوام طويلة، مع ما يرافق ذلك من بؤسٍ اقتصاديّ ومعيشيّ لأهلنا في القطاع. وقد بلغ هذا البؤسُ مراتبَ قصوى مع تدمير غالبيّة الأنفاق التي تربط القطاعَ بالخارج. ثمّ جاءت خطوةُ رئيس السلطة الفلسطينيّة في رام الله، محمود عبّاس، بخفض أجور موظّفي السلطة في القطاع بنسبة 20%، لتصبَّ الزيتَ على النار، ولتُشْعر الغزّيين بأنّهم ضحيّةٌ لتدبير انتقاميّ اتّخذه عبّاس ضدّ حركة حماس لزعزعة سيطرتها على القطاع.[1]
وكأنّ القطاعَ لم يكْفِه تضييقان، فخضع لتضييقٍ ثالث، سببُه سلطةُ "حماس" المتزمّتة اجتماعيًّا ودينيًّا وتربويًّا، وسببُه إجراءاتُها غير الديمقراطيّة أحيانًا في حقّ الفصائل الوطنيّة الأخرى. لكنّ الأخطر في هذا المجال أنّ تحالفات "حماس" السياسيّة، الإقليميّة والعربيّة، قد أرخت بثقلها على العمل الوطنيّ: فلا هي في صلب "محور المقاومة" بسبب عدائها للنظام السوريّ والتصاقها بتركيا وقطر، ولا هي (بالتأكيد) في المحور المعادي للمقاومة بسبب سجلّها الوطنيّ الكبير المعادي لـ"إسرائيل." وربّما يعود ذلك إلى أنّ سياساتها العامّة تخضع لقراراتٍ تتخطّى الساحة الفلسطينيّة والعربيّة، لكونها ــــ باعترافها ـــــ "جناحًا من أجنحة الإخوان المسلمين."[2]
ــــ وفي الضفة الغربيّة سلطةٌ وصلتْ إلى ما دون القعر في التنازل عن غالبيّة الثوابت الوطنيّة: بدءًا من الأرض (إذ قنعتْ بـ 22% من فلسطين التاريخيّة...وبلا سيادة)، مرورًا بفلسطينيّي 48 (الذين تخلّت عنهم لصالح "لجنة تواصل مع المجتمع الإسرائيلي"!)، وانتهاءً بحقّ العودة إلى فلسطين (مَن ينسى إعلانَ محمود عبّاس الشهير: "من حقّي أن أرى صفد لا أن أعيشَ فيها. فلسطين في نظري هي حدود 67، وحدودُها القدسُ الشرقيّة. هذا هو الوضعُ الآن وإلى الأبد"؟).[3]
ــــ أما "اليسار" الفلسطينيّ، فوضعُه لا يسرّ صديقًا ولا يُغيظ عدوًّا. إمكانيّاتُه ضئيلة، وقياداتُه في معظمها مترهّلة تعيش على أمجاد الماضي الغابر، والمحاسبة غائبةٌ أو شبهُ غائبة، ومعدّلاتُ "التسرّب" من التنظيمات على قدم وساق. بعضُ كوادر اليسار الأساسيّة في السجون منذ سنوات، وبعضُ عناصره انتقلوا إلى منظّماتٍ غير حكوميّة مشبوهةِ التمويلِ والأهداف، وهناك مَن انخرط في صفوف أجهزة الشرطة والأمن الفلسطينيّة. ثم إنّ اليسار في فلسطين، في مجمله، لم يعد ولو "قوّةً أخلاقيّةً" تُحرج المستسلمين، ناهيكم بردعهم!
ــــ وإلى ذلك كله يضاف انقسامٌ حادّ بين حركتيْ فتح وحماس بشكل خاصّ، وشبهُ انقطاع عن التواصل المباشر بين غزّة والضفة (ومناطق 48 وأماكن النزوح). وهذا ما يزيد من صعوبة البحث عن خياراتٍ تُخْرج الفلسطينيين الممزَّقين والمشتَّتين من عنق الزجاجة الراهن.
***
لكنْ، في مقابل ذلك كلّه، شعبٌ يواجه بحماسٍ وإيمانٍ عزّ نظيرُهما في العالم والتاريخ: بالصرخة، والصدرِ العاري، والقبضة، ودولاب الكاوتشوك، والحجر، والسكّين، والمولوتوف. بأطفاله، وفتيانه، وفتياته، ونسائه، ورجاله. شعبٌ كلّما تراكمتْ عليه المصائب، وتكالب عليه المتآمرون، ازداد عنفوانًا وشراسةً وكرامةً وتحدّيًا وتمسّكًا بأرضه. شعبٌ يُدهش نفسَه قبل أن يُدهش أعداءه، وقبل أن يُذهلَ "قياداته." شعبٌ لم يعد يأبه بكلامنا هذا لأنّ مقاومته نهجُ حياة... مُذ أدركَ الحياة.
وثمة، بالإضافة إلى ذلك، تململٌ واضح، قد لا تصحّ تسميتُه "حَراكًا" بعد، في صفوف الشباب الفلسطينيّ بنوعٍ خاصّ، لا سيّما في الضفّة الغربيّة. وهناك، على ما نلاحظ، "قناعاتٌ" جديدة، تنمو لديهم، وإنْ ببطء، بأنّ طريقَ التفاوض والسلْم لن تؤدّي إلّا إلى المزيد من التهويد والقضم والفقر والمهانةِ الوطنيّة، وإلى المزيد من إحكام الفاسدين قبضتَهم على مقدِّرات البلاد وإمكانيّاتها في المستقبل. قد لا يكون التفكيرُ في العودة إلى السلاح هو الطاغي لدى الشباب المتململ؛ فالعوائقُ جمّة، وتجربةُ السلاح لم تكن هي ذاتُها "مثاليّة." لكنّ تجربة المفاوضات الطويلة العقيمة (1993 ــــ 2018 وما بعد) لم تكن لترضيهم وتشفي كبرياءهم الوطنيّ الجريح في أيّ حالٍ من الأحوال.
وعلاوةً على ذلك، هناك تصاعدٌ لافتٌ جدًّا في حركة المقاطعة العالميّة. فلو تناولنا العامَ الماضي وحده (2017) لهالنا حجمُ الإنجازات،[4] التي ينبغي أن تُحسَبَ في سجلّ القضيّة الفلسطينيّة، مع أنّ كثيرًا من الفلسطينيين والعرب لا يعلمون بها للأسف؛ بل إنّ بعضَهم (الأخ العزيز منير شفيق عبر إذاعة النور مثلًا) لا يعيرها أدنى أهميّة. إليكم هنا بعضَ هذه الإنجازات:
ـ أكبر نقابة للمزارعين في الهند، AIKS، وهي مؤلّفة من 16 مليون مزارع، أعلنتْ تأييدَها لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
ـ أكبر اتحاد نقابات عمّال نرويجيّ، LO، ويضمّ مليونَ عامل، تبنّى مقاطعةً دوليّةً شاملة لإسرائيل.
ـ 21 كنيسة أميركيّة أعلنتْ نفسَها خاليةً من منتوجات HP الداعمة لإسرائيل.
ـ ثالث أكبر صندوق تقاعد في الدانمرك استثنى الشركاتِ والبنوكَ الإسرائيليّة من جهاتِ الاستثمار.
وهنا لا نستطيع أن نُغفل أيضًا إنجازات المقاطعة على الجبهة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة أيضًا. فخلال السنة الماضية وحدها ألغى عدد من الفنّانين العالميين عروضَهم في دولة الاحتلال، ومن بينهم مغنّيةُ الراب النيوزيلنديّة لورد، وانسحبتْ 9 عروض فنيّة من مهرجان PopKultur في برلين بسبب رعاية السفارة الإسرائيليّة له، ورفض 6 لاعبين من أصل 11 لاعبًا في دوري كرة القدم الأميركيّة الوطنيّ (NFL) القيام برحلة دعاية مدفوعة إلى الكيان الصهيونيّ لأنهم أدركوا أنّ هدفها "تحسينُ صورة" هذا الكيان المجرم.[5] ولم يكن الوطنُ العربيّ مستثنًى من القيام بحملات مقاطعة بارزة، وخصوصًا في لبنان، سواء على مستوى الشركات الداعمة للعدوّ (مثل G4S)، أو على مستوى السينما (غال غادوت....) والفنّ؛ وقبل ساعات أعلنتْ مغنّيةُ البوب العالميّة شاكيرا، بعد حملة ضخمة ضدّ عرضها في تل أبيب في 9 تمّوز، أنها لم تكن تنوي القيام بذلك العرض أصلًا (رغم وجود إشاراتٍ كثيرةٍ تفيد عكسَ زعمها).
الوضع إذن ليس بذلك السوء. المهمّ حشدُ الطاقات الموجودة (وهي ليست بالقليلة)، وتشبيكُ الحلفاء، وتنسيقُ الجهود. والمهمّ أيضًا، على المستوى الفكريّ تحديدًا، التخلّصُ من عدّة أوهام:
أوّلُها، وهمُ قيام دولةٍ وطنيّةٍ مع بقاء الاحتلال. يومًا بعد يوم نكتشف "خدعةَ" المرحليّة الني باعونا إيّاها منذ العام 1974 بذريعة التكتيك والدهاء السياسيّيْن؛ فقد كان هدفُ بعض القادة، منذ البداية، قيامَ سلطةٍ فلسطينيّة على أيّ شبرٍ "يُعطى" (وليس مجّانًا)، والقبولَ بهذا الشبر إلى أبدِ الآبدين. قد يكون خيارُ الكفاح المسلّح أصعب اليوم من البارحة، لكنه سيكون أقلَّ صعوبة بالتأكيد إذا جرى بناء جبهة مقاومة فلسطينيّة عسكريّة مشتركة.
ثانيها، وهمُ الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة في ظلّ اتفاقيّات استسلام (أوسلو)، وفي ظلّ "تنسيق أمنيّ" مع العدوّ. التعبير نفسه، أي "الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة،" يتطلّب منا التركيزَ على كلمة "وطنيّة" بدلًا من "وحدة." فلا وطنيّة مع التخلّي عن 78% من فلسطين أو عن اللاجئين، ولا وطنيّة مع إبقاء إجراءاتِ التنسيق مع القتلة.
ثالثُها، وهمُ تحرّر غزّة من دون الضفّة أو "الشتات" أو 48. كلّ تفكيرٍ في تحرير جزءٍ على حساب جزءٍ آخر طعنةٌ نجلاء لمجمل العمل الوطنيّ الفلسطينيّ. التنسيق ضروريّ بين كلّ "أجزاء" شعبنا المقطَّعِ الأوصال. والتفرّدُ بحجّة التكتيك خطأٌ قاتلٌ آخر. وإذا كان كسرُ الحصار عن غزّة أهمَّ الأولويّات الآن، فإنّ ذلك لن يتمّ من دون تحرّكٍ شعبيّ كبير في الضفّة الغربيّة بشكلٍ خاصّ.
رابعًا، وهمُ النصر بلا حلفاء. علينا أن نحدّد، من جديد، مَن هم حلفاؤنا على المستوى العربيّ والإقليميّ والدوليّ. معسكرُ الأعداء واضح، وهو الحلف الإسرائيليّ ــ الأميركيّ ــ الرجعيّ العربيّ، وقد حدّد بوضوحٍ لا مثيلَ له أنّ هدفَه تصفيةُ القضيّة الفلسطينيّة والتخلّي عن القدس واللاجئين. قد لا نحبّ بعضَ أطراف المحور المواجه، "محور المقاومة،" ونمقتُ بالتأكيد تزمّتَها واستبدادَها. لكنّ النصرَ على معسكر الأعداء لا يمكن أن يتمّ "على الطلب" à la carte)، وإنْ كان نقدُ معسكر الحلفاء، دومًا وأبدًا، أكثرَ من ضروريّ ــ ــ خصوصًا من طرف العاملين في الشأنين الثقافيّ والسياسيّ التقدّميّ.
من جديد نحن أمام مواجهات أخرى في فلسطين، وقد تشتعل جبهاتٌ جديدة مع محاولة ترامب ونتنياهو التخلّصَ من مآزقهما الداخليّة. ولا خيارَ لشعبنا إلّا المواجهة الواعية، والتماسك على أرضيّة الثوابت الوطنيّة، والتمسّك بسلاح النقد.
بيروت