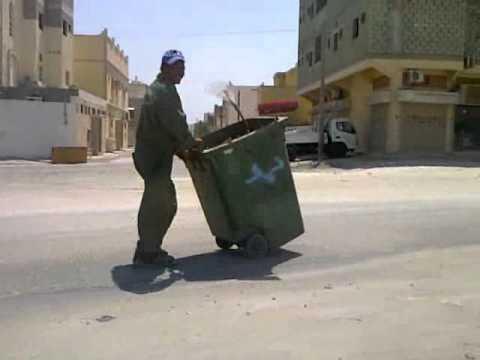كاتب سوري، وباحث في معهد الدراسات المستقبليّة.

"يناجي الذئبَ، يسأله النّزالَ:/ تعالَ يا ابنَ الكلب نَقْرَعْ طَبْلَ/ هذا الليل حتى نوقظَ الموتى. فإنّ/ الكُرْدَ يقتربون من نارِ الحقيقة/ ثم يحترقون مثلَ فراشةِ الشُّعَراء" (محمود درويش، "ليس للكرديّ إلّا الريح").
غداةَ توقيع اتفاقيّة لوزان سنة 1923 سأل الحلفاءُ المنتصرون في الحرب العالميّة الأولى المندوبَ التركيّ ــــ الكرديّ الأصل، عصمت إينونو، عن مصير قومه (الكُرد) إنْ دَعم الحلفاءُ إقامةَ جمهوريّةٍ تركيّةٍ فوق أرض الأناضول. اتصل الرجلُ بصديقه، رئيسِ البرلمان وقتها، مصطفى كمال أتاتورك، وأخبره بما يجري. فاستدعى أتاتورك النائبَ الكرديّ حسن خيري، وطلب منه إعلانًا على الملأ أنّ الكرد "جزءٌ من الأمّة التركيّة ويفضّلون البقاءَ ضمنها." فعل خيْري ما طُلب منه، فأرسل أتاتورك كلامَه (مع صورته) عبر التلغراف إلى إينونو، الذي عرض كلامه بدوره على الحلفاء المجتمعين، فوافقوا على إنشاء الدولة التركيّة الحديثة.
بعد إعلان الجمهوريّة بأشهر، قُبض على خيري بحُجّة مخالفة الدستور لأنّه كان يتفاخر بارتداء زيّه الكرديّ في جلسات البرلمان، وحُكم عليه بالإعدام. لكنّ خيري، قبل إعدامه، طلب من الحاضرين دفنَه في مكانٍ عامّ ليتسنّى لقومه أن يبصقوا على قبره جزاءَ خيانته لهم. القصّة، بحسب الأوساط الكرديّة، حقيقيّة، وتضيف إليها وثائقُ تاريخيّةٌ أنّ عدد النوّاب الكرد من أعضاء الجمعيّة التأسيسيّة التركيّة ممّن طلبوا بقاءهم ضمن الجمهوريّة الناشئة كان 72 نائبًا يمثّلون مختلف مناطق الوجود الكرديّ.[1]
المسألة الوطنيّة الكرديّة في سوريا حتى السبعينيّات: موجز
للمسألة الوطنيّة الكرديّة في سوريا مساران متقاطعان. الأوّل يتعلّق بالكرد القاطنين في البلاد قبل تأسيس الدولة السوريّة بحدودها المعروفة مطلع القرن الفائت؛ والثاني يتعلّق بالتغيّرات التي طاولتْ تركيا الحديثة، ودفعت الكردَ إلى الشمال السوريّ في هجراتٍ جديدةٍ لم تهدأ حتى اليوم.
أ ــــ المسار الأوّل: كُرد المدن الكبرى. في سوريا الحاليّة كُردٌ مقيمون منذ عهودٍ قديمة، إذ لم تتوقّف الهجرة بين مناطق العالم منذ بدء التاريخ تبعًا لعوامل الاقتصاد أو السياسة أو غيرها. تسجِّل المرويّاتُ التاريخيّةُ، مثلًا، هجرةَ قبيلة النزاريّة الكرديّة إلى مناطقَ سوريّةٍ مختلفة، منها الشام وحماة.[2] كما حصلتْ هجراتٌ أخرى في عهد الدولة الأيّوبيّة (وعائلتُها الحاكمة مسلمةٌ كرديّة) نتيجةً لتوطّن جزءٍ من جيش صلاح الدين في بعض مناطق الشام وحلب، حيث أنشأوا أحياءً عاشت إلى اليوم: كحيّ "المهاجرين" في دمشق وحيّ "ركن الدِّين" أي (حيّ الكُرد). تضاف إلى ذلك هجراتٌ مختلفة إلى مناطق العشوائيّات المحيطة بالمدن الكبرى (كوادي المشاريع قرب دُمّر ومزّة جبل في دمشق، والشيخ مقصود في حلب)، وقد قدِمتْ من منطقة الجزيرة إثر جفافٍ حادٍّ ضربها في ثمانينيّات القرن الماضي، ويقدَّر عددُهم بأكثر من مئة ألف نسمة.
لكُرد المدن الكبرى دورٌ وطنيٌّ كبير في تاريخ سوريا المعاصر. فقد شاركتْ عائلاتٌ كثيرة، مثل البرازي والشيشكلي والزعيم والحناوي وبدرخان والإبيش وبوظو وزلفو، وأفرادٌ مثل المؤرّخ محمد كُرد عليّ، في النضال الوطنيّ ضدّ الاحتلال الفرنسيّ على امتداد ثلاثين عامًا. ولم يأتِ هذا الدور من ثقل كُرديّتهم، بقدرِ ما هو نتيجةٌ لامتزاجهم بالمجتمع السوريّ عمومًا، وبالدمشقيّ ــــ الحلبيّ خصوصًا، على الرغم من حفاظهم على تقاليدهم الكرديّة الأبرز (كالاحتفال بالنوروز).
ولم يحدث أنْ تعارك هؤلاء الكردُ مع عناصر عربيّة (أو غير عربيّة) على قاعدة الكُرديّة إلّا باستثناءات بسيطة (حدث أحدُها في حلب بتشجيع أحد الزعماء الإقطاعيين).[3] كما ظلّت حقوقُهم الوطنيّة كحقوق سائر السوريين. ولم يَحُلْ خلوُّ المؤتمر السوريّ الأوّل (باريس 1918) من الأكراد دون أن يتبوّأ كرديٌّ (هو فوزي السّلو) رئاسةَ سوريا لاحقًا، ودون أن يكون قائدان من قادة انقلابات ما بعد الاستقلال عسكريّيْن كرديّيْن (هما حسني الزَّعيم وأديب الشيشكليّ ــ ــ والأخير على ما يُعرف عنه كان متأثّرًا بفكر الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ).[4]
ب ــــ المسار الثاني: "أجانب تركيا." المسار الثاني هو الأبرز، وأدّى إلى ظهور الكُرد مكوِّنًا عرقيًّا واضحًا في سوريا، أو ما عُرف لاحقًا بمشكلة "أجانب تركيا." فقد أدّت السياساتُ الطورانيّة القمعيّة الهائلة، الهادفةُ إلى "تطهير" هضبة الأناضول من غير الترك المسلمين، إلى قتلٍ وتشريدٍ طاولا الأرمنَ، ثم الكُردَ، في غضون أقلّ من عقديْن، وذلك في مناطقَ سبق أن شهدت استقرارًا تاريخيًّا لآلاف السنين. ومع تهجير الأتراك من أصلٍ يونانيّ إلى اليونان، لم يبقَ في تركيا مسيحيون، على الرغم من أنّ أورفا والرها وأنطاكيا والقسطنطينيّة وسميرنا كانت عواصمَ العالم المسيحيّ لقرون.[5]
أدّت السياساتُ الكماليّة، المتأثّرة بالنزعة النازيّة، إلى قتل الكرد ونفيهم إلى أقاصي الشرق التركيّ، بعد أن شكّلوا مع الأرمن والعلويين العرب قُرابة 5 ملايين إنسان من كامل سكّان الهضبة الأناضوليّة (حوالي 11 مليونًا).[6] وبعد ثورة الشيخ سعيد النورسي (الكرديّ) سنة 1925، أكمل الطورانيّون محاولةَ اقتلاع الكُرد من شرق البلاد، بالتعاون مع فرنسا، حتى أواخر العام 1936، فوصل أكثرُ من 80 ألف كرديّ ليستوطنوا منطقةَ الجزيرة العليا في سوريا (قرب الحدود الحاليّة)، تبعهم عددٌ من الآشوريين من العراق (9 آلاف). وقد عمل هؤلاء جميعًا في الزراعة، برعايةٍ فرنسيّةٍ عملتْ على تحويل المنطقة اقتصاديًّا، لتصبح منطقةً تعجّ بالحياة والعمران (فعلى سبيل المثال تحوّلت القامشلي من شبه قرية إلى مدينة يبلغ عددُ سكّانها 63 ألفًا عام 1940).[7]
لم تحُلْ سياساتُ فرنسا الانتدابيّة دون إعادة تأسيس "جمعيّة الاستقلال" (خويبون) لتحرير كُردستان تركيا من "آخر جنديّ تركيّ." وقد رعت المفوضيّةُ الفرنسيّة اجتماعاتِ الجمعيّة، وصالحتْهم مع عدوّهم التاريخيّ: الأرمن. وحتى ذلك الوقت لم يَطرح الكردُ الجدد في سوريا أيَّ مطالبَ سياسيّةٍ بعيدًا عن الفلك الوطنيّ. وبقي ذلك الوضعُ على حاله حتى العام 1936، حين أثار الفرنسيّون الزعاماتِ المرتبطةَ بهم من كلّ القوميّات في المنطقة، فطالبتْ هذه الزعاماتُ بالحكم الذاتيّ للجزيرة، أسوةً بمطالباتٍ مشابهة في مناطقَ سوريّةٍ أخرى. وكان الهدفُ الأوحد من ذلك هو الضغط على الحكومة الوطنيّة من أجل توقيع ملاحقَ لمعاهدة 1936 تعطي فرنسا أولويّةَ التنقيب عن النفط.[8] وقد استمرت الحركةُ الانفصاليّة، التي ضمّت قياداتٍ كُرديّةً وعربيّةً وآشوريّةً وأرمنيّةً، تلقّت من فرنسا سنويًّا مبالغَ ماليّةً كبيرة [9] حتى العام 1937. ومن المطالب المرفوعة إلى المفوّضيّة: مرابطةُ قوة فرنسيّة بصورةٍ دائمة في الجزيرة، وتعليمُ اللغة الكرديّة رسميًّا. وقد جاء الردُّ على الحركة الانفصاليّة من عامودا؛ فحين هاجم الدقوريّون (وهم كُرد مقيمون في المنطقة منذ قرون) الثكنةَ الفرنسيّة في آب 1937، ردّت فرنسا بتدمير عامودا بالطائرات والمدفعيّة، فقُتل 26 شخصًا، وشُرّدتْ 600 عائلة أكثر من عام.[10]
بعد هذه الواقعة برز الانقسامُ الكرديّ: بين الانفصاليين بقيادة حاجي زلفو آغا، وزعماءِ الكرد في دمشق بقيادة علي زلفو آغا، صاحبِ الدوْر الوطنيّ المشهود ــ ــ إذ قاوم زحفَ غورو على دمشق، فحكمتْ عليه فرنسا بالإعدام غيابيًّا، وأدّى رفضُه الحركةَ الانفصاليّة إلى نزع الشرعيّة عنها. ويسجَّل هنا أيضًا موقفٌ شجاع للحزب الشيوعيّ السوريّ ولأمينِه العامّ خالد بكداش، وهو كُرديّ أيضًا من دمشق، إذ أصدر بيانًا فضح فيه الحركةَ الانفصاليّة بالأسماء والتفاصيل.[11]
بين العامين 1936 و1938 اشتعلتْ ثورةُ "درسيم" في قلب الولايات الشرقيّة للأناضول بقيادة سيّد رضا، فردّت السلطاتُ بتعليق المشانق ونفي الأهالي ومحوِ قرية درسيم من الوجود. وهذا ما أدّى إلى تدفّق كُرديّ جديد إلى منطقة الجزيرة السوريّة، قُدّر بمئات العائلات. ولمّا كان هؤلاء قد فقدوا الجنسيّة التركيّة، تبعًا للقانون التركيّ وللاتفاقيّة الفرنسيّة ــــ التركيّة الموقّعة سنة 1938، فقد عمدتْ فرنسا إلى تجنيسهم تحت اسم "مكتومي القيد." وقد بلغتْ نسبةُ الزيادة السنويّة في التسجيل، بين العامين 1938 و1945، 16.2% من إجماليّ سكّان الجزيرة، البالغ عددهم 146 ألفًا.[12]
حتى أوائل الستينيّات، ومع بدء مرحلة تطبيق الإصلاح الزراعيّ، استمرّت الهجراتُ الكرديّة إلى منطقة الجزيرة مدفوعةً بعوامل متعدّدة، أبرزُها: الازدهارُ الاقتصاديّ للمنطقة، والانتفاعُ من عمليّة توزيع الأراضي على الفلّاحين، والهربُ الكرديّ من سياسات إعادة التوطين التركيّة في مناطق شرق الأناضول التي تحوّلتْ إلى قفار. كما أنّ السلطات التركيّة لم تغمضْ عينَها عن اكتشافات المنطقة النفطيّة في العام 1956. وبذلك تحوّلت الجزيرةُ السوريّة إلى منطقة استقطاب وتوتّر دائميْن في علاقة الحكم السوريّ بتركيّا. ولعلّ هذا ما يُفسّر سبب تأخّر تعداد سكّان المنطقة حتى العام 1962 (تعزو الحكومةُ السوريّة السببَ إلى عدم توفّر نفقات إجراء الإحصاء).[13]
في العام 1962، أصدرتْ حكومةُ خالد العظم قرارًا بإنهاء كلّ سجلّات الأحوال المدنيّة السابقة، وبإجراء إحصاءٍ جديدٍ لجميع سكّان الجزيرة باعتماد العام 1945 نقطةَ تحديد المواطنيّة؛ فقد تكشّف للحكومة وللأحزاب وجودُ عمليّاتٍ غير شرعيّة للحصول على الهويّة السوريّة منذ العام 1945 وما تلاه.[14] وقد انتهت عمليّةُ الإحصاء بتسجيل 85 ألفًا بصفة "أجانب أتراك،" أيْ ما يُعادل 28% من سكّان المحافظة البالغُ عددُهم 302000. وقتها، اعتُبرتْ شهادةُ تعريف من المختار، وشهادتين من شاهديْن، كافيةً لإثبات الوجود. إلّا أن الكثيرين لم يُثبّتوا وجودهم في السجلّات، كي يُعفوا أولادَهم من الخدمة العسكريّة، واقتناعًا بما سوّغ لهم بعضُ الإقطاعيين الطامعين في الاستحواذ على أراضيهم.[15]
من غرائب إحصاء 1962 تجريدُ شخصيّات سوريّة وازنة من جنسيّتها، مثل رئيس هيئة الأركان السوريّة توفيق نظام الدين (1955 ــــ 1957)، وشقيقه عبد الباقي، رئيسِ الوفد الوطنيّ الجزراويّ في مواجهة المفوّض الساميّ الفرنسيّ إبّان الحركة الانفصاليّة عام 1936. مثلُ هذه الحوادث أفقد الإحصاءَ مصداقيّتَه، إذ بدا وكأنّه عمليّةُ انتقامٍ قوميّ عربيّ؛[16] والحقّ أنّ مَن أدار هذا الإحصاءَ كان محافظَ الحسكة سعيد السيّد، شقيقَ جلال السيّد (بعثيّ من دير الزور) الذي وصف نفسَه بأنه" قوميّ عربيّ متطرّف."
أعادت حركةُ 8 آذار 1963، التي أوصلَت البعثَ إلى السلطة، الفلّاحين المنقولين إلى الأراضي التي طُردوا منها داخل الجزيرة، من دون أيّ تمييزٍ قوميّ بينهم، عربًا وكردًا. وإلى العام 1970، اتُّبِعتْ سياسةُ إنشاء حزام عربيّ على طول الحدود مع تركيا. وفي العام 1973 نُقلتْ إلى مناطقَ (لا يسكنها كُرد) أعدادٌ من الفلّاحين الذين غُمرتْ أراضيهم في مشروع سدّ الفرات عام 1969 ــــ وهؤلاء لم يتجاوزوا 4000 أسرة ـــ ومُنحوا أراضيَ تعادل حيازتَهم السابقة حول بحيرة السدّ. ولم يهجَّر أيُّ فلاح كرديّ من منطقته، ولا احتلّ أحدٌ قريةً كرديّة، خلافًا لما تزعق به بعضُ الأدبيّات الكُرديّة.[17]
هنا، لا بدّ من التذكير بنقطة مهمّة تضيء على العلاقة السوريّة ــــ العراقيّة في شأن المسألة الكرديّة. فسوريا هي الدولة الوحيدة التي عارضتْ، في العاميْن 1964 و1966، إعلانَ وقف إطلاق النار بين الجيش العراقيّ والميليشيات الكُرديّة (التي كان لجلال الطالبانيّ ومسعود البرزانيّ يدٌ قويّةٌ فيها). وقد سبق للجيش السوريّ أن شارك الجيشَ العراقيَّ معاركَه في الموصل ضدّ الكرد سنة 1963، في ظلّ الحكومة البعثيّة. وكلا الأمرين تمّ من وجهة نظر قوميّة ترى في الحراك الكرديّ نظيرًا للحركة الصهيونية، وذلك بعد تردّد أنباء عن مساعدة "إسرائيل" لهذه الحراك باستمرار.

سوريا هي الدولة الوحيدة التي عارضتْ إعلانَ وقف إطلاق النار بين الجيش العراقيّ والميليشيات الكُرديّة
من السبعينيّات إلى 2011
بعيْد حرب أكتوبر 1973 ضدّ "إسرائيل،" أَقنع شاهُ إيران (ومن ورائه كيسينجر) الحركةَ الكرديّةَ العراقيّة بدعمها في ثورةٍ تقوم بها في الشمال العراقيّ لنيل الاستقلال عن العراق. لكنْ، مع انطلاق المعارك، طلب نظامُ صدّام حسين من الشاه قطعَ دعمه للانتفاضة الكرديّة مقابل تنازلاتٍ عراقيّة في شطّ العرب. وافقتْ طهران، وأغلقتْ حدودَها مع كردستان العراق، فتعرّضتْ تلك الانتفاضة (المدعومةُ أميركيًّا وإيرانيًّا بالسلاح والعتاد) لهزيمةٍ ساحقة، هي الأكثر مأساويّةً في التاريخ الكرديّ، وانتهت حياةُ الملّا مصطفى برزانيّ، الرجل الأوّل في الحركة الوطنيّة الكُرديّة على مدى نصف قرن، بخسارةٍ أليمة.[18] ولن تكون تلك هي المرّة الأولى التي ستضحّي فيها القوى العظمى، وأميركا أوّلُها، بالأكراد على مذبح مصالحها ومصالح "إسرائيل."[19]
هكذا انتقلت المسألةُ الكرديّة، في عهدِ ما بعد الاستقلال، من مسألة وطنيّة إلى قطعة شطرنج في لعبة الصراعات السياسيّة الإقليميّة بين الدول الأربع، من دون تحقيق نتائج تفيد الأكرادَ لأكثر من ربع قرن تالٍ، لا في العراق (حيث واصل النظامُ ارتكابَ مجازر متكرّرة ضدّهم مستخدمًا السلاحَ الكيمياويّ في مدينة حلبجة)، ولا في إيران (التي استمرّت في قمعهم بلا هوادة)، ولا في سوريا نفسها.
على أنّ التدخّل السوريّ في المسألة الكرديّة في العراق لم يعنِ "الانفتاحَ" عليها داخل سوريا طوال سنوات حُكم الرئيس حافظ الأسد منذ العام 1970. صحيح أنّه كان هناك ما يشبه الاعترافَ بوجود الكُرد الفعليّ في مفاصل الحياة السوريّة، مع السماح لهم بالعمل والاستثمار والترقّي في قطاع الدولة، بل في القطاع العسكريّ أيضًا، لكنْ لم يُسمح لهم بأيّ حقوق قوميّة ــ ــ كالاحتفال بعيد النوروز القوميّ في 21/3 من كلّ عام، حيث تستنفر الأجهزةُ الأمنيّة، وتبدأ جولةَ اعتقالات بمجرّد المطالبة بأيّ حقّ من الحقوق القوميّة دون مستوى الانفصال، كاعتماد اللغة الكرديّة لغةً ثانيةً في البلاد والتدريس بها. وقد استمرّ الوضعُ الكرديّ تحت الرقابة والقمع ومنع الانتشار في الشمال، وذلك بإصدار قانونٍ يمنع بيعَ الأراضي أوشراءها هناك إلّا بموافقة (مستحيلة) من الأجهزة الأمنيّة ووزارة الدفاع، على اعتبار المنطقة تابعةً لإدارتها على طول الحدود مع تركيا. وبقيتْ مشكلةُ مَن لم يُجنَّسوا معلّقةً مع قانون الطوارئ، حتى مطلع العام 2011، حين حُلّت المشكلة بجرّة قلمٍ رئاسيّة، في خطوةٍ هدفتْ إلى تجنيب انضمام الكرد إلى الحَراك الشعبيّ.
سنة 1978 ظهر حزبُ العمّال الكردستانيّ حركةً سياسيّةً تتبنّى إقامةَ دولة كردستان الكبرى، على نهج الماركسيّة اللينينيّة، وذلك على يد عبد الله أوجالان، مستفيدًا من التجاذبات الإقليميّة السوريّة مع العراق وتركيا، ومن علاقاتٍ سبق لمام جلال (مؤسِّسِ البيشمركه) أن أقامها مع المقاومة الفلسطينيّة، وبخاصّةٍ جورج حبش، إذ أقام معسكراتٍ تدريبيّة بدعم من النظام السياسيّ السوريّ في البقاع اللبنانيّ وأخرى بالقرب من دمشق، مع إنكار سياسيّ سوريّ معلن لوجود أوجالان أو لقواته. وقد شارك بعضُ عناصر حزب العمّال، السوريين والعراقيين، في المقاومة الوطنيّة اللبنانيّة ضدّ القوات الإسرائيليّة عام 1982 ضمن ما دُعي وقتها "وحدة اليسار الثوريّ ضد الإمبرياليّة." فحركة أوجالان هي يسار اليسار الكرديّ، الذي أدار ملفَّه لعقودٍ جلال الطالبانيّ، الخصمُ اللدودُ للملّا البرزانيّ ولابنِه مسعود من بعده. وبقي الملفّ عالقًا بين سوريا وتركيا حتى العام 1998، حين طلب الأسد الأبُ خروجَ أوجالان من سوريا، متخلِّيًا عن ورقة حزب العمّال، بعد أن فقدتْ قيمتَها السوريّة كعنصر ضغطٍ على تركيا.[20]
استخدم نظامُ الأسد الأب المنظوماتِ الكرديّةَ المدينيّة (المستعربة) ضمن منظومات علاقته بالمدن والمكوّنات السوريّة الأخرى، خصوصًا في دمشق وحلب. فقد عمل كثيرًا على نفي تهمة الإقصائيّة عن نظامه. هكذا، مثلَا، كان الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي (الكُرديّ الذي نقل ملحمةَ ممو زين إلى العربيّة) عرّابَ علاقة النظام برجال الدين الدمشقيّين، وهو مَن صلّى صلاة الجنازة في قلب مدينة القرداحة عقب رحيل نجل الأسد الأكبر (باسل) سنة 1994. كما أنّ الشيخ أحمد كفتارو (كرديّ أيضًا) عمل مفتيًا للجمهوريّة طوال عقود. وهناك أسماء كرديّة أخرى لامعة في الشأن العامّ السوريّ، ومنها ما انضمّ إلى تيّار اليسار، وعمل في غالبيّته تحت مظلّة الحزب الشيوعيّ السوريّ (خالد بكداش)، وعبره وصل إلى قبّة مجلس الشعب.
في مناطق الشمال السوريّ لم يتغيّر شيء في أحوال الكرد، وهذا شأن بقيّة السوريين. فقد استمرّت القبضةُ الأمنيّة قويّةً، وخفتت المطالبُ (الوطنيّة أو الانفصاليّة). وفي العام 2004 وقع صدامٌ في القامشلي بين مشجّعي فريقيْن لكرة القدم: نادي الجهاد (الحسكة) الذي يُعتبر كُرديًّا، ونادي الفُتوّة (من دير الزور). فلجأ النظامُ إلى الحلّ الأمنيّ لمعالجة الخلل "القوميّ،" فسقط بين مشجّعي الفريقين ستة قتلى[21] (تعلن المصادرُ الكرديّة عن 60 وأكثر)، كما اعتُقل عشراتُ الأشخاص من عرب وكُرد ممّن تسبّبوا في إثارة القلاقل.[22]
المسألة الوطنيّة بعد العام 2011
مع انطلاق الحَراك السوريّ في آذار 2011، انقسم الكُرد حياله ــــ كبقيّة السوريين ــــ حقبة قصيرة، قبل أن ينضمّ قسمٌ منهم إليه. ولئن شهدتْ غالبيّةُ المناطق الكُرديّة تظاهراتٍ واحتجاجات، فإنّها لم تكن في كثافة المناطق الأخرى.
لم تكن البداية من الشمال، بل من حيّ الأكراد (ركن الدين) وزورآفا (وادي المشاريع /دمّر) في دمشق، حيث خرجتْ مظاهراتٌ تطالب بالحريّات، بشكلٍ يشابه مطالبَ بقيّة السوريين، من دون وجود أيّ مطالب قوميّة خاصّة.
في أيّار 2011 أصدرتْ معظمُ الأحزاب الكرديّة في القامشلي بيانًا وضعتْ فيه تصوّرَها الخاصّ لحلّ سياسيٍّ لـ"الأزمة." فدعت إلى بدء حوارٍ بين النظام والمعارضة، وإلى وضع مبادئ لإصلاحات ديمقراطيّة، منها مجلسُ تأسيسيّ سوريّ، من دون أن تنسى المطالبَ المشروعة للكرد "في إطار وحدة البلاد." وقد كان هذا البيان أوّلَ البيانات التي تقترح حلولًا من منظور "وطنيّ" لِما يجري في البلاد.
في تشرين الأول 2011 أُعلن عن تأسيس "المجلس الوطنيّ الكرديّ في سوريا" برعاية مسعود البرزانيّ، رئيسِ حكومة إقليم كردستان، فحظي بدعم أكثر من 13 حزبًا كرديًّا. وقد تقدّم، في مؤتمره التأسيسيّ، بجملةٍ من المطالبات، أبرزُها: الاعتراف بالمكوّن الكرديّ مكوِّنًا رئيسًا في البلاد، و"إيجادُ حلّ عادلٍ لقضيّته القوميّة بما يضمن حقَّه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد."
الإشارات المُبكّرة التي قدّمها المجلسُ الوطنيُّ الكرديّ، والحَراكُ الكُرديّ المرتبط به، كانت ذات حمولة قوميّة كرديّة لم ترُقْ كثيرًا المكوّنَ العربيَّ المشاركَ والفاعلَ في التظاهرات. ثمّ اتّضح الأمر بُعيْد نيسان 2012، حين أصدرت الرئاسةُ السوريّة القانون رقم 49، القاضي بتجنيس مَن لم يجنَّس من الكُرد في إحصاء العام 1962، وقد بلغ العدد (وفقًا لوكالة الأنباء السوريّة الرسميّة) 103 آلاف شخص، ولم يَرفض أيٌّ منهم الجنسيّةَ السوريّةَ رسميًّا ــ ــ ما أشّر إلى انقسام كُرديّ مُبكّر.
في العام نفسه، ظهر "المجلسُ الوطنيّ السوريّ" المعارض (المدعوم تركيًّا وقطريًّا). ومع ذلك، بقي الحذرُ الكُرديُّ قائمًا، إذ لم تنضمّ إلى هذا المجلس إلّا "الحركة الثوريّة الكرديّة." لكنّه حظي باعتراف إقليم كردستان العراق. كما انتُخب في حزيران 2012 الكاتبُ والناشط الكرديّ، عبد الباسط سيدا، رئيسًا للمجلس.
وسرعان ما ظهرت الخلافات ضمن المجلس، تعلّقتْ بالموقف من الكُرد بعد إسقاط النظام: هل يكون حكمًا ذاتيًّا أمْ سيتسمر الوضع على حاله مع مزيدٍ من الحقوق القوميّة والوطنيّة للكرد؟ هذا الشقاق ترك أثرَه في المجلس، كما في الجمهور الكُرديّ في مناطق الشمال.
في أيلول 2012 انضمّ "المجلس الوطنيّ الكرديّ" إلى "الائتلاف الوطنيّ لقوى المعارضة السوريّة،" وذلك بعد موافقة الأخير على توقيع مسوَّدة تضمّنتْ بنودَ اتفاقٍ تُقدِّم تصوّرًا لمستقبل علاقة "الحكم الجديد" بالأكراد. وكان هدف "الائتلاف،" من وراء ذلك، كسبَ كتلة كرديّة تؤكّد تمثيلَه جميعَ الأطياف.
الصراع بين الاتحاد الديمقراطيّ والمجلس الوطنيّ
بقي الاتّفاق السابق حبرًا على ورق؛ ذلك لأنّ القوّة على الأرض كانت لـ"حزب الاتحاد الديمقراطيّ،" مظلّة حزب العمّال الكردستانيّ. فقد فرض "الاتحاد" سلطانَه على مناطق في شمال البلاد، وفي تمّوز 2012 هيمن على جميع مؤسّسات مدينة عين العرب/كوباني بقوّة السلاح من دون معارك، وعلى بعض مؤسّسات عفرين والقامشليّ. وبعد عام تقريبًا أكمل "الاتحاد" السيطرةَ على كلّ المؤسّسات المدنيّة، من دون أيّ معارك مع القوّات الأمنيّة السوريّة، ومنها محطّاتُ الوقود والأفران وجميع البنى الخدميّة.
في تشرين الثاني أعلن "الاتحاد" عن تأسيس "الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة،" مقسِّمًا المناطقَ الكرديّة إلى ثلاث مقاطعات، هي القامشلي وعفرين وعين العرب، لكلٍّ منها مجلسُه التشريعيّ والتنفيذيّ الخاصّ به، تحت اسم "روجافا" (كردستان الغرب)، في ما يُعدّ خطوةً في اتّجاه فرض الحكم الذاتيّ. لم تلقَ هذه الخطوةُ اعترافًا من دمشق، وتزامنتْ مع مؤتمر جنيف الثاني ــ ــ ما عنى توجيهَ رسائل قويّة إلى المجتمع الدوليّ عن الموقع الذي بلغه "الاتحادُ" في سوريا ومدى تأثيره على مجريات الوضع.
الصراع بين أقوى تيّاريْن كردييْن كان على طُرق الإدارة، لا على الإدارة نفسها. ففي مناطق سيطرة المجلس الوطني الكرديّ، بقيت الإدارة كرديّةً فعلًا، لكنْ لم تُدعَ مكوّناتُ المعارضة السوريّة الأخرى إلى المشاركة في المؤسّسات أو الإدارات التي خرجتْ عن سيطرة الحكومة. ولم يَطرح أيّ من الكُرد فكرةَ تشكيل إدارة مشتركة تضمّ فرقاءَ المعارضة الآخرين. لقد شقّ كلّ فريق من الأكراد طريقَه وحده ــ ــ وهو ما سيصبّ عليه لاحقًا غضبًا عارمًا، سواء في صفوف المعارضة الأخرى، أو في صفوف النظام نفسه.
كان العنوان العريض لسياسات "المجلس الوطنيّ" هو "النضالَ لتثبيت حقوق الكرد في سوريا." إلا أنّ ممارساته الفعليّة ــــ كما ممارسات "الاتحاد الديمقراطيّ" ــــ تتجاوز بكثير هذه الحقوق إلى ما يعتبره عمومُ السوريين خطيرًا.[23]
تطوّرات المسألة الوطنيّة اليوم
إعلان الإدارة الذاتيّة بشكلها الكرديّ الحزبيّ كان سببًا من أسباب تدخّل تركيا في المشهد السوريّ. فبعد أن فتحتْ تركيا حدودَها للمسلّحين المتدفّقين (مع استضافة أكثر من 3 ملايين لاجئ استفادت منهم بمليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبيّ)، وجدتْ أنّ أمنَها القوميّ في خطر، فقرّر البرلمانُ التركيّ إجازةَ دخول الجيش التركيّ إلى الشمال السوريّ؛ فالملفّ الأكثر حساسيّة لأيّ حكومة تركيّة حتى الآن هو الملفّ الكرديّ.
دخلتْ أنقرة إلى عفرين لضرب التواصل بين الكانتونات الكرديّة الثلاثة كما زعمتْ. كان دخولها ناجمًا عن التخوّف التركيّ القديم من خلق كيانات كرديّة في الدول الثلاث التي تحتضن الأكراد (حتى اليوم تُرابط قواعدُ عسكريّة تركيّة في عدّة مناطق تحيط بمنطقة الحكم الذاتيّ العراقيّة). ويزداد التخوّفُ في الحالة السوريّة، نظرًا إلى العمق الاستراتيجيّ الكبير الذي يشكّله كردُها في جنوب البلاد وشرقها.
إعلانُ الكانتونات الثلاثة ضمن الإدارة الذاتيّة أنتج عواقبَ استراتيجيّةً على المسألة الوطنيّة، كما على المسألة القوميّة لدى الكرد وبقيّةِ المكوِّنات السوريّة. فالتخلّص من "داعش" أضاف إلى الرصيد الكرديّ نقاطًا مفيدةً في صياغة "عقد وطنيّ" بالتعاون مع باقي المكوّنات السوريّة (المعارضة والنظام). إلّا أنّ قِصر النظر القوميّ الكرديّ أدّى إلى كوارث ستطاول في لاحق الأيّام كاملَ المنطوق الحاكم لإدارة المنطقة.
في الجانب المعارض، لم تبقَ أمام "حزب الاتحاد الديمقراطيّ" أيُّ بوّابةٍ للاتصال بالمعارضة السوريّة، المسلّحة وغير المسلّحة. فعمليّات التهجير والمذابح المرتكبة ضدّ المكوّن العربيّ أفضت إلى القطيعة الحدّيّة، حتى وصل الأمر إلى تعاون قوى المعارضة المسلّحة غير الكرديّة مع الأتراك لطرد الكرد من مناطق عفرين ومنبج. وفي حال تنفيذ عمليّة شرق الفرات [التي أعلن أردوغان عزمَه تنفيذَها لضرب مقرّات حزب الاتحاد الديمقراطيّ] سيكون هؤلاء رأس الحربة الموجّهة ضد الإدارة الذاتيّة.
أما في جانب العلاقة بالحكومة السوريّة ونظامها السياسيّ، فإنّ تطوّرات عفرين تحديدًا كانت أكثرَ من كافية لفهم طريقة تفكير الإدارة الذاتيّة كلها مع منطوق الوطن السوريّ. ففي حين تغاضى النظامُ عن ممارسات "الاتحاد الديمقراطيّ" في بناء الإدارة الذاتيّة على الأرض (وهو أصلًا غير قادر على التدخّل إلّا في نطاق ضيّق جدًّا)، فإنّه لم يقطع حبلَ الودّ مع المنطقة؛ فبقيت الرواتبُ الحكوميّة تصل في مواعيدها كلَّ شهر، وبقيتْ خدماتٌ كبرى (مثل الكهرباء والماء) مرتبطةً بالدولة السوريّة. إلّا أنّ العلاقة، في جانبها الأعمق، ظلّت ضمن خانة رفض النظام لِما يجري هناك رفضًا مطلقًا.
عند بدء "عمليّة غصن الزيتون،"[24] ظهرتْ مطالباتٌ محلّيّة ودوليّة (روسيّة وإيرانيّة) بتسليم إدارة المنطقة إلى الحكومة السوريّة (بعد إبعاد رموز حزب الاتحاد الديمقراطيّ ورفعِ العلم السوريّ). ولكنّ الإدارة الذاتيّة رفضتْ ذلك، داعيةً إلى مقاومة شعبيّة وأهليّة للاحتلال التركيّ. فقد أعلنتْ قوًى مدعومةٌ من الإدارة الذاتيّة في عفرين عن تشكيل "المقاومة الوطنيّة السوريّة،" وذلك في مؤتمر صحفيّ عُقد في مدينة تل رفعت. وقد صرّح أعضاءُ هذا المؤتمر إنّ هدفه قيادة "مقاومة وطنيّة" ضدّ تركيا. كما ورد تصريحٌ من الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستانيّ (PKK)، جميل بايِك، أنّ الكُرد في سوريّة سيدافعون عن الفدراليّة التي أعلنوها ضدّ تركيا.[25]
رفضُ تسليم عفرين إلى إدارةٍ حكوميّةٍ سوريّة قد لا يكون، وفق المنظور التركيّ، كافيًا لإبعاد شبح الإدارة الذاتيّة، إذ ليس هناك اعترافٌ رسميّ بالإدارة حتى من قِبل أقرب الداعمين لها (أي الأميركيين والبريطانيين). وباستثناء ممثّليّة موسكو، فإنّ بقيّة الممثليّات، التي تُشِيع الإدارةُ الذاتيّة أنّها قد افتتحتها، لا تزال تحت غطاء غير سياسيّ.[26]
خسارةُ عفرين جعلتْ تركيا وروسيا تلعبان على وترٍ مضاف، مشتقٍّ من تهجير جزءٍ من السوريين. فبُعيْد تحرير الغوطة من جماعات المعارضة المسلّحة، بادرت السلطاتُ التركيّة إلى توطين جزءٍ من السوريين في عفرين، في بيوت كُردٍ هُجّروا، قالت تركيا إنّها لعناصر "إرهابيّة" من حزب العمّال أو "قوّات سوريا الديمقراطيّة" (ق.س.د). وهذا الأمر ترك أثرًا سلبيًّا لدى الطرفين، وأعاد خندقةَ العلاقات العنصريّة بين الطرفين من بوّابة إنكار إمكانيّة التصالح في قادم الوقت بين المكوّنات العربيّة والكرديّة. والحقّ أنّ أهل الغوطة ضحايا مثلهم مثل الكُرد، ولم يصلوا إلى منفاهم الشماليّ برغبتهم (المُعلنة على الأقلّ)، بل ثمّة اتفاق دوليّ يسيِّر ما يجري بين روسيا وتركيا وإيران... ودمشق نفسها.
قرارُ الانسحاب الأميركيّ الأخير من البلاد شكّل صدمةً كبيرةً للإدارة الذاتيّة ولـ ق.س.د. ومجلسها. فقد أعاد الإدارةَ إلى رشدها المفترض بعد فقدان أحد سدنة دعمها، فدعت الحكومةَ السوريّة إلى تسلّم منبج بعد تواتر أنباءٍ عن قرب دخول الجيش التركيّ إليها. وهذا ما حصل ضمن اتفاق روسيّ ــــ تركيّ.
اليوم، في ظلّ الحديث عن منطقة أمنيّة تركيّة شرق الفرات (فعليًّا تحتلّ تركيا قرابة 25 ألف كم مربّع من المناطق السوريّة) بموافقةٍ أميركيّة،[27] فإنّه يجب على الإدارة الذاتيّة والمجلس الوطنيّ الكرديّ وجميع الهيئات ذات الصلة التفكيرُ فعلًا في درء الأخطار عن المنطقة وعدم تقديم حجج مضافة إلى النظام التركيّ لاختراق المنطقة وتدميرِها، كما حصل في عفرين وغيرها. إنّ الحلّ الأقرب إلى المنطق، في ظلّ تبعيّة المعارضة الباقية لتركيا، هو تسليم المنطقة إلى الجيش السوريّ والحكومة السوريّة.
دمشق
[1] الجنرال حسن خيري من "درسيم،" التي ستمحوها القوّاتُ التركيّة في الثلاثينيّات، كان قائدًا للجيش الكرديّ الذي شكّله صديقُه المقرّب أتاتورك عام 1919. وردَت الواقعة في عدّة مصادر، منها: https://xelilkalo.wordpress.com/2010/11/08
[2] أبو عبيد البكري، المسالك والممالك، الجزء الأول، تحقيق: ادريان فان ليوفن واندري فيري (الدار العربيّة للكتاب والمؤسسة الوطنية، طبعة 1992)، ص 574.
[3] محمد هوّاش، تكوّن جمهورية، سورية والانتداب (طرابلس: مكتبة السائح، الطبعة الأولى، 2005)، ص 65.
[4] كمال ديب، تاريخ سوريا المعاصر من الانتداب الفرنسيّ إلى 2011 (بيروت: دار النهار)، ص 123.
[5] فيليب مانسيل، ثلاث مدن مشرقية، سواحل البحر الأبيض المتوسّط بين التألّق والهاوية، ترجمة مصطفى قاسم (الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العددان 354 و355)، ص 31 ــــ 257.
[6] حميد بوزرسلان، تاريخ تركيا المعاصر، ترجمة: حسين عمر (أبو ظبي: منشورات كلمة، وبيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافيّ العربيّ ، ط 1، 2009)، ص32، 42 حتى نهاية الفصل.
[7] محمد جمال باروت، ضمن مجموعة مؤلّفين، العرب وتركيا، تحدّيات الحاضر ورهانات المستقبل، (بيروت: المركز العربي لدراسة السياسات، ط 1، 2012)، ص 135
[8] المصدر السابق، ص 144.
[9] محمد هوّاش، ص 95.
[10]العرب وتركيا، ص 149.
[11] محمد جمال باروت، التكوّن التاريخيّ للجزيرة السورية (بيروت: المركز العربيّ للأبحاث ودراسات السياسات، ط 1، 2013)، ص 417.
[12]العرب وتركيا، ص 160.
[13]المصدر نفسه، ص 165
[14]للاطلاع على التفاصيل الوافية: العرب وتركيا، ص 158 وما بعدها.
[15]على الرابط http://bit.ly/2hSCgvu
[16]مزيد من التفاصيل الموثّقة في المرجع السابق نفسه، ص 173، وفي كتاب باروت التكوّن التاريخيّ للجزيرة السورية، وهو من أدق المراجع التاريخيّة في تناول تلك المرحلة.
[17] العرب وتركيا، ص 167.
[18]جنكيز تشاندار، قطار الرافدين السريع، ترجمة عبد القادر عبد اللي (بيروت: الدار العربيّة للعلوم ناشرون، ط 1، 2014)، ص 51 وما بعدها.
[19] كمال ديب، ص 467.
[20] جنكيز تشاندار، ص 61 وما بعدها.
[22]المصدر السابق.
[23] فالمجلس، مثلًا، لم يطالب بالفيدراليّة في اجتماعاته التأسيسيّة الأولى، "إلّا أنه انتقل في الاجتماع الثالث منها إلى المطالبة بها، فأصبحت الفدراليّة أولَ فتيل الخلافات مع المعارضة السوريّة،" ومع حزب الاتحاد الديمقراطيّ، الذي حوّل الطرحَ النظريّ إلى واقع، مستفيدًا من قوته العسكريّة وحضوره الكاسح على الأرض. https://www.enabbaladi.net/archives/173154#ixzz5ccuejtrz
[24] هي عمليّة عسكريّة شنّتها تركيا وفصائلُ "الجيش السوريّ الحرّ" على مواقع قوّات سوريا الديمقراطيّة المحيطة بمدينة عفرين السوريّة في 19/1/2018
كاتب سوري، وباحث في معهد الدراسات المستقبليّة.