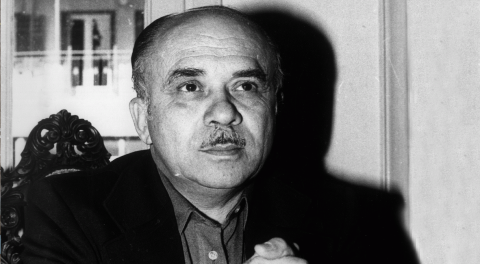"أستطيعُ الاختفاءَ متى أشاء": هذا ما كانت تتباهى به مينا. وكنّا نتعجّب منها قائلين: "لم نركِ تختفين مرّةً يا مينا!" فتجيب: "وكيف ستروْنني وأنا مختفية يا أغبياء؟" تلك كانت حجّتَها التي ترمينا بها، ثمّ تغيب ليومٍ أو بعض يوم، لتظهرَ فجأةً وتخبرَنا ماذا فعل كلٌّ منّا أثناء غيابها. كنتُ في الصفّ السابع، وكانت في مرحلة المراهقة، ولا تذهب إلى المدرسة. وكنّا نحسدها، أنا ورفاقي.
حدّثتنا والدتي كيف استيقظتْ صبيحة يوم خريفيّ على صوت خربشةٍ آتيةٍ من شرفة المطبخ. في البدء، ظنّت أنّ قطّةً تعبثُ بشيءٍ ما. وعندما نظرتْ من النافذة وجدتْها هناك، في يدها قطعةُ خبز ممّا نتركه عادةً للعصافير واليمام، فأشفقتْ عليها وأدخلتْها البيت. وبعد أن قدّمتْ إليها كوبًا من الشاي و"قضّوضةً"(1) من اللبنة والزعتر، قادتها إلى الحمّام لتغتسل، ثمّ أعطتها ثيابًا من ثياب أختي التي كانت في مثل عمرها وحجمها. أذكرُ جيّدًا ذلك اليوم عندما استيقظنا ــــ أنا وأختي ــــ ووجدناها في الصالون تثرثر مع أمّنا. ألقينا تحيّة الصباح وعلى وجهينا يرتسم السؤال: "مَن هذه؟". وبعد كلمات الترحيب والتعريف بنفسيْنا، وَجدتْ نفسَها مُطالبةً بالمثل.
ــــ عندي عدّة أسماء، قالت باسمةً.
ــــ هلّا تذكريها لنا؟ قالت أختي.
ــــ يافا، ومريم، وأسيل، ونوّاره. اختاروا واحدًا ونادوني به.
كان أمرًا غريبًا ومضحكًا أن يحمل المرءُ أربعة أسماء! ومن قبيل الدعابة قرّرتْ أمّي منحَها اسمًا خامسًا؛ وهكذا شكّلنا من الأحرف الأولى لأسمائها اسمًا جديدًا فأصبحتْ: مينا. وصارت لنا رفيقةٌ لا نعرف عنها سوى الاسم الذي ابتكرناهُ لها وأعجبها.
كانت مينا لافتة للأنظار. فعيناها الخضراوان، وشعرُها الكستنائيّ المائل إلى الشقرة، وقوامُها المتناسق، وصدرُها النافر، وابتسامتُها الساحرة؛ كلُّ ما فيها كان "فتنةً للناظرين." وكانت تتعرّض للكثير من المضايقات من بعض شبّان الحيّ، فتهرب لتقضي النهار معنا، نحن رفاقها الصغار. أمّا ليلًا فتختفي، ولا أحد يعلم أين.
***
بقيتْ على هذه الحال مذ عرفناها، لشهرٍ أو أكثر. إلى أن قرّرتْ والدتي الاهتمامَ بها بشكل جدّيّ بعد أن شجّعناها على ذلك، فخصّصتْ لها الغرفةَ الصغيرة على سطح بيتنا. وبهمّةِ والدي الذي أعاد طلاءها، وبحماسنا في المشاركة في تنظيفها وترتيبِ ما توفّر من أثاث بسيط، غَدَت عشًّا صغيرًا يليق بمينا التي بَكت من فرطِ سعادتها، وأبكتنا معها. بعد ليلة واحدة من حصولها على عشّها هذا، اعترفتْ لي بأنّها كانت تنام في الفرن القريب: تتسلّل ليلًا من نافذته المخلوعة، وتزحف داخل بيت النار الدافئ، وتبقى هناك إلى بزوغ الفجر، ثمّ تتسلّل إلى الخارج قبل مجيء العمّال، وتهيم على وجهها باقي ساعات النهار. وبدوري اعترفتُ لها بسرقتي مرآةً صغيرةً ذاتَ غطاء أحمر من دكّان جارنا. ولمّا رأيتُ الدهشةَ ترتسم على وجهها، وظننتُها من علامات الإعجاب، أخرجتُ المرآة من جيبي وقدّمتُها إليها، فأخذتْها بعد أن قالت بحزم: "لا تفعلْ ذلك ثانيةً." ولم أفهم ما ينبغي ألّا أفعله: السرقة، أمْ تقديم الهدايا لها؟!
مضت الأيّامُ وتعلّقتُ بمينا. وصرتُ أقضي الكثير من الوقت عندها: نتسلّى، ونضحك، وتُسمعني حكاياتها الغريبة كالمعتاد. في إحدى زياراتي سألتُها أنْ تبرهن لي قدرتَها على الاختفاء، فوافقتْ، وطلبتْ منّي إغماض عينيّ، والعدَّ من واحد إلى عشرة، ففعلتُ. وعندما فتحتُ عينيّ وجدتُها تقفُ وسط الغرفة ساكنةً كتمثال. قلتُ:
ــــ ماذا تفعلين؟
ــــ ...
ــــ أنا أراكِ!
ــــ ...
ــــ لكنني أراكِ!
ــــ ...
فجأةً، تحرّكتْ نحو السرير لتجلسَ عليه، وعلى شفتيها ابتسامةُ الواثق من نفسه. وأصرّت على أنّها اختفت، وأنّ ما رأيتُه كان مجرّدَ أوهام!
***
تطوّرتْ علاقتُنا بمينا وصارت جزءًا من العائلة. فها هي تساعد أمّي في أعمال البيت، وتنوب عنها في الذهاب إلى السوق وشراءِ ما نحتاج إليه، وباتت تجلس معنا إلى المائدة كفرد من أفراد الأسرة؛ حتّى إنّ أبي صار يدلّلها ويشتري لها الهدايا مثلنا. وحين يشتدّ البرد، كانت أمّي تستبقيها للنوم في الصالون قرب المدفأة، فتسلّينا بقصصها الغريبة أو المُخيفة: كحكاية الرجل الذي يتحوّل ليلًا إلى حشرة صغيرة، ثمّ يزحف إلى منازل الجيران، فيتلصّص على النساء في الأسرّة والحمّامات، وفي الصباح يعود إلى هيئته الأولى رجلًا دنيئًا يبتزهنّ بما لديه من معلوماتٍ خاصّةٍ عنهنّ، ومَنْ لا تستجبْ له يزُرها في الليلة التالية ويدخل إلى بطنها عن طريق فمها أو "من تحت" ــــ هكذا كانت تُعبّر ــــ ويبقى يُعذّبها إلى أن تلفظَ أنفاسَها. كنّا نعلمُ أنّ تلك مجرّدُ خرافة، ورغم ذلك كانت أختي تتكوّر على نفسها وترتجفُ مِن الرعب كلّما سمعتْ مثلَ هذه الحكايات. أمّا أنا فكنتُ أتماسك كي أحظى بإعجابها، فتنظر إليّ بخبثٍ قائلةً: "أنا أيضًا أستطيع الدخول إلى جسدكَ،" فأضحكُ وأتحدّاها أن تفعل.
***
لم أفهم أوّلَ الأمر سببَ رغبتي في الوجود مع مينا. ولم أفهم نظراتِها الفاحصة لي حين نكون وحدنا في غرفتها. ولم أتجرّأ على تفسير سبب تنفسّها السريع، ولهاثها في بعض الأحيان، حين ضَمّها لي وتقبيلي على وجنَتيّ وعنقي. ولكنْ، للحقّ، كان ذلك يُشعرني بلذّةٍ غريبة، ويقرّبني إليها. في تلك المرحلة كنتُ قد بدأتُ بالاطّلاع على عالَم الجنس من خلال الكاتالوكات.(2) لم يكنِ التلفازُ قد دخل حياتَنا بعد، لذا كانت الكاتالوكات نافذتَنا السحريّة. وكانَ معتزّ ــــ ابنُ الجيران الذي يكبرنا بعدّة سنواتٍ ــــ يَستغلّنا ويُؤجّرنا الكاتالوكَ بليرة ونصف الليرة في النهار، مشترطًا إعادتَه نظيفًا. لم يحصل حتّى ذلك الوقت أن استأجرتُ أحدَ هذه الأشياء؛ فقد كانت تربيتي المنزليّة تمنعني من ذلك. لكنّ الفضولَ القاتلَ جعلني أكسر تلك الحواجز مرّتين، وألبّي دعوةَ رفيقٍ لي ــــ وهو زبونٌ مُدمنٌ عند معتزّ ــــ وأشاركُه الفُرجةَ مجّانًا. سوى ذلك، كنتُ أكتفي بالاستماع إلى الآخرين، وأتخيّلُ ما يتكلّمون عنه، مُستعينًا بالمخزون البسيط في ذاكرتي لأُشاركَهم الحديثَ كي لا أبدوَ مُغفّلًا. هكذا استمرَّ الأمرُ بريئًا بيني وبين مينا ــــ من جانبي على الأقلّ ــــ لفصليْن دراسيّيْن.
إلى أن جاء اليومُ الذي سألتني فيه إنْ كنتُ أرغبُ في أن أصبحَ ابنها. وعندما وافقتُ، قامت وأسدلتْ ستارةَ غرفتها، ثمّ أقفلتْ بابَها واستلقتْ على السرير. جلستُ قربها وضممتُها، فأخذتْ تُقبّلني على شفتيّ قبلاتٍ رقيقةً ناعمةً اقشعرَّ لها جسدي كلُّه. ثمّ سألتني، وهي تتنفّس بصعوبة، إنْ كنتُ أُريدُ أن أرضعَ ثديَها. وقبلَ أن أجيبها، رفعتْ قميصَها إلى أعلى، وبانَ صدرُها. كنتُ مذهولًا لا أعرفُ ماذا عليَّ أن أفعل؛ فهذا ليس جزءًا من اللعبة! وحين ألْقمتْني حلمتَها شعرتُ أنّ نارًا بدأتْ تأكلني، وأنّ شيئيَ الصغير بدأ يُؤلمني قبلَ أن تَمدَّ يدها الطريّةَ إليه، فأرتجف، ثمّ ألتصقُ بجسدها أكثر. لم تنفعني صورُ الكاتالوكات في شيء؛ فممارسة الأمر مختلفةٌ عمّا رأيناه. وخلالَ ثوانٍ، وجدتُ نفسي أبكي بطريقةٍ مضحكة. كنتُ خائفًا، ومُربَكًا، وضائعًا بين رغبتين: الهروب، أو الاستسلام. لكنّ أصابعَها الطريّة حسمتِ المسألة، وامتثلتُ لرغبتها حين همستْ في أذني: "اخلعْ ثيابكَ،" وسبقتني إلى ذلك. خلال لحظاتٍ كانت تهصرني بين ذراعيها. وبدأتُ أُنقّل شفتيّ بين حلمتيها، وأَخورُ كعجلٍ صغيرٍ، وأركلُ برجليّ في كلّ الاتّجاهات، إلى أن صرختْ بي كي أهدأ. هدأتُ، وأنا ألهثُ، وشيئي بين يديها يكادُ يتفتّقُ ويخرجُ منه الدم. عجبتُ من حجمه الجديد. وانشغلتُ عنها بمراقبته قبل أن تشدّني إلى صدرها، وتوجّهَني بصوتها المحموم إلى ما تريده، فأقوم بما تريد، وأكرّر ما أفعل. إلى أن أحسستُ بشيءٍ من الدوخةِ وجفافِ الحلق، وأخذ جسدي يتشنّجُ، وشعرتُ أنّ كائنًا بريًّا بدأ يعوي داخلي، ويكاد يخرجُ من مساماتي. عندها، عَرفتْ أنّ رحلتي وصلتْ إلى نهايتها، فأبعدتني عنها في الثانية التي اجتاحتني رعشةٌ عظيمة، ورأيتُ سائلي يطفرُ فوق جسدها وفي كلّ مكان. شعرتُ بالذعر واللذّة معًا. وكنتُ شبهَ غائبٍ عن الوعي، أتحايلُ على زوغانِ النظر، مُحدّقًا في عينيها مباشرةً، لا أقوى على أيّ فعل.
بعد أن مسحتْ كلّ شيءٍ بكمّيّةٍ كبيرةٍ من المحارم الورقيّة، نظرتْ إليَّ بعطف، ولم تلُمني كما كنتُ أتخوّف. ولا بدَّ أنّ منظري كان يثير الشفقة، فضمّتْني ثانيةً إلى صدرها، لأغرق في بحرٍ من الدفء والهدوء والأمان. وأظنّني بدوتُ ابنها بحقّ في تلك اللحظات.
لا أعلم كم مضى من الوقت وأنا مستغرقٌ في النوم، قبل أن أستيقظَ وأجدَ نفسي وحيدًا، فأسارع إلى ارتداء ملابسي، وأخرج من الغرفة، وأنزل درجاتِ السلّم بخفّةِ قطّ، لأجدَها مع أمّي في المطبخ تساعدها في إعداد طعام الغداء. عندما التقت نظراتُنا وابتسمتْ لي من خلف ظهر أمّي ــــ تلك الابتسامة ذاتَ المغزى ــــ شعرتُ أنّني أراها لأوّل مرّة. لا أستطيعُ وصفَ مشاعري بدقّةٍ حينها: فقد كانت خليطًا من الخوف والإعجاب والزهو والنفور والإحساس بالذنْب.
***
سارعتُ في الخروج من البيت مثقلًا بكلِّ ما سلف، وتوجّهتُ إلى دكّان جارنا "الكنغر،" الذي حظي بهذا اللقب بسبب حركاته الغريبة. طلبتُ منه علبة تبغ وعلبة ثقاب؛ وكانت تلك هي المرّة الأولى التي يخطر لي فيها أن أدخّن.
سألني: "ما نوعها؟"
قلت: "لا يهم."
ناولني علبةَ ثقاب، وعلبةَ دخان "ناعورة،" قائلًا مع تكشيرة: "هذه لا يهمّ." ابتسمتُ للنكتة وأنا أدفع النقود. ثمّ توجّهتُ إلى بيت معتزّ. استأجرتُ كاتالوكًا. خبّأتُه تحت ثيابي، لصيقًا لبطني، وتابعتُ السير إلى بيت رفيقي المدمن. عندما أخبرتُه بما أحمله لم يصدّق، واستغرقَ في الضحك، ثمّ تبعني إلى السطح. وهناك أجهزنا على "باكيت" الناعورة خلال ثلاث ساعات، ومارسنا العادةَ السرّيّة جنبًا إلى جنب، لأكثر من مرّة، ولم نُلطّخ الكاتالوك كما وعدتُ معتزّ. لم أشرح لرفيقي سببَ هذا التغيّر المفاجئ، رغم إلحاحه بالأسئلة؛ فقد توقّعتُ بفطرتي أنّ البوحَ سيُفقدني مينا. كنتُ منتشيًا بسرّي هذا، وبتُّ أنظرُ إلى رفيقي نظرةَ استعلاءٍ، مُعتبرًا نفسي من أصحاب الخبرة؛ حتّى إنّني أسديتُ لهُ بعض النصائح حول كيفيّة التعامل مع البنات!
مع غياب الشمس، أعدتُ الكاتالوك إلى معتزّ، الذي تفحّصهُ جيدًا، ثمّ مدّ يده إليّ بربع ليرة قائلًا: "هذا لأنّك أعدته نظيفًا." وأضاف مع إشارة OK من إبهامه: "زبون جيّد."
***
بقيتُ أتحاشى مينا عدّةَ أيّام. لم أعرف كيف سأتواصل معها من جديد. أحسستُها فتاةً غيرَ التي عرفتُها. ثمّ حاولتُ تجاوز مشاعري المختلطة، منقادًا إلى شهوتي الحارقة واشتياقي الجارف، فصرتُ أسترقُ النظرَ إليها حين تكون عندنا. وحصل أن ضَبَطتْني مرّةً، فجمدتُ مكاني. لاحظتُ في عينيها حيادًا قاتلًا كأنّها نسيتني، أو كأنّ شيئًا لم يحصل بيننا. مرّ وقتٌ طويلٌ، قبل أن أفهم أنّ المرأة ليست وحيدةَ الجانب أو ثنائيّته كالرّجل؛ فهي، إنْ أرادت، قادرة على إخفاء مشاعرها والادّعاء بعكس ما تشعر به. "المرأة موشوريّة التكوين،" هذا ما سمعتُ أحدَ أساتذتي يقوله، بعد سنوات، في معرض حديثه عن التكوين النفسيّ للمرأة. وكان يقصد الجانبَ الجماليّ عندها، من حيث تفكيك الضوء إلى ألوان قوس قزح، مشيرًا إلى قدرتها على الخلق وتجميلِ الحياة. يلحّ عليّ اليومَ هذا التشبيهُ وأنا أتذكّر مينا، التي انتقمتْ منّي لابتعادي عنها في ذلك الوقت كأنّها مرضٌ مُعدٍ. ومضى شهر قبل أن تصفح عنّي، طرقتُ بابها خلاله مرّات عدّة، وكنتُ أعودُ مُحْبَطًا إلى معتزّ، الذي عرف بخبرته أنّني علقتُ بصنّارته، فلم يعُد محتاجًا إلى التعامل معي بخصوصيّة.
***
لا أحدَ يعرفُ أيّ شيءٍ عن مينا غير الذي أخبرَتنا إيّاه بنفسها: "لا عائلةَ لي. لا أقارب. لا إخوة. لا أخوات. وعيتُ على الدنيا في بيتِ رجلٍ عجوزٍ أناديه جدّو، ولا أعلمُ إنْ كان جدّو بحقّ. كان بيته فقيرًا بشكلٍ لا يُطاق. وقبل وفاته بأيّام، أصيب بالشلل، وبقي جالسًا على كرسيّه الخيزران المهترئ، حتّى فارق الحياة." أعادت مينا على مسامعنا هذه السيرة عدّة مرّات. وفي كلّ مرّة كانت تتوقّف لبرهة قبل أن تضيف، والشعورُ بالذنب ينضح من كلماتها: "أظنّه مات من الجوع." أمّا أين كان بيت هذا الـ"جدّو،" أو كيف عاشت بعد وفاته، ومَن اهتمّ بها بعد ذلك، فلم تُفصح عن شيءٍ من هذا على الإطلاق. المعلومة الوحيدة (التي ظننتُ أنّها تسرّبتْ منها) جاءت عبر صورةٍ رأيتُها تحت وسادتها ذاتَ يوم: كانت صورةً قديمةً، بالأسود والأبيض، لسيّدة جميلة، تَظهرُ كأنّ أحدًا نبّهها من الخلف فالتفتتْ إليه وصوَّرها. لم يكن هناك أثرٌ لابتسامةٍ، كما هي العادة في مثل هذه الصور، وحلّتْ محلَّها نظرةُ غزالةٍ فاجأتْها حركةٌ قريبةٌ، فنظرتْ مذعورةً تبحثُ عن مصدر الصوت. عندما رأتْني أتمعّنُ في الصّورة هجمتْ عليّ وانتزعتْها من يدي، ثمّ خبّأتْها في جيبٍ داخليّ من سترتها.
ــــ صورةُ مَنْ هذه؟
ــــ إنّها لأُمّي.
كلّما عدتُ بذاكرتي إلى تلك الأيّام أستغربُ قدرةَ مينا على الكلام والتعبير والتصرّف وهي في ذلك العمر الصغير. وكنتُ أستغربُ أكثر حفظَها للكثير من الحكايات. صحيحٌ أنّها كانت تختصرُ في كلامها وحركاتِها وتعابيرِ وجهها، لكنّها كانت تقول الأشياءَ من دون مواربة؛ تقولها كما تراها ولا تهتمّ لوجهة نظر الآخرين. واكتشفتُ مع الأيّام أنّها كانت تتمتّعُ بميزةٍ مناقضةٍ تمامًا لطبيعتها تلك، تستخدمها في الأوقات المناسبة: كانت تمتلك قدرةً غريبةً على الكذب والادّعاء. وفهمتُ لاحقًا أنّها كانت تفعلُ ذلك لتحمي عالمها الهشّ. فتلك الصورة التي ادّعت أنّها لأُمّها تَبيّن أنّها صورة الممثّلة المصريّة فاتن حمامة. لم أكن حينها أعرف فاتن حمامة، بل علمتُ ذلك من أمّي في ما بعد، حين برّرَتْ تصرّفها قائلةً بحزن: "المسكينة تريد أمًّا!" تساءلتُ أكثر من مرّة: "أهي مقتنعة فعلًا بهذه الكذبة أمْ كانت تُمثّل أمام الآخرين؟" ورجّحتُ الفرضيّة الثانية، حين علمتُ أنّ أختي وأمّي شاهدتا الصورةَ مثلي. وتأكّدتُ أكثر حين عرفتُ أنّها كانت تتعمّد إظهارَ طرف الصورة من تحت وسادتها كي نراها ونسألَها عنها.
***
بعد شهر ــــ بدا أطول من المعتاد ــــ فتحَتْ لي مينا بابَ غرفتها، واستقبلتني كما كانت تفعل في السابق. لم نتكلّم عمّا حصل. لم تسألني، ولم أسألها. جلسنا معًا نصفَ ساعة شبه صامتيْن. وقبل أن أغادر، دار بيننا الحوارُ الآتي:
ــــ هل تُحبّ المغامرات؟
ــــ تعرفين أنّني أحبّها.
ــــ هل تذهب معي اليوم مساءً؟
ــــ أذهب. ولكنْ إلى أين؟
ــــ ستعرف مساءً.
كنتُ سعيدًا بهذا التحوّل. فضممتُها وحاولتُ تقبيلها، لكنّها أشاحت عنّي بوجهها قائلةً بغنج: "اتركْ شيئًا للمساء." كان الفصل شتاءً، والجميعُ ينام باكرًا. وكنتُ متلهّفًا لمغامرة المساء. ما إنْ صارت الساعة العاشرة حتّى سمعتُ، بحسب الاتّفاق، نقرًا خفيفًا على زجاج نافذتي. أزحتُ الستارة فرأيتُها تحت ضوء الشارع الخفيف متلفّعةً بشالٍ صوفيّ، وتحت إبطها شيءٌ لم أميّزْه. خرجتُ، وتبعتُها بصمت، إلى أن وصلنا زاويةَ الشارع، حيث التفَّت حول المبنى البشع المكسوّ بالسيراميك، الذي يحتلّ الطابقَ الأرضيَّ منه فرنُ أبو صطيف. حينها فقط عرفتُ وجهتنا، وشعرتُ بالأدرينالين يغزو أوردتي. في الجهة الخلفيّة من المبنى وجدتُ النافذة التي تكلّمتْ عنها لا تزال على حالها: مخلوعة القضبانُ، مكسورة الزجاج، ولم تكن بالعلوّ الذي تخيّلتُه. بحركة واحدة صارت مينا فوق، ومدّت يدها إليّ. رفضتُ أن تساعدني، وقفزتُ مثلها، وبعد لحظات كنّا في الداخل. راقبتُها وهي تزيح اللوح المعدنيّ الذي يُغطّي فتحة بيت النار، ولحقتُ بها ما إنْ وَلَجتْهُ وقلبي يكادُ يخرج من بين أضلاعي. وتبيّن أنّ اللفافة التي كانت تتأبطّها هي البساطُ الصوفيّ السميك الذي كنتُ أراه فوق سريرها طوال الوقت. وها هي تفرشه على الأرض بحركة سريعة وتتمدّد فوقه.
"إنّه أشبهُ بالرحم": الدفءُ وتكوينُ المكان جعلاني أفكّر هكذا وأنا أجول بنظري متفحّصًا ما حولي. فاجأتني مينا بإشعالها عودَ ثقاب، وإيقادِها شمعةً صغيرةً، وبزجاجة نبيذ، وكأسيْن، وتفّاحتيْن. أخرجتْ كلَّ ذلك، كما يفعل الساحر، من حقيبتها القماشيّة التي لم أكن قد انتبهتُ إلى وجودها ونحن في الطريق. وخلال دقائق كنّا نقرع كأسيْنا ونضحك ملءَ قلبيْنا، ونتبادل القُبَل المجنونة، وظلالُنا تستطيل وتمتدّ حولنا كأنها أرواحٌ تشاكسنا طوال الوقت.
بعد عدّة كؤوس بدأتُ أشعر بخلايا جسدي تطلبها. وظهرتْ في عينيْها الشهوةُ التي كنتُ أنتظرها. وقالت ضاحكةُ: "استَوينا."(3)
"استوينا." كرّرتُ خلفها وأنا أنزع ثيابَها قطعةً قطعةً، ممرِّغًا وجهي بصدرها وعنقها وشفتيها، حتّى أصبحتْ عاريةً بين يديّ. كانت تشهق وتضحك، وتبادلني القبلات، وتنزع عنّي ثيابي في الوقت ذاته. بدَتْ متحرّرةً من كلّ شيء، وتريدني حتّى آخر شهقة. ولم أستطع منعَ نفسي، وأنا في أكثر لحظات الإثارة، من ملاحظة رائحة الخبز التي اختلطتْ بعرقنا. وكنتُ أشعر بطعمها وأنا أطبع قبلاتي فوق جسدها وهي تهمس في أذني بجنون، المرّةَ تلو المرّة: "كُلني، كُلني..." وكنتُ آكلها بتلذّذ، وأذهبُ بعيدًا في خيالي إلى جبال مدينتي، حيث النساءُ يخبزن، لأشاركهنّ في تخمير العجين، والعجن، والتقريص،(4) وإيقاد التنّور، وإحمائه، والرَّقّ،(5) ووضع الأرغفة في التنّور، وإخراجها ناضجةً كقمرٍ مكتملٍ في ليلة صيف.
كنتُ غارقًا في اللذّة، أُحلّقُ في عالمٍ آخرَ، فاردًا جناحيَّ للريح، أجوبُ تضاريسَ الجسد الفتيّ. أقتربُ، أبتعدُ، تلامسُ شفتايَ هضابَها بخفّة ريشة. أميلُ بجناحيّ أضربُهما في الهواء. أعلو وأعلو، ثمّ أعودُ سابحًا بهدوء، لأغوصَ عميقًا حيث أحترقُ، لأُبعثَ من جديدٍ كطائر الفينيق. وهكذا... حتّى نضجنا معًا كرغيفيْن شهيّيْن، مضمّخيْن برائحة الخمر والتفّاح والقمح.

***
في تلك الليلة فقدتْ مينا عُذريّتها وكانت سعيدة بذلك، على خلاف ما كنتُ أشعر به. وقد لاحظتْ خوفي، فسألتني:
ــــ ما الأمر؟
ــــ لا شيء.
لم أكن أمتلكُ الخبرة الكافية للتصرّف في مثل هذه المواقف. وكانت مينا تعرف ما تفعل؛ كانت هادئةً بطريقةٍ مغيظة. أذكر جيّدًا كيف اجتاحتني رغبةٌ هائلةٌ في صفعها، لا لسبب إلّا لأنّني شعرتُ بأنّها تسخر من الذعر الذي بدا جليًّا في نظراتي وكلماتي المرتبكة. كنتُ أفكّر في طريقةٍ للتنصّل ممّا حصل. كنتُ أريد إلقاءَ اللوم عليها، لكنّ الكلمات خانتني. والغريب أنّها عرفتْ ما يدور في ذهني، فقالَت بهدوء: "لا تخفْ. لن تتحمّل عبءَ ما حصل." ثمّ أكملتْ بعد أن تأمّلتني لبرهة: "كنتُ أريدُ ذلك." فأحسستُ بضآلتي أكثر.
***
يتساقط الثلج في الخارجِ بهدوء، وأنا جالسٌ قرب النافذة أراقبُ الدخانَ المتصاعدَ من فوّهات المداخن المزروعةِ على سطوح الأبنية المقابلة. بين يديّ روايةٌ باللغة الإنكليزيّة، تدور أحداثُها في مدينة لندن، وتتحدّث عن شابٍّ فقير، يعمل في مخبزٍ، ويقع في حبّ صبيّةٍ تتردّد إليه يوميًّا لتشتري الخبزَ وهي عائدةٌ من عملها. تعرض الرواية مرحلةً من تاريخ لندن، حيث أسكنُ الآن، وتدور معظمُ أحداثها في حيّ يُدعى سوهو. وقد وصف هذا الحيَّ كولن ويلسون في كتابه: ضياع في سوهو. لم يكن وصفًا مشجِّعًا على الإطلاق، إذ اعتبرَه مكانًا للعبث واللهو والشذوذ بأشكاله كافّةً. أيقظتْ ذاكرتي تفاصيل علاقة الحبّ بين بائع الخبز وحبيبته، وأعادتني إلى الماضي البعيد، وإلى مينا... أو بالأصح: إلى معلّمتي مينا، التي سامحتني من جديد، وكان لها الفضلُ في اكتشافي عالمَ المرأة والجنس والحبّ. وتذكرتُ كيف التقينا عدّة مرّات لاحقًا في الفرن، وكيف توهّج "بيتُ النار" بجسديْنا الضاجّيْن بالحياة، وكيف عشنا تلك اللحظات من جديد وتخطّينا إرهابَ الدين والمجتمع، وكسَرْنا جدارَ خوفنا بقلبيْن راجفيْن شكّلا رابطةً سرّيّةً بيننا، اعتبرتُها شيئًا مقدّسًا في ذلك الوقت.
تذكّرتُ مينا التي تفوّقتْ عليّ أخلاقيًّا وإنسانيًّا، وعرفتْ أنّ وجودَها في بيتنا لن يكون في صالحي. كنتُ متيّمًا بها، وكانت تعرف أنّ هذا سيقضي عليّ في آخر الأمر. وجاء رسوبي في صفّي ليؤكّدَ لها ذلك، فاختفت في إحدى الليالي فجأةً، كما ظهرتْ قبل سنوات، ولم تترك خلفَها من أثرٍ سوى صورة فاتن حمامة التي وجدتُها في مكانها المعتاد تحت وسادتها، فاحتفظتُ بها وبقيتْ ترافقني أينما ذهبتُ. وها هي الآن أمامي معلّقة على الجدار في إطار أنيق، أنظر إليها والدموعُ تحتقن في عينيّ.
اللاذقيّة
1- القضّوضة: الشطيرة أو السندويشة.
2- الكاتالوك أو الكاتالوج: مجلّة تحتوي على صور جنسيّة (بورنو). هكذا كنّا نطلق عليها في ذلك الزمن.
3- استوينا: نضجنا (إشارة إلى نضج الخبز في بيت النار).
4- التقريص: تشكيل العجين على شكل أقراص بحجم قبضة اليد تقريبًا.
5- الرَّق: بسْطُ أقراص العجين، وتحويلُها إلى رقائق دائريّة، من خلال ضربها بالأكفّ وتقليبِها، قبل وضعها في التنّور لتنضج.