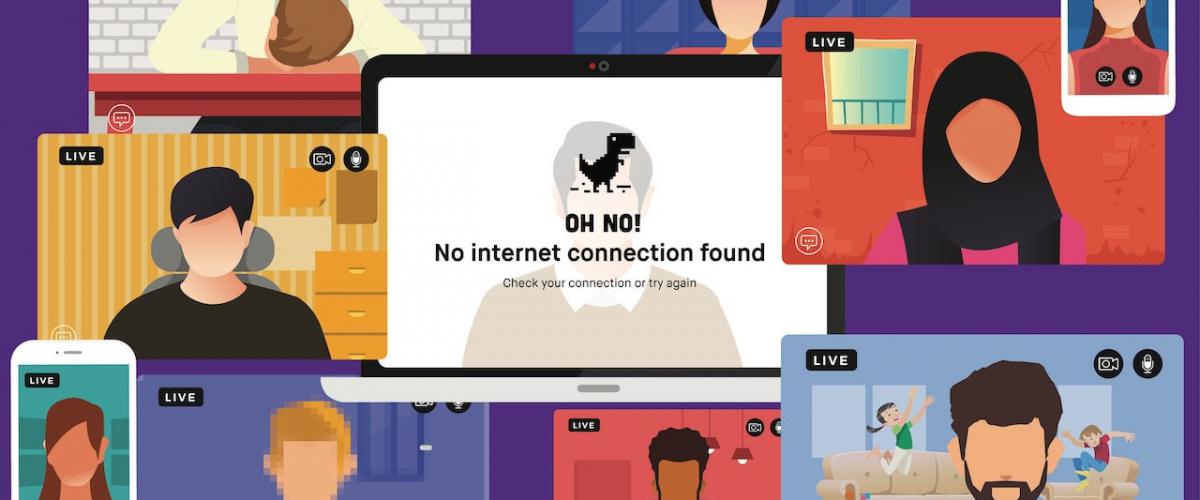كنتُ أعرفهم.
يومَ صدر قرارُ وزارة التربية بتاريخ 28 شباط 2020 بإقفال المدارس والجامعات في لبنان تجنّبًا لانتشار وباء كورونا، كنتُ على معرفةٍ وثيقةٍ بطلّابي في الجامعة اللبنانيّة الأمريكيّة - كلّيّة الإعلام، بعد مضيّ ما يقارب نصفَ الفصل الدراسيّ (وكان بالمناسبة الفصلَ الأوّلَ لي كأستاذةٍ جامعيّة). بدأتْ مرحلةُ العزل والإقفال، وأنا على معرفةٍ تامّةٍ بهويّة صاحب الخيال الأوسعِ بينهم، وصاحبةِ النكاتِ الألذعِ والقدرةِ على ابتداع الـ"الميمز" أو الصور الإلكترونيّة النقديّة الساخرة. صوري الذهنيّة عن الطلّاب حاضرةٌ من دون جهد، مدعَّمةً بأرشيفٍ من المواقف والاختبارات. أعرف مَن يسارع إلى الجلوس في المقعد الأماميّ، ومَن يتعمّد الجلوسَ في الركن الأبعدِ من القاعة. مدركة تمامًا مَن يُكْثر التذمّر، ومَن يُكْثر العمل. عرفتهم.
الزووم والموعدُ المؤجَّل
فترةٌ وتمضي.
هكذا اعتقدنا.
لا يُنْكر الطلّابُ فرحتَهم في اليوم الأوّل من إبلاغنا إقفالَ الجامعات. اعتقدوا أنّها ستكون بمثابة إجازةٍ مؤقّتةٍ لهم وراحة - مدّة أسبوعين - نعود بعدها إلى القاعات وضغطِ تسليمِ الأبحاث. وضعْنا موعدًا تقريبيًّا كي يقدِّموا عروضَهم البحثيّةَ أمام الصفّ في القاعة.
استفحل الكورونا. تأجّل الموعد. وسرعان ما تنبّه الطلّابُ إلى أنّها ستكون مرحلةً أشدَّ صعوبةً بكثيرٍ من زمن القاعات. والأسبابُ عدّة: لم نكن بعدُ مهيَّئين تقنيًّا - أو نفسيًّا - لخوض تجربة التعليم عن بُعد، وأغلبُ المحاضرات كانت قد صيغت بشكلٍ يعتمد بكثافةٍ على الحضور الشخصيّ. فاعتمدنا، في البداية، على نشر الرسائل الصوتيّة المطوَّلة أو الفيديو المسجّل مسبَّقًا لشرح الدروس تفصيليًّا للتلاميذ.
بعد تخبُّطنا الأوّل مع واقعنا الجديد، تعرّفنا على تطبيق زووم ومميّزاتِه التفاعليّة المباشرة تحت إشراف إدارة الجامعة. الاعتياد على زووم تقنيًّا كان أسهلَ ممّا توقّعتُ، لكنّ حاجزًا نفسيًّا ما بدأ ينشأ. تأجّل الموعد. الطلّاب يشعرون بالغربة. صار عليهم إعدادُ أوراق بحثيّة وفيديوهات بتعليماتٍ سريعةٍ يتلقّوْنها من خلف شاشة. حتى إنّني لم أكن مهيّأةً ضمنًا لتلقّي هذا القدْر من رسائل الطلّاب الإلكترونيّة الاستفساريّة ليلَ نهار، وللردّ عليها. شعرتُ في البداية أنها تقتحِم عليَّ عُزلتي وحاجتي الوجوديّة إلى هذه العزلة.
كنّا نستهلّ الصفَّ في كلّ مرّةٍ بآخرِِ مستجدّاتِ كورونا في لبنان. فساعةُ المحاضرة (والزووم عادةً يقطع الاتصالَ كلَّ 40 دقيقة) كانت تبدأ تقريبًا في موعد صدور تقرير وزارة الصحّة نهارًا عن أعداد مصابي كورونا اليوميّ (في بداية الأزمة كان التقريرُ يصدر نهارًا، وبعدها بات يصدر ليلًا). لذا، دائمًا ما كان يتطوّع أحدُ التلاميذ في بداية حصّة الزووم لمشاركة أعداد المصابين في ذلك اليوم - وكانت قلّما تتجاوز الثلاثين حينها. لكنّ خوفَنا كان عميقًا. خوفُنا كان جديدًا.
مضى الفصلُ كلُّه ونحن في رحاب الزووم.
لم نعد إلى القاعة. أُلغي الموعد.
"لا داعي للهلع"
حالةٌ من الهلع تنتابني. غريب! ها أنا أجلس في بيتي في غرفة الجلوس المريحة، فلِمَ أجْزَعُ هكذا؟ ما كنتُ سأجزع على هذا النحو أمام قاعةٍ مليئةٍ بوجوهٍ جديدة! لكنّها دقائقُ معدودةٌ فقط وأعْبرُ نحو العالم الافتراضيّ، فأكونُ في مواجهة أكثر من 40 تلميذًا جامعيًّا لم أرهم في حياتي قطّ - من خلف شاشة الكمبيوتر.
الفصل الجامعيّ الثاني، الحاليّ، بدأ من يومه الأوّل باعتماد تقنيّات التعلّم "أونلاين" عن بُعد. الوضع هذه المرّة مختلفٌ عن المرّة السابقة. أنا أجهلُهم. أنا خائفة. أخاف ألاّ أخترِقَ الشاشة. كيف أحفظ أسماءَهم كلَّها وأميّزُ الأصواتَ والشخصيّاتِ افتراضيًّا؟ كيف لي أن أوجِدَ لغةً مشتركةً بيننا، وأنا لا أرى انعكاسي في عيونهم؟

كيف لي أن أوجِدَ لغةً مشتركةً بيننا وأنا لا أرى انعكاسي في عيونهم؟
كنتُ قد نويتُ في الأسبوع الأوّل الحديثَ عن المادّة بشكلٍ عامّ - كما أفعل عادةً. لكنْ، مع بدْء حصّة الزووم الأولى، اكتشفتُ أنّها الفكرةُ الأسوأُ على الإطلاق. لا، لم يحِنْ موعدُ الكِتاب بعد، وليس هو المهمَّ الآن. أُغيِّرُ رأيي. أضعُ الكتابَ جانبًا، وأسألُهم عن اهتماماتهم، مواهبِهم، قضاياهم. يأخذنا الحديثُ إلى انفجار مرفأ بيروت: ماذا كان كلٌّ منّا يفعل لحظةَ الإنفجار؟ كيف تأثّرتْ حياتُه؟ يقول معظمُهم إنّه يطمح إلى الهجرة، وإنّه ما عاد يطيق حالَ البلد. صوري الذهنيّة عن كلٍّ منهم بدأتْ تتشكّل.
بدأتُ أعرفهم.
الزووم نهجًا
كان عليّ هذا الفصلَ تدريسُ مادّتيْن: الأولى عن التربية الإعلاميّة لتمكين الفئات المضطهَدة، والثانية عن فنّ الخطاب والتواصل الشفهيّ.
يا لَلهول! فنُّ الخطاب مِن على الزووم؟!
تبدو لي هذه المهمّةُ خاليةً من الروح، تمامًا كتعليم التمثيل المسرحيّ أونلاين! كيف أتخطّى هذا الحاجز؟ كيف أتناسى أنّ إحدى أبرز ركائز فنّ الخطاب تعتمد على مواجهة الجمهور خارج حدود مساحتنا الآمنة، وعلى النظرِ المباشر في عيونهم، والتحرّكِ بديناميكيّة ضمن مساحة المنبر المتاحة للخطيب؟ الآن، بعضُنا في الصفّ يجلس على سريره أو أريكته، بانتظار إتقان فنّ الخطاب!
حسنًا، العالم يتبدّل. فنُّ الخطاب يتبدّل. بدلًا من المسارح والمنابر، ضاق الجسدُ وضاقت المساحة، وبات لنا ركنٌ خطابيٌّ، هو عبارةٌ عن مربّعٍ صغيرٍ يَظهر من خلاله وجهُ المتحدِّث ويداه مِن على الزووم خلال عرضه إمكاناتِه الخطابيّةَ أمام جمهورٍ مباشر.
علينا، إذًا، إعادةُ تخيّل مفهوم "الخطابة" ضمن الواقع الرقميّ: قد يكون الخطيبُ الأكثرُ تأثيرًا اليوم هو نفسَه ذاك الجالسَ في مواجهة كاميرا الهاتف ليتحدّث عن قضايا حقوقيّةٍ وتحرّريّةٍ من على متن أريكته!
أمّا محاضراتُنا التفاعليّةُ المباشرة، فقد تجنّبتُ تسجيلَها - أو سجّلتُ بعضَها على مضض عند الضرورة - ليشاهدَها التلميذُ لاحقًا كمادّةٍ مسجلّةٍ متوفّرةٍ إلكترونيًّا إنْ فاته الصفُّ المباشرُ بسبب سوء شبكة الانترنت في لبنان. لكنْ، على الرغم من أنّ هذه الفكرة عمليّة، فإنّني لم أكن أريدُ للتلاميذ أن يشعروا بأنّهم تحت كاميرا المراقبة الإلكترونيّة خلال تعبيرهم عن آرائهم النقديّة من شتّى القضايا الاجتماعيّة والسلطويّة. أردتُها مساحةً آمنةً لنا. أنا عادةً أُحفِّز الطلّابَ على تحدّي نُظُمِ الرقابة، فلا يُمكنني - إذًا - أن أُشْعرَهم بأنّهم تحت نظامٍ رقابيٍّ صارم، شبيهٍ بكاميرات وزير التربية السابق أكرم شهيِّب خلال الامتحانات الرسميّة!
أملٌ رقميّ... أملٌ افتراضيّ
يُخْبرني أحدُ الطلّاب أنّه فقد والدَه جرّاء وباء كورونا قبل أسبوعيْن فقط من بدء الفصل الدراسيّ الحاليّ. كلَّ أسبوع، يُرسل إليّ طالبٌ أو طالبةٌ تقريرًا طبّيًّا يفيد بإصابته أو إصابتها بوباء كورونا.
تُصارحني المستشارةُ النفسيّةُ في الجامعة بحالةٍ نفسيّةٍ دقيقةٍ، وحاجاتٍ تعليميّةٍ خاصّةٍ، تتعلّق بأحد طلاّبي، من أجل أخذها في الاعتبار في سياق التعليم الرقميّ.
أحد الطلاب يُطْلعني على مصاعبَ مادّيّةٍ يعانيها في تسديد القسط الجامعي جراء الأزمة الاقتصاديّة، ويقول إنّه لم يستطع تسديدَ قسط الشهر الماضي بعد.
معظمُ الطلّاب الآن يعاني الفقدَ والمرضَ والقلقَ والاكتئاب. وأنا بتُّ أشعر بأمومةٍ ما نحوهم، أمومةٍ من خلف الشاشة. يجب أن أزوّدَهم بالأمل، أليس هذا أيضًا جزءًا من مهمّتي ومن واجبي الأخلاقي كمُدرِّسة؟ كأمٍّ افتراضيّة؟
لكنْ، صدقًا، أصعبُ التحدّيات الحاليّة هي أن تبثّ أملًا أنتَ نفسُك الآن تفقدُه وتفتقدُه. لا يمكن أن تبدو متشائمًا في عين التلاميذ. يجب ألّا يَلْحظَ أحدُهم أنّني لم أنم الليلةَ الماضيةَ من كثرة قلقي ومخاوفي من المستقبل. لا يحقُّ لي أن أريَهم الخوفَ في عينيَّ. في الواقع، اكتشفتُ أنّ التحدّي الأكبرَ لنا اليومَ في قطاع التعليم، في ظلّ الوضع الحاليّ المأساويّ في لبنان، لا يكمُن في صعوبة التعليم الإلكترونيّ عن بُعد، بل في القدرة على ابتداع "أملٍ رقميّ" للتلاميذ ، وإنْ كان مجرّدَ أملٍ "افتراضيّ."
بيروت