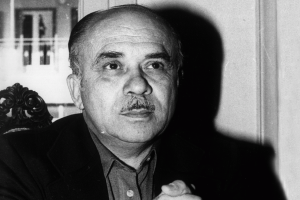إحدى اسوإ الآفات في العمل السياسيّ هي الاتّكال.
لن أقول إنّها آفة عربيّة، على ما يذهب إلى ذلك بعضُ المنظّرين العرب (شبهِ الاستشراقيين)، ولكنّها بالتأكيد ظاهرةٌ بارزةٌ في المشهد العربيّ على الأقلّ.
نعم، ثمّة استشراءٌ مخيفٌ عندنا لثقافة الاعتماد على الآخرين. و"الآخرون" هم الدولةُ، والأحزابُ، ووسائلُ الإعلام، ومنظّماتُ المجتمع المدنيّ، وغيرها. الطريف في الأمر أنّنا نُلقي بتبعات أيّ إخفاقٍ يواجهنا، أو أيّ إحباطٍ يصيبنا، على أحدِ هذه الأطراف أو بعضِها أو جميعِها، فيما نحن نؤكّد أنّنا لم نكن نعوِّل عليها أصلًا!
من تجربة شخصيّة أقول: إنّ مناهضة التطبيع مع "إسرائيل" هي من أكثر الأنشطة التي تتعرّض لكيْد ثقافة الاتّكال. وهذه الثقافة تقتات بنزعاتٍ أخرى لا تقلّ سوءًا، وخصوصًا: نزعات المزايدة، و"خالفْ تُعرَفْ،" والشعور بالدونيّة الحضاريّة. وغالبيّتُها تُستخدم من أجل تبرير القعود، وتبرئةِ الذات الاتّكاليّة من تحمّل مسؤوليّتها عن التغيير.
خذوا المسألة الأخيرة التي أثيرت حول المخرج اللبنانيّ المطبِّع زياد دويري. فحين أفلحتْ حملةُ المقاطعة في لبنان في استصدار قرار من جامعة الدول العربيّة، عبر مكتب المقاطعة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، بمنع فيلمه الذي صَوّر أجزاءً منه في فلسطين المحتلّة طوال 11 شهرًا، حظي عملُ الحملة بترحيب واسع من طرف القوى الوطنيّة بشكلٍ عامّ. لكنْ، حين سُمح للمخرج نفسِه بتصوير فيلمه الجديد في لبنان، بلا محاسبةٍ ولا محاكمةٍ ولا استجوابٍ ولا عقاب، تعالت الأصواتُ من طرف بعض هذه القوى (المرحِّبة سابقًا!): "أين كانت حملةُ المقاطعة؟ أين كان مكتبُ المقاطعة؟" وكأنّ مواجهةَ الخروق التطبيعيّة الكثيفة مسؤوليّةُ حفنةٍ من المتطوِّعين وغير المتفرّغين، أو مسؤوليّةُ مكتبٍ صغيرٍ لا يسع أكثرَ من ثلاثة أشخاص (بمن فيهم الموظّفةُ اليتيمة) في الوزارة المذكورة!
والأمثلة أكثرُ من أن تحصى، وهي تُبرز اتّكالَ العديد من الفئات (التي لا يُشكُّ في وطنيّتها وقوميّتها) على حملة المقاطعة من أجل كشف الأفلام ذات المكوِّنات الإسرائيليّة، والكتبِ الإسرائيليّة، والسلعِ الإسرائيليّة، والفنّانين والمثقفين ذوي المواقف المطبِّعة أو المتصهينة. صحيح أنّ ذلك الاتكال يَعكس ثقةَ كثيرٍ من هؤلاء الاتّكاليين بحركة المقاطعة وأدائها، لكنّ هذه الحركة عاجزةٌ وحدها عن الوفاء بمستلزمات تلك المهمّةِ الشاقّة.
إنّ العدوّ يعوِّل كثيرًا على تلميع صورته الدمويّة في أذهان العالم، ويَصرف ملايينَ الشيكلات ويقيم المؤتمرات الضخمةَ لمحاربة حركة المقاطعة العالميّة. لذا، فإنّ حملاتٍ صغيرةً لن تكون قادرةً وحدها على الفضْح والمتابعة والتعبئة، ومن ثمّ المواجهة؛ خصوصًا إذا تمرّدتْ دولتُنا نفسُها على قانون المقاطعة، وكافأت المطبّعين، بل رشّحتْهم لجوائز الأوسكار، كما حدث في حالة المطبّع دويري.[1] وبدلًا من أن يمدّ الوطنيون إلى حملات المقاطعة يدَ العون عند الحاجة، أو ينشئوا حملاتِ مقاطعةٍ بديلةً "أكثرَ فعّاليّةً" مثلًا، فإنّهم يسلقون حملاتِ المقاطعة الموجودة بألسنةٍ حِداد!
أذكرُ، قبل أعوام، أنّني كنتُ، بمعيّة رفيقاتي ورفاقي في حملة المقاطعة، نوزِّع على المارّة مناشيرَ تحت جسر الكولا. فمرّ أحدُ الكتّاب الصحفيين والوطنيين. صافحني وربّت على كتفي قائلًا: "يعطيكم العافية. أنتم رمزُ الكذا وعنوانُ المذا و..." قاطعتُه ضاحكًا: "الله لا يعطينا العافية بجاه النبي والمسيح. نحن لا كذا ولا مذا. تفضّلْ وزّعْ معنا يا خواجة."
لن يستطيعَ مجتمعُنا، في حالته الراهنة، أن يتقدّمَ كثيرًا في مواجهة "إسرائيل" وداعميها إنْ واصل كلٌّ فردٍ فينا الاتّكالَ على الآخر ثم نقدَه إنْ "قصّر." وفي مواجهة ثقافة الاتّكال الاستسلاميّة، لا بدّ من تعزيز ثقافة المبادرة على مستوى الأفراد والتشكيلات الصغيرة والمتوسّطة. صحيح أنّ النصر النهائيّ لن يكونَ إلّا بتفعيل الأحزاب والنقابات والهيئات، وتصحيحِ اختلالاتها الحاليّة المريعة، وصولًا إلى بناء مجتمع ودولة ووحدات إقليميّة عربيّة متماسكة ومتعاونة؛ غير أنّ الركونَ إلى مثل هذه الحلول الإستراتيجيّة الكبرى من دون عمل تراكميّ ويوميّ لن يقود إلّا إلى المزيد من الإخفاق والإحباط.
بيروت